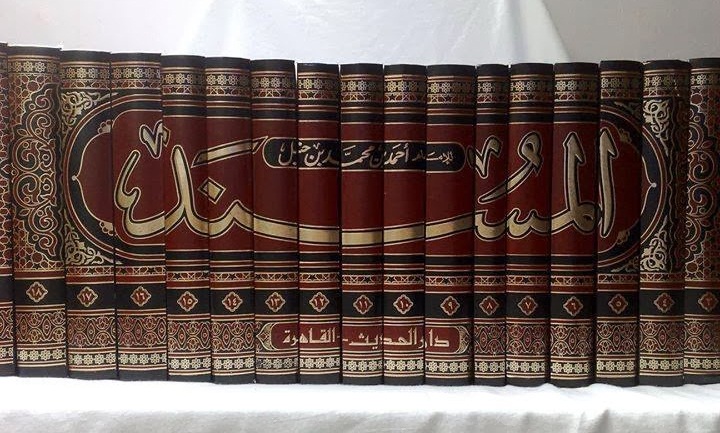السَّلفيَّة السائِلَة.. «مفهومُ السَّلفيَّة» في مساربِ «ما بعد السَّلفيَّة»


هوية بريس – د. عبد الله العجيري
الثلاثاء 28 أبريل 2015
اعتراف
لي مدَّةٌ ليستْ بالقصيرةِ لم أكتبْ فيها شيئًا ذا بالٍ؛ لذا فإنِّي أشعُرُ بثِقَل القَلمِ في يدي، وأجِدُه يزداد ثِقَلًا حين يَهُمُّ بكتابة نقديةٍ لأصدقاءَ لهم في القلبِ مكانةٌ، (ولو كان قولُ ما يراه الإنسانُ حقًّا يُتْرَكُ لشيءٍ= لَتَرَكْتُه كرامةً لصُحْبةٍ أخشى فَقْدَها. لكنَّ الحقَّ أمانةٌ، وإذا لم يوجَدْ من يقومُ به= لم يَجُزْ تَرْكُه لوَجْهِ أحدٍ من النَّاسِ)، وأنا على ثقةٍ تامَّةٍ أنَّ ما سأكتبه لن يؤثِّرَ على صحبةٍ أو يُزيلَ وُدًّا.
البداية
حين بدَأْتُ بمطالعةِ كتابِ “ما بعد السَّلفيَّة” للصَّدِيقينِ ش. “أحمد سالم” وش. “عمرو بسيوني”، كنتُ حريصًا على أن تتخلَّقَ في نفسي انطباعاتي الذَّاتيَّة عن الكتابِ بعيدًا عن ضَغْطِ تأثير انطباعاتِ الآخَرينَ، خصوصًا وأنا أعلَمُ أنَّ الكتابَ سيكون كتابًا جَدَليًا بامتيازٍ، وسيُحْدِثُ جدَلًا في المشهد الفكريِّ والشَّرعيِّ بشكلٍ عامٍّ، وفي الداخِلِ السَّلفيِّ بخاصةٍ.
والذي ستتشكَّلُ فيه بُؤَرُ ممانعةٍ ذاتيةٍ طبَعِيَّةٍ مِن النَّقْد والمراجعة؛ فبَعضُ النُّفوسِ قد لا تحتمِلُ النَّقْد، وبعضُها قد تحتمله، ولكن لا تحتملُ أن يكونَ مُعْلَنًا. وأجدني -بحمد الله- كما أجِدُ غيري ميَّالًا إلى استيعابِ الممارسَةِ النَّقديَّة واسِعَ الصَّدرِ لها، بل داعيًا ومُرَحِّبًا بها كَوْنها ضرورةً لتصحيحِ المسار، ومعالجَةِ الأخطاءِ، وإذا أنتَ لم تسمَحْ للمُحِبِّ القريبِ بالمراجَعةِ والنَّقْد، فاحتَمِلْ جنايةَ البعيدِ بالبَغْيِ والتَّشْويهِ.
ومع قناعتي بأهميَّة الفِعْل النقديِّ إلا أنه لا يعني الرِّضا بأيِّ نَقْد وقبولَ أيِّ مراجعةٍ، بل أجدني متشوِّفًا جدًّا للتَّعرُّفِ على المضامينِ النَّقديَّة ذاتِها، وتَقْييمِها من جِهةِ الصَّوابِ والخطأ، بل وَفَرْزِ ما كان خطأً وصوابًا إلى درجاتٍ بحَسَب رُتَبِها من جهةِ القَطْع والظَّنِّ، ثم التفاعُلِ معها بحَسَب درَجاتِها حماسةً لما أَجْزِمُ بصوابِه، وحماسةً بالضِّدِّ لما أجزم بخَطَئِه، في مقابلِ شيءٍ من الفُتُور حيالَ بعضِ الأفكارِ الأقَلِّ درجةً.
نعم، كانت تتسرَّبُ إليَّ بعضُ المواقِفِ السَّاخِطَة على الكتابِ من هنا وهناك، والتي كانت تُعَبِّر في كثيرٍ من الأحيان عن حالَةٍ من الغَضَب دون أن تُقَدِّمَ في كثيرٍ من الأحيانِ مبرِّراتٍ واضحةً لهذا الغَضَب، أو تقدِّمَ مبرِّراتٍ لا ترقى لمستوى وطبيعةِ الغَضَب. فجاء بعضُ ما كُتِبَ حولَ الكتابِ وكأنَّه مجرَّدُ تقريرٍ وصفيٍّ للكتابِ، ولكنْ بِلُغةٍ غاضبةٍ متوتِّرةٍ.
وأعترِفُ أنِّي كنتُ متحيِّزًا للكتابِ تحيُّزًا ناشئًا عن طبيعةِ الوُدِّ والعَلاقة الجميلةِ التي تربطني بالأخَوَينِ الكريمينِ؛ ولذا فكنتُ أقرأُ الكتابَ قراءةَ مَن يُحْسِنُ ظنَّه بصاحِبِه، خصوصًا في تلك المواضعِ المجمَلَةِ التي تفتحُ لتعدُّد الفهومِ مجالًا، أو مواضِعِ الحيادِ التي أدرَجَها الكتابُ تحت بند (تأْريخ الأفْكار) وهو الموْقِف الذي أرى أنَّ الأخَوَينِ الكريمينِ لم يلتَزِماه حقيقةً، فجاءت تلك التحيُّداتُ في مواضِعَ لا تُناسِبُ الرِّساليَّة المعهودة منهما، وظَّلَتْ مع ذلك (تقييمات الأفكار) في غيرها متناثِرةً في مواضِعَ متعدِّدةٍ في طولِ الكتابِ وعَرْضِه.
نعم، لم يَرُقْ لي تصنُّعُ الحيادِ بين السَّلفيَّة والأشْعَريَّة في مسألةِ تأويلِ الصِّفاتِ، والقَبول بالموقِفِ السلفيِّ فيها تنزُّلًا، أو تحقيق موقِفِ الصَّحابة من مسألَةِ الاستغاثة بغيرِ الله، وهل بالإمكانِ القَطْع بإثباتِ التكفير به عنهم؟ لكني لم أقرَأْها قراءةَ من يُفَتِّشُ بين السُّطُور، ويتطلَّبُ معنًى غائبًا، ويتساءلُ لعلَّ وراءَ الأَكَمَةِ ما وراءها، بل أنا أعْرِفُ صاحبَيَّ وأنَّهما ليسا أشعَريِّينِ مُتستِّرينِ، أو دعاةً لقبوريةٍ في طَوْرِ تَقيَّة.
أنهيتُ الكتابَ سريعًا لأعاوِدَ الْتِهامَه مرةً ثانيةً. ولستُ أكتمُ سرًّا إن قلتُ إنِّي شعرْتُ بمرارةٍ وقلقٍ عميقٍ حيالَ كثيرٍ من المسائلِ والمباحِثِ، وكنتُ مهمومًا بدرجةٍ أكبرَ بتلك المسائلِ العِلْمية المُشْكِلة والتي لم تصادِفْ في تقييمي منهجَ أهلِ السُّنَّة والجماعة، أما جدليَّاتُ وصْف واقع المشْهَد السلفيِّ وتجليَّاته المعرفيَّة والإصلاحيَّة ومدى دقَّة التقييماتِ التي قدَّمها الكتابُ في هذا المضمار فهي مسائِلُ وإن وقع فيها ما أَعُدُّه تجاوزًا وما يصلح أن يكونَ مادَّةً دَسمةً للمراجعة والبَحْث بل والانتقاد لكنَّها احتلَّت في نفسي موقعًا متأخِّرًا نسبيًّا، بل لو كانت مُشْكلة الكتاب في هذه الدَّائرة فقط لهان الأمرُ عليَّ -واللهِ- مع شِدَّتِه في نفسه. فضلًا عن تلك الرُّؤى والأفكار الاجتهاديَّة التي يُمكن أن يكون الأَخَوانِ مُصِيبينِ فيها فِعلًا.
وكتابٌ تُقارِبُ صفحاتُه السَّبْعَمائة صفحة لا يُمكنُ أن يَتِمَّ التعرُّضُ لكافَّةِ أفكارِه ورُؤاه وتقديمُ رؤيَةٍ نقديَّةٍ متكامِلَة من خلال مقالةٍ مُفْردةٍ، بل يحتاجُ الأمر إلى كتاب موازٍ أو سِلْسلةِ مقالاتٍ متتابِعةٍ يُكْمل بعضُها نقصَ بعضٍ لتُغطِّيَ كافَّة مساحات الكتاب، وهي مساحات شاسِعَةٌ فعلًا، وأرجو أن تُقدِّمَ هذه المقالة رؤيةً نقديَّةً متحلِّيَة بالعلم والعَدْل والموضوعيَّة لواحدة فقط من تلك الأفكارِ الموجودة في الكتاب. والتي أرى أنها شَكَّلت أحد المُرْتكَزات التي قام عليها، وواحدةً من أهمِّ القضايا التي قدَّم فيها مراجعةً ورؤيةً جديدةً، وهو مفهوم السَّلفيَّة ذاتِها، ومَوْقِعها من خارطة المسلمين، ومدى أهمِّية وجود السَّلَفِيين في عالم اليوم، بل وفي التاريخ الماضي والمستَقبل.
السلفية بين رُؤْيتينِ
حين تناوَلَ الكتابُ “مُصطَلَح السَّلفيَّة” قدَّم مفهومًا يتضمَّنُ قدْرًا من الزيادة والخصوصِيَّة على ما هو موجودٌ في الكتابة السَّلفية، وهو ما أنتج اختلافًا في تحديدِ مَوقع السَّلفية من الخارطة الإسلاميَّة، وما الذي يمكن أن يتولَّدَ من إزاحة هذا التيارِ عن الخارطة بالكُلِّية. “السَّلفيةُ” في الذِّهْنية السَّلفيةِ هي معنًى مطابِقٌ “لمفهومِ أهْلِ السُّنَّة والجماعة” بمفهومها الخاصِّ، وهو -أي اسْم أهل السُّنَّة والجماعة- اسمٌ عريق في تاريخ الإسلامِ، وهو من ألوانِ التَّميزاتِ العَقَدية المبكِّرة والتي تواضَعَ أهْلُ السُّنَّة عليها كشعارٍ مُمَيِّز عن الفِرَق البِدْعِيَّة في الأمة، وكُنْ على ذِكرٍ لهذا المعنى واستحْضِر في نفسك عباراتِ السلفِ في استعمالاتهم لهذا الشِّعار المُمَيِّز، بل استحْضِرْ عامَّةَ التداول العِلْمي لهذا المصطلح في المُدَوَّنة العَقَدية قديمًا وحديثًا؛ فإنه سيكون نافعًا فيما سيأتي إن شاء اللهُ.
ويمكن القولُ إجمالًا إنَّ هذا التميُّزَ عائدٌ في أصوله إلى المُكَوِّن العلمي والمنهجي للسلفيَّة؛ فالأصلُ في التداول السلفيِّ لمصطلح السلفيَّة أن تُستعْمَل كتعبيرٍ عن منهج خاصٍّ في النَّظر والاستدلال يُفْرِز مُكوِّنًا علميًّا يمثل قائمةً من المُحْكَمات الشَّرعيَّة، وهي مع تلك الأُسُس المنهجيَّة تمثِّل حالةَ الفَرْق بين الخطِّ السلفي السُنِّي والتيارات الخارجة عنها، وهذا المنهج هو في حقيقته التزامٌ واجبٌ بهَدْي السَّلف الصالح، والذي يمثِّل فيه صحابةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم المَرْكزَ وتدور في فَلَكِه مقولاتُ ومواقِفُ التابعين وتابعيهم. وهذه الرؤيةُ السلفيةُ للسلفيةِ لم تَغِبْ عن الكتاب، بل أورد الكاتبانِ بعضَ المقولات لسلفِيِّينَ يُعبِّرون فيها عن هذه الرؤية لمفهوم السلفيةِ.
أمَّا رؤيةُ الكتابِ ذاتِه في تحرير واستعمالِ مفهومِ السلفيَّة فوَقَع فيه قَدْرٌ من الاضطراب والإشكال؛ فقد ظلَّ الكتابُ يُراوِحُ في استعمالاته للسَّلفية بين اعتبارها وصفًا إجرائيًّا وتأريخيًّا للتعبيرِ عن طائفةٍ من طوائف الأمَّة لها تميُّزُها العَقَدي الذي لا يلزم أن يكون صوابًا في نفس الأمرِ، وبين اعتبارها مفهومًا شرعيًّا ومنهجيًّا يتضمَّنُ قدْرًا من المَدْح والامتياز بالاعتزاءِ إلى السَّلَف الصالح وضرورة وَضْع اشتراطاتٍ شرعيَّةٍ خاصَّة لتصحيح مثل هذا الانتساب.
إضافةً إلى المُراوَحَة بين الطبيعة العِلمية للخطاب السلفي وكَوْنه يُمثِّل رؤيةً منهجيَّة تُفرِزُ مقولاتِه العلميَّةَ، وأخرى تستجْلِبُ المُكَوَّن العمليَّ وتجعله شرطًا في صِدْق الانتساب للخطِّ السلفي؛ ففي أوَّلِ صفحة من الكتاب مثلًا بل في أوَّلِ جُمَلِه يصادف القارئُ العبارةَ التاليةَ في سياقِ شَرْح السلفية: (السَّلفيَّةُ: هي طلَبُ ما كان عليه صحابةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهي منهجٌ يُطْلَب وليست حقيقةً تُحازُ، وكلُّ سلفيٍّ فهو كذلك من حيث إنَّه يَطْلُب التشبُّهَ بالسَّلَف ومَنْهَجِهم، لا من حيث إنَّه سلفيٌّ حقًّا، ومَن زَعَم اكتمالَ سَلَفِيَّته=كَذَب. والسلفيةُ المراد بها: الإيمانُ بما أجمعت عليه صحابةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إيمانًا بالقَوْل والعمل) [9]. ويزيد الأَمْر وضوحًا في إدخالِ المُكَوَّن العمليِّ في لُبِّ المفهوم السلفي: (فإنَّ السلفيَّةَ ليست مجرَّدَ مضامينَ معرفيَّةٍ مَن حازَها=فهو سلفيٌّ!) [11] وذلك عَقِبَ الحديث عن ضرورة طَلَب الدين الأوَّل ليس في بابَيِ التوحيد والقَدَر فحَسْب، بل في غيره من أبواب الأحكام والأخلاق والسلوك.
ويؤكِّد هذا المعنى بقوله: (بل إنَّ من أعْظَمِ البلايا: أن تتحوَّلَ السلفيةُ إلى حالة معرفيَّةٍ مجرَّدةٍ، ليس معها مقتضياتُها الإيمانيةُ من التحقُّقِ بأعمال القلوب، وعبادات الجوارح، ومكارم الأخلاق) [11] لكنه يعود فيقول: (السلفيةُ اسمٌ يَصْدُق على مفهومٍ معرفيٍّ / إبستمولوجيٍّ منهجيٍّ، ويَصْدُق على تحقُّقاتٍ تاريخيةٍ لأفرادٍ وجماعات حاولوا التزامَ هذا المنهج المعرفي ومقتضياتِه التطبيقيَّة) [81]. وما مِن شَكٍّ أنَّ لاستجلاب المُكَوَّن العملي بمخْتَلف تجليَّاته الأخلاقية والسُّلوكية والحُكْميَّة في تحرير مفهوم السلفية آثارَهُ العِلميَّةَ والعَمَليةَ، وأنَّ فروضَ الالتزام السلفي تبعًا لذلك ستكونُ بلا شكٍّ أوفَرَ وأكثرَ، ودائرة الإخلالِ بسلفيَّةِ الشَّخص ستكون بطبيعة الحال أوسَعَ وأكبرَ.
ومع قناعتي بأنَّ أصْلَ إدخالِ مُكَوَّن العمل في اسم السَّلفيَّة أو أهل السُّنة ليس فيه كبيرُ ضَيْرٍ إذا ما تحرَّر قَدْر هذا المكَوَّن ومنزلتُه مما أُدْخِلَ فيه. بل إنَّ أصْلَ هذا الإدخال مسألةٌ حاضرةٌ فعلًا في الوَسَط السُنِّي السلفي، وهو مَحَلُّ تداوُلٍ كبيرٍ في مصنَّفاتهم ومدَوَّناتهم بل ومُتُونهم العَقَدِية، يتم فيها الإشارةُ إلى مسائِلِ الأخلاق والعَمَل والتزكية كمُكَونات لمنهجِ أهلِ السُّنَّة والجماعة.
ففي واحدٍ من أشْهَرِ المتون العَقَدية السُّنِّية المركزية مثلًا، والتي يتخرَّجُ عليها عامَّة طلبة العلم في الأوساطِ الشَّرعيَّة السلفيَّة -أعني العَقَيدة الواسِطيَّة لأبي العباس ابن تيمِيَّة- جاء النصُّ في آخرها على (جماع مكارِمِ الأخلاق يتخلَّق بها أهْلُ السُّنَّة والجماعة)، فالمقصود أنَّ سائر هذه المكونات حاضِرةٌ فعلًا في كثير من الكتابات العَقَديَّة المختَصَرة والمُطَوَّلة في الإطار السلفيِّ، يتِمُّ من خلالها التأكيدُ على أن طريقة السَّلَف ليست تصوُّراتٍ نظريةً فقط، وإنما هي عِلْم وعمل، وأنَّ المرء يزداد لُحوقًا بالسلف بقَدْر اعتقاده وعَمَله. فإذا كان الأمْرُ كذلك ولم يكُنْ ثمَّةَ إشكالٌ مبدئيٌّ مِن دخول مُكَوَّن العمل في المفهوم، فأينَ المَأْزِق والإشكال؟ في ظني أن القضيَّة التي لم يتمَّ تحريرُها بشكلٍ دقيقٍ في الكتاب هي تحريرُ منزلة هذا المُكَون العمليِّ من اسم (السلفية) أو (أهل السُّنة والجماعة)، فالمُكَونات المُؤَسِّسَة لهذه المفاهيم ينبغي التمييزُ بين رُتَبِها ومدى تأثيرِها في إعطاء الاسم وسَلْبه، إما إعطاءً وسلبًا مُطلقًا أو إعطاءً وسَلْبًا نسبيًّا.
فلدينا (نواقضُ للمفهوم) و(أسبابُ القصور في تحقيق المفهوم) فالإسلام مثلًا له نواقِضُ يَخْرُج بها المرءُ من دائرته كالشِّرْك بالله، وسبِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والطَّعْنِ في الدين، وجَحْدِ معلومٍ من الدين بالضرورة، وهكذا، وله أسبابٌ لا ترفع الاسْمَ بالكلية، لكن يَنْقُص من الوصف بقَدْر ما ارْتُكِب من هذه الأسباب الموجِبَة لنقصانِ الوَصْف، فكذا مفهومُ أهل السُّنة ومنهج السلف له نواقِضُ كتعطيلِ الصِّفات، وإنكار القَدَر، والقَدْح في حُجِّيَّة النقل، يَخْرج بسببها المرءُ من دائرة أهل السُّنة، وله أسباب تَنْقُص من اتِّصاف المرء بالسُّنَّة وطريقة السَّلَف بقَدْر ما قَصَّر في الاجتهاد في أعمالهم وأخلاقهم دون أن تُوجِبَ خروجَه من الدائرة السُّنِّية أو السلفيَّة بإطلاق، ولئن جاز لغةً نَفْيُ اسمِ السُّنَّة والسلفية عنه باعتبار انتقاصه من كمال السُّنة الواجبِ لكن لا يَصِحُّ اعتقادُ انتفاءِ الاسم عنه مطلقًا، بخلاف من أتى بناقِضٍ من نواقضه؛ فإن الاسم يزول عنه ولو قُدِّرَ أنه جاء بعد ذلك بشيءٍ مِن شُعَبِه وفروعه.
وهذا أحدُ مواضع الافتراق عما قرَّره الكتاب قائلًا: (ومَن نَفى الاسْمَ عن غيره بسبب مخالَفَةِ هذا الغَيْرِ لِمَا أجمعَتْ عليه الصَّحابة إجماعًا قطعيًّا، فهذه طريقةٌ صحيحةٌ ما دام ينفي كمال التسلُّف الواجب؛ فإنه ليس ثَمَّ رجلٌ له حظٌّ من الإسلام إلا وله حظٌّ من السلفية بقَدْر ما معه من الإسلامِ، وكما صَدَّرْنا كلامنا= فإنَّه لا تكْمُل سلفيَّةُ رجلٍ ما دام معه شيءٌ من مخالفة السلفيَّة في القول أو العمل، كما أنَّه لا يكْمُل إسلامُ رجلٍ ما دام ضَيَّع شيئًا من الدين الواجب عِلمًا أو عملًا) [10] فالتَّسْوية بين مُكَوَّن العلم والعمل هنا في مَنْح وسَلْب اسم السلفية مُشْكِل؛ إذ التقصيرُ في المكوَّن العملي فقط بالوقوع في الذُّنوب والمعاصي لا يصِحُّ أن يكون ناقضًا ينتَقِضُ بسببه المفهومُ بالكلية فيَخْرج المرءُ به من إطارِ أهلِ السُّنَّة والجماعة، وبالتالي من السلفية، بخلافِ أصولٍ علمية معيَّنة فإنها تصَحِّح ذلك الإخراجَ لا على وَجْه نفْيِ كمال التسلُّف الواجب فحَسْب بل بسَلْب اسمه المُطْلَق.
ومِثْل هذا التناولِ الذي مارسه الكتابُ حيالَ مصطلح (السلفية) -وهو مصطلحٌ خاصٌّ وُضِع للدَّلالة على معنى مخصوص- يمثِّل إعادةَ إنتاجٍ اصطلاحيٍّ يعود بالإبطال على الفائدة التي وُضِعَ هذا المصطلح لأجله، ولتَنْدَرِس ملامحه بما يصحِّح إلباسَه على من قصد واضِعه عدمَ إلباسِه، فالمعتزلةُ والخوارج والشيعة والقَدَرية كلُّهم يمكن أن يكونوا سلفيينَ باعتبارٍ وإن لم تكْمُل سلفيَّتُهم، والسَّلفيون كذلك من أصحاب الذنوب والمعاصي ليسوا سَلَفيينَ باعتبارٍ.
ومع ظني أنَّ هذه المسألة جديرةٌ بالتحقيقِ والتحرير، وأنَّ قَدْرًا مما حرَّرَه الكتابُ فيها لا يخلو من إشكالٍ، فقد ظَلِلْتُ أتساءلُ هل نحن أمامَ مخالفة اصطلاحية مغتَفَرَة؟ أم أنَّ هذه الرؤية الاصطلاحيَّة، استتبَعَتْ مواقفَ عِلْمية تُخرِج الأمرَ عن إطارِ الخلاف التعريفي؟
الفِرْقة الناجيَة بين تصوُّرين
يتَّكئُ الخطابُ السلفيُّ عادةً في تقرير رُؤيَتِه لحقيقة السلفية ومفهومِ أهل السُّنة والجماعة على جملةٍ من النُّصوص الشَّرعية، يقف على رأسها حديثُ “الفِرْقة النَّاجِيَة”، وهو حديثٌ تناوله الكِتاب بطبيعةِ الحال ليقَدِّمَ مرةً أخرى رؤيةً مُخالِفَة للإِرْث السلفيِّ، وَلِيَشْحَنَه بمضامينَ ستُحْدث في تقييمي ارتباكًا عميقًا في تحقيقِ طبيعة هذه الفِرْقة، وطبيعة النجاة المقصودة، وضرورة وجود طائفة مخصوصةٍ برؤية عَقَدية ممِّيزة عن بقيةِ طوائِفِ الأُمَّة في خارطة الإسلام، وصِلَتها باستبقاء الحقِّ في هذه الأمَّة.
الرواية التي اعتمدها الكتابُ هي رواية أصحاب السُّنَن مِن طُرُقٍ عن أبي هريرةَ ومعاويةَ وأنسِ بن مالك وغيرهم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (افترَقَتِ اليهودُ على إحدى وسبعينَ فِرقةً، وافترقَتِ النَّصارى على اثنتين وسبعين فرقةً، وستفترق أمَّتي على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً، كلُّها في النار إلا واحدةً، قالوا: من هي يا رسولَ الله؟ قال: هِيَ ما أنا عليه وأصحابي).
ابتدأ الكتابُ بإيرادِ وِجهة النظر السلفية في هذا الحديث؛ حيث قال بوضوح: (تذهب السلفيةُ المعاصِرَة، تبعًا لشيخِ الإسلام ابن تيمِيَّة بدرجةٍ أساسيةٍ، إلى أنَّ هذا الحديثَ هو في قِسْمة فِرَق المسلمين، وأنَّ الخلافات الواقعة بين المسلمين في العقائد هي مَوْرد القِسْمة والافتراق، وأنه ثمَّ فرقةٌ واحدةٌ هي الناجية يوم القيامةِ غير متوَعَّدَة بعقابٍ من هذا الوجه، وهي الفِرْقة التي التزمت بما عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه في أصول الاعتقاد، وترى السلفيةُ أنها هي هذه الفِرْقة وأنَّ باقي الفِرَق التي تخالفها في الاعتقاد هي من الفِرَق الناريَّة) [51].
وهذه الرؤية هي رؤية مطابِقَةٌ فعلًا لتصوُّر السلفيينَ لطبيعة هذه الفِرْقة، وإن كان ثمَّةَ تحفُّظٌ على الإيحاء بأنها تَصَوُّرٌ فريدٌ للسَّلفيَّة المعاصِرَة، أو أنَّها ناشئة من أثر الخطاب التَّيميِّ؛ فإنَّ هذا التصور شائِعٌ جدًّا قبل السلفية المعاصِرَة، بل هو تصوُّرٌ تتبنَّاه حتى التصوراتُ غيرُ السلفية، وهو ناشئٌ أصالةً من منطوق الحديث ومفهومه، ومن واقع الأمَّة المُسْلِمة ذاته، ومن معجم عقديٍّ تأريخي راصِدٍ للحالة. ومرورٌ سريع على الكتابات المؤرَّخة لظاهرة الافتراق في الأمة -سلفية وغير سلفية- بل ومُطالعةٌ عَجْلَى لكثيرٍ من المُدَوَّنات العَقَدية -السُّنِّية وغير السنية- سيُلْحَظ حديثُها المكثَّف عن طائفة عَقَدية مميَّزة، في مقابل فِرَق مُنحَرِفةٍ عنها، بل إنَّ هذا المعنى المكثَّف قد يتم تركيزه أحيانًا وتضمينُه بعضَ عناوينِ هذه المدَوَّنات.
أما الرؤية التي يتبنَّاها الكتابُ في تحديد طبيعة هذه الفِرقة فقد جاء ليقرِّرَ (أن هذه الفِرَق كلَّها متوعَّدةٌ بالنار إلا فرقةً واحدة، هي ما كان عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه. وهذا المعنى لا إشكالَ فيه؛ فالثابتُ بالأدلة القطعيَّة أن من خالف ما كان عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العِلم والعمل أنه يكون متوعَّدًا بالنار، وليس في هذا الحديث إلا إجمالٌ لِما فصَّلته الشريعةُ في أحكامها المختلفة أمرًا ونهيًا وإخبارًا) [55]، وعليه فقد كَرُّوا بالنقد على التناوُل السلفي المعتاد لمثل هذا الحديثِ والذي عدُّوه الفَهْم الأخطرَ لهذا الحديث والذي أتى بالخَلَل في التصور (وهو فَهْمُ مَن عيَّن مجموعةً من الأبوابِ أو المسائل كأصولِ الدين أو أصول مسائل الاعتقاد، وجَعَلها حصرًا وقصرًا مناطَ الافتراق، وبالتالي جعل من التزم فيها قولًا معيَّنًا كان من الفرقة الناجية دون من خالف فيها، وهذا الفهم غَلَطٌ ظاهر؛ فإنَّ الحديث أتى في كلِّ ما كان عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من العِلم والعمل، وهذا يشمل أصولَ الاعتقاد وفروعَه، وأصولَ الشرائع والأعمال وفُروعَها، وسائرَ أبواب الأخلاق والمعاملات؛ فإنَّها كلَّها يجب فيها التزامُ ما كان عليه النبي صلى الله علي وسلم).
بل قالوا بوضوحٍ شديدٍ: (مصطلح الفِرْقة الناجية مرادفٌ تمامًا لمصطلح الإيمان الكامل بالواجبات؛ أي إنَّ المراد به تحقيقُ الموافقة التامة لما كان عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل وتجنُّب سائر المخالفات التي تجعل هذه الموافَقةَ ناقصةً وتوجِبُ الوعيد بالنار، وهذا المفهومُ بهذه الصورة مفهومٌ ذِهنيٌّ لا يكاد يتحقَّق في الخارج إلا في السابقين المقَرَّبين ممن يقبِضُهم الله، وقد تَقبَّل حسناتِهم وغفر لهم خطاياهم في الدُّنيا، وقد أدرَكَتِ الحقَّ الواجبَ كلَّه لم يَفُتْهم منه شيءٌ، وهي منازلُ النبيينَ لا غير، أما كُلُّ مؤمنٍ يلقى ربَّه وقد اكتسب خطيئةً، فليس من الفِرْقة الناجية، بل يبقى متوعَّدًا بالنارِ حتى يُعْذَرَ بتأويل، أو تَغْلِبَ حسناتُه سيئاتِه، أو يغفرَ الله له، أو يشفعَ له الشافعون، إلى آخر موانعِ إنفاذِ الوعيد. ومن هنا يظهر: أنَّ استحضارَ هذا الحديث في أبواب العقائد ينبغي ألَّا يزيد استحضاره في أبواب العبادات والمعاملات والأخلاق، وأنَّ استحضارَه على معنى أنَّ طائفةً من الناس حقَّقَت القول أو العمل في بابٍ مُعَيَّن -دون غيره- تكون هي الفِرْقة الناجية دون ما عداها= غَلَطٌ ظاهر) [56].
هذا هو التصور الذي تبنَّاه الكِتابُ في تعليقه على مفهوم الفرقة الناجية، وأنه ليس ثمَّةَ فرقةٌ متميِّزةٌ حقيقيةٌ يَصْدُق عليها وصفُ النجاة، وإنما مقصودُ الحديث أنَّ عندنا إيمانًا قد جاء به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فمن أتى به جميعًا فهو ناجٍ، ومن خالفه جميعًا فهو هالِكٌ، ومن أتى ببعضٍ وخالف بعضًا فهو ناجٍ بما أتى منه هالِكٌ فيما قَصَّر. وأن مفهوم الفرقة الناجية لذلك لا يعدو أن يكون مفهومًا ذِهْنيًّا لا يكاد يتحقَّقُ في الخارج إلا في السابقين المقرَّبين، وهو وصف لا أدري ما المساحَةُ التي يُغَطِّيها وهل يشمل جميعَ الصحابة مثلًا أم يختَصُّ ببعضهم دون بعضٍ، أم أنَّها أضيقُ دائرة فلا تشتمِلُ إلا على النبيينَ لا غير.
هذا الفهم للحديث، وهذا التحديدُ لطبيعة الفِرْقة الناجية غلطٌ ظاهرٌ، وهو معنًى غريبٌ لا أعلم أحدًا من أهل العِلْم أشار إليه أو قال به، وظاهِرُ الحديث لا يساعِدُ عليه مطلقًا. والذي أوجب للكاتبينِ الوقوعَ في هذا الغلط الظاهر أنَّهما خلطا بين معنى النجاة المُطْلَقة، وبين نجاة خاصَّة إضافيَّة في بابٍ معيَّنٍ خاصٍّ. فامتداحُ الشارع في هذا الحديث للفِرْقة الناجية إنما هو لمُكَوِّن مخصوصٍ من مكوِّنات النجاة لا ترتيب النجاة المطلقة لمن أتى بهذا المكَوِّن، فمقصودُ الحديث امتداحُ المكَون المنهجيِّ العقديِّ، والذي يحقِّقُ الوَحْدة المطلوبة شرعًا في مقابِلِ ذمِّ الافتراق البِدْعي الناشئ من الإخلال بذاك المكون المنهجي، وبالتالي فالحديثُ جاء بامتداح الفِرْقة التي حَصَّلت هذا المُكَون وأعطته وَصْف النجاة دون الفِرَق الأخرى التي لم تحقِّقْه فتُوُعِّدَتْ بالهلاك. وهو فهمٌ ظاهِرٌ جدًّا من الحديث.
فالافتراقُ المشار إليه في الحديث هو افتراقٌ في الدين لا على مستوى الذُّنوب والمعاصي العَمَلية؛ فإن هذه بمجَرِّدها لا تُوجِب افتراقًا، وإنما الموجِبُ للافتراق هي الأهواء البِدْعية، يدلُّ على ظهور هذا المعنى من هذا الحديث ما يلي:
– تشبيه الافتراق الواقِعِ في الأمة بالافتراق الذي وقع للأمم السالفة (اليهود والنصارى) ولم يكن ذاك الافتراقُ افتراقًا بمجرد مقارَفَة بعضِ أفراد تلك الأُمَم للذنوب والمعاصي، بل هو افتراقٌ وتحزُّبٌ على مكوَّنات عَقَدية ومنهجيَّة متبايِنَة، أوجب حالةً من التَّشَظِّي في الدائرة النَّصْرانية والدائرة اليهودية، وواقعُ هذه الديانات وتاريخها شاهِدٌ على موجِب هذا التفرُّق.
– لو سلَّمنا لذاك الفَهْمِ الغريب الذي أورده الكِتابُ في شرح الحديث وأنَّ الفِرْقة الناجية لا تَصْدُق إلا في حقِّ من أتى بالإيمان الكامل الواجب؛ فالافتراقُ سيكون حتْمًا بسببِ التقصير في الإتيانِ بذاك الإيمانِ الكامل، فكلُّ إخلالٍ في مكَوِّنات الإيمان وشُعَبِه سيسْتَتْبِع فِرَقًا بعددها، فكما أنَّ لَدَينا فُرقةً وقعت بسبب إخلالٍ في المُكَون العقدي والمنهجي وهو ما نتفَهَّم معناه ونتعَقَّلُه، فثمَّة فُرقةٌ وقعت أيضًا للإخلالِ بالمكوَّن العملي بالإتيان بالذنوب والمعاصي، فيصحُّ إذن أن يقالُ إنَّ مِن الثِّنْتَين والسبعين فِرْقةً، فِرقةَ الزَّواني، وفرقة المُرابين، وفِرْقة الكَذَبة، وفرقة مُدْمِني الخمر .. إلخ، بل ثَمَّة فِرَقٌ بعدد كلِّ نَقْص متصوَّر على الإيمان الكامل الواجب، وهو معنًى باطلٌ لا يحتمله الحديث، والعجيبُ أنَّ الكتاب أشار إلى احتمالِ تفسير الحديث به، فقال: (ونَفْس التَّعْداد يحتمل أن يكون مقسومًا على شُعَبٍ مختلفة من الاعتقادات والأقوال والأعمال، على غِرارِ شُعَب الإيمان، وقد يكون وَفْق موارِدَ أخرى، الله أعلم بها) [57].
يُوَضِّحُ بطلان هذا التصور:
– أنَّ مُجَرَّد الوقوع في الذَّنْب والمعصية لا يُوجِب افتراقًا، وإنما الافتراقُ الذي تتناوله النصوصُ الشرعية بالذَّمِّ هو ما كان ناشئًا عن التبدُّلات المنهجية في مساراتِ النَّظَر والاستدلال وما تُفْرِزه هذه المساراتُ من انحرافات في مُكَوَّن العلم والعمل، لا أنَّ الفِرْقة تقع لمجرَّدِ خطأٍ في العلم والعمل. ولم يكن الصحابةُ فمَن بَعْدَهم يتعاملونَ مع المذنبين باعتبارهم مُحْدِثينَ فُرقةً في الأمَّة، بل هو معنًى يتناولُ لونًا مخصوصًا من ألوان الانحرافِ الموجِب لوقوع الفُرقة في الدِّين. والتفريق في التعامُل بين أصحاب الذنوب والمعاصي، وأهْل البِدَع والأهواء في التراث السلفي، أشْهَرُ من أن يُوضَّحَ وأنْ يُنَبَّه إليه. بل لو تأمَّلْنا واقعَ الذنوب والمعاصي في حياة أفراد الأمَّة لوجدنا أنها لم تَزَلْ حاضرةً ولم توجِبِ افتراقًا كما هو مشاهَدٌ حتى اليوم بخلافِ الإخلال والانحراف البِدْعي والذي أوقع ذاك الافتراقَ الدينيَّ المذموم.
– ولذا فإنَّ السَّلَف الصالح حين استعملوا اسم السُّنَّة كاسْمٍ مميِّزٍ لهم دون سائر الطوائف البِدْعية، فإنَّهم لم يستعملوه بقَصْد الإشارة إلى الإصابة الكاملة للسُّنَّة في جليل أمْرِها ودَقِيقِه، فمن قصَّرَ في شيء من شأنها رفعوا عنه اسْمَ السُّنِّي، بل استعملوه أصالةً للإشارةِ إلى مكوِّن ديني مخصوص متى توافَرَ للشَّخْص ولو كان مقَصِّرًا صحَّ استعمالُ الاسم في حقه، ومتى قصَّر في ذاك المكَوِّن استحقَّ نَزْعَه وسَلْبَه، ولم يقع من أحدهم ولا ممن تلاهم تَسْييلٌ لمعنى السُّنَّة ليحدِّثَنا عن موافقة أهلِ البِدَع في بعض شأنِ السُّنة؛ كونهم مسلمينَ، وما من مسلمٍ إلا ولديه قَدْرٌ من تحقيقِ السُّنة، وعليه فإنَّ أهل البدع يَدْخُلون في مسمَّاها باعتبار الموافقة، ويَخْرجون منها باعتبار المخالفة، تمامًا كالسُّنِّي العاصي فإنَّ معصيته لا تكون من السُّنَّة، فهو سُنيٌّ من وَجْه وخارجٌ عن السُّنة من وجه، فمثل هذا الاستعمال المائِعِ لم يكن واردًا على أذهانِهم قطُّ، وليس له حضورٌ في استعمالاتهم، وهو يُفْقِد شعارَ السُّنَّة الفائدةَ التي وُضِعَ لأجلها، بل لهم من الاستعمالاتِ الكثيرة الدَّالة على إعطائهم اسمَ السُّنة لبعض العُصاة دون أهل البِدَع، ما يكشف عن مفهومِ هذا الاسم ومكوِّناته المركزيَّة.
– يؤكِّدُ خطأ ذلك التفسيرِ الذي تبنَّاه الكِتابُ لمفهوم الفِرْقة الناجية أنَّ الحديث جاء ليَكْشِف عن وقوع إشكاليَّة دينيةٍ عميقةٍ مستقبليةٍ في حياة هذه الأمَّة وهي تَشَظِّيها إلى فِرَق=طوائف=كانتونات دينية تمثل جُيوبًا عَقَدية في واقع الأمة، وأنَّ ثمَّة فصيلًا منها قد حقَّق امتيازَه العقديَّ عليها جميعًا لالتزامه هَدْيَ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِه، أمَّا وقوع الذنوب والمعاصي وارتهانُ النَّجاة بمجانبتها جميعًا بتحقيقِ الإيمان الكامل فمعنًى أجنبيٌّ تمامًا عن الحديث، ولا تحتمله طبيعةُ النُّبوءة النبوية؛ إذ الذنوبُ والمعاصي واقِعٌ مُشاهَدٌ حاضِرٌ في مجتمع الصَّحابة، وإنما الحديثُ يتناول ظاهرةً دينيةً مستقبليةً.
– ولو فُسِّرَ الحديثُ بذاك التفسيرِ المذكور في الكتاب، فكل الطوائف الإسلامية سيلحقها الذَّمُ الواردُ فيه لإيقاعها للفرقة المذمومة، فأهْلُ البِدَع واقعون في الافتراق المذموم، وأهل السُّنة بمن فيهم من أصحاب الذنوب والمعاصي واقعون فيه أيضًا، فلا نجاةَ لطائفة من طوائف الأمة من إحداث الفرقة المذمومة.
وبكل حالٍ فليس ثَمَّة ما يُحْوج للخروجِ عن هذا الظاهر للحديث، وتوَهُّم أن الحديثَ قَصَد التنبيه إلى النجاة المطلقة لهذا الفصيلِ لمجرَّدِ تحقُّق هذا الامتياز العَقَدي؛ إذ هذا غيرُ مقصودٍ أولًا في الحديث، ولا هو مفهومٌ لمن تناولَ الحديث من أهل العلم ثانيًا، ولا هي الرُّؤْية التي يتبنَّاها السَّلفيونَ، بل هي رؤيةٌ تعودُ على فائدة الحديث ومعناه بالإبطالِ؛ إذ الحديثُ جاء بذَمِّ الافتراق وتحذيرِ الأمَّة منه، وهو معنًى -كما سبق- لا يكون بمجَرَّد مقارَفَة الذنوب والمعاصي، بل يكون بموجِباتٍ أخرى تُحدِثُ هذه الفرقة المذمومة، أمَّا الحديثُ عما به تتحقَّقُ النجاةُ المطلَقَة، فليس مرادًا للحديثِ أصلًا، وإنَّما جاء الحديثُ بالتَّنبيه إلى سببٍ من أسباب النجاة يتوافَرُ لطائفةٍ من هذه الأمَّة دون بقيَّة طوائفها، وتوافُرُ هذا السبب لا يلزم منه ضرورةً تحقُّقُ وعْد النجاة بإطلاق؛ إذ هو موقوفٌ على شروطٍ وانتفاءِ موانِعَ كسائر نصوص الوَعْد، وغيابه أيضًا غيرُ مُستَوْجِبٍ ضرورةً للهلاكِ، فهو الآخَرُ لا يكون إلا بتوافُر شروطه وانتفاءِ موانعه؛ كسائر نصوص الوعيد، وهو معنًى ليس فيه أدنى إشكالٍ ولا تنشأُ منه لوازِمُ فاسدةٌ.
وفي ضوء ذاك المعنى الغريب الذي فَهِمَ به الكاتبان هذا الحديث، قالا في الحاشية: (سواءٌ أكانت هذه الفِرْقةُ هي أهل السُّنة والجماعة، أو أهل الحديث، أو المعتَزِلة، أو الأشاعرة، أو الشِّيعة، أو غيرهم؛ فكل فِرْقة وافقت النبيَّ في بابٍ من أبواب ما جاء له فهي ناجيةٌ في هذا الباب، وكلُّ فرقة خالفَتِ النبيَّ في باب من الأبواب فهي الهالكة –هي في النار، يعني متوَعَّدة- في هذا الباب. وَفْق هذا التصوُّر فقد يكون أحمدُ بن حنبل من الفِرْقة الناجية في بابٍ، والقاضي عبد الجبار من الفِرْقة الناجية في بابٍ أو مسألة، وكلاهما من الفرقة المتوَعَّدَة بالنار في أبوابٍ أخرى حصل فيها الذَّنْبُ المحض، أو الخطأُ الموقوفَةُ مغفِرَتُه على العذر، وإنما تكون إمامةُ أحمدَ باعتبار كثرة صوابِهِ وهدايته المشهودِ بها لا باعتبارِ نجاةٍ بالتصوُّر الافتراقيِّ) [56].
وبعيدًا عن التَّمثيل والمقارنة بين الإمام أحمد والقاضي عبد الجبار، وهي مقارنة مستفِزَّة ومثيرة فعلًا، وكأنَّ التَّمثيلات ضاقَتْ إلا بحشر رجلٍ بقَدْر الإمام أحمد وجَلالَتِه في هكذا سياق، فحقيقةُ هذا الكلام إلغاءٌ لمفهوم الافتراقِ والنجاة في الحديث، وتذويبٌ لملامحِ الفِرْقة الناجية، بل والفِرَق الهالكة؛ إذ يصحُّ في ضوء هذا الفَهْم القولُ بأنَّ كلَّ الفِرَق ناجية، وكلها هالِكَة أيضًا، وذلك بحسَب مُوافَقَتِها للهَدْي النبويِّ، وهو المعنى الذي صرَّح به الكتاب فعلًا تحت ذريعةِ الوَهْم المسيطِر أنَّ النجاة والهلاك في الحديث نجاةٌ مطلقَةٌ وهلاك مطلق، في حين أنَّ الحديث لم يتناوَلْ هذا المعنى أصلًا، وإنما الحديثُ يتناولُ الحديثَ عن نجاةٍ وهلاكٍ في باب دينيٍّ مُعَيَّن مخصوصٍ. مع اعتبار شروطِ وموانعِ النَّجاة المُطْلَقة والهلاك المُطْلق. فأصحابُ الفِرْقة الناجية= أهل السُّنة والجماعة= السلفيون، قاموا بهذا الباب الديني العَقَدي على الوَجْه المطلوب، وبالتالي توفَّرَ لهم من مقوِّماتِ النَّجاة ما لم يتوفَّرْ لغيرهم، فهم موعودون بالنجاة بشَرْطه كما أنَّ غيرهم ممن أخَلَّ بهذا المُكَون متوعَّدٌ بالهلاك بِشَرْطه أيضًا. ومع أن المؤَلِّفينِ يفهمان ويُصَرِّحان أنَّ أهل العلم لا يقصدون نجاةً مطلقةً حين يتحدَّثون عن فِرْقة ناجية من بين سائر الفِرَق، إلا أنَّهما يناقشان هذا المعنى، ويجتهدان في رَدِّه بحماسة، وكأنَّ أحدًا قال به، أو أنَّه لازِمٌ لطريقة أهل العلم المعروفة في فَهْم الحديث.
أهميَّة السلفيَّةِ وجودًا وعَدمًا
والأكثرُ خطورةً وأهميةً مما سبق جميعًا هو معالجةُ الآثار العِلْمية والعَقَدية المترتبة على فهم المؤَلِّفينِ لحديث الافتراق، فهل نحن أمام غَلَطٍ في فهم حديث لا تتجاوز آثارُه العلميَّةُ حالةَ الغَلَط هذه، أم ثَمَّة غلط متولِّدٌ سيكون له تأثيرٌ في واحد من التصوُّرات المنهجية السُّنِّية؟
أخشى أنه تَسرَّب للباحِثَينِ فعلًا خلَلٌ منهجيٌّ هنا ولا أَجْزِم؛ إذ السؤالُ الأكثرُ أهميَّة بالنسبة لي: هل ثمة وجودٌ فعلًا لطائفة معينةٍ مخصوصةٍ التزمت الهَدْيَ الأول في المنهج والاعتقاد؟ دَعْ عنك الحديثَ عن الذنوب والمعاصي، فإنَّ هذه لم يَسْلَمْ منها بعضُ أصحابِ الهَدْي الأَوَّل –أعني صحابةَ النبي صلى الله عليه وسلم- مع اتفاقنا على أنَّهم كانوا يتلقَّوْن عن نبيِّهم صلى الله عليه وسلم تصورًا عقديًّا موحَّدًا يُمَثِّل مُحْكَم التقريراتِ العَقَدِية والمنهجية السُّنِّية، ولم يقع لهم بسببِ منظومةِ العقائدِ هذه لونٌ من الافتراق البِدْعي المذموم، من جنس ما وقع في زمانِهم من الجيل التالي. السؤال ثانيًا: هل ثمَّةَ تيارٌ عَقَدي مخصوصٌ سارٍ في تاريخ الأمة من جيلِ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا يزالُ يعتقِدُ ما اعتقده النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أم أنَّ الحقَّ العَقَدِيَّ الذي كان عند الصحابة تَفَرَّق وتشَظَّى بعدهم في طوائِفِ الأمة المختَلِفة فما عاد يحوزُه كلَّه فصيلٌ منها دون آخَرَ؟
هذا السؤالُ المنهجيُّ في تقييمي هو السؤالُ الأكثرُ خطورةً، والذي تترتَّبُ عليه آثارُه العِلْمية الخطيرة، بإعادَةِ ترتيبٍ كاملة لمنظومة التعامُل مع آراء الفِرَق الإسلامية باعتبارها فضاءً محتملًا للحَقِّ، والسعي في تطلُّب هذا الحق في تلك الفضاءات، مع تنوُّع عقائدها واتجاهاتها ومساراتها في البَحْث والنَّظَر. وأنَّ انفرادَ أهْلِ السُّنَّة والجماعة برأْيٍ عَقَدي دونهم لا يلزَمُ منه أن يكون هذا الرأيُ هو الحقَّ الموافِقَ للهَدْي الأوَّل في نفس الأمر. والذي أخشاه فعلًا أن يكون الباحثان يتبَنَّيَان في هذه المسألة رؤيةً عَقَدية مُبايِنَة تقولُ بأنَّ الحقَّ بكافَّةِ تشكُّلاته عِلميَّةً وعَمَليَّةً قد توزَّعَ في الأمَّة؛ فحِفْظُه إنما يكونُ بِحِفْظ مجموع الأمَّة، لا بحفظ طائفةٍ مخصوصة منه، وهذا المعنى جاء في أكثرَ من موضعٍ؛ منها:
√ (فالحَقُّ مُفرَّقٌ في أمة محمد لا يَجْمَعه كلَّه واحدٌ بعينه ولا جماعةٌ بِعَيْنها، ولا يفوتُ جميعُه الأمَّةَ كلَّها حتى لا يُدْرِكه منهم أحدٌ، فالحقُّ كلُّه فيهم كُلِّهِم، وليس واحدٌ منهم يجمَعُه كُلَّه) [67].
√ (كما أنَّ الحَقَّ أنَّ حِفْظَ الدين ليس مستلزِمًا لحِفْظِ السلفيَّةِ؛ لأنه ليس موقوفًا عليها من كُلِّ وجه، فحِفْظُ الدِّينِ يحصل في شُعَبٍ عديدة: في الاعتقادِ، والأعمال، وليس كلُّ ما تتبنَّاه التحقُّقاتُ التاريخيَّة للسَّلفيَّة من اختياراتٍ في تلك الأبوابِ يُمكِنُ القَطْعُ أنَّه هو الدِّينُ الذي أُنْزِلَ على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفَهِمَه الصحابةُ) [637].
وهذه غَمْغمةٌ في مقامٍ لا يصلُحُ فيه إلا الوضوحُ والبيانُ التامُّ؛ فرُوحُ البحث تُسَرِّب للقارئ أن المؤلِّفَينِ يريدان إفهامَه أنَّهما ينتقدانِ أحدَ الأَوْهام السلفيَّة -أعني طُهُوريَّة العقيدة والمنهج- لذا جاء مبحثُ حديثِ الفِرْقة الناجيَة والطائفة المنصورة لتصحيحِ هذا التصوُّر، وأنه لا وجودَ لطائفةٍ مُعَيَّنة مخصوصةٍ في الخارج تَحقَّقَ لها ما لم يتحقَّقْ لبقيَّةِ الفِرَق الإسلامية مِن حُسْن التصوُّر والمعتَقَد والعمل، والذي يمثِّل خطًّا قائمًا وموجودًا فِعلًا في حياة الأمة، ويمكن التعرُّف عليه والدُّخول فيه. فهل نحن أمامَ محاولةٍ لتأميمِ العقيدةِ السُّنية الصحيحة بانتزاع قنواتِ الإنتاج العَقَدي السليمِ من دائرة أهْلِ السُّنة خاصةً وتحويلِها مِلْكيَّةً عامَّةً مُشاعة بين مختَلِف الطوائف الإسلامية؟
ولستُ مهمومًا هنا بمناقشة مُشكلات التعرُّف على تلك المنظومة العَقَدية الممَيِّزة وكيفيَّة التوصُّل إليها، وهي إحدى الإشكاليَّاتِ البحثيَّة القائمة فعلًا في الكتاب والجديرة بالمناقَشَة، والتي حرَّر فيها الكتابُ موقفًا شديدَ الإشكال تحت تقريراتٍ مِن جِنْس:
√ أثر الذَّات المتلقِّيَة الناظِرَة في كلام السلف، وإشكالية التنازُع التأويلي لتُراثِ السَّلَف.
√ موقع الإجماعات العَقَدية التالية لجيل الصَّحابة، وكيفية التخريج العَقَدي على مقولاتهم.
√ استحالة الوصول إلى دينٍ مُصَفًّى كالذي ترَكَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو الصحابةُ.
√ انعدام المطابَقَة العَقَديَّة بين مختلِف التحقُّقات السلفيَّة.
لستُ حريصًا الآن على مناقشة هذه القضايا مع شديدِ استغرابي من إيرادِ الكتاب لها على نحوٍ لا يخلو من إجمالٍ لا يصلح بتاتًا؛ إذ ما الفارقُ الموضوعي مثلًا بين حديثِ الكتاب عن تأثيرِ الذَّات المتلقِّية النَّاظِرَة في كلام السلف وإشكاليَّة التنازع التأويلي لتُراثِهم، وبين مشكلاتنا مع العلمانيينَ في دعواهم أنَّ النصَّ مقدَّسٌ والفَهْمَ غيرُ مُقَدَّس، وأنَّ الوحْيَ الإلهي يتأَنْسَنُ بفعل الفَهْم البشري، فالجواب هنا عينُ الجواب هناك، والإشكالية هي ذات الإشكالية. وأعلمُ أن جواباتِ مثل هذا الاستشكالِ حاضرة عند المؤلِّفينِ، بل سَمِعْتُها منهما مرارًا في سياقِ نَقْد الأطروحة العلمانية، فلَيْتَهُما حرَّرا هذا الموضع على نحوٍ مُفَصَّل قَفْلًا لبابِ شُبهةٍ أن تَلِجَ، ولئلا يتسرَّبَ لوَهْمِ المتلقِّي أنه مع التسليم بمعياريَّة فَهْم الصحابة مثلًا فإنَّ الوصولَ لفهْمٍ مطابِقٍ لهذا المعيار غيرُ مقدورٍ عليه لأنَّه لا يخرج عن كونه عملًا بشريًّا عُرْضةً للخطأ، فيترتَّبُ عليه التشكيكُ في جملةٍ عريضةٍ من مقرَّراتِ ذلك الجيلِ المقطوع بها.
عمومًا ليس من غرضي هنا بيانُ مشكلات مثل هذه الإطلاقات السالفة وما يترتَّبُ عليها من لوازِمَ خطيرةٍ وباطلةٍ، وإنما غرضي الآن تثبيتُ مسألةِ وجود هذه المنظومة المنهجيَّة العَقَديَّة، لا كيفية التعرُّف عليها، وما قد يَعْرِض من إشكاليات في طريقة التعرُّف عليها؛ إذ هو سؤالٌ تالٍ على الإقرارَ بمسألة الوجود، كما أنَّ البَحْث الأنطولوجي (علم الوجود) سابقٌ للبحث الإبستمولوجي (عِلْم المعرفة). وهو ما لم يتَّضِح لي موقِفُ الأخوينِ الكريمين منه على وجه مُطَمْئِنٍ، فهل الحقُّ المفَرَّق في أمَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم يشملُ الحقَّ العَقَدي فلا يكون لفَصيلٍ عَقَديٍّ من الأمة تميُّزٌ على مستوى النَّقاوة العَقَدية على بقيَّةِ الفصائل إلا تميزًا بمقدارِ الكَمِّ، أما تمامُ التمَيُّز بحيث يصِحُّ أن يُقالَ إنَّ الحقَّ العقديَّ لا يخرج عنها وقد يوافقها غيرُها على بَعْضِه وإن لم يطابِقْها فيه؟ وهل لِحفْظ السلفيَّة أثرٌ حقيقيٌّ في حِفْظ الحق ولو من الوَجْه العقدي دون بقية الأوجه؟ أم أنَّه لا ارتباطَ بين حِفْظ السلفية وحِفْظ الحقِّ في الأمَّة بحيث لو قُدِّرَ أنَّ السلفيَّة زالت من الوجود بالكُليَّة فسيظَلُّ الحقُّ قائمًا موجودًا فيها؟
الرؤيةُ التي أتبنَّاها عن يقينٍ أنَّ هذا الفصيل قائمٌ موجود فعلًا، وأنَّه على خلاف بَقيَّة فِرَق الأمة قد حَقَّقَ الامتيازَ العقدي والمنهجيَّ المطلوبَ، وأنه يمثِّل الفِرْقة التي وعدها الشارِعُ بالنجاةِ في مقابل توعُّدِ بقية الفِرَق المخالِفَة بالهلاك، من غير اعتقادِ أنَّ ذلك موجِبٌ لنجاةِ كُلِّ فردٍ منهم على جِهَة الإطلاق، ولا إنفاذ وعيدِ الهلاكِ لكلِّ من كان خارجًا عنها، ودون اعتقادِ عِصْمَة أفرادها من الوقوع في الذنب والمعصية أو حتى خَطَأ بعضِهم في بعض المُكَوَّن العلمي مما لا يَخْرج به المرءُ من هذه الفِرْقة. وبناءً عليه فإن وجودَ هذه الفرقة المخصوصة المُعَيَّنة في جَسَد الأمَّة ضرورة لقيامها بحقٍّ لا يَشْرَكهم فيه غيرُهم، وأنه لو قُدِّر زوالُهم من المشهد بالكلِّيَّة فسيزول قَدْرٌ من الحقِّ يقينًا، بخلاف زوالِ غَيْرِهم؛ فلن يلزَمَ منه زوالُ شيءٍ من الحق.
هذا ما أراه وأعْتَقِدُه، ولولا أنه قد تسرَّبَ إلى وهمي المعنى الفاسِدُ من خلال قراءة الكتاب لما كَتَبْتُ هذه المقالة؛ فإن هذا السؤالَ لم يكن واردًا في ذهني مطلقًا قبل قراءةِ الكتابِ، وإنما دفعني إلى إيرادِه ما رأيتُ فيه من سياقاتٍ مُوهِمَة وإشكالاتٍ. مع التأكيد والتذكيرِ بأنَّ قراءتي هي قراءةُ من يُحسِنُ الظَّنَّ، ويسعى في حَمْل الكلام على محامِلَ مقبولةٍ، لكن ظَلَّتْ هذه المسألةُ تتأرجَحُ في ذهني وتميل بي إلى نِسْبة القول الفاسِدِ، ويكفيني منهما أن يُنْكِرا هذا الوَهْمَ الفاسد، ويُصَرِّحا بقولٍ بيِّنٍ واضِحٍ لا غمغمةَ فيه: أنَّ وجودَ السَّلفية=أهل السنة والجماعة، يُمَثِّل ضرورةً دينيَّةً في حياة الأمَّةِ، وأنَّه لا يُتَصَوَّر حِفْظُ الحَقِّ على وجه التمام دون وجودها.
وأَجِدُني في غِنًى عن التَّنبيه إلى أنِّي لا أعني بالسلفيَّة فقط تلك الأحزابَ والتجمُّعاتِ القائمةَ، التي حملت اسمَ السلفيَّة. بل مرادي تلك المَدْرَسة الممتَدَّة في عُمْقِ التاريخ، والتي مِن أعيانها أئِمَّةُ الإسلامِ من التابعين فمَن دونهم، ممن يسمِّيهم المؤلِّفان (أهل الحديث)، والتي يقابِلُها سائِرُ الفِرَق البِدْعِية المعروفة.
وبعبارة أوْضَحَ: هل يرى المؤلِّفانِ أنه من الممكنِ أن نَجِدَ شيئًا من الحَقِّ فات أهلَ الحديثِ، ثُمَّ أدْرَكَتْه الأشعريَّةُ، أو الماتريديَّةُ، أو المعتزلةُ، أو الشيعةُ، أو الخوارجُ، ونحوُهم؟
سؤال يُقْلِقُني جوابُ الأخوين الفاضِلَينِ عنه.