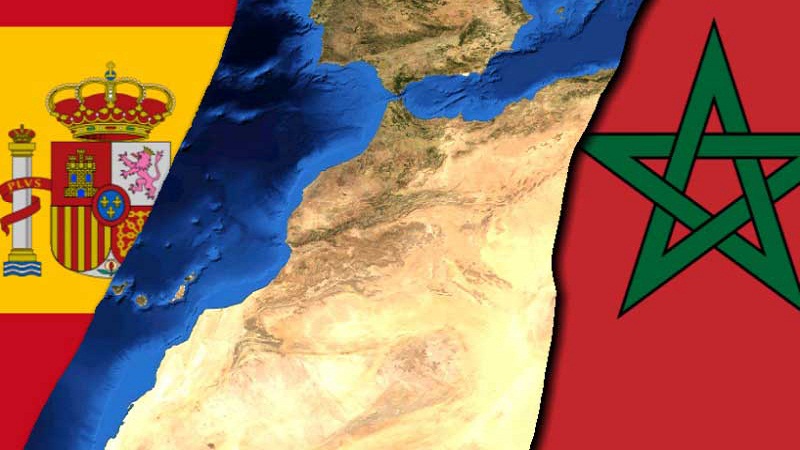إصلاحات “البسملة”.. والمشروع الاستعماري الذي لا ينسى (في الجزائر)
المشاهدات: 2٬752
هوية بريس – أبو محمد حبيب
عندما انتهت مهام “برنارد إيمي Bernard Emié” سفير فرنسا في الجزائر، قرر أن يكون “طواف الوداع” لعش الدبابير الذي يتكاثر فيه نسل الوصاية الفرنسية، أدى زيارة “مجاملة” لوزيرة التربية وحدها من دون سائر الوزراء في الحكومة الجديدة، السفير الذي يغادر إلى منصب “حساس” في بلده، سيترأس المديرية العامة للأمن الخارجي أحد جناحي جهاز المخابرات المكلف بمكافحة الجوسسة.
الزيارة لم تكن بريئة ولا “روتينية” كما أوحى بذلك بيان الوزارة المقتضب، فمنذ مجيء سيدة “الكراسك” (مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية) إلى وزارة التربية تلاحقت حملات “التغريب” و”الفرنسة”، وبدا أن الجهة التي أوحت بتعيينها أخرجت أفضل ما عندها من العجينة التي تصنع على عين الاستعمار القديم، فهي امرأة تجسد مشروع التغريب لسانا وفؤادا، فقد أفاق الجزائريون في دهشة على وزيرة تقود قطاع التعليم، ولكنها لا تعرف من اللسان العربي معنى ولا مبنى، وتخوض إصلاحات لا يعرف لها زمام ولا خطام، عنوانها الوحيد والبارز هو دحرجة اللغة “الرسمية” وتقليص أحجامها، والعبث بمقرراتها، وانتقاء نصوصها وفق الهوى الأيديولوجي الذي تشبعت به الباحثة التي عمرت سنوات طويلة في المركز المذكور.
ووصل بها الحال إلى الاستعانة بـ”خبراء” فرنسيين خلص، وهو أمر حاولت عبثا إخفاءه وكتمانه حتى أحرجتها الوزيرة الفرنسية التي صرحت بشكل علني أن دور هؤلاء الخبراء يتعدى مجرد تكوين الأساتذة إلى تكوين المكونين، وهو ما أكد جميع الشكوك التي رافقت العملية التي تسميها الوزيرة ومستشاريها “إصلاحات” ويسميها العوام تندرا وقدحا “إسلاخات” بمعنى أنها تفضي في النهاية إلى “سلخ” عناصر الهوية بعملية تدريجية، ووفق نفس يقوم على الإنهاك، وبعثرة ساحات الجدل، وقد أفلحت في وقت سابق من هذه الفضيحة المتعلقة بالخبراء في معركة-إشاعة تدريس الدارجة الجزائرية بدل الفصحى، استهلكت حبرا كثيرا، وأحرقت أعصابا لشهور عديدة ثم خارت وخمدت، إلا أن وزيرا سابقا لهذا القطاع قال بالحرف: “فكرة التدريس بالعامية ليست مشروعا جديدا تم طرحه بسبب مشكل معين في تدريس اللغة لتلاميذ الأقسام الابتدائية بل هي خطة “مجمدة” كان ينتظر أصحابها الوقت المناسب”.
ثم أعقب ذلك شجار آخر، وكان الدور هذه المرة على مادة “العلوم الإسلامية” التي مستها أكبر حزمة من التحويرات والتغييرات منذ ربع قرن تقريبا، فمذ تم إلفاء “التخصص” في هذه المادة وجعلت مادة يمتحن فيها طلبة البكالوريا في جميع التخصصات والشعب، عدَّ ذلك “مقايضة” لحفظ التوازن، ولكنه غير قابل للتنازل، وبدعوى تخفيف مواد الامتحان المصيري وتقليلها، كانت الضحية الأولى هي “العلوم الإسلامية”، وأمام بعض الأصوات التي ارتفعت تصيح وتستنكر تراجعت السيدة رمعون خطوة إلى الوراء، وزعمت أنها مجرد اقتراح، وليس غريبا أن تعاود الكرة في قابل الأيام.
أكثر الأشياء التي عبثت بمصداقية “الباحثة” الأكاديمية ومن حولها من المستشارين المؤدلجين هو فضيحة كتاب “الجغرافيا” الذي أعد ليكون باكورة الجيل الثاني من الإصلاحات، فقد حمل عورة علمية اعتبرت في حينها ورقة “سرية” للتطبيع النفسي مع “اليهود” كخطوة أولى، لقد تضمن الكتاب خريطة العالم وفي القلب منها الإشارة إلى دولة “إسرائيل” ومحو اسم “فلسطين”، وبسبب المخيال الشعبي الذي ينظر إلى هذه القضية بقدسية، أوشكت الغضبة التي أعقبت هذا الخطأ-الفضيحة أن تطيح بالمرأة القوية، ولكنها أصلحت “خطيئتها” بذخ أموال كثيرة، وتكفل الزمن بالباقي.. إنه النسيان دائما يمنحها مزيدا من التمدد والاستطالة..
في العام الماضي جرى الوادي فطم على القري، ومسحت الأرض بكرامة الدولة، وأحال بعض المراهقين الذين يعبثون في مواقع التواصل الاجتماعي امتحان “البكالوريا” إلى مهزلة تامة الأركان والصفات، ووقفت السيدة التي تعتد بكبريائها مهزومة وهي تشهد تسريب مواد الامتحان واحدا تلو الآخر، وأوشكت الشهادة الوحيدة التي تحظى بمصداقية نوعا ما أن تذهب أدراج الرياح، وطأطأت الوزيرة قليلا ثم قررت أن تعيد الامتحان في دورة “جديدة”، وجرت تحقيقات لا تسمن ولا تغني من جوع، وبدل أن تطير الرؤوس الكبيرة صاحبة الأمر والنهي، تم التضحية بأسماك صغيرة إشباعا لرغبة “الوعيد” لا أكثر، وخرجت حفيدة قدور بن غبريط سالمة لا شية فيها مرة أخرى، وعرف كل أحد حينئذ أنها تأوي إلى ركن شديد، يحميها حماية لا مطمع لأحد في النيل منها.

آخر الحملات التي تخوضها سيدة الهدم والتغريب هو أوامرها “الشفهية” بمحو وإزالة “البسملة” من جميع كتب ومقررات المواد الدراسية التي تطبع هذه الأيام، بدعوى أن البسملة لا علاقة لها بالرياضيات والفيزياء والطبيعيات، هل وصلت دقة الإصلاحات التي تباشرها الوزيرة وطاقمها الأكاديمي إلى هذا الحد؟ أي أثر إصلاحي ينعكس على التلميذ الذي يتصفح المقررات خالية من البسملة وأكثر هؤلاء يمضون سنواتهم الدراسية لا يشعرون بوجودها ولا بفقدانها؟ هل بلغ العداء “الأيديولوجي” الذي ورثته باحثة علم الإنسان إلى درجة التأفف من بضعة حروف درج عليها المسلمون مؤمنهم وفاسقهم عبر قرون؟
معركة “البسملة” تكشف حقيقة الحرب التي يخوضها الاستعمار القديم، مستعينا بأعوانه الذين تربوا في تلك المعاهد التي أنشأها الأوروبيون بغرض فهم الشعوب “البدائية” وتلقيحها بحقنة الحضارة التي حملها المبشرون والعسكريون، حتى إذا قويت شوكة “تلاميذ” الاستعمار أخرجهم من مخابئهم، وسلطهم على أكثر الحقول خطرا وأثرا، وأعانهم بأبواقه الإعلامية التي تقبض أثمانا عالية.
محو البسملة أو إثباتها أمر هين، وجئية لا تعني الكثير في رسم خطط البرامج التربوية، ولكنها على المستوى الرمزي تفضح طبخة الاستعمار الذي يأنف أنصاره من كل رمز “ديني” ينهكهم ويجعلهم في مواجهة “الهوية” التي تقطع صلاتهم بالضفة الأخرى حيث يتنفسون هواء أوروبيا خالصا قوامه الحرية التي لا تعني إلا شيئا واحدا وهو “تقييد” الدين وقهقرته إلى الزوايا المظلمة حيث يئن ويصمت ويتألم.
السيدة التي تقبض على مصير الأجيال، وتعيث فيها فسادا دون حسيب ولا رقيب، وتعبث بكل مقدرات الأمة التي قدمت ضريبة غالية، وتسلم أرصدتنا إلى هاوية سحيقة لا قرار لها.. تبدو فوق “الحكومة” وأكبر من “وزيرة” وأكثر عدة وعتادا من “الجمعيات” والأحزاب، تلاحقها الفضائح تترى ولا تزداد معها إلا عتوا وصلفا، بل إنها كلما حوصرت بفضيحة جديدة جاءتها التهاني، وأرسلت إليها البعوث، وثارت جرائد وقنوات الدعاية الاستعمارية في الدفاع عنها، ومباركة أمجادها، وتحقير خصومها الذين ينعتون بالهمجية والرجعية والداعشية.
لا يتعلق هذا المشهد بموظفة “سامية” تخطئ وتصيب، أو وزيرة تعلقت بمنصب الجاه والسلطة، أو سيدة تسامق طموحها حتى عانق السحاب، ولكنه “مشروع” استعماري يخدمه الخبراء والمستشارون، وتمده دوائر “سرية” بكل لوازم المعركة الطويلة التي تصرع الأجيال، وتسحب من تحت أقدامهم ذرات التراب التي تذكرهم بقداسة الأرض، وطهارة العرض، وهو مشروع يهدأ أو يتوارى ولكنه لا ينسى..