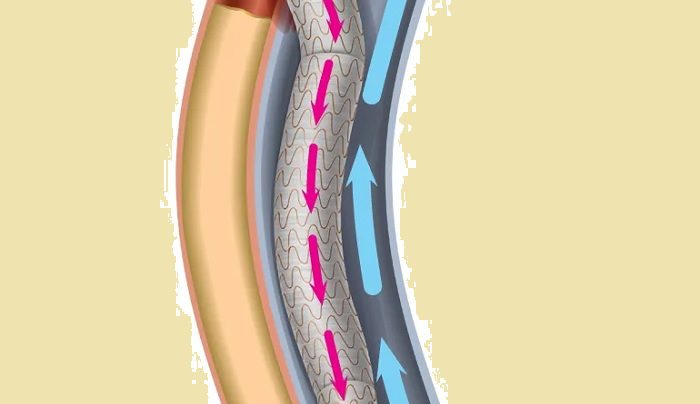إماطة الأذى عن الطريق

عمر السطي
هوية بريس – الخميس 07 يناير 2016
هناك على آخر مقعد في الحافلة المتجهة إلى مدينة الفنيدق، أخذني النوم حينا؛ فرأيت فيما يرى النائم كأني أسمع حديثا عن تحرير فلسطين.
كان الحديث يبدوا مألوفا؛ فلطالما سمعت مثله الكثير؛ حتى أصبح بالنسبة لي؛ لا يعدوا أن يكونا أسطوانة مشروخة! يكررها كل من أفلست أطروحاته الأخرى.
فحديث فلسطين كمزاولة الأنشطة الموازية، للترويح عن النفس حينا أو لزيادة الأرباح حينا آخر! مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا أن الربح أنواع..! ولست هنا ممن يقلل من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المسلمين؛ ولا ممن يعترف بمشروعية الكيان الصهيوني، ولكن ممن يقول احترموا عقولنا يا جماعة. فإن التخلية قبل التحلية…! ومن باب رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فكيف بمن لم تتوفر له الوسائل اللازمة لمحاربة الأمية؛ أو قبل ذلك محاربة الجوع الذي احتل أمعاء الكثيرين..! أن يرفع صوته بقوله إنه سيحارب “إسرائيل”! أو سيقتلعها من الوجود!
لا التاريخ؛ ولا الجغرافيا؛ والمنطق؛ ولا الواقع؛ ولا حتى الخيال! يسعف مثل هذه الأطروحات -وإن لله سننا لا تحابي أحدا-؛ لأنها لم تتخلص بعد من موروثات الاستعمار! الذي جاء بـ”إسرائيل” من العدم ليحولها إلى جرثومة تحتل موقعا استراتيجيا في جسد الأمة .
ومن أبرز هذه الموروثات نجد مفهوم الدولة الوطنية التي جاءت بها معاهدة سايكس-بيكو، والتي جزأت جسد الأمة إلى دويلات؛ أو محميات!! -إذا أردنا الدقة في التعبير- وإنه لمن المستحيل مع ترسخ المفهوم السالف الذكر، أن نتحدث عن تحرير أي شبر من تراب الأمة. لماذا؟ الجواب عن هذا بسيط ومعقد في نفس الوقت! فالنظرة التجزيئية؛ والسطحية في التحليل؛ تحجب الأبعاد الخطيرة للمفاهيم التي جاء بها الاستعمار. والتي ولدت ونشأت في ظروف حضارية خاصة بأصحابها، ولا يمكن تعميمها على العالم كله؛ والعالم الإسلامي بالتحديد. نظرا لخصوصيته الحضارية؛ وتركيبته الاجتماعية المعقدة؛ ولتفرد موروثه الثقافي.
فمفهوم الدولة الوطنية؛ أو القومية يفرض حدودا نفسية إضافة إلى الحدود المادية بين أفراد الأمة الواحدة. فمن أي منطلق تريد تحرير فلسطين؟ إن كان بدافع الإنسانية! فأنت لم تختلف كثيرا عن اليهودي القاطن بـ”إسرائيل”؛ الذي لا يؤيد وجود “إسرائيل”! وإن كان من منطلق العروبة! فإن القومية العربية أثبتت فشلها تاريخيا؛ بل صارت نكتة فاشلة حتى!! أما إن كان من قبيل الوازع الديني ووحدة الأمة فإنه تمت عقبة تاريخية.
إنها الحدود التي فرضت علينا فرضا، حتى أصبحت من المسلمات التي لا يمكن مناقشتها أو التعقيب عليها..! الآن حملة التجهيل “بالذات” طالت كل شيء. فحتى السؤال الفلسفي الذي تساءله الفلاسفة قبل الميلاد، لم يعد يطرأ على الذهن ذلك السؤال عن الذات: من أنا؟ وماذا أريد؟ هل لي ذات مستقلة؟ هذه الأسئلة أصبحت محرمة بحسب شريعة العصر، حيث فقد الناس أدنى إحساس بالذات الحضارية للأمة. أي الدائرة الشاسعة [إنما المؤمنون إخوة].
وفي المقابل رسخت ثقافة الدوائر الضيقة! فبمجرد أن يجتمع اثنان يشتركان في نفس اللغة؛ أو الجنس! يعلنون دولة أو أقلية أو قومية يحاربون من أجلها! لكن الذات الواسعة وأقصد هنا ذات الأمة، لم تعد تمثل أحدا من الناس فقد أصبحت موضة بالية .
القضية إذن معقدة أكثر مما نظن، وتحتاج إلى عقول نيرة لتسبر أغوارها بحثا عن الخلل. هل هو خلل تنظمي؟ أم عجز عسكري؟ أم شلل حركي؟ أم هو خلل فكري بالدرجة الأولى؟ وهنا مكمن الخطر بحيث إذا كان البعد النظري قائم على أسس خاطئة، لن تتمكن معه أي وسيلة مهما كانت فعاليتها تحقيق المقصود. والحال هنا كذلك! إذ أن الخلل فكري بالدرجة الأولى والمشكلة بادئا في التشخيص الدقيق للواقع..!! وموقعة الذات؛ أي على أي أرض نقف؟ ومن أين نبدأ في معركة التغيير والتحرير؟ وليس العيب في الخطأ لكن العيب كل العيب في الضحك على أبناء الأمة وتوهيمهم بأنهم يقفون الموقف الحق؛ وأنهم يصوبون طاقاتهم وقدراتهم نحو الهدف المنشود..
معركة الأمة الآن، معركة شاملة؛ على كل الأصعدة وأول خطوة بعد إخلاص النية، هي الوعي بكل أشكاله حتى تتبصر الأجيال. وتسير الطلائع على بصيرة؛ فإن “خبط عشواء” أدت ثمنه الأمة الكثير من دمائها وطاقاتها دون الوصول إلى المنشود… وعلى هذا فإن معركة الأقصى تبدأ بإماطة الأذى عن الطريق حتى لا تتعثر خيول الفاتحين.
استفقت من حلمي القصير فأبصرت من نافذة الحافلة أضواء سبته المحتلة… للوهلة الأولى تذكرت من مر في ذهني من الذين مروا هناك خلدهم التاريخ لتبقى أسماؤهم في بطون الكتب تذكر من مر عليها بأنه كان هناك مسلمين.. فقلت في نفسي هي أيضا أرض مقدسة؛ والمرور بها واجب مقدس ولو على سبيل التبرك أو من باب الإماطة عن الطريق.