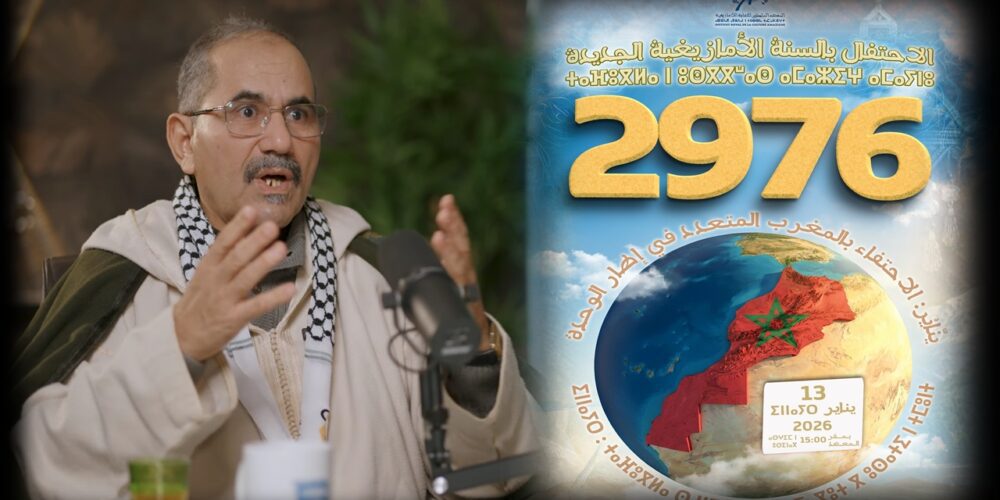ارتباط المغاربة بالمشرق.. لماذا؟

هوية بريس – د.عبد الكبير حميدي
في كل أزمة من أزمات الأمة، أو قضية من قضاياها، ظل المغاربة يعبرون عن مستوى من الوعي كبير، ودرجة من التعاطف ظاهرة، يضعانهم في طليعة شعوب الأمة المهتمة بأمورها، المتفاعلة مع همومها، المناصرة لقضاياها.
ظهر هذا التعاطف المغربي الواسع، وتجلت تلك النصرة الظاهرة، أيام الجهاد الأفغاني ضد الغزو السوفياتي، وإبان الغزو الأمريكي للعراق، وأثناء العدوان الصربي على مسلمي البوسنة والهرسك، وخلال ثورات الربيع العربي، وفي مظالم مسلمي الروهينغيا في ميانمار، والإيغور في الصين، ومحن مسلمي الهند، وغيرها من نكبات الأمة ومظالم المسلمين.
ولئن كان تفاعل وتعاطف المغاربة حاضرين لافتين في كل قضايا الأمة، فإنهما ظهرا ويظهران أكثر وأكثر، كلما تعلق الأمر بقضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين التي تحتل منزلة فريدة في الوجدان والوعي الجمعي المغربي، يجعلها موضع إجماع من كل فئات الشعب المغربي ونخبه الحية، إلا من شذ وأبى، ويرقى بها إلى مستوى “القضية وطنية” المعادلة لقضية الصحراء ومثيلاتها من القضايا الوطنية المغربية.
وعندما يتصاعد التعاطف المغربي مع قضية فلسطين، ليسجل نسب مشاركة شعبية قياسية، تجعل منه واحدا من أكبر الحراكات الشعبية العربية، كالذي يجري هذه الأيام، تتعالى بعض الأصوات النشاز التي اختارت التغريد خارج سرب المغاربة، واحترفت السباحة ضد التيار، تتساءل عن طبيعة العلاقة بين المغاربة والمشارقة؟ وعن سر ارتباط المغاربة بالمشرق؟ وعن سبب تعاطفهم مع القضايا “المشرقية”؟ أو على حد تعبير أحدهم: لماذا كل هذا الارتباط بالمشرق؟.
قبل الشروع في الجواب عن هذا السؤال المفتعل، تجدر الإشارة – هنا – إلى أن هذا النوع من الأسئلة، لا مشروعية لها ولا صدى عند المغاربة، فهم لا يعرفونها، ولا يكترثون لها، ولا يتفاعلون مع من يطرحها، ولا وقت عندهم يضيعونه مع مثل هذه المشاغبات والهرطقات، وهذه السفسطة الفارغة، وإنما تصدر عن فئة محدودة معزولة، تعيش في برجها الخيالي العاجي، خارج السياق الاجتماعي والتاريخي والحضاري للشعب والأمة.
أقول لأصحاب السؤال المفتعل: لماذا الارتباط بالمشرق؟: ما يربطنا بالمشرق كثير، وكبير، ومتين، ووثيق:
يربطنا بالمشرق سطوع شمس الإسلام علينا منه، وتحمل المشارقة لتضحيات الجهاد، وأعباء الفتح، لحمل رسالة الإسلام العظيم إلى بلادنا، ومن يومها والمغاربة يكنون للعرب الفاتحين كل حب وتقدير، ويعرفون لهم فضلهم ومنزلتهم، لدرجة أنهم آووا المولى إدريس الأكبر القرشي الهاشمي، الذي لجأ إليهم وحيدا طريدا، وأكرموه ورفعوه، وزوجوه وملكوه، حبا في دينه وجده ونسبه الشريف، وحتى أنهم استقدموا العرب إليهم أيام الموحدين وقاسموهم أرضهم وديارهم، وساكنوهم وصاهروهم، ونصبوا عليهم دولتين عربيتين شريفتين: دولة الأشراف السعديين، ودولة الأشراف العلويين، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بآل بيته الأطهار. وقد تواتر هذا الحب والاحتضان، إلى أن دخل الاستخراب الفرنسي وأذرعه التغريبية، فنفث المستشرقون سموم الفرقة والعنصرية في عقول بعض المغاربة، وصوروا لهم إخوانهم العرب على أنهم غزاة مستعمرون، جاءت بهم الغنائم والأطماع، ولا شأن لهم بدعوة أو فتح، مستغلين في ذلك أخطاء وتجاوزات بعض ولاة بني أمية الظلمة، التي لا يخلو منها تاريخ أمة. فكانت النتيجة دعوة البعض إلى قطع كل صلة بالمشرق، والبحث عن انتماءات بديلة، كالانتماء الإفريقي، والانتماء المحلي التاريخي، وهي دعوات لا أصداء لها عند المغاربة، ولا قبول لها بينهم، بدليل تفاعلهم الكبير مع قضايا الأمة – كقضية فلسطين – التي ما فتئوا يدعمونها بقوة، ويناصرونها بعزم، ويقيمون لها الفعاليات الشعبية، والمسيرات المليونية، ويعتبرون أنفسهم الجناح الغربي للأمة الإسلامية المجيدة، القائم على شؤونها الحارس لثغورها.
يربطنا بالمشرق اللغة العربية لغة القرآن، التي لا تصح الصلاة بدونها، ولا يفهم الإسلام من غير طريقها، والتي أحبها المغاربة ونبغوا فيها، وخدموها ونشروها، واتخذوها لغتهم الثانية إلى جانب لغتهم الأمازيغية، وكتبوا بها علومهم وآدابهم وتاريخهم، وجعلوها لغة دين وهوية مع شقيقتها الأمازيغية، ولا زالوا يتحدثونها ويخدمونها، حتى صارت جزءا لا يتجزأ من لسانهم، وركنا من أركان هويتهم، وجانبا من حياتهم وثقافتهم، بعد تلاقحها مع لغتهم الأمازيغية الأصلية، فتولد من زواجهما الميمون العامية المغربية، التي هي وسط بين اللسانين، ومزيج من اللغتين، والتي تعكس الطبيعة المزدوجة للشعب المغربي العربي الأمازيغي، والتي تعبر عن تنوع الأمة المغربية اللغوي والثقافي، في إطار مرجعية الإسلام، وتحت راية القرآن.
يربطنا بالمشرق التاريخ الإسلامي المشترك، الذي أسهم فيه العرب والعجم على حد سواء، فقد تعاون الطرفان في حمل رسالة الإسلام، وتعاضدا في بناء حضارة القرآن، وتكاملا في كتابة صفحات تاريخ المسلمين المشرق، فتشكلت من ذلك الأمة الإسلامية العظيمة، وتكون منه المجتمع الإسلامي المجيد، بما يميزهما من تعدد وتنوع وثراء، في إطار الوحدة الدينية، والأخوة الإسلامية، التي تساوت في ظلها الأعراق، وتكافأت الأجناس، وذابت القوميات والنعرات، ولم يتبق من معايير التفاضل بين المسلمين سوى معيار التقوى والإيمان.
ويربطنا بالمشرق المستقبل الواحد والمصير المشترك، بحكم انتمائنا لنفس الفضاء الجغرافي والثقافي والحضاري: فضاء الأمة الإسلامية أو العالم الإسلامي، وبحكم أن التحديات واحدة، والطموحات واحدة، والآمال مشتركة: فتركة الاستعمار الثقيلة واحدة، وتحديات الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي واحدة، ومشاكل البناء الداخلي واحدة، ولا خيار أمام المغاربة والمشارقة معا، سوى التعاون والتعاضد، والتضامن والتآزر، حتى يكون لهم وحدة وقوة، وأثر وهيبة، وكلمة وصوت مسموع، في عالم يسوده منطق القوة، ولا يعترف بغير الأقوياء.
وأخيرا وليس آخرا، يربطنا بفلسطين على وجه الخصوص، سبب إثارة هذا اللغط والجدل العقيم، روابط قوية ووشائج تاريخية: يربطنا بها باب المغاربة، وحارة المغاربة، وأوقاف المغاربة، وبطولات المغاربة في معركة حطين – بقيادة صلاح الدين الأيوبي – لتحرير بيت المقدس، وعشرات الأسر المقدسية من أصول مغربية، ويربطنا بها قبل ذلك وبعده: المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى رسولنا – صلى الله عليه وسلم – ومعراجه إلى السماوات العلى، ويكفي المغاربة مجدا وعزا وفخارا، أنهم الشعب المسلم الوحيد الذي يملك بابا باسمه من أبواب المسجد الأقصى، فلا وجود فيه لباب المصريين، أو لباب السعوديين، أو اليمنيين، أو الشاميين، بل لا وجود فيه لباب الفلسطينيين أنفسهم.
ومع كل هذه الوشائج والأواصر والارتباطات، فإن خصوصية المغرب المسلم تظل قائمة، وإن تميز الغرب الإسلامي عن الشرق الإسلامي تبقى واضحة جلية لا يسع أحدا إنكارها، ولكنها خصوصية في إطار الوحدة، وتميز في إطار الانتماء الإسلامي الواسع، إلى أمة الإسلام العظيم، وإلى حضارة القرآن الكريم.