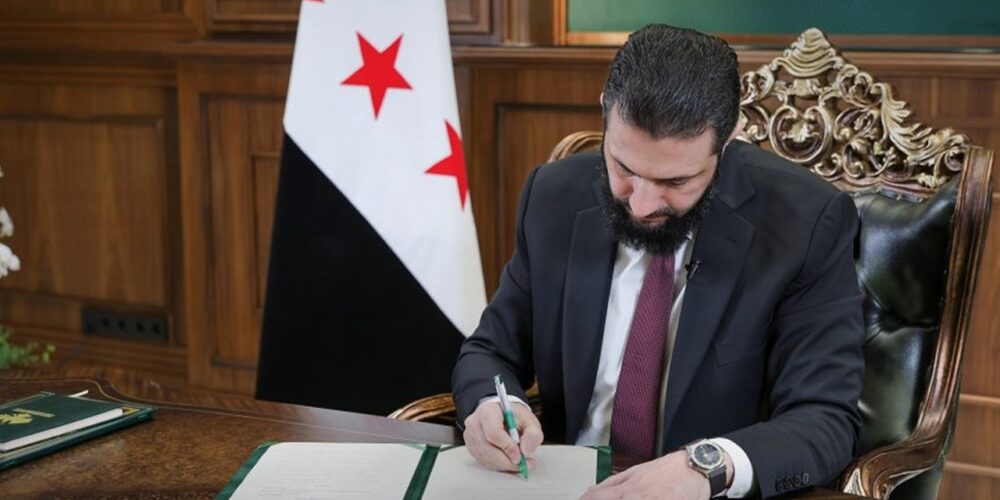التشويه الممنهج لصورة العربي في التعليم الإسرائيلي

التشويه الممنهج لصورة العربي في التعليم الإسرائيلي
هوية بريس – د. لطفي الحضري
مقدمة
يأتي هذا المقال في سياق عالمي شديد الحساسية، تُمارس فيه ضغوط سياسية وإعلامية مكثفة، أمريكية وأوروبية وإسرائيلية، سواء في إطار التطبيع المعلن أو غير المعلن، وتهدف صراحة إلى إعادة تعريف حدود “المقبول” في الخطاب التربوي والثقافي العربي والإسلامي. فقد أصبح أي نص تعليمي يتناول اليهودي أو الإسرائيلي، ولو توصيفا جزئيا أو نقدا موثقا أو تمييزا بين “بعض” اليهود أو “بعض” السياسات الإسرائيلية، عرضة للتجريم المسبق، والتأويل العدائي، والاتهام بالتحريض أو الكراهية، حتى وإن استند إلى وقائع تاريخية ثابتة أو معطيات بحثية موثقة.
وفي هذا المناخ الضاغط، تُدفع المؤسسات التعليمية العربية والإسلامية إلى تفريغ مناهجها من أي محتوى نقدي أو سردية تاريخية صريحة أو توصيف واقعي للصراع، بذريعة “السلام” أو “التعايش”، بينما يُغض الطرف، في المقابل، عن منظومة تعليمية إسرائيلية تُمارس، وفق المعايير القانونية ذاتها، شكلا من أشكال التحريض المنهجي طويل الأمد. فالمفارقة الصارخة أن ما يُدان عربيا بوصفه “تحريضا”، يُمارس إسرائيليا بوصفه “تربية وطنية-دينية”، رغم أن مخرجاته الواقعية تُقاس بعدد الضحايا، لا بعدد الشعارات.
المنهج التعليمي بوصفه بنية موَلِدة للإبادة
غير أن ما يجري اليوم من قتل وإبادة جماعية ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني لا يمكن تصنيفه بوصفه مجرد أفعال عسكرية معزولة، ولا باعتباره انحرافا سلوكيا ظرفيا، بل ينبغي قراءته في إطاره البنيوي الكامل، وفي مقدمته الإطار التربوي. فالإبادة، وفق المعايير القانونية الدولية، لا تُعرف بالفعل التنفيذي وحده، بل تشمل التحريض المسبق، والتأهيل الذهني، وبناء القابلية النفسية للجريمة.
ومن هذه الزاوية، تشكل الكتب المدرسية الإسرائيلية أحد الأعمدة الصلبة في إنتاج هذه القابلية، إذ تقوم بدور ممنهج في نزع إنسانية الفلسطيني، وتجريده من صفة المدني، وإعادة تعريفه منذ الطفولة بوصفه تهديدا وجوديا، أو كائنا أدنى، أو عائقا تاريخيا يجب إزالته.
إن المناهج التعليمية الإسرائيلية، بما تستند إليه من مرجعيات توراتية وتلمودية، لا تكتفي بتبرير العنف، بل تؤسس له معرفيا وأخلاقيا، وتمنحه شرعية دينية وتاريخية مسبقة. وبهذا المعنى، لا يمكن فصل القتل الجاري عن التعليم الذي سبقه، ولا الإبادة الميدانية عن الإبادة الرمزية والمعرفية التي مارستها المدرسة لعقود. فحين يُربى الطفل على أن الأرض له وحده، وأن الآخر دخيل أو مدنس أو عدو مطلق، فإن الانتقال من الكتاب المدرسي إلى الزناد ليس قفزة، بل استمرارا منطقيا لمسار واحد.
ومن هنا تنطلق هذه السلسلة من المقالات، لا بوصفها خطابا سياسيا أو رد فعل انفعالي، بل باعتبارها جهدا تحليليا نقديا يسعى إلى مساءلة المنهج التعليمي الإسرائيلي من زاوية المسؤولية القانونية والأخلاقية، ويفكك آلياته التربوية والنفسية والرمزية، ويكشف كيف تتحول المدرسة إلى فضاء تأسيسي لإنتاج العنف، وبناء وعي جمعي مهيأ للإبادة قبل أن يبلغ الطفل سن المساءلة القانونية.
إن الهدف من هذا العمل ليس تبادل الاتهامات، بل تثبيت حقيقة منهجية واضحة: أن التعليم ليس محايدا، وأن المنهج الذي يُنتج قابلية القتل شريك في الجريمة، وأن الصمت الدولي عن هذه الحقيقة ليس حيادا، بل تواطؤ معرفي وأخلاقي مع الإبادة.
منهجية الكراهية:
تكشف الدراسات الحديثة عن وجود بنية تربوية ممنهجة في البرامج التعليمية الإسرائيلية، تقوم على تشويه صورة الإنسان العربي في وجدان الطفل اليهودي، لا عبر التحريض الصريح وحده، بل من خلال آليات أعمق وأخطر. إذ يُقدم العربي في كثير من المضامين التعليمية بوصفه كائنا مشوها في بنيته النفسية والعقلية:
₋ عاطفيا، متهورا، عديم الرؤية، لا يستحق الاحترام أو الندية، بل الازدراء أو الشفقة.
وفي هذا السياق، يشير هارفين إلى أن غياب أي برامج تربوية جادة تُعالج العلاقة مع العرب، مقابل تكريس سرديات مشوهة عنهم، أسهم في إنتاج طلاب جامعيين إسرائيليين لا يُبدون أي استعداد نفسي للتسامح، لأنهم تشكلوا منذ الطفولة على رفض العربي دون وعي مباشر أو مساءلة نقدية.
وقد أثبتت دراسات تحليلية لكتب المرحلة الابتدائية والثانوية وجود عدد كبير من العبارات، المباشرة وغير المباشرة، التي تُرسخ مشاعر الكراهية والتمييز تجاه العرب. فمن جهة، يُقدمون على أنهم أعداء بالفطرة، ومن جهة أخرى تُزرع في نفس الطالب فكرة أن العربي “لا يفهم” إلا لغة القوة، وأن ممارسة العنف ضده مبررة أخلاقيا وتربويا، بل ومطلوبة أحيانا بوصفها وسيلة دفاع أو وقاية.
ويأتي تصريح الحاخام “عوفاديا يوسف” في أبريل 2011، حين وصف العرب بأنهم “أولاد أفاعي”، ليعزز هذا التوجه، إذ لا يمكن فصل هذا الخطاب عن المناخ التربوي العام، بل يبدو امتدادا عضويا للخطاب المؤسس داخل المنظومة التعليمية. فعندما يُنشأ الطفل:
₋ على أن العربي ليس ندا إنسانيا، بل عقبة في الطريق الإلهي للسيطرة والتمكين.
فإن ذلك يُنتج نفسيا ما يمكن تسميته بـ”النرجسية الهُوياتية”، وهي حالة مرضية تتشكل فيها الهُوية على أساس تضخم شعوري بالذات الجمعية، يقوم على ادعاء التفوق الديني والسياسي والأخلاقي، ويحتاج إلى نفي الآخر وتحجيمه كي يستمر. وتُغذى هذه النرجسية بكراهية وقائية موجهة ضد كل مختلف، ليس لأنه يشكل خطرا فعليا، بل لأنه يهدد صورة التفوق المتخيلة التي تقوم عليها الهُوية نفسها.
ولم تقف الاستراتيجية الصهيونية عند حدود التعليم النظامي، بل سعت إلى تعميم خطاب الكراهية عبر أدوات الإعلام والفضاء الجماهيري، بما يُنتج استمرارية سلوكية على أرض الواقع، تبدأ من التنمر على الأطفال العرب في المدارس المختلطة، ولا تنتهي عند تبرير سياسات التهجير والمجازر بوصفها “ضرورة أمنية”.
“من سرق القمر”؟:
لم تكن قصة “من سرق القمر؟” الواردة في كتب الأطفال الإسرائيلية مجرد حكاية عابرة، بل شكلا رمزيا بالغ الدلالة للبرمجة الشعورية المسبقة، حيث يُزرع في وجدان الطفل أن العربي هو سبب الظلام، وسارق الحلم، ومعطل النور.
وفي هذا الإطار، يشير يوروش إلى أن عملية الشحن العدواني ضد العرب تُنفذ عبر أدوات متعددة، تبدأ من النصوص الأدبية ذات المضامين العنصرية المباشرة، وتمتد إلى الرسومات والتعليقات المصاحبة، التي تُسهم في خلق انطباع وجداني دائم لا يقوم على التحليل أو التقييم، بل على الربط الشعوري السلبي.
ففي قصة “بيروي إيغناز” الشهيرة للأطفال، تُسأل الطفلة الصغيرة: “من سرق القمر؟” فتُجيب دون تردد: “العرب”. وحين يُطرح عليها السؤال: “وماذا يفعلون به؟” تُجيب: “يعلقونه للزينة على جدران بيوتهم!”، ثم يُكمل الراوي: “أما نحن فسنحوله إلى مصابيح صغيرة تُضيء أرض إسرائيل”.
بهذه البنية السردية، يُقدم العربي بوصفه كائنا فوضويا غير منتج، يعيش على السطو والتطفل، بينما يُقدم الإسرائيلي بوصفه صاحب الرؤية والمستقبل والضوء. وتندرج هذه الآليات ضمن ما يُعرف بـ”التأطير الرمزي القهري”، أي خلق رموز مختارة بعناية لغرس مشاعر مركبة من الخوف والاحتقار والتفوق، في مرحلة تسبق النضج النقدي لدى الطفل.
ولا يتعلق الأمر هنا ببرمجة إدراكية سطحية، بل بتشويه بنيوي للوجدان، يُحول كل تفاعل لاحق مع العربي إلى تفاعل تحكمه سلفا صورة سلبية جاهزة، تُسقط تلقائيا دون وعي أو مراجعة. فالطفل لا يُعلم حقائق، بل يُدرب على رد فعل وجداني مُسبق. ومع تكرار هذا النوع من القِصص، تتكرس في بنيته النفسية ما يُعرف بـ”الذاكرة الانفعالية”، وهي نمط من الذاكرة لا يقوم على المعرفة، بل على الانطباعات المشحونة عاطفيا، المختلطة بالخوف أو التفوق أو الاشمئزاز، والتي يصعب تفكيكها لاحقا.
وهكذا تُصبح الكراهية للعرب نتاجا تربويا ممنهجا، لا موقفا سياسيا طارئا، وتُغذى منذ الطفولة عبر سرديات مدروسة، فتتجذر في الوعي الإسرائيلي منذ مراحله الأولى.
التكوين المبكر للغطرسة الإثنية
في أحد كتب المطالعة المقررة للصف الثامن، يُنقل شعور أحد اليهود الأشكناز الذين كانوا يقيمون في فلسطين قبل عام 1948، يعبر فيه عن غضبه من معاملة اليهود السفارديم، قائلا: “كنتُ ثائر الأعصاب في تلك الأيام… مُهتاجا… نفس يائسة… الأطفال يمرون بأولادي ويهتفون: عبدٌ عربي!”.
ولا يُقدم هذا المقطع بوصفه شهادة شخصية معزولة، بل يُدرس للطلبة ضمن سردية نفسية تستبطن تصنيفا عنصريا مزدوجا. فمن جهة، يُصور العربي بوصفه عنصرا دونيا بطبعه، شتاما، يطلق ألفاظا مهينة، ومن جهة أخرى تُحول معاناة اليهودي إلى لحظة مركزية في السرد، تُشحن بها نفسية الطالب اليهودي بشعور المظلومية التاريخية، وتُمهد من خلالها الأرضية النفسية لرفض أي علاقة طبيعية أو متكافئة مع العربي.
ويمثل هذا النمط أحد أشكال التكوين العاطفي المبكر، الذي يُغرس في الطفل عبر روايات منتقاة بعناية، تُقدم الآخَر باعتباره مصدرا دائما للتهديد والإهانة، وتُغذي الإحساس بأن استرداد الكرامة لا يتحقق إلا بالتمايز القومي ورفض المساواة.
كما تكشف هذه القصة عن وظيفة التعليم في هذا السياق، إذ لا يُدرس التاريخ للفهم والتحليل، بل لتكريس مظلومية مضخمة تُستخدم لاحقا لتبرير عنف الدولة، وترسيخ فكرة أن كل عربي هو بالضرورة امتداد لسلسلة من الإهانات التاريخية التي طالت اليهود. وبهذا، يتشكل في نفسية الطفل الإسرائيلي نمط مركب من الشعور بالحق المقدس، والتهديد الدائم، والتفوق الأخلاقي، بوصفه مكونات أساسية للهُوية.
خاتمة
يكشف هذا العرض، في مجمله، أن التشويه الممنهج لصورة العربي في التعليم الإسرائيلي ليس نتاج زلات عابرة أو اختيارات تربوية معزولة، بل هو بناء متكامل تتداخل فيه المدرسة، والنص، والرمز، والسرد، لتشكيل وعي مبكر مشحون بالكراهية، ومحصن ضد المراجعة، ومهيأ لتبرير العنف قبل أن يراه، والتفوق قبل أن يُسائل معناه. فالعربي لا يُقدم هنا بوصفه إنسانا له تاريخ وثقافة وحق في الندية، بل بوصفه وظيفة رمزية داخل خطاب تربوي قائم على الخوف والعداء ونفي الآخر.
إن خطورة هذه المنظومة لا تكمن فقط فيما تقوله صراحة، بل فيما تُدربه خفية: ردود فعل وجدانية جاهزة، ذاكرة انفعالية مُسبقة، وهُوية تُبنى على نفي غيرها. وبهذا المعنى، فإن المدرسة الإسرائيلية لا تكتفي بنقل معرفة منحازة، بل تُنتج إنسانا مؤدلجا نفسيا، يرى العالم من خلال ثنائيات مغلقة: نور-ظلام، مختار-دوني، أمن-تهديد، وهي ثنائيات تُغلق أفق السلام الحقيقي قبل أن يبدأ.
ومن هنا، فإن تفكيك هذه المضامين ليس عملا توثيقيا فحسب، بل ضرورة معرفية وأخلاقية، لفهم كيف يُصنع الصراع في الوعي قبل أن يُمارَس في الميدان، وكيف تتحول الطفولة إلى مختبر لإعادة إنتاج العداء عبر الأجيال. وفي المقالات القادمة، سنواصل تعميق هذا التفكيك، بالانتقال إلى تحليل النصوص التاريخية والجغرافية، والخرائط، واللغة الدينية، والصورة البصرية، لرصد كيف تتكامل هذه العناصر في بناء صورة العربي بوصفه “الآخر غير القابل للاعتراف”.
فالمعركة هنا ليست على السرد فقط، بل على الوعي، وعلى الحق في أن يُرى الإنسان إنسانا قبل أي تصنيف آخر.
فالمعركة هنا لا تُدار على مستوى السرد وحده، بل تمتد إلى الوعي، بل وتتغلغل في طبقات اللاشعور الجمعي، حيث تُزرع الصور الأولى، وتُبنى الانطباعات السابقة على التفكير، ويُصادر الحق في أن يُرى الإنسان إنسانا، قبل أن يُختزل في أي تصنيف ديني أو قومي أو سياسي.