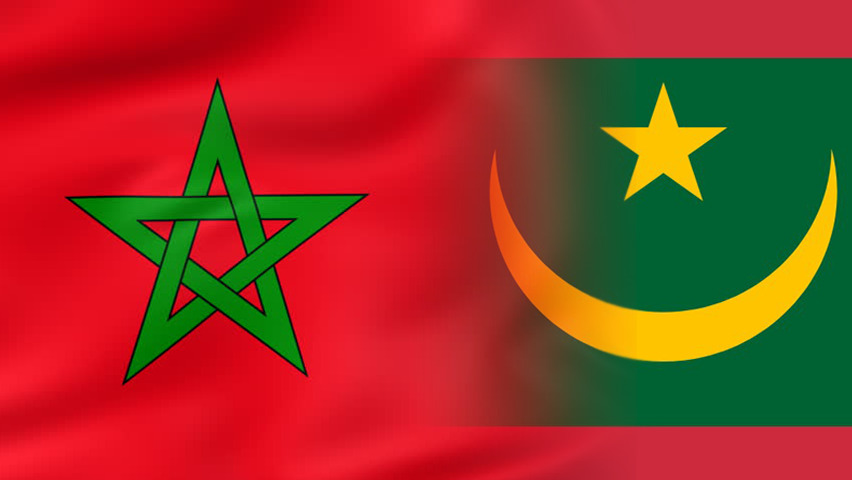التعليم في المغرب في عهد “الحماية” الفرنسية بين الفرنسة وسلخ الهوية

هوية بريس – حاتم بن محمد الكوراجي
“إن القوة تبني الإمبراطوريات، ولكنها ليست هي التي تضمن لها الاستمرارَ والدوام، إن الرؤوس تنحني أمام المدافع، في حين تظل القلوب تغذي نارَ الحقد والرغبة في الانتقام، يجب إخضاعُ النفوس بعد أن تم إخضاعُ الأبدان”؛ جورج هاردي.
“إن سياسة فَرنسا تجاهَ اللُّغة العربية الفصحى كانت واضحةً لا لبس فيها، وهي محاربةُ هذه اللغة بكل وسيلة ممكنة، وقطعُ الصلة بكل ما يؤدي إلى نشرها وتعلُّمها؛ لأن الهدف المرسوم هو تطويرُ المغاربة – والبربر منهم بصفة خاصة – خارجَ إطار هذه اللغة، والانتماء للحضارة العربية الإسلامية”؛ محمد عابد الجابري.
في دراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية يُساعِدنا الربط المنهجيُّ بين الأسباب والمنهج على فهم الظاهرة، ويقرِّبنا أكثر من بِناء نظرة شمولية فاحصة؛ ذلك أن الاقتصار على التحليل الواقعي، وملاحظة سير هذه الظواهر بعيدًا عن الأسباب والنتائج المراد تحقيقها – يجنح بنا بعيدًا عن الحقيقة، ويُغرِقنا في تفاصيل التحليلات، وقد يصعب علينا في أحيانٍ كثيرة تفسيرُ الوقائع، ووضعها في سياقها العام، خصوصًا ما قد يبدو منها متناقضًا ومختلفًا، واستصحابُ دراسة الهدف بالتوازي مع منهجية تحقيقه – تجعلنا أكثر إلمامًا وفهمًا، وتجعل عملية جمع الجزء إلى مثيله يسيرةً ومنطقية، والذي يخضع في الغالب للكل.
وقبل الحديث عن واقع التعليم في المغرب إبَّان فترة الحماية، تجدر الإشارة إلى الدوافع الأساسية للسياسة التعليمية الفَرنسية، والتي يتحدث عنها “هاردي” – مسؤول السياسة التعليمية في المستعمرات الفَرنسية – بشكل واضح وصريح؛ إذ يقول:
“إن القوة تبني الإمبراطوريات، ولكنها ليست هي التي تضمن لها الاستمرارَ والدوام، إن الرؤوس تنحني أمام المدافع، في حين تظل القلوب تغذي نارَ الحقد والرغبة في الانتقام، يجب إخضاعُ النفوس بعد أن تم إخضاعُ الأبدان…”[1].
نحن إذًا أمام نصٍّ صريح واضح لا يحتاج إلى واسعِ نظر لاستنتاج الهدف الأساسي من السياسة التعليمية الاستعمارية في المغرب، إنها حصرًا – وكما يعبر “هاردي” – تهدف إلى إخضاع النفوس للمستعمِر؛ حيث يتم الاستفادة من المخزون البشري للمستعمَرات، لخدمة مصالح فَرنسا، وضمان تبعيَّة الجيل الذي ستتم تنشئته في المدارس الفَرنسية؛ أي إن الحديث عن “تطوير المغرب” وإخراجه من “ظلمة الجهل والتردِّي” – كما يحب أن يبشرنا بذلك (وايسرجر) – لم يكن إلا خطابًا ترويجيًّا لذرِّ الرماد في العيون، وليتمَّ ترويض المغاربة دون محاولة استثارتهم أو استعدائهم، ويتضح هذا جليًّا حين معاينة السياسة العملية التي اتَّبعتها فَرنسا، خصوصًا إذا ما تم النظر إليها تبعًا للأهداف المصرَّح بها، وبِناءً على ذلك سيتم اتباع سياسات تعليمية ممنهجة لتحقيق السيطرة وتسريعها، والحد من ممانعتها، أو التقليل منها في أقل الأحوال.
وقد اتَّبعت فرنسا في سبيل تحقيق أهدافِها خطةً تعليمية، اعتمدت في الأساس على التفرِقة والطبقية، فكان التعليمُ في عهد الحماية طبقيًّا بامتياز، لا على صعيد العِرق فقط، بل تجاوز ذلك إلى طبقة دينية وأخرى اجتماعية، فوَفْقَ هاردي فإن فرنسا ملزَمة بالفصل بين تعليم خاص بالنخبة الاجتماعية، وتعليم لعموم الشعب؛ الأول يفتح في وجه أرستقراطية مثقفة في الجملة…، إن التعليم الذي سيقدَّم لبناء هذه النخبة الاجتماعية تعليمٌ طبقي يهدف إلى تكوينها في ميادين الإدارة والتجارة، وهي الميادين التي اختص بها الأعيان المغاربة، أما النوع الثاني، وهو التعليم الشعبي الخاص بالجماهير الفقيرة والجاهلة جهلًا عميقًا، فيتنوع بتنوع الوسط الاقتصادي؛ في المدن يوجَّه التعليم نحو المِهَن اليدوية، خاصة مهن البناء، وإلى الحرف الخاصة بالفن الأهلي، أما في البادية، فيُوجَّه التعليم نحو الفلاحة…، وأما المدن الشاطئية، فسيوجَّه نحو الصيد البحري والملاحة[2].
فحسب رؤية “هاردي” فالمغاربة المسلمون ثلاث طبقاتٍ: طبقة الأعيان، وطبقة سكان المدن “الجهال”، ثم القرويون المنعزلون، الأكثر فقرًا وجهلًا!
ويعطي “مارتي” رؤيةً تفصيلية لهذه الطبقات الثلاث والمنتمين إليها، فيقول: “هناك انقسام طبقي واضح في المغرب…؛ ففي أسفل السُّلَّم هناك الجماعات الدنيا، نصف مستعبدة ونصف مسخَّرة…، ثم هناك الشعب: فلاحون، ورعاة…، ثم هناك البرجوازية التجارية والقروية، وأخيرًا هناك في أعلى السُّلَّم “رجال المخزن”…، ورجال الدين”[3].
وينبغي أن يكون لكلِّ طبقة تعليمُها الخاص، ومدارسها الخاصة بها، وموادُّها التي تناسب وضعيتَها الاجتماعية، وليس مِن المناسب أبدًا – كما يرى مارتي – أن تختلط هذه الطبقاتُ وجوديًّا وتعليميًّا ببعضها البعض.
و”يستطرد هاردي” لبيان الطريقة التي سيتم الاستفادة بها من المدارس الطبيقة المخصصة للمسلمين، ومدى جدوى المواد المقرَّرة لتحقيق ذلك، فيقول:
“إن أكثر ما يجب أن نهتمَّ به هو أن نحرِصَ على ألَّا تصنع لنا المدارس الأهلية رجالًا صالحين لكل شيء، ولا يصلحون لشيء، يجب أن يجد التلميذ بمجرد خروجه من المدرسة عملًا يناسب التكوين الذي تلقَّاه؛ حتى لا يكون من جملة أولئك العارفين المزيفين، أولئك اللا منتمون طبقيًّا، العاجزون عن القيام بعمل مفيد، والذين تنحصر مهمتهم في المطالبة، هؤلاء الذين عمِلوا على جعل التعليم الأهلي يصبح منبعًا للاضطراب الاجتماعي”[4].
ولا بد من تسجيلِ ملاحظة بخصوص كلام (هاردي)، وهي توجُّسه مِن تحوُّل هذه المدارس الأهلية من إنتاج “آلات بشرية” تخدم مصلحة المستعمر وسياساته، إلى خريجين ذوي توجُّهات ثورية، “مهمتهم المطالبة”، فيجب أن يبقي التعليم خاليًا من الجانب القيمي، ومما من شأنه أن يعكر صفو السياسة الاستعمارية، أو يقف حاجزًا أمامها وعائقًا لاستقرارها!
وهذا التوجُّس لم يكن خاصًّا بهاردي فحسب، بل هو عامٌّ عند السلطات الاستعمارية، يقول “مارتي” معبرًا عن نفس التوجه:
“وإذًا فيجب ألَّا نهتمَّ بالكم، يجب ألا نصنع في المغرب سنةً بعد أخرى وبشكل مطَّرد – وعلى حساب مصلحة المجتمع المغربي ومصلحة الإمبراطورية الفَرنسية – رجالًا يُنمِّي فيهم التعليم أذواقًا وحاجات وآمالًا لن يقدروا هم على إرضائها بأنفسهم، ولن تقدر الحماية ولا المخزن، ولا المستعمرة، ولا الاقتصاد المغربي على تحقيقها لهم”[5].
فمن المهم جدًّا عند “مارتي” أن يكونَ للسياسة التعليمية في المغرب سقفٌ، وأن يكون “تحديث المغاربة” في مجال التعليم مرتبطًا بتحقيق الأهداف الاستعمارية الفَرنسية، ولا يتجاوزها إلى أبعد من ذلك، فليس المطلوب إذًا تخريجُ طبقات متعلمة واعية، بل مجرد تعليم مختلف الطبقات ليسخَّروا لخدمة فرنسا، وعليه؛ فإن أيَّ تطوير للوعي يعدُّ مخاطرة كبيرة في سياسة المستعمِر، فالتطوير المستمر يعني – حسب هاردي – “صناعة رجال ينمي فيه التعليم أذواقًا وحاجات وآمالًا”، لن تقدر ولن تقبل الحماية توفيرها؛ لأن ذلك سيكون ضد مصلحة فرنسا الاقتصادية والسياسة في المغرب.
لقد تم في هذا السياق الاهتمامُ البالغ بتطوير جامعة القرويين، وهو ما يظهر للوهلة الأولى بعيدًا عن النهج الفرنسي المتَّبع إزاء التعليم الأصيل ومبادئه الإسلامية ولُغة تدريسه، خصوصًا إذا ما تم استصحاب تصريح “هاردي” حول الوقوف بصرامة في وجه الفقهاء الذين يقِفون عقبة في ولوج طلبة المدارس “البربرية – الفَرنسية”، لكن ذلك لم يكن خارج السياق العامِّ، ولم يكن استثناءً، بل تم بتناسق شديد مع رؤية سلطات الاستعمار للأهداف التي ينبغي أن يحققها التعليم المغربي، وإبعاد أي عامل مشوش على تحقيقها أو مبطئ لسيرها العادي.
يُوضِّح المستشرق الفَرنسي “بيكي” ذلك مؤكدًا على أن هذا “الإصلاح” لا يتعارض ومصالح فَرنسا في المغرب، بل العكس، يجنِّبها خطرًا أكبر وشرًّا أعظم، فيقول:
“لقد احتفظت الحماية، دون تردد، بالتعليم القائم في هذه المساجد، وعمِلتْ على ترميمه، وعلى إعادة جامعة فاس إلى سابق إشراقها، ومِن المؤكد أنه من مصلحتنا ألا يذهب المغاربة للبحث عن هذا النوع من التعليم في الخارج؛ كالجامع المشهور جامع الأزهر بالقاهرة”[6].
فأكبر هواجس فرنسا إمكانية احتكاك هؤلاء الطلبة بالحركات التحرُّرية القومية والإسلامية في مصر، أو أن يتم تزويدهم بجرعات ثقافية إنجليزية منتشرة آنذاك في مصر، وإنجلترا هي الغريم التقليدي للثقافة الفَرنسية، والمنافس على المستعمرات!
يضيف “مارتي” شارحًا المصلحة في إعادة ترميم القرويين متسائلًا: “ألا يعودون – الطلبة المغاربة – مزوَّدين بميول إنجليزية أو بروح النهضة الإسلامية والتعصب الوطني؟”[7].
ويذهب “مارتي” بعيدًا حين يُقرِّر أن مما ينبغي على فرنسا أن تجعل نصب أعينِها ألا تقع فيما وقع فيه الإنجليز، فيتم إرسال بعثات من الطلاب المغاربة – خصوصًا من مدارس الأعيان – إلى فرنسا، وأنه ينبغي توفير الموادِّ المدروسة في المدارس المغربية؛ لأنهم سيتلقَّون في المقاهي وفي الجامعات وفي الشوارع آراء ومبادئ ثورية[8].
أما فيما يخص المواد العامة ولُغة التدريس، فيقول “هاردي”: “إنها بطبيعة الحال اللُّغة الفَرنسية، التي بواسطتها سنتمكَّن من ربط تلاميذنا – المغاربة – بفرنسا، والتاريخ الذي يجب أن يعطيهم فكرة عن عظمة فرنسا”[9].
“إن اللُّغة الفَرنسية في اعتبار (هاردي) هي أكثر من لُغة للتدريس – بالمعنى الديداكتيكي البيداغوجي – إنها أيديولوجية تعمل على ربط المغاربة بفرنسا وبتاريخها العظيم / المجيد، ومن هذه الأمجاد والعظمة التي لا تُدرَّس طبعًا الاستعمارُ الألماني لفرنسا، ودخول هتلر إلى قصر الإليزيه، وإلقاء خطابه التاريخي، إن اللغة الفَرنسية هي سلاح المعركة إذًا، ولربح الرهان لا بد من حسن استعمال هذا السلاح، حتى ولو تطلَّب الأمر اقتلاع الشعوب والأمم من امتدادها الحضاري، والرمي بها في مزابل التاريخ؛ إن الغاية تبرر الوسيلة؛ حسب جورج هاردي”[10].
ويتضح جليًّا مدى حرص “هاردي” وغيرِه من المستشرِقين الاستعمارِيين على ربط أي إجراء دقَّ أو جلَّ بالهدف الأساس، وهو خدمة فَرنسا، والطبيعي أن يتم ذلك على حساب اللغة العربية التي تم حصارها في المدارس العتيقة والتعليم الأصيل المضيَّق عليه أصلًا؛ إذ كان يتم “إغلاق كتاتيب تعليمِ القرآن، ومُحاربة معلِّمي القرآن، والتقليص من حصص تعليم العربية في المدارس الرسمية المزدوجة، وإحداث مدارس فَرنسية خالصةٍ، تابعة للبعثة التعليمية الفَرنسية، وخاضعة لوزارة التعليم الفَرنسية مباشرة، أو مدارس كاثوليكية تحت مُسمَّيات واضحة أو مُتستِّرة، ومدارس أخرى فَرنسية بربرية، كما عَمِلَتْ على إحداث معهد عالٍ لتعليم الدارجة المغربية؛ لتخريج الأطر والمساعدين القادرين على مخاطبة المواطنين بالدارجة عِوَضَ الفصحى”[11].
أي إن السياسة اللُّغوية المعتمدة ذات شقَّينِ أساسين:
أولهما: القضاء على اللُّغة العربية الفصحى، ثم إحلال اللغة الفَرنسية محلها، غير أنه لا بد لنا من تسجيل ملاحظة مهمة حول هذا التغير اللُّغوي الذي كانت تسعى فرنسا إليه في تعاطيها مع النظام التعليمي المغربي، وهو مركزية اللُّغة الدارجة – التي سُمِّيت حينها بالمغربية – في هذا المشروع الاستعماري، ذلك أن المحتل الفَرنسي سعى جاهدًا إلى أن تتبوأ اللغة الدارجة مكانةً استعمالية كبرى، كما ورد فيما ذكره الباحث سلمان بونعمان من إنشاء فرنسا معهدًا عاليًا لتعليم الدارجة المغربية؛ لتخريج الأطر والمساعدين القادرين على مخاطبة المواطنين بالدارجة، عِوَضًا عن الفصحى.
“فإن سياسة فرنسا تُجاهَ اللغة العربية الفصحى كانت واضحةً لا لبس فيها، وهي محاربةُ هذه اللغة بكل وسيلة ممكنة، وقطعُ الصلة بكل ما يؤدي إلى نشرها وتعلُّمها؛ لأن الهدف المرسوم هو تطويرُ المغاربة – والبربر منهم بصفة خاصة – خارجَ إطار هذه اللغة والانتماء للحضارة العربية الإسلامية“[12].
وما سُمِّي آنذاك بالتعليم الإسلامي لم يحمل مِن هذا الوصف غير الاسم، وقبل سنة 1944 م “لم يكن هناك أي اهتمام باللغة العربية والمواد الإسلامية، فلقد كانت اللغة العربية والثقافة الإسلامية ممنوعةً أو شبه ممنوعة، إلا ما كان مِن بعض الدروس الدينية في مدارس الأعيان، أما بعد سنة 1944م، فقد تم تخصيص 10 ساعات للغة العربية والمواد الدينية، مقابل 20 ساعة للفَرنسية والمواد المدروسة، وفي الابتدائي ظلَّت حصص العربية هزيلةً مملة، غير خاضعة لأي توجيه أو مراقبة، فقد كانت طرق التلقين تقليدية، وكان الأساتذة ضعفاء من جهة التكوين البيداغوجي، وفي الثانويات اعتُبِرت اللغة العربية لُغة ثانية، أما في “الليسيات”، التي كانت مدار نخبة بعد أن تم السماح بعد سنة 1944 م للمغاربة بولوجها، فقد كانت العربية مادةً مهملة، مادتها قصص خرافية وحكايات تشوه المغرب وتاريخه”[13].
ومن جهة أخرى تم تقسيم سكان المغرب – بالنظر إلى الدين الذين ينتمون إليه – باعتبارهم ثلاثة كيانات غير متجانسة: المسلمون، واليهود، والأوربيون، وتم تخصيص نمط تعليم لكل طائفة من هذه الطوائف، وقد سبق الحديث عن التعليم المخصص للمغاربة المسلمين.
أما فيما يخص المدارس اليهودية، فإن أول ظهورها في المغرب كان قبل فرض الحماية، وتحديدًا في عهد المولى محمد بن عبدالرحمن، الذي أصدر ظهيرًا لحماية اليهود بعد تدخُّل الرابطة الإسرائيلية عقب إعدام يهوديينِ اتُّهما بتسميم مندوب الحكومة الإسبانية، وقد جاء في نص الظهير:
“بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نأمر مَن يَقِفُ على كتابنا هذا…، مِن سائر خُدَّامِنَا وعُمَّالِنَا، والقائمين بوظائف أعمالِنا، أن يعاملوا اليهود الذين بسائر إيالتنا بما أوجبه الله تعالى من نَصْبِ ميزان الحق، والتسوية بينهم وبين غيرهم في الأحكام؛ حتى لا يَلْحَقَ أحدًا منهم مثقالُ ذرة من الظلم ولا يُضَام، ولا ينالَهم مكروه ولا اهتضام، وألا يتعدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم، وألا يستعملوا أهلَ الحرف منهم إلا عن طيب أنفسِهم، وعلى شرط توفيتهم بما يستحقُّونه على عملهم…، ومَن ظَلَمَ أحدًا منهم أو تَعَدَّى عليه، فإنَّا نعاقبُه بحول الله…”[14].
ليتم إنشاء حوالي 20 مدرسة يهودية بتمويل من الرابطة الإسرائيلية العالَمية، ومنظمات يهودية أخرى في الفترة ما بين 1862م إلى 1911م، ولم يحتَجِ المستعمرُ إلى إدخال كثير من التغييرات على هذه المدارس، فقد فرضت اللجنة المركزية للرابطة الإسرائيلية العالَمية مقرَّرًا عامًّا في كل مدارسها، يعتمد على تعلُّم اللغات الأجنبية والتحدُّث بها بطلاقة، واعتماد اللُّغة الفَرنسية لغة تعليم، مع اعتماد اللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، والحساب والمواد التالية: الهندسة، والفيزياء، والكيمياء، بالإضافة إلى العِبْرية والتاريخ اليهودي، والتاريخ العام، والجغرافية[15] .
ومما يثير الانتباهَ كون اليهود اعتمدوا مبكرًا في مدارسهم اللغة الفَرنسية لغةً أساسية، رغم أنهم في الأصل مواطنون مغاربة، ترجع جذور قسم منهم إلى وجود الفينيقيين في المغرب، وقسم آخر إلى ما بعد سقوط الأندلس؛ حيث هاجروا هم والمسلمون بعد الاضطهاد النصراني لهم، ولعل ذلك يرجع إلى كون اليهود ينظرون إلى أنفسهم كطائفة لا انتماء لها لهذا الوطن، ولا رابطة بينها وبين المغاربة المسلمين، فكانت هذه المدارس بعد الاستعمار نسخةً طبق الأصل من التعليم الأوربي، الذي كان بدوره يساير برامج التعليم الفَرنسية خطوة خطوة.
وكانت المدارس اليهودية صنفين: مدارس الرابطة الإسرائيلية، والمدارس الفَرنسية الإسرائيلية، وقد بلغت نسبة التمدرس عند يهود المغرب 90 في المائة؛ لأن ولوج المدارس كان إجباريًّا ومعممًا[16].
وكما هو الشأن بالنسبة لجميعِ أنواع التعليم، فقد سجَّل “هاردي” رؤيتَه بخصوص تعليم اليهود والأهداف المتوخَّاة منها قائلًا:
“وأما بالنسبة للفتيات (الإسرائيليات)، فيجب أن نجعل منهن قبل كل شيء ربات منزل نظيفات، سليمات الجسم، مسلَّحات بمبادئ التربية وقواعد حفظ الصحة، كما يجب أن نفتح للائي يُرِدْنَ منهن عملًا يكسبن به عيشهن…، أما فيما يخص الذكور، فالهدف هو تحويل العقلية اليهودية المغربية إلى عقلية متحضِّرة، مع احترام الدين والعادات الدينية الإسرائيلية، أما من الناحية العلمية الفنية، فيجب تعليم الاسرائيليين تعليمًا فنيًّا؛ كالمحاسبة التجارية، والتسيير الإداري، وعلى العموم إعدادهم للميادين العصرية المنتجة إعدادًا يحارب فيهم الفقرَ”[17].
ويلاحظ أن النتائج المرجوَّة من التعليم اليهودي والمدارس اليهودية تُباين ما يراد تحقيقه من نمط التعليم الخاص بالمغاربة المسلمين؛ حيث يتم النظر لليهود وكأنهم مواطنون أوربيون لا مغاربة، وكونهم أقرب لروح الاستعمار من الهُوِيَّة المغربية، ليشكلوا جماعة وظيفية تابعة للاستعمار قلبًا وقالبًا.
والغريب أن “هاردي” في ثنايا حديثه عن التعليم اليهودي في المغرب يجعل من أهدافه إعدادَ اليهود ليكونوا قادرين على إعمار “الأرض الموعودة”، فيقول:
“ومَن يدري، فإذا كان بعضهم متأكدًا من أنه سيجد نفسه يومًا يعيش في طمأنينة الأرض الموعودة – فلسطين – فما عليهم إلا أن يُقبِلوا منذ الآن على المدارس الفلاحية“[18].
يبقى أخيرًا التعليم الأوربي الخاص بأبناء الفَرنسيين خصوصًا والأوربيين عمومًا، وهو تعليم لا يحتاج إلى شرح مخطط الحماية بشأنه، خصوصًا ونحن نعلم أنه بقي دومًا التعليمَ الممتاز بالمغرب، التعليم الذي يساير التعليم الموجود بفَرنسا، ويكفي أن ننظر إلى “مدارس البعثة الفَرنسية” الموجودة حاليًّا، والتي هي استمرار له، إنها خير مَن يعطينا تفاصيل أخباره“[19].
وتاريخ المدارس الأوربية يعود إلى ما قبل الحماية، فقد تم إنشاء أول مدرسة أوربية بطنجة سنة 1909 م، ليصل عدد المؤسسات الثانوية سنة 1950 إلى حوالي 14 مؤسسة، تتوزَّع على كبريات المدن المغربية؛ من أهمها: ثانوية رينو سانت أوليرRegnault SAINTAULAIRE بطنجة، وكورو بالرباط، وليوطي بالبيضاء، وبويميرو بمكناس، ومانجان بمراكش، إضافة إلى الثانوية المختلطة بكل من مدينتي فاس ووجدة[20].
وكانت الدراسةُ في هذه المدارس مقصورةً على الفَرنسيين والأوربيين، ولا يُسمَح إلا نادرًا وبشروط ثقيلة ولوج المغاربة إليها، ولو كانوا من أبناء الأعيان الذين كانت تسترعي انتباهَهم لجودة التعليم فيها، وما تحويه من مقرَّرات خاصة بالعلوم الحديثة، كما أنها كانت تؤهل المنتسبين إليها لنَيْل شهادات تمكنهم من إتمام دراستهم العليا.
وكما عمِلت السلطات الفَرنسية عقب توقيع “معاهدة الحماية”، على ترسيخ وضع اجتماعي واقتصادي وثقافي جديد، يصب في مصلحة فرنسا، ويعود بالنفع عليها في شتى المجالات، لم يكن الوضع التعليمي باعتباره مفتاحًا مهمًّا نحو مسح الهُوِيَّة الحضارية للمغاربة نشازًا، بل تم إقرار نظام تربوي جديد، خاصة في المدن والمناطق المأهولة بالسكان الأمازيغ.
وكان من أحد أهم مميزات النظام الجديد فَرْنَسَةُ التعليم بالكلية، بل والعمل على محوِ كل أثر للغة العربية من ذاكرة المتعلِّمين، لم يكن ذلك من أجلِ أن اللغة الفَرنسية – كما ينظر إليها أربابُها في ذلك الوقت – هي لغة “العلم” و”الحضارة” و”الرقي”، أو أداة للتواصل فقط؛ وإنما محاولة ربط مستعمرات فرنسا بالدولة الفَرنسية، وكأنها جزء حقيقي منها، واعتبار هؤلاء المتعلمين رعايا للدولة الفَرنسية الأم، وإن كان هذا الربط حصل بدرجات متفاوتة في المغرب الأقصى، وكان في أعلى درجاته في الجزائر، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مقاطعة فَرنسية، خصوصًا أن الفَرنسيين ما زالوا منتشين بغبار معارك الثورة الفَرنسية التي أسقطت الملكية وأقامت “الجمهورية الخالدة”؛ لذلك قامت سياسة فرنسا الطبقيَّة فيما يخص الأمازيغ على إنشاء مدارس خاصة بهم؛ لتحقيق الانفصال التام عن الهُوِيَّة العربية الإسلامية، وقد سرَّعت من وتيرة ذلك خصوصًا بعد إصدار “الظهير البربري”، وإن كان نصه لم يتضمن بندًا خاصًّا بالتعليم، غير أن مجموع ما حواه يرسخ سياسة فرنسا القاضيةَ بفك الارتباط بين الأمازيغ والعرب.
ولم يكن كل ذلك يتم برضا أهل البلد الأصليين، بل يتم فرضه بكل وسيلة متاحة وممكنة، طوعًا أو كَرْهًا، فقد كانت المعركة الثقافية التعليمية لفرنسا معركةً مصيرية؛ لإطالة الهيمنة الاستعمارية على مستعمراتها، ولتوهين كل حركة ممانعة في عكس اتجاه المصالح الفَرنسية، فكان لسكَّان الجبال من الأمازيغ النصيبُ الأكبر من هذا المشروع؛ فهم في فكرِ فرنسا مجرَّد قبائل معزولة لا يربطها بالنسيج المجتمعي المغربي رابطٌ، فلغتُهم مختلفة، وتقاليدهم مختلفة، وعملية إعادة تأهيلهم لُغويًّا وثقافيًّا ستكون يسيرةً – خصوصًا وأن ثورات القبائل الأمازيغية ظلت تُشكِّل عاملًا سلبيًّا لإتمام السيطرة على ربوع المملكة، وفي أحيان كثيرة تهديدًا للوجود الفَرنسي في مناطقهم – ليس في اتجاه فصلهم عما تراه فرنسا هُوِيَّة دَخيلة عليهم، بل حتى سلخهم عن لُغتهم الأم الأمازيغية، وهُوِيَّتهم الإسلامية، والتي – حسب “ليوطي” – تعدُّ عقبةً في طريق فرض اللغة الفَرنسية على الأمازيغ؛ فكونهم مسلمين يعني ضرورة ارتباطهم بالقرآن، وارتباطهم بالقرآن يعني حفاظهم على اللغة العربية تعليمًا وتعلمًا وممارسة لُغوية، يبين ذلك ما ورد في دورية “ليوطي” إذ يقول:
“بداية ليس علينا أن نُعلِّم العربية لمجموعة من الناس استغنَوا عنها دائمًا، إن العربية عنصر أسلمة لكونها تلقَّن في القرآن، أما مصلحتنا فتفرض”.
ففيما يخص الأمازيغ يرى “ليوطي” أنه لا يمكن فرض اللغة الفَرنسية عليهم إلا بالقضاء على العربية وسلخهم من الإسلام؛ ليسهل بعد ذلك الانتقال من الأمازيغية للفَرنسية حسب تعبيره؛ فإنه يدرك شدة ارتباط الأمازيغ بالبُعْد الديني المتمثِّل في الإسلام، ومِن ثم التمسُّك بالبعد اللُّغوي المتمثل في العربية، فالحرب على العربية يتم باعتبارها أولًا عامل تجميع مجتمعي وربط أساسي للأمة بدينها، وثانيًا باعتبارها مانعًا يحول دون تبوُّء الفَرنسية المكانة العليا.
وفي هذا الإطار تم إنشاء ما عُرِف بالمدارس البربرية – الفَرنسية، فبدأت سلطات الحماية مشروعًا لبناء هذه المدارس سنة 1923 م، فأنشأت عدَّة مدارس في أكتوبر من السنة نفسها، في مناطق جبال الأطلس، خاصة إيموزار، وعين الشكاك بناحية فاس وأزرو، وعين اللوح بناحية مكناس وخنيفرة والقباب، بالإضافة إلى مدرسة هرمومو بناحية تازة[21].

ويشرح “مارتي” هُوِيَّة هذا النوع من التعليم وأهدافه قائلًا:
“لقد حصل الاتِّفاق بين إدارة التعليم العمومي وإدارة الشؤون الأهلية، وتحدَّدت بذلك مبادئ سياستِنا التعليمية البربرية، بكامل الدقة، إن الأمر يتعلَّق هنا بمدارس فَرنسية – بربرية، مدارس تضم صغار البربر، يتلقَّون فيها تعليمًا فَرنسيًّا محضًا، ويسيطر عليها اتجاه مهني، فلاحي بالخصوص، إن البرنامج الدراسي يشتمل على دراسة تطبيقية للغة الفَرنسية، لغة الحديث والكلام، بالإضافة إلى مبادئ الكتابة والحساب البسيط، ونُتَف من دروس الجغرافية والتاريخ، وقواعد النظافة، ودروس الأشياء…، إن أي شكل من أشكال تعليم العربية، إن أي تدخل من جانب الفقيه، إن أي مظهر من المظاهر الإسلامية – لن يجد مكانَه في هذه المدارس؛ بل سيُقصى بكل صرامة…”[22].
ويمكن تلخيص أهم معالم هذه المدارس فيما يلي:
• التعليم سيكون فَرنسيًّا محضًا.
• مجالات التدريس الأساسية هي المهن والفلاحة.
• اللغة التي ستدرس بها المقررات هي الفَرنسية فقط.
• اللغة العربية والحس الإسلامي مغيَّب بالكلية، بل ستواجه كلُّ محاولة للتدخل بصرامة.
ولم يتم حصر نظام التعليم هذا في المدارس الابتدائية فقط، بل تم تعميمه على المرحلة الثانوية والدراسات العليا أيضًا، فتم إنشاء ثانويات بربرية – فرنسية؛ كثانوية أزرو التي تم إنشاؤها سنة 1927 م، والمدرسة العليا الفَرنسية البربرية سنة 1914 م[23].
غير أن نظام التعليم في عهد الحماية عامة، والمدارس البربرية – الفرنسية خاصة، عرف فشلًا ذريعًا وانهيارًا مدويًا؛ فمن مجموع المدارس البربرية – الفَرنسية، ظلت ثانوية أزرو الوحيدة المحافظة على طابعها غير العربي، وإلى حدود 1948 م فقط.
هذا السقوط والفشل بقدر ما كان مفرحًا ونصرًا للحركة الوطنية، بقدر ما خلف آثارًا كارثية على ساكنة الجبال، الذين حُرموا من التعليم نهائيًّا، خصوصًا أن السلطات الاستعمارية قد قامت بتصفية الكتاتيب القرآنية في سياق السياسية البربرية، وقد كانَتِ الملاذَ التعليمي الوحيد في هذه المناطق، ولم يكن الحال في البوادي المغربية بأحسن حالًا؛ إذ كانت هي الأخرى محرومةً من التعليم الحديث.
وإذا علِمنا أن نسبة سكان البوادي والأرياف بلغت 90 في المائة، يتضح لنا حجم الكارثة التعليمية التي تسبَّبت بها سلطات الحماية؛ أي إن نسبة غير المتمدرسين، أو الذين تلقوا تعليمًا ضحلًا، تتجاوز 90 في المائة من مجموع الساكنة، باعتبار أن كثيرًا من البالغين سنَّ التمدرس لم يلتحقوا بالمدارس.
وقد عرَفت الفترةُ من 1944 م فما بعد حراكًا وطنيًّا نشيطًا، وتحولت الحركة الوطنية من مجرد المطالبة بالإصلاح إلى الحديث عن الاستقلال، وقد كان لهذا الأمر أثرُه على التعليم؛ حيث عرَفت هذه الحقبة ظهورَ المدارس الخاصة العربية الوطنية، والتي كانت نوعًا من أنواع الممانعة ضد التعليم الذي وضعه المستعمر ومنافسة له، ولا بد من الإشارة أن التعليم في المدن أيضًا كان هزيلًا ضعيفًا، فلم تتجاوز نسبة المتمدرسين من البالغين سنَّ التمدرس في سنة 1945 م 2.7 في المائة، وإنما وُصف بالأفضلية من جهة مقارنته بالتعليم في الأرياف والبوادي.
والإشارة إلى غياب التعليم في البادية، يجب ألَّا يُفهم منه أن جماهير المدن كانت أحسن حظًّا في هذا الميدان، لقد بقي التعليم الفَرنسي في المغرب تعليمَ نخبة، ضيِّق الانتشار، قليل المردود؛ كما يتجلى في البيانات التالية:
في الفترة ما بين 1912 إلى 1945:
• حتى سنة 1920 كان مجموع تلاميذ المدارس الابتدائية لا يتعدى 7000.
• سنة 1938 لم يتجاوز 23.270 طفلًا، في المقابل تجاوز عدد تلاميذ المدارس الأوربية 34.000، وتلاميذ المدارس اليهودية 19.000، علمًا أن عدد الأوربيين يُمثِّل3.3 في المائة من سكان المغرب، وأقل منه نسبة اليهود المغاربة.
• سنة 1945 لم يكن عددُ التلاميذ يتجاوز 41.490.
وتتَّضِح كارثية التعليم في المدن في هذه الفترة، خصوصًا بالنظر إلى النتائج؛ وهي كالتالي:
• ما بين 1926 و1936 كان عدد الحاصلين على الباكالوريا الأولى 30 تلميذًا، بمعدل 3 تلاميذ في السنة.
• وكانت حصيلةُ التعليم الفَرنسي في المغرب منذ قيامه إلى سنة 1944 كما يلي: 3 أطباء، 6 محامين، 6 مهندسين، فلاحان.
في الفترة ما بين 1945 إلى 1955:
عرَفت هذه الفترة تحسنًا ملحوظًا؛ وذلك راجع لرفعِ سلطات الحماية نسبةَ القَبول في الابتدائي؛ حيث ارتفعت من 2500 إلى 10.000 تلميذ، ليصل عدد التلاميذ في المدارس الإسلامية سنة 1950 إلى 114.535، وفي سنة 1953 إلى 190.000 تلميذ، و210.018 تلميذًا في سنة 1954، ورغم ذلك لم تتجاوز نسبة المتمدرسين ممن بلغ سن التدريس سنة 1950 7 في المائة، ونسبة 11 في المائة سنة 1954.
وقد كانت نتائج هذه الفترة كالتالي:
• 4.188 تلميذًا حاملًا للشهادة الابتدائية.
• 175 حاصلًا على الباكالوريا، في حين حصل على البكالوريا الثانية 94 تلميذًا.
التغيير الثاني الذي عرَفته هذه الحقبة هو سماحُ السلطات الفَرنسية بالولوج للمدارس الأوربية؛ حيث تم تخفيف شروط الولوج للطلبة المغاربة، ليتهافت الأعيان، وأبناء الطبقة البرجوازية والأرستقراطية على هذه المدارس؛ لأنها الوحيدة – إلى جانب اليهودية – التي كانت تقدِّم تعليمًا عصريًّا يضمن للمتخرجين فيه مستوى لائقًا، يمكِّنهم من متابعة دراستهم العالية، ليبلغ عدد التلاميذ المغاربة في هذه المدارس في السلك الثانوي 1560، و4600 في السلك الابتدائي سنة 1955، في حين لم تضم المدارس الثانوية المخصصة لأبناء المغاربة إلا 4233 بعد أن تحوَّلت المدارس الإسلامية لمدارس تلجُها الطبقة المتوسطة والفقيرة بعد هجرة أبناء الأعيان إلى المدارس الأوربية.
وقد عرَفت هذه الفترة تحولًا مهمًّا، وهو السماح بإنشاء المدارس الوطنية الخاصة، والتي كانت تُقدِّم محتوًى وطنيًّا يولِي القيم الإسلامية والوطنية والعربية أهميةً كبرى، وقد استقطبت جموعًا واسعة من أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة، وصارت هذه المدارس تتطور باستمرار وباطِّراد رغم التضييقات التي كانت تطول أطرها من معلمين ومديرين[24].
ولئن كانت فرنسا قد وجدَتْ في فترة الحماية نظامًا تعليميًّا تقليديًّا ضعيفًا، كان من الممكن أن يتطوَّر ويتقدم لو هيِّئت له الإمكانات والظروف المناسبة، فإنها غداةَ الاستقلال تركت نظامًا تربويًّا هزيلًا متهالكًا، ظلت الطبقيةُ سمتَه البارزة، وأصبح لدينا ثلاثة أنواع من التعليم:
1 – تعليم عمومي يلجه أبناء الطبقة الدنيا، ضعيف المحتوى والطرائق، يعاني مشاكل بِنْيَوية خطيرة، وظل رغم ضعفه متمسكًا بالطابع الفرنكوفوني.
2 – تعليم خاص كان من المفروض أن يكون نواةً لتعليم مغربي وطني مستقلٍّ، غير أنه سقط تحت الضغوط التِّجارية في محاولة مضاهاة التعليم الأوربي، فلم يحتَفِظ بطابعه الوطني المغربي، ولم يكتسب القيمة العلمية التي كان يرجوها، فظل مترنحًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، على أن الجرعة الفرنكوفونية كانت أشد تركيزًا في هذا التعليم من مثيله العام.
3 – تعليم أوربي حديث، تتوفر فيها الشروط البيداغوجية والديداكتيكية، لاكتساب القدرات المؤهلة لولوج المدارس العليا والجامعات العلمية المتخصصة، يلجه القلة الأوربيون وأبناء الأعيان والعِلية من القوم.
والغريب أن أقطاب الحركة الوطنية كانوا ممن تسابقوا ليستفيدَ أبناؤهم مِن هذا التعليم رغبةً في تأهيلهم لإتمام دراساتهم العليا، وبقيت هذه المدارس تابعةً لفرنسا حتى بعد الاستقلال، وكأنها مدارس فَرنسية في أرض المغرب لا تربطها صلة به، بل تخضع مباشرة للقنصليات والسفارات الأجنبية!
ومِن عجيب ما يُذكر أن فريق قناة “الجزيرة” كان يعدُّ برنامجًا حول الفرنكوفونية في المغرب، فلما أرادوا الدخول إلى إحدى مدارس البعثات، تعذَّر عليهم ذلك، وطلب منهم أخذ الإذن مباشرة من القنصلية الفَرنسية، وجدير بالذكر أن خريجي هذه المدارس شَغَلوا مناصب سياسية واقتصادية في البلاد بعد الاستقلال، وما زالت عملية التدوير الطبقي التعليمي قائمةً إلى يومنا هذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب ص: 18، دار النشر المغربية – الدار البيضاء.
[2] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، ص: 18.
[3] نفسه، ص: 21.
[4] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، ص: 20، 21.
[5] نفسه، ص: 22.
[6] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، ص: 10
[7] نفسه، ص: 11.
[8] نفسه، ص: 23.
[9] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، ص: 19.
[10] إدريس الجنادري، الفرنكوفونية أيديولوجية استعمارية بغطاء ثقافي ولُغوي.
[11] سلمان بونعمان، النهضة اللُّغوية ومخاطر سياسة التلهيج اللُّغوية، مركز نماء.
http://www.nama – center.com/ActivitieDatials.aspx?id=320
[12] سلمان بونعمان، النهضة اللُّغوية ومخاطر التلهيج.
[13] نقلًا عن محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، بتصرف يسير، ص: 46.
[14] أحمد الناصري، الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى، الجزء التاسع، ص 11: 3 – 114.
[15] أحمد السوالم، ومضات من تاريخ التعليم اليهودي بالمغرب، موقع: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.
[16] انظر: “أضواء على مشكل التعليم في المغرب”، ص: 41، 42.
[18] نفسه، ص: 25.
[19] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، ص: 25.
[20] محمد اليزيدي، النخبة المغربية والتعليم الأوربي زمن الحماية.
[21] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، ص: 31.
[22] المصدر نفسه، ص: 30، 31.
[23] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، ص: 32.
[24] بتصرف واختصار من كتاب “أضواء على مشكل التعليم في المغرب”.
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/social/0/112376/#ixzz7LXlLMqSC