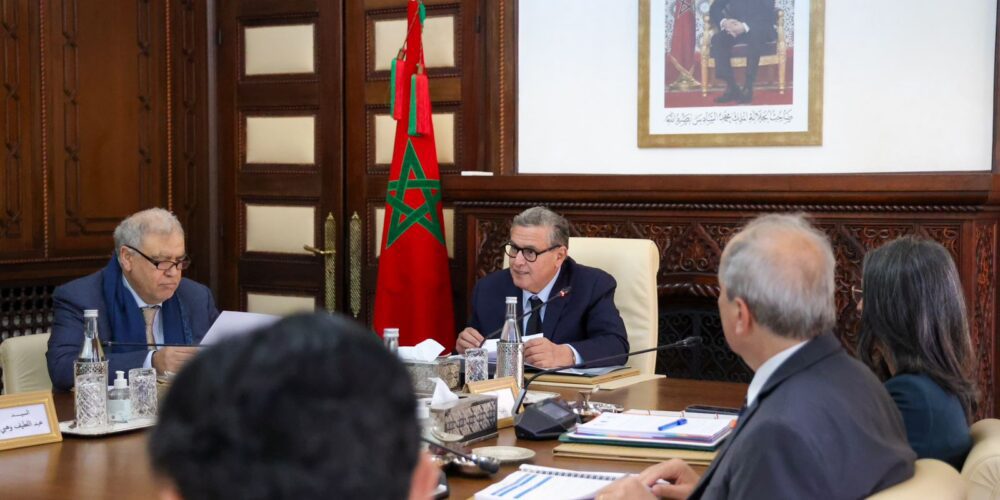“التنوير” على الطريقة الإمبريالية..

هوية بريس- محمد زاوي
عندما طرح إيمانويل كانط سؤاله الشهير: ما التنوير؟ كان يصدر آنذاك عن خلفية جدّ مركبة، محكومة في جوهرها السوسيو-سياسي بما لا يقل عن ثلاثة شروط تاريخية: شرط التأخر الألماني، شرط الثورة البورجوازية الفرنسية التي سبقت نظيرتها الألمانية، وشرط الثورة الصناعية في بريطانيا وما أفرزته من تقدم في المنطق التجريبي. وخلاصة؛ فقد كان كانط محكوما في سؤاله بتأخر ألماني، وليبرالية فرنسية، وتجريبية بريطانية. وإن الواقع المتأخر لألمانيا، أي ترددها الاجتماعي والسياسي بين زمنين قديم (إقطاعي) وحديث (بورجوازي)؛ إن هذا الواقع هو ما أنتج فكرة التناقض -كنواة للفكر الجدلي- عند كانط. فتوقف عندها كانط، واكتشف وحدتها وحقيقتها هيجل، وأكسبها مضمونا ماديا كارل ماركس (راجع دراستين لعبد السلام الموذن: “الوعي التاريخي القومي”/ “ثورة ماركس في نظرية المعرفة”). هذا مسار من التنوير، من ليبرالية ووضعانية وتجريبية إلى إرساء قواعد الفكر الجدلي، بشقيه المثالي والمادي.
والسؤال هو: ما حظنا اليوم من هذا الواقع؟ وما حظ دعاة “التنوير” عندنا منه؟ الجواب قد يكون صادما، لأن معظم “تنويريينا” اليوم هم خارج التاريخ العربي والإسلامي الحالي. يصارعون “كنيسة” غير موجودة، رونيه ديكارت نفسه لم يستطع مصارعتها، فاكتفى بتحييدها عن التطوير العلمي لقوى الإنتاج. يناقضون إقطاعا لم يتشكل في أي زمن، بما في ذلك فترات ما قبل تدخل الاستعمار. يبحثون عن تخليصٍ للإنسان من قيودٍ في الدين قد تكون متوهمة لديهم، كما قد تكون مطلوبة لإنجاز بعينه في التاريخ. يدعون إلى حرية ما بعد حداثية، نيوليبرالية لا تشبه الحريات البورجوازية الليبرالية الأولى. يفكرون في الأخلاق فلسفيا وكأننا نعيش محاطين بفلاسفة أثينا أو شعراء العباسيين، إذ لا أخلاق إلا أخلاق الفلسفة وحكمة الناظمين. يدعون إلى حرية المعتقد، وكأن معتقداتنا عبء علينا وما ينقصنا هو تعريضها ل”مباضع تجربة” كلود برنار. يدافعون عن مرأة عاملة يستغلها الرأسمال ويحولها إلى سلعة قابلة للتبادل التجاري، وينسون أخرى لظروفها من التفاوت الاجتماعي والمجالي.
هناك قناة داخلية لهذا النوع من “التنوير”، وهي إنتاج “فضاء عام” متوازن طرفاه متناقضان إيديولوجيا مع استحضار ما قد يتحقق من لقاء بينهما في الأهداف السياسية، أي تفكيك البنى الإيديولوجية الضرورية لاستمرارية الدولة ووحدتها وسيادتها. هذا التفكيك يقع تحت قناعين: “أصولي” و”حداثي”. فعندما يستهدف “الحداثي” المنطق التقليدي (الضروري) في أصوله، يكون “الأصولي” قد وجه سهام نقده لمؤسسات هذا المنطق ومذاهبه. لا ننفي مراجعات هنا وهناك، إلا أن المنطق العام للتناقض المذكور هكذا بدأ، وما زال مستمرا، لكن لا ندري بأية وتيرة. يتحقق التوازن في حدود معينة من التناقض بين “الحداثي” و”الأصولي”، وعندما تُتَجاوز هذا الحدود فإننا ننتقل من برنامج “التوازن” إلى برنامج “التفكيك”. هذه هي المعادلة المعقدة للانفتاح على كل من الشرق والغرب؛ فمن جهة هذا الانفتاح ضروري، ومن جهة أخرى يجب ضبط إيقاعه حسب المطلوب تاريخيا.
الحديث هنا عن “التنوير”؛ فأي تنويرٍ هو إلينا أقرب؟ التنوير تجليات لعل أبرزها:
-في الفكر والنظرية: وهنا يجب أن نتكلم بوضوح، لأن معظم نخبنا تبنت الحداثة كشعار لا كمنطق نظري. ولذلك فإن هذه النخب بقيت حبيسة مثالية الموجة الأولى للحداثة، حداثة روسو وفولتير ولوك وطوكفيل ومونتيسكيو. في حين أن منطق الحداثة عرف تقدما مع المدرسة الألمانية، مع كانط وهيجل وفيورباخ وماركس وفيبر، وصولا إلى مدرسة فرانكفورت. وهناك نخبة أخرى لم تفارق مناطقها الأرسطي في التفكير، وعلى درجة كبيرة من الانتقائية. أما النخب التي ارتبطت بالمنطق الجدلي، خاصة المادي منه متأثرة بالفكر الماركسي، فقد حنطته في قوالب وفشلت في تبيئته كما حصل في الصين مثلا. واليوم، ماذا نجني؟ حديث وكلام بغير نظرية، دعاة ثقافة بالجملة، “تنوير” خارج رهاننا في التاريخ.
-في المسألة الدينية: الموقف من المسألة الدينية يجب أن يتخذ بعدين؛ بعد وجودي (ديني)، وبعد تاريخي (إيديولوجي). السائد اليوم إما رفض تاريخي للدين، وإما تعلق لا تاريخي بالإيديولوجيا الدينية. والمطلوب هو: التعلق الوجداني بالدين، وإخضاع الإيديولوجيا الدينية للنقد التاريخي. عدم التمييز بين البعدين الوجودي والتاريخي في المسألة الدينية، يحرِم “دعاة التنوير” من الوجد العرفاني والنجاعة التاريخية في آن واحد. بميزان الفرد ربما يُعتبر الأمر مجرد تجربة، ولكنها مصائر دول وجتمعات تعيش وتستمر وتحافظ على سيارتها واستقلالها بالإيديولوجيات الدينية، بل بها تحمي الوجدان البشري. هل يعني هذا عدم إخضاع الدين كظاهرة للبحث الإنساني؟ هذا موضوع مختبر، والتاريخ وحده يحدد إلى أي حد يتصالح واقعنا السياسي والاجتماعي مع نتائج المختبرات، بما فيها تلك المختبرات التي تنزع إلى التأسيس الفلسفي للأخلاق بأفق فصلها عن مصدرها الديني.
-في الاقتصاد: وهنا يبتلع “التنويريون” ألسنتهم وكأن الاقتصاد لا يعنيهم، وكأنهم في خيفة من أمرهم، من أن تنكشف حقائق الماضي الحداثي والحاضر الما بعد حداثي. وكأن علاقة الإمبريالية الجديدة ب”التنوير الحداثوي” تأبى أن تنكشف عورتها اقتصاديا واجتماعيا. لا أحد من “التنويريين” يهتم اليوم بالإجابة على سؤال: في أي واقع من الاقتصاد نعيش؟ إلى أي حد تحررنا من قبضة الرأسمال الأجنبي؟ من يرعى ماليا الجمعيات والمراكز والمنظمات العوامية والما بعد حداثية؟ ولأي غرض؟ وكيف امتزج الاقتصاد والسياسة في منظومة واحدة تبتز الدول وتضغط عليها منذ سقوط جدار برلين وسيطرة “الأحادية القطبية”؟ منطق الحداثة منطق حسابي، نتج عنه إدخال الحسابات الدقيقة على الإدارة والجيش والاقتصاد، بل والموسيقى أيضا (راجع “مفهوم الدولة” لعبد الله العروي). وأولى أن ينطلق التحليل “التنويري” من منطلق اقتصادي يفرض جبريته النسبية على السياسة والثقافة؛ غير أن “التنويريين العرب” يفضلون وجهة أخرى، الحديث في كل شيء ما عدا الاقتصاد. هناك ثلاث إشكاليات اقتصادية لا يهتم بها “التنوير العربي” هي: كيف التحرر من الرأسمال الأجنبي؟ ما السبيل لتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني؟ وأيّ توزيع اجتماعي “عادل” يصلح لنا في هذين الشرطين؟ يغيب هذا عن تنويريينا فيهرعون إلى منافسة الفقهاء في الفتوى!
-في السياسة: الإيقاع فى العملية السياسية ليس إرادويا، الإيقاع موضوعي وتحكمه بنيات في المجتمع. صحيح أن البنى السياسة تعيد إنتاج الكثير من هذه البنى، إلا أنها لم تكن لتستطيع ذلك إلا من موقع تحتله في المجتمع، بما لهذا الموقع من تجليات اقتصادية وسياسية وثقافية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النضال الديمقراطي نفسه ليس محررا من قبضة المجتمع (علما أن المجتمع ليس منفصلا عن الدولة)، وليس إرادويا، وهو أقرب إلينا مما هو أقرب إلى النموذج الغربي. الانتقال إلى وضعية ديمقراطية تمثيلية خاضع في تاريخنا الخاص لتوازن تاريخي بين السلط، وهذا التوازن هو أساس توازنها في الدستور. قياس هذا التوازن إلى آخر غربي لا يجيب على سؤالنا الملح: كيف نحقق انتقالا ديمقراطيا متناسبا مع “زمننا السياسي” لا مع أي زمن آخر؟ الاختلاف حاليا في السقف: هل لنضالنا الديمقراطي من سقف؟ هل يصح التعجيل بمطلب الديمقراطية “الكاملة” في ظل استهداف أجنبي للتراب والاقتصاد والدين والنظام العام الخ؟ هناك من يسير بسرعة مفرطة، وهناك من يشتغل بمنطق الأولويات. ولما كان “التنوير العربي” منشغلا بالإيقاع الغربي، توهم تجاوز شرطه التاريخي، فضمّن برنامجه: دعوة سابقة لأوانها إلى ديمقراطية تمثيلية كاملة، وانفتاحا على ديمقراطيات جديدة ويعتبرها بديلة كالديمقراطية التشاركية. فلا نحن تجاوزنا شرط “التقليد السياسي”، ولا نحن تجاوزنا شرط “الديمقراطية التمثيلية”؛ فأين يعيش “التنوير العربي”؟!
-في مفهوم الحرية: هناك من يرفض القول بالضرورة، ويرى أن الحريات غير خاضعة لها، وأنها “مقدسة” وفوق الجميع. وهذا قول ما قبل هيجلي، هناك من يريد إعادة إنتاجه في زمن متقدم. هؤلاء الذين يرفضون الضرورة يعيشونها كما هي، أما رفضهم فذهني فقط. يقولون إنها لا تعني أي شيء، ولا ينتبهون أن الكلام الناقد لا ينقص منها شيئا، وربما تتعزز وتتأكد كلما ارتفعت وتيرة النقد. مطلب الحريات بلا حدود ليس منزلة سامية لصاحبه، لأنه قد يتحول إلى مجرد تعويض سيكولوجي في ضرورة تكاد تصبح جبرية. يشمل هذا النقاش طموحات سياسية وأخرى فردية، وهذه الأخيرة هي اليوم الأكثر رواجا وإغراء بمخاطبتها للغريزي في الإنسان ب”الجنس الغابوي” الذي لا يعرف حدودا طبيعية (الفطرة) أو نظامية (الزواج). والحقيقة أن النشاط الجنسي موضوع فردي، لكنه يدبَّر بشكل جماعي حتى يحافظ على طاقته الحيوية، وحتى تتحقق به مصالح المجتمع بدل أن تضيع برغبات الأفراد. وإن هذا التركيز “التنويري” على حقوق الشواذ جنسيا، وهذا الاهتمام بحرية الجسد وتصريف الغريزة بلا حدود، ليس بريئا ولا عفويا.. هناك صناعة للانحراف الجنسي هدفها “تقليل الأفواه الجائعة” والتحكم في ديموغرافية العمالة والعطالة، وعدد كبير من ‘التنويريين العرب” تنطلي عليه حيلة “الحريات الجنسية”! في نفس الإطار تُستهدَف الأسرة تحت قناع “تحرير المرأة”، فيتحول “التنوير” إلى أداة للهدم، للعودة إلى الوراء، إلى ما قبل الأسرة، أي ما قبل الدولة. قد يحتج “التنوير العربي” بدعوة مثالية إلى “المساواة” الزوجية في بيت الأسرة؛ وهذه فضلا عن أنها دعوة مثالية لا تراعي خصوصية المجتمع العربي، فإنها تعيق هذا المجتمع تاريخيا وتعرقل إمكانات الإنتاج التقليدي التي يفرزها.
“التنوير” ثورة في العقل لا في اللسان، وإن ثورة في العقل خير من ألف ثورة في اللسان.. وكم من “تنوير” خطابي، إيديولوجي، ترعاه الإمبريالية الجديدة.. فعندما يصرخ داعية التنوير في وجه التقليد، ربما تكون هذه الإمبريالية قد أنجزت أولى مهامها في الاختراق!