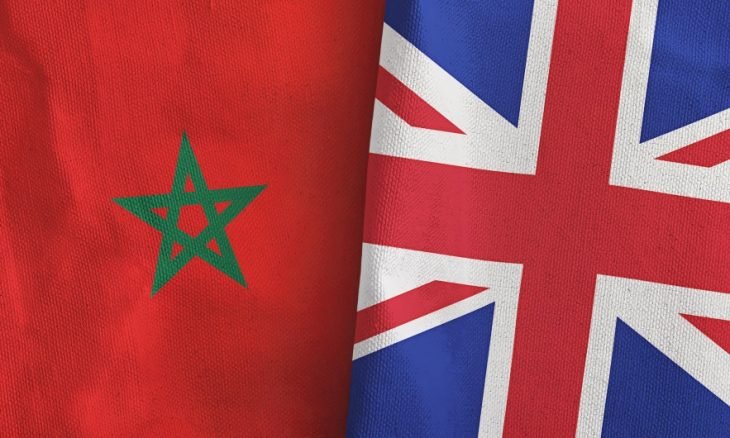التّعريف بأدب التّأليف

هوية بريس – ربيع السملالي
كثُر المُؤلّفونَ في زماننا…
وتكاثرتِ المَطبعاتُ التّجارية التي لا تردّ كاتبًا يَحملُ في يده اليمنى كتابَه المخطوط بمداد التّكنولوجيا المُتوحشة، وفي اليد اليُسرى مالا وهاتفًا ذكّيا فيه صفحته (الفيسبوكية) التي تعجّ بالإعجابات والتّعليقات والمشاركات، لأنّ ذلك صارَ دليلا على الإبداع والنّجاح في زمان (سوشيال ميديا)، ومن شروط بعض دور النّشر التّجارية أن تكون منشوراتك تتجاوز المائة إعجاب على أقلّ تقدير، وإلا فلن تستطيع المغامرة معك إلا إذا نَقَدْتَها ثمنَ الطّبع لتكون الخسارة مناصفةً إذا باء مشروع هذا الكتاب بالفشل.. ومن غريب ما حدّثني به ناشر مبتدئ أنّه فكّر قبل خوض غِمار تجربة الطّبع والنّشر في فتح محلّ للمأكولات الخفيفة والثّقيلة، لكنّه تراجعَ بعدما استخار واستشار وعلم علم يقين أنّ الطّباعة في زمن الغثاء (الفيسبوكي) سيكون لها ربح، وستقام لها أسواق ومعارض لا ينبغي تجاوزها بغير اهتمام.
وقد فصّلت القولَ في هذا الموضوع في مقالتي السّاخرة (خفافيشُ الأدب وصيادو النّعام)، وفي هذه المقالة يروقُني أن أذكر شروط التأليف المبثوثة في كتب أهل العلم والفضل، لعلّها تكون سببًا في هداية أصحاب هذه الفوضى باسم إشاعة العلم والثّقافة والأدب والفكر.. فأقول:
إنّ الكاتب الذي يحترِمُ ذاته ويعي رسالته ومهامه مَعنيٌّ بتقديم معلومة جديدة للقارئ، تزيد ثقافته وتُوسّع مداركه المعرفية. ويتطلّبُ ذلك البحث والتّنقيب في بطون الكتب والتّقصي عن أبعاد الفكرة ومن ثمّ إخضاعها للتّحليل لصياغة الرّأي الجديد الذي يبني الكاتبُ استنتاجه عليه في تصنيفه.. هذا الكتاب الذي يصيبه التّشطيبُ والتّهذيبُ والتّدقيق عشرات المرّات قبل خروجه من بين يديه.
لذلك يقول بورخيس: (لو لم نطبع كُتُبنا لبقينا نصحّحها إلى أن نموت).
والتأليف على سبعة أقسامٍ لا يؤلّفُ عالِم أو أديبٌ عاقل إلاّ فيها، وهي إمّا شيء لم يُسبَقْ إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يُتممه، أو شيء مغلَق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشيء من معانيه، أو شيء متفرّق يجمعه، أو شيء مختلط يُرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنّفه فيصلحه.
وينبغي لكلّ مؤلّف كتاب في فنّ قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس فوائد، استنباط شيء كان مُعضلا، أو جمعه إن كان متفرّقًا، أو شرحه إن كان غامضًا، أو حسن نظم وتأليف، وإسقاط حشو وتطويل.
وشرط في التأليف إتمام الغرض الذي وُضع الكتاب لأجله من غير زيادة ولا نقص وهجر اللّفظ الغريب وأنواع المجاز اللهمّ إلاّ في الرّمز، والاحتراز عن إدخال علم في آخر وعن الاحتجاج بما يتوقّف بيانُه على المحتجّ به عليه لئلا يلزم الدّور.
وزادَ المتأخّرون كما يقول حاجي خليفة في (كشف الظّنون): اشتراط حسن التّرتيب ووجازة اللّفظ ووضوح الدّلالة وينبغي أن يكون مسوقًا على حسب إدراك أهل الزمان وبمقتضى ما تدعوهم إليه الحاجة، فمتى كانت الخواطرُ ثاقبة والإفهام للمراد من الكتب متناولة قام الاختصار لها مقامَ الإكثار وأغنتْ بالتّلويح عن التّصريح، وإلاّ فلابدّ من كشفِ وبيان وإيضاح وبرهان ينبّه الذّاهلَ ويوقظ الغافل.
وفي أزهار الرّياض للمَقَرّي: ورأيتُ بخطّ بعض الأكابر ما نصّه: المقصودُ بالتأليف سبعة: شيء لم يُبق إليه فيؤلّف، أو شيء ألّف ناقصًا فيُكمل، أو خطأ فيُصحّح، أو مشكل فيُشرح، أو مُطوّل فيُختصر، أو مفترق فيُجمع، أو منثور فيرتّب.
وقد نظمها بعضُهم فقال:
ألا فاعـلمنّ أنّ التّـآلـيفَ سـبعـةٌ…لكلّ لبيبٍ في النّصيحة خالصِ
فشرحٌ لإغلاق وتصحيح مُخطئ…وإبداعُ حِبر مُقدم غير ناكص
وترتيبُ منثورٍ وجمع مُفــــــــرَّق…وتقصير تطويل وتتميم ناقص
فالتأليف المعني هنا هو: ما انطوى على عمل إبداعي ولو قلّت نسبة الإبداع والابتكار فيه. أمّا النّقلُ المُجرّدُ، أو التّجميع العشوائي، أو التَّكْرار، أو المحاكاة، أو الانتحال لصور أخرى سابقة فلا يُعدّ ذلك كلّه إبداعًا ولا ابتكارًا.
وفي ذلك يقول ابنُ خلدون في (المقدّمة؛ ص:457): فهذه جِماعُ المقاصد التي ينبغي اعتمادُها بالتأليف ومراعاتها، وما سوى ذلك ففعل غير مُحتاج إليه، وخطأ عن الجادة التي يتعيّنُ سلوكُها في نظر العُقلاء، مثل انتحال ما تقدّم لغيره من التأليف أن ينسبه لنفسه ببعض تلبيس، من تبديل الألفاظ، وتقديم المتأخر وعكسه، أو يحذف ما يحتاج إليه الفنّ، أو يأتي بما لا يحتاج إليه، أو يبدّل الصّواب بالخطأ، أو يأتي بما لا فائدة فيه، فهذا شأن الجهل والقِحَّة. اهـ
ثمّ لا ينبغي أن يُخرجَ ما صنّفه إلى النّاس ولا يدعه عن يده إلاّ بعد تهذيب وتنقيحه وتحريره وإعادة مطالعته ، فإنّه قد قيلَ: الإنسان في فُسحة من عقله وفي سلامة من أفواه جنسه ما لم يضع كتابًا أو لم يقل شعرًا.
وقيل: من صنّفَ كتابًا فقد استشرف للمدح والذّم فإن أحسنَ فقد استُهدِفَ من الحسد والغيبة وإن أساء فقد تعرّض للشتم والقذف.
وقيلَ كما في (محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني): عرْضُ بناتِ الصُّلب على الخُطّابِ أسهلُ من عَرْضِ بنات الصّدر على ذوي الألباب.
وقال القاضي الفاضلُ أبو عليّ عبد الرّحيم بن الحسن اللّخمي ، في رسالة له بعثَ بها إلى العِماد الأصفهاني يعتذرُ إليه من كلام استدركه عليه: إنّي رأيتُ أنّه لا يكتبُ إنسان كتابًا في يومه، إلاّ قال في غَدِه: لو غُيّرَ هذا لكانَ أحسنَ، ولو زيدَ كذا لكان يُستحسنُ، ولو قُدّمَ هذا لكان أفضلَ، ولو تركَ هذا لكان اجملَ، هذا من أعظم العِبر، وهو دليل على استيلاء النّقص على جُملة البشر. [مقدمة شرح الإحياء للزَّبيدي].
يقول كيليطو في كتابه (الأدب والارتياب ص:10):
…ولهذا قيل: لا يزالُ المرء في فسحة من أمره ما لم يقل شعرًا أو يؤلّف كتابًا. ذلك أنّ الخطرَ ماثل والعدو بالمرصاد. أي عدو؟ يصفُ الجاحظُ في البيان أساسا الحرب المفتوحة بين الخُطباء، وفي كتاب فصل ما بين العداوة والحسد يتحدّث عن الصّراع الذي يفرّقُ أصحاب القلم. لكن الأهمّ من هذا ملاحظة مفاجئة نجدها في كتاب الحيوان، مفادها أنّ القارئ عدو الكاتب. قد لا يكون القارئ عدوًا صريحًا، إلاّ أنّه في الخفاء يبحث عن الثّغرات وعن نقط الضّعف بهدف التّهجم على الكتاب والنّيل من مؤلّفه. ليست الصداقة أساس العلاقة بين القارئ والكاتب، وإنّما على العكس، الضّغينة والكراهية والحرب. ومن ثمّ لابدّ للكاتب أن يتذكّر على الدّوام أنّه يخاطبُ متلقيًا بالضّرورة مُعارضًا ومعاديًا: (وينبغي لمن كتب كتابًا أن لا يكتبه إلا على أنّ النّاس كلّهم له أعداء). وويل لمن ينسى هذه القاعدة ولا يكون دومًا في حالة استنفار قصوى.
إذا كان النّاس كلّهم أعداء الكاتب، فهل الكاتبُ من جهته عدو النّاس كافّة؟ على الأقل يعرف أنّه محلّ ريبة لمجرّد أنّه يكتبُ، فكأنّه مُقترف لذنب يجب التّكفير عنه، ولذلك تراه يتودّد إلى القُرّاء ويُفوضهم سعيا منه إلى استمالتهم وإضعاف شوكتهم وإبطال كراهيتهم. ولا أعرفُ مؤلّفًا اهتمّ بالقارئ العدو كما فعل الجاحظ، فهو يشركه في مشاريعه ويدعو له (حفظك الله).. (أكرمك الله ) وفي كل لحظة يلتفت إليه ليتأكد من انتباهه ويُذكي اهتمامه. إذا سلّمنا بانّ القارئ عدو، فالنّتيجة الحتمية أنّ كلّ كاتب في وضعية شهرزاد، وكلّ قارئ في وضعية شهريار. اهـ
لذلك يُستشفُّ من افتتاحية كثير من مُصنّفاتِ الأوائل قلقٌ كبير من الإقدام على الكتابة، لكونها مليئة بالمخاطر، ومن يركبها فقد ركبَ الصّعب، فلابدّ أن يلتزمَ الحيطة، لكي يفوز بالسّلامة، ولا سلام في الكلمات، لأنّ السلامة في الصمت..
يقول صاحب الربيعي في كتابه (تقنياتُ وآليات الإبداع الأدبي): والكتابة رسالة إنسانية ومسؤولية تضعُ الكاتبَ وجهًا لوجه مع ضميره أولا ومن ثمّ مع المجتمع المتلقي لأفكاره وآرائه فإن كانت أفكارًا إنسانية ساهمت في رفع مستوى الوعي الاجتماعي، وإن كانت أفكارًا شريرة عمدت إلى نخر منظومة الوعي الاجتماعي.
وعن تأليف الكتب ومزاياها يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه النّافع (صيد الخاطر ص:316): رأيتُ من الرّأي القويم أنّ نفعَ التّصانيف أكثرُ من نفع التّعليم بالمُشافهة، لأنّي أشافهُ في عمري عددًا من المُتعلّمين، وأشافه بتصنيفي خلْقًا لا تُحصى ما خُلِقوا بعد، ودليل هذا أنّ انتفاع النّاس بتصانيف المتقدّمين أكثرَ من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم.
فينبغي للعالم أن يتوفّر على التّصانيف إن وُفّق للتّصنيف المفيد، فإنّه ليس كلّ من صَنَّفَ صنفَ، وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنّما هي أسرار يُطلع الله عزّ وجلّ عليها من شاء من عباده، ويُوفّقه لكشفها: فيجمع ما فُرِّقَ، أو يُرتِّبُ ما شُتِّتَ، أو يشرح ما أهمِل، هذا هو التّصنيف المفيد.
وينبغي اغتنامُ التّصنيف في وسط العمر، لأنّ أوائل العمر زمنُ الطّلب، وآخره كِلاَل الحواس.
قلتُ: من أغرب ما قرأت عن التّصنيف ما لدى الأخباريين أنّ ابن سينا قال: إنّه كلّما كنت أتحيّرُ في مسألة لم أظفر بالحدّ الأوسط في القياس، ذهبتُ إلى الجامع وصلّيتُ وابتهلتُ إلى مبدِع الكُلّ حتى يفتح لي المُنْغَلِق، ويتيسّر المتعسّر، ونتُ أرجع في اللّيل إلى داري وأضع السّراج بين يدي وأشتغلُ بالقراءة والكتابة. ويحين يغلبني النّومُ أو أشعرُ بالضّعف عدلت لشرب قِدح من الشّراب لأستعيد قوّتي ثمّ أرجعُ إلى القراءة وحالما يأخذني النّوم أحلم بتلك المسألة بأعيانها وتتضح لي وجوهها، فجميع العلوم التي وقفتُ عليها وتعلّمتها كانت في منامي.
ودامت لكم المسرّات.