“الديمقراطية” الحليف المخلص للديكتاتورية

هوية بريس – إبراهيم الطالب
ما جرى في تونس من انقلاب ناعم لحد الساعة طبيعي جدا، فهو فقط من أواخر فصول الحلف المقدس بين الديمقراطية والديكتاتورية.
نعم حلف مقدس، ولا تناقض من حيث الواقع بين الديكتاتورية والديمقراطية.
فالديكتاتورية في بلداننا يجوز أن تكون ديمقراطية، بل قد تكون حداثية، ويفرح بها “الديمقراطيون” في بلاد العربان جميعا، فأزيد من 40 سنة وتونس يروج لها أنها المثال في الحداثة والتنوير، رغم دكتاتورية بورقيبة وخلفه بنعلي، وذلك فقط لأنها كانت ضد الله وضد الإسلاميين.
الديمقراطية منذ وجدت وهي تحترم الديكتاتورية، ولا ترى غضاضة في دعمها ما دامت تخدم مصالح النظم “الديمقراطية” التي لا تعترف سوى بالقوة والاستغلال.
فرنسا بمجرد ما انتهت من ثورتها ضد الظلم والإقطاع وانتصرت للحقوق المدنية وقيم الديمقراطية، واتخذت لها شعار “الحرية والمساواة والإخاء”، وكتبته على لباس حرسها الوطني، سارعت بإرسال جيوشها إلى الإسكندرية بقيادة نابوليون بونابرات سنة 1798، ثم انطلقت جيوش بلاد التنوير إلى الجزائر 1830 وتونس 1881.
أما في المغرب فبعد أن اكتمل التنوير في فرنسا ونضجت فلسفات الأنوار وتغير الشعب الفرنسي فصار ديمقراطيا حداثيا عقلانيا، أصدرت الحكومة الفرنسية الإعلان العلماني وتم ترسيمه سنة 1905، بعدها بسنتين كانت جيوشها تحتل وجدة وتقنبل الدار البيضاء وتقتل الآلاف من المدنيين وتحتل الشاوية تبقر بطون الحوامل وتشعل النار في فروات رؤوس العجائز والصبيان.
قال أحد مثقفي الغرب -لا أتذكر اسمه-:
“الديمقراطية عندما تخرج من الغرب يصبح لها معنى آخر”.
وهذا صحيح جدا فالدول الغربية عندما تخرج من بلدانها تلغي صلتها بالديمقراطية ولا تستخدمها إلا من أجل حرب الإسلام والضعفاء، وتصفية الخصوم الحضاريين.
فالديمقراطية التي تريدنا الدول الغربية أن نعيشها هي الديمقراطية التي تجعل المسجد والحانة على قدم المساواة، أن يختفي معنى الطهر، أن يغيب معنى الإيمان ويتساوى مع الكفر.
الديمقراطية التي اراد لنا ليست أن تحتكم إلى الشعب، وليست هي آلية الانتخاب للتداول على السلطة، فالديمقراطية في فلسطين أفرزت فوز حماس، فتم الانقلاب عليها بإيعاز من الغرب والكيان الصهيوني الذي يعتبره الغرب الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وبلاد المسلمين، رغم أن الديمقراطية الصهيونية وسعت لها الأحزاب الدينية اليهودية بلحاهم الطويلة وضفائرهم المسدلة، وعقائدهم التلمودية التي تستبيح القتل في أمم العالم لتحيا إسرائيل.
الديمقراطية مرفوضة عندما أفرزت فوز مرسي والإخوان في مصر، لذا تم الانقلاب عليها وسجن مرسي وقتل في سجنه، واستقبل السيسي في عواصم العالم رويدا رويدا، حتى تمت شرعنة الانقلاب في الغرب وأمريكا.
الديمقراطية قبل ذلك بعشرين سنة أفرزت فوز جبهة الإنقاذ في الجزائر فتم الانقلاب عليها من طرف الاستخبارات الفرنسية، فكانت العشرية الحمراء، مات عباس مدني وأصبح علي بلحاج سجين المرض يتنقل من قسم إلى قسم بين مصالح الشرطة، وبقي العسكر يحكم رغم المسيرات تلو المسيرات في بلاد المليون شهيد.
فالديمقراطية لدينا مستوردة من الغرب، يقيم محرابها حداثيون مدعومون من منظمات دولية لا يتجاوز تفكيرهم ما بين سرة المرأة وركبتها، هم دوما مع الحرية الجنسية وضد الحرية السياسية والفكرية والعقدية.
الديمقراطية هي المطلب الأسمى في كل المناسبات، وهي الشرط الغربي الذي يفرض في كل المحافل الدولية علينا، لكن هذه الديمقراطية لا ينبغي أن تتجاوز القدر الذي يهدد مصالح الغرب في بلداننا.
هذه هي الحقيقة، لمن أراد أن يراها.
لذا يضطر الغرب في كل مرة تفرز الديمقراطية فوز الإسلاميين، إلى التعاون مع الدكتاتورية، لأنها الحل الوحيد لقمع الإسلام والمسلمين ومن الانطلاق والإقلاع على أسس الهوية والتاريخ المجيد.
فسواء لديهم كنت ديمقراطيا حتى النخاع، وتحاكمت في الصراع السياسي إلى الشعب، فإنك لا بد أن تسقط وتسجن، لأنك لم تستوعب درس التاريخ: تاريخ الاحتلال.
وحتى لو صبرت ونفيت وسجنت حتى تهذبت أخلاقك، وبدلت وغيرت فصرت عقلانيا ديمقراطيا، ثم بعد عقود مديدة جلست على كرسي الحكم بقرار صادر عن الصناديق، فإنهم لن يرضوا عنك لأنك إسلامي، وسيحاكمونك لأنك لم تفهم الدرس مرةً أخرى، وسترمى في السجن، فإما الموت أو الخلود في زنازين المعتقلات.
الأمر نفسه إن كنت جهاديا ترى في الجهاد وسيلة لإسقاط الاستكبار العالمي، وهاجرت وصعدت جبال طورابورا حالما بعدل الإسلام، وبإرجاع الخلافة الإسلامية التي أسقطتها بريطانيا وفرنسا وروسيا وكل الأمم المتحدة على المسلمين في بداية القرن العشرين، فلن يتركوك بل سيبيدونك بالتفجير والتدمير ولو دخلت الجبال لأنك تريد أن يرجع الإسلام وتحكم بشريعته. ولأنك لم تفهم أنهم أمم متحدة ضد المسلمين، فهي متحدة رغم معاركها وقتالها الضاري بينها، فلن يتركوك ولو كنت في أفغانستان/طالبان ومعك الشعب كله، واعترفت بك خمس دول وصار لك ناطق رسمي في منظمتهم التي تحكم العالم.
وحتى لو تغيرتَ وقرأتَ دينك قراءة أكثر انفتاحا كما يريدون، فصرت حداثيا، عقلانيا تكفر ببعض الغيب وتؤمن ببعض، واستصنمت قيم التعايش مع اليهود والنصارى في كل محفل، وشطبت عقيدة الولاء والبراء من إيمانك وتبنيت قيم المواطنة، وطبلت للنساء وآمنت بالمساواة في كل شيء بين الجنسين، فكن مرتاحا لن تحكم لأن خلفيتك الإسلامية الباهتة تمنعك رضاهم.
وحتى لو آمنت بالسلام وانتهجت الحوار كوسيلة وحيدة وفريدة لفض النزاعات، ولعنت المجاهدين في الشيشان والصومال وأفغانستان، وانتقدت تراثك، وتبرأت من السلفية ومن طالبان ومن كل ذي لحية، وكنت شديد الحذر ممن تتفق معهم في غالبية أفكارك، وخشيت أن تنسب إلى الغلو والتطرف، وحلقت لحيتك حتى تبدو مثلهم، فلن تحكم يوما ما دمت مصنفا عندهم مسلما، هذه هي النتيجة مهما اجتهدت أن تكون كما شاؤوا وأرادوا، فأنت عندهم ستبقى مسلما مهما فعلت.
دعونا نقف مع هذه الـ”هُم” في عندهم، ماذا تعني؟؟
تعني ضميرا متصلا مضافا إليه، أما “عند” التي تستضيفها فهي ظرف زمان الحضور ومكانه.
“هم” تعني من ينظر إليك مهما كنت ومهما غيرت وبدلت من تاريخك وهويتك ودينك أنك تحمل في “جيناتك” عقيدة إسلام الصحابة الذين أسقطوا قيصر وكسرى، وتحتفظ في خريطتك الوراثية بطموحات غزو التابعين الذين بنوا حضارة الأندلس ووصلوا إلى مشارف باريس، ينظرون إليك أنك سليل الغافقي وترنو نفسك دوما إلى أن تحكم بلادهم كما حكم آل عثمان ثلثي العالم وأسقطوا مدينة البيزنطيين القسطنطينية مدينة آية صوفيا، التي انتفضت باريس وواشنطن لما أرجعها أردوغان إلى طبيعتها التي اكتسبتها منذ محمد الفاتح، ورفع فيها الآذان وأقام فيها الصلاة.
“هُمْ” تعني الشركات المتعددة الجنسية التي يمتلك اليهود الصهاينة في العالم أغلب رؤوس أموالها، تلك الشركات التي تحتاجها شعوبك لتستورد منهم أيضا دوائها وسلاحها وقوتها، وتحتاجها دولك حتى تسكن من روع شعوبها فلا تنتفض ضد الفساد.
“هُمْ” تعني المؤسسات المالية والنقدية التي تتدخل في تعليم بنيك وأفراد أمتك، وتحدد لك نوع الأسرة التي يجب أن تحيا فيها، يحددون نسلك، ويحددون كيف تعيش، وبما ينبغي أن تعتقد، كل ذلك مقابل تمويلات هي في الأصل ديون بنسب ربوية تستغرق عقودا من ثروة بلادك، وإن كانت هي أيضا نتيجة نهب ثرواتك من زمن الاحتلال إلى اليوم، لكن بدون تلك القروض لن تستطيع إصلاح تعليمك المفلس، ولن تشتري الأدوية لمرضاك ولن تلقحهم ضد كورونا ولا بوحمرون، وفي نفس الوقت لن تنجح مشاريعك كلها لأنك لا تدري أن الذي يعطيك الدواء هو من يزرع فيك المرض، لأنك ارتضيته الخصم والحكم، الصديق والعدو، هو أصل ظلمك وتلتمس أن يمكنك من العدل والإنصاف.
وعندما تضاف “هُمْ” إلى “عِنْدَ”، هنا يختلط الزمان والمكان، حيث “عِنْد” لا تعني عندهم في بيوتهم أو داخل حدود بلدانهم، فالعالم بعد ثوراتهم على الكنيسة والدين، صار كله “عندهم” و”لهم” واللام هنا للملك، قسموه بينهم، بعد أن تقاتلوا، في حروب تجاوزت معاركها العد والحصر، ثم أنشأوا عصبة الأمم لتنظيم حملات استعمار الدول، ثم اختلفوا فقامت حرب أخرى بينهم، سموها كونية لأن القتلى كانوا من كل دول العالم وأغلبهم من المستعمرات التي كانت تحتلها دولهم، لكن بعدها أنشأوا لهم منظمة سموها “الأمم المتحدة”، يحسب المساكين منّا أن لفظ “الأمم المتحدة” يشمل المغرب والجزائر وليبيا والصومال ودجيبوتي، أبدًا “الأمم المتحدة” تعني الأمم التي اختارت ألا تتقاتل مرة أخرى بينها، فسمت نفسها الأمم المتحدة، فهي أمم متحدة علينا نحن الضعاف سواء كنا مسلمين في أفغانستان أم بشرا ممن خلق الله في نيكاراغو أو گواتيمالا، المهم أن لا يقتتلوا بينهم في بلدانهم.
ولما كان لابد من القتال لتستمر شركاتهم الكبرى في صناعة الأسلحة والذخيرة، فقد اتفقوا أن تكون ساحات القتال بينهم في بلدان الضعفاء وأن يتقاتل هؤلاء الضعفاء بالنيابة عن جيوشهم.
لهذا خلال 45 سنة من الحرب الباردة التي كان العالم خلالها تحت تهديد دائم بحرب نووية بين أمريكا والاتحاد السوفييتي، كانت تلك الحرب الباردة، باردة في واشنطن وموسكو لكنها ساخنة مشتعلة في أفغانستان والعراق وبين المغرب والجزائر وفي آسيا وأمريكا الجنوبية.
لقد أصبحوا أكثر نضجا في القتل، فصاروا لا يقتلون إلا من أجل السلام، فغزو أفغانستان كان من أجل السلام العالمي، وكذلك غزو العراق كان من أجل انتزاع أسلحة الدمار الشامل الصدامية التي لم يعثر عليها لحد الساعة، والتي كانت ولا تزال مكدسة في الكيان الصهيوني على بعد مراحل قليلة من بغداد في مفاعل ديمونة ومخابئ الأسلحة.
لكن الديمقراطية تحرم أن يمتلك المسلم السلاح النووي وتبيعه لليهودي والنصراني، وإذا ما امتلكه كما في باكستان فسيقيمون له من يهدده بنفس السلاح كما في الهند.
لقد أصبحت الأمم المتحدة علينا واقية رقيا إنساني كبيرا، فهم لا ينهبون إلا من أجل التوزيع العادل للثروات، فمثلا دخلوا العراق لإسقاط الاستبداد من أجل العيش الكريم، لكن ليس للعراقيين بل لأبنائهم، فما حدث هو التفقير الشامل للعراقيين والنهب الكامل للثروات العراقية، في حين كان العراقي العادي زمن صداما مضرب المثل في الغنى والثروة.
وطبيعي أن يفتقر العراقي فنفط العراق يسيل بانسياب كامل في مصانع أمريكا الديمقراطية بلاد الحرية والعلمانية والحداثة.
إننا بكل وضوح ويقين نعيش مرحلة يراد للأمة أن تتخلى عن فكرة إرجاع الحكم بالشريعة والتحاكم إلى أحكام الدين، والقطيعة مع القرآن.
لقد تطور الأمر ولم يعد قاصرا على طرد الإسلاميين من الحكم أو حل تنظيماتهم أو مؤسساتهم، الهدف الآن هو تجفيف كل مصادر الخطاب الإسلامي الذي يحمل فكرة أن الإسلام كان ويمكن أن يكون دينا ودولة.
إننا نعيش زمن محاربة الإسلام في نفوس الأفراد لا التنظيمات، لهذا يتم تجفيف منابع خدمة الإسلام، وهدم منابر الخطاب الإسلامي، وما دام هذا هو الحال في بلاد المسلمين، فلا إشكال أن تسن فرنسا قانون تعزيز القيم العلمانية، وتقيم محاكم التفتيش للخطباء والأئمة، وتمنعهم حتى من قراءة آيات تخالف عقيدة الجمهورية العلمانية، في حين لا تجرؤ على فعل الأمر نفسه في البِيع والكنائس، وبهذا نعلم أن المستهدف اليوم هو الإسلام سواء في بلاد الديمقراطية أو بلاد الديكتاتورية والحلف المقدس بينهما هو ألا يعود الإسلام ولا يسود.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.













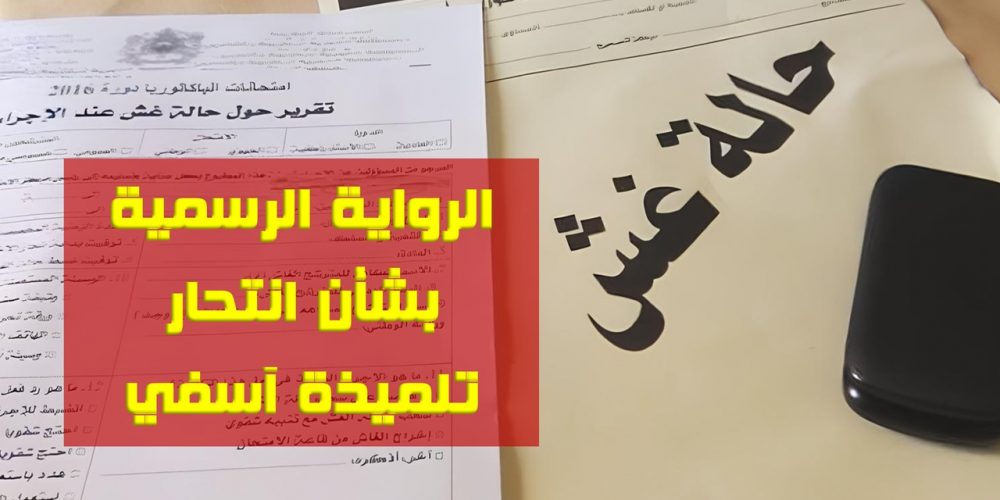



























حياك الله أخي إبراهيم على هذا المقال الماتع الذي وددت أن لو استرسلت فيه أكثر لكني أعلم أنك تعلم أن القارئ اليوم ما عاد يطيق أكثر من هذه السطور وهذا فصل آخر من فصول الديمقراطية في تسطيح المعرفة وقصرها في فيديوهات قصيرة على طريقة السندويتشات السريعة التحضير ناهيك عن محتواها المليئ بالجذور الحرة التي تسرطن الجسم والفكر على حد سواء فإلى الله المشتكى ولاحول ولا قوة إلا بالله