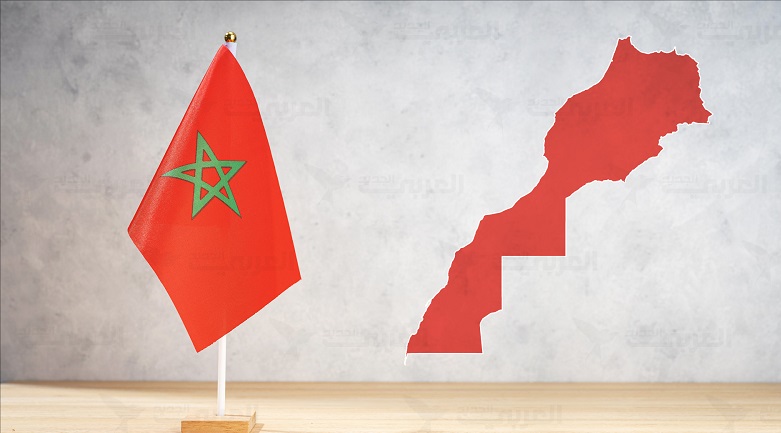الشيخ إبراهيم بقلال يكتب: تقعَّرُوا قليلا…

هوية بريس – إبراهيم بقلال
قرأت في مدة وجيزة أكثر من أكتوبة يدعو أصحابها إلى تسهيل لغة الخطاب إلقاء وإنشاء وتركِ التكلُّف فيها ومراعاة أحوال المخاطَبين والقراء، لكن بدا لي أن هؤلاء النَّقَدة المستدركين يطلقون ويُعمِّمون ولا يَحْترِزون في قصدهم، حتى إنه لَيُفْهَمُ من بعضهم أن كل جمال في الكتابة وحِرْص على النّقاء في الإلقاء هو تَصنُّع مذموم وتكلف وتقعُّر منبوذ، فأقول معقبا: لقد كان الناس يكتبون للخاصة و ينبذون نتائج أفكارهم عند أهلها ومن هم أحقّ بها. والآن صارت وسائل التواصل جريدة مبذولة لكل أحد، يطّلع على ما يعنيه وما لا يعنيه، وعلى ما يفهم وما لا يفهم، فكان لِزاما أن يعلم الناقد أن الغرابة والخفاء أمر نسبي، فمن تطلَّع لما ليس مقصودا به فكل شيء بالنسبة له خفاء وتكلف وإن كان عند المخاطَبين به من أوضح الواضحات و أنصع الناصعات. فلازِمٌ لمن لا يفهم الشيء أن يفهم أنه غير مقصود به، ولازم أيضا لمن كتب أن يُنَبِّهَ من لا يفهم كلامه أنه ليس إليه فلْيَسْتَرِح ولْيَدَّخِرْ طاقته فيما يعنيه، ولهذا يُرْوى أن أبا تمام قيل له على سبيل الإحراج:”لم تقول ما لا يُفْهَم؟” فأجاب:”وأنت لم لا تفهم ما يقال.”. نعم، إن التقعر عند الأدباء مذموم منذ قرون والتكلُّف الغالي يعود على الكتابة بالتقبيح لا التحسين لأن ما ثَقُلَ على الكاتب و المتكلم ثَقُلَ أيضا على السامع والمتعلم، وفيه يقول أبو الفتح البستي:
ولا تُكْرِه بيانَك إن تأبّى فلا إكراه في دين البيان
لكنهم لا يقصدون أبدا بنَبْذ التقعُّر والتكلف كل تحسين و تجميل، قال الغزالي في الإحياء بعد ما أنكر ما ينكره الأدباء: (ولا يدخل في هذا تحسين كلام الخطابة و التذكير من غير إفراط ولا إغراب..).
وهذا الجاحظ يُنكِرُ على من يُغرِبون في كلامهم من الأدباء و يأتون -كما قال – بما لَوْ خوطب به الأصمعي لجهل بعضَه يقول في البيان والتبيين: ( وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولا من آدابهم )، لكن انظر إلى رسائل الجاحظ و إلى كتابه هذا الذي ينكر فيه الإغراب و التقعر أليس من أجمل الأدب وأروعه وأعذبه و أحكمه؟! وهل يجيء مثله دون انتقاء أو يجيء خاليا من الصنعة والتعمُّل؟! ولم سمى العسكري كتابه بكتاب الصناعتين إذا لم يكن الأدب تصنعا ومحاولة؟! وهو نفسه ينكر التقعر والإغراب في نفس الكتاب و يحض ثَمّ على تخيُّر اللفظ الجميل لكن دون تغليب على المعنى لتكون الألفاظ توابع والمعاني متبوعة فيقول :(الكلام أيدك الله يحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وتخيُّر لفظه وإصابة معناه وجودة مطالعه).
لعل بعض النَّقَدة يرَوْن غيرهم في مرآة أنفسهم، فإذا كان الواحد منهم يتعب عند كل أكتوبة أراد تَحْلِيتَها أو يخرج عن جمال الأدب وخفته وحسنه بشدة تكلفه وثخانة طبعه، فيظُنُّ أنّ كلَّ الناس يتكلفون. وإنما يتعب المقتدرون من المُنْشئين مرة لا في كل مرة، وذلك حين التحمُّل والتأصيل لا حين الأداء والتبليغ، إذن لضاع منهم وقت طويل عند كل إلقاء وإنشاء و لبردت المعاني من كثرة الانتظار وتَعَسُّر الظرف الجامع والقالَب الرائع. ولا أدري إذا تركت كل أسباب الجمال في الأدب من المقتدر كيف يكون البيان سحرا أم كيف ينظم الناظم شعرا؟!
لقد أدّت دعوى التسهيل غير المنضبط إلى نتائج سيئة على العلم وعلى الدعوة، ومثال الأول ما تراه في بعض مجالس العلم وشرح المتون وسرد الكتب من الانفصام اللغوي الأدبي التام بين لغة المتن ولغة الشرح، وبين لغة الكتاب ولغة التعليق، فيسمع الطالب فقرة أو بيتا من الكتاب المشروح يأنس منها بيانا وجَزالة وشِدّة أَسْر تبني عقله وتُنمي ذوقه وفكره، ثم يهوي به الشرح في مكان سحيق من الركاكة والإسفاف. فقهٌ بلا لغةِ فقهٍ وشرحُ حديثٍ لا يحترم لغة الحديث وتفسيرٌ لآيات الإعجاز بعِيّ وفَهاهة وحَصْر. كل هذا في مجالس الطلبة ورياض الخاصة، والصواب أنه إذا خوطب الخواص (فارفعوا عن عُرَنَةَ) وإذا خوطب العوام ( فكل عرفة موقفٌ).
ثم بعد هذا أين هؤلاء الكتاب والأدباء الذين يكتبون فيتقعرون بحيث تبعَثُ كثرتهم على التنبيه والتصحيح حتى لا يفسدوا العربية والأدب المتين المتفشي فينا القائم بيننا.
الأدب فينا ضامر والكتابة الأدبية الجميلة منكمشة تحتاج بعثا وإحياء، فكثير ممن هم في الواجهة الأدبية لا يكتبون بالعربية الفصيحة. فليتنا نتقعر قليلا ونضع القواميس بجانبنا لنحيِيَ العربية الفصحى ونتخلص في كتاباتنا من العبارات العجمية والألفاظ العجمية التي يظنها الناس عربية سواءٌ الكاتبُ منهم والقارئ .
فبالله تقعّروا قليلا حتى إذا تخلصت خطاباتنا وكتاباتنا من العجمية فحينئذ ننتقل إلى محاربة الغرابة العربية، بعد أن نكون تخلصنا من الغرابة العجمية، فكم من الكتاب يكتبون بلغة عجمية لكن بحروف عربية أبجدية ثم يتناقلها قراء الكتب الفكرية ويتفاصحون بها، فإذا حاول محاول أن يخرج عن المألوف ويرتقي بالكتابة ولو جهد المُقِلّ نعتوه بالتقعر المذموم. والحقيقة أن هؤلاء المتقعرين قد تكون لهم حسنة بعث مَواتِ الألفاظ العربية، والتقريب بيننا وبين كلام العرب وألفاظهم، فقد تغلغل كلام الإفرنج في منشوراتنا ومطبوعاتنا تغلغلا حثيثا خفيا. ورحم الله الأديب عبد الله كنون حين يقول -ونعم القائل- في كتابه “التعاشيب” :(كان عيب الرافعي في نظر بعضهم هو هذه القعقعة اللفظية وهذا التقعير في التعبير بحيث أنه كان يتصيد الكلمة الجزلة وأختها المناسبة لها في القوة فيجيء كلامه مُسْتعصِيا على الفهم داعيا إلى التأمل الطويل. ونحن لا نرى هذا عيبا ولا ندعوه إلا بالأسلوب المتين الذي كان على الرافعي أن ينهض به حين شاعت الألفاظ السوقية في كتابة الصحفيين وضعفت المادة اللغوية عند كثير من المنشئين).
إن الألفاظ العجمية الغربية تميت الألفاظ العربية لتأخذ مكانها، وإن تهذيب حقل العربية من هذه الشوائب التي صارت ظاهرة مخيفة أولى بالاهتمام من شيء لا يبلغ أن يكون ظاهرة إن سُلّم أنه مَعيب .
وإني لأعجب أشد العجب حين أرى من يشار إليه بشارة الأدب ونصرة العربية يختار لكتاباته أو محاضراته عناوين بلسان عربي هجين، ولله ذر الأستاذ أحمد الغامدي حين وصف هذه الألفاظ والعبارات بالعبارات المنافقة حيث تكون عربية الظاهر أعجمية الباطن.
ودونك هذا المثال في كتابه “العرنجية” مبينا لحجم المعضلة ومدى انتشارها ومدى السكوت عنها وعدم الانتباه لها. يستعمل الكتاب اليوم كلمة (جنس) للجماع، وأصل ذلك أن الغرب يستعملون كلمة (sex) للزوجين الذكر والأنثى، ثم توسعوا في لفظة (sex) فاستعملوها للجماع، ففعل كتابنا ومنشئونا مثل ذلك واستعملوا الجنس للجماع، والجنس في العربية هو النوع بإطلاق،كقولك: “التفاح جنس من الثمار” أي نوع منها، لكن تجد من يقول من كتابنا (الجنس محرم بدون زواج) وهذا معناه في العربية الصحيحة الفصيحة (النوع محرم بدون زواج)!!!
وذكر لي صديق أريب أنه كان في مجلس أحد المشايخ الشناقطة فذُكرت عنده عبارة (فلان له خلفية أو عنده خلفية…) فضحك وتعجب كيف يقول هذا عربي. إن كنت فهمت لم ضحك الشيخ فحسن وإلا فتقعر قليلا في دواوين لغتك لتتخلص من آثار العجمة الدخيلة واعلم أن هذه اللغة دين فانظروا عمن تأخذون دينكم!