المآلات النفسية والاجتماعية للمدارس الإلزامية
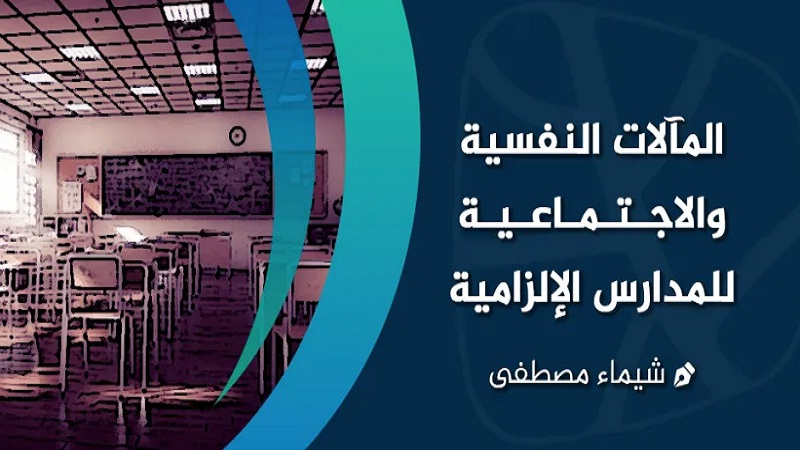
هوية بريس – شيماء مصطفى
عند النظر إلى عدد من الظواهر الاجتماعية المؤثرة في حياتنا مثل شيوع الفردانية والبراغماتية، نجد أنَّ بعض أسباب انتشارها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمدارس الإلزامية وما تحمله من أساليب مؤطرة لها، إذ إنها تمس جوانب كثيرة من حياة الفرد بدءًا من تكوينه الفكري من خلال المناهج المدروسة فيها -وهذا أشرتُ إليه في مقال سابق- مرورًا بإشكالات نفسية تتكون في الطفل، وصولًا إلى ظواهر اجتماعية منتشرة من بواعثها الحيوية هذه المدارس، سأحاول بعون الله في هذا المقال تتبع بعض هذه الإشكالات والوقوف عليها.
أهمية الجو الأسري في مرحلة الطفولة
تُعَدُّ الأسرة من أهم المؤسسات التي تسهم في التنشئة الاجتماعية لأفراد المجتمع وأعظمها تأثيرًا في حياة الأفراد والجماعات، وقد ظلت قديمًا -لقرون طويلة- المضطلع شبه الوحيد بتربية الناشئة، وكان من غايتها أن يعلم الكبار الصغار سبل العيش والسلوك بالإضافة إلى توفير الحاجات الجسمية والنفسية والضرورية لأفرادها، وقد تقوم بوظائفها في الحدود التي يسمح بها نطاقها وبالقدر الذي تقتضيه حاجاتها الاقتصادية والخلقية والتربوية، فكانت المركز الأساسي في حياة الأفراد ولذا فقد كانت تتمحور مهامها حول عمليتين رئيسيتين:
الأولى: الإعداد اللازم للحصول على ضروريات الحياة العملية بصورة آلية مباشرة.
والثانية: تتمثل في التدريب على الطرق والقيم المقبولة والمألوفة في حياة الجماعة بطريقة عرضية وطبيعية من خلال مشاركة الصغار مع الكبار أفعالهم وأحاديثهم في مواقف الحياة المحسوسة.
فالتربية الأسرية لا يختلف على أهميتها اثنان، لضمان التنشئة السليمة للطفل، وتعتبر السنوات الأولى التي يقضيها الطفل في منزله من أكبر المؤثرات المسئولة عن تشكيل مستقبله فهي أول وسط ينمو فيه، ويتشرب الأحكام الأخلاقية والتقاليد والعادات والأعراف السليمة من خلال الجو العاطفي الذي يتفاعل معه في الأسرة، فتفعيل الوظائف التربوية لا يتحقق إلا بتكاتف جهودها، فتقوم بأدوار وواجبات عديدة أهمها إشباع حاجات الطفل النفسية وتوسيع مداركه وزيادة معارفه، وحتى تتمكن الأسرة من القيام بدورها التربوي لا بد من إعدادها بشكل سليم.
كما أن الأسرة تحظى بمكانة تربوية كبيرة بين المؤسسات الأخرى، باعتبارها مؤسسة تربوية غير نظامية، ولا يمكن أن تتحقق التربية المتكاملة للطفل إلا إذا بدأت منها، كونها اللبنة الأولى التي ينشأ فيها الطفل، وأساس المجتمع المترابط، الذي بني من أول لحظة على التوافق والتراحم والانسجام والتشارك في الحقوق والواجبات، بل جعل المنهج الإلهي الأسرة مسؤولة عن نفسها وغيرها، أو من هو في محيطها الأسري بكثير من الاهتمام والرعاية بالأطفال بصورة متكاملة.

كيف تضعف المدرسة دور الأسرة؟
يصف الإمام الغزالي -في معرض حديثه عن التربية- الطفل بأنه “قابل لكل ما نُقِش عليه، ومائل إلى كل ما يُمال إليه، فإن عُوِّد الخير وعُلمه نشأ عليه وسعد، وإن عُود الشر وأُهمل شقي وهلك” [إحياء علوم الدين]، والمتأمل في مقولة الإمام الغزالي يجد أن عملية التربية مكتسبة يكتسبها الطفل من البيئة التي تهيَّأ له، فإن كانت حسنة فإنها تجعله ينشأ نشأة صحيحة، وإن كانت سيئة أدت به إلى أن يكون فردًا غير صالح في المجتمع، لذا كانت مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي يجب العناية بها في حياة أبنائنا.
فعندما يذهب الطفل إلى المدرسة يقع عليه ضغط نفسي حيث إنه يكون مُطالبًا بالتكيُّف أو التأقلم مع وضع جديد بكيفية معينة، وسلوكيّات محددة، ومن الممكن أن يكون البدء في نشاطات جديدة له أثر إيجابي وتغيرات جيدة، ومن الممكن أيضًا أن يكون مرتبطًا بتغيرات سلبية، إذ إنه يتم التعامل مع النشء ذوي العقول الغضة التي يسهل التأثير عليها وبالتالي تتحكم المدرسة في قدر كبير مما يصل إلى عقول الأطفال.
فبقاء الطفل ساعات طويلة مستمرة في بيئة تتوارد عليها أخلاقيات مختلفة وأحيانًا متضادة حتمًا ستؤثر فيه سلبًا خصوصًا في المراحل العمرية الأولية، حيث إنّه يتطبع بصفات الأطفال الآخرين السيئة التي لا نحبها في أبنائنا كالعنف، والتنمر، واللامبالاة، وعدم الطاعة.
وكذلك ابتعاده عن والديه اللّذَين تعلّق بهما يُدخله في نفق الانفصال عنهما، حيث إنّ قلق الانفصال لدى الأطفال يمر بمراحل هامة وهي:
1- المرحلة الأولية، الاحتجاج والبحث، وفيها يحاول الطفل جاهداً أن يحتج ويبكي على انفصاله عن الأب أو الأم، مع إصراره على البحث عنهم أو حتى اللحاق بهم إذا أمكن.
2- مرحلة اليأس، وهنا يدرك الطفل أن الأب أو الأم غير موجودين، وأنه لن يتمكن من اللحاق بهم، حيث تظهر ملامح اليأس والإحباط عليه، ويرفض فيها الاستجابة للآخرين من حوله.
3- مرحلة الانفصال، وفيها يبدأ الطفل بفصل جميع المشاعر والروابط العاطفية والانفعالية بالشخص الذي ابتعد عنه، كما أنه يقلل من تفاعلاته الاجتماعية مع الآخرين، ويقلل من اهتمامه بهم خوفاً من أن يبتعدوا عنه هم أيضاً.
وأكثر الأطفال معاناة من قلق الانفصال هم الأطفال من الشهر السادس وحتى سن ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يقل قلق الانفصال كلما كبر الطفل، لأنه يصبح أكثر اعتمادًا على ذاته. ولقدرته المعرفية على التذكر بأن مقدم الرعاية إذا ذهب سيعود، مما يخفّف من شعوره بالقلق.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال بعد سن الخامسة وكذلك المراهقين قد يعانون من قلق الانفصال، وأنّ من يتعرض للانفصال تظهر عليهم علاماته كاليأس والإحباط والخوف، وقد يعانون من مشكلات سلوكية كالتبول اللاإرادي والكوابيس [مجلة كلية التربية بالإسماعلية. مصر، عدد 22: 85-126].
وكذلك نلاحظ وجود العنف بين الأطفال في المدارس، إذ كثيرًا ما يكون هناك تعارك بين الطلاب في المدرسة أو اعتداءات مختلفة، الأمر الذي قد يؤدي أحيانا إلى نتائج مؤذية لهم على العديد من الأصعدة النفسية والجسدية، وتؤثر على شخصياتهم مستقبلًا.
ونتائج العنف عادة ما تؤدي إلى إحداث خلل في عملية نمو الطالب في المجتمع، الأمر الذي يفضي إلى خلق شخصيات تعاني اضطرابات نفسية أو خاضعة ومنقادة وغير قادرة على اتخاذ قرارات إيجابية بناءة لمواجهة مشاكلها المختلفة.
وقد اخترقت الظاهرة مناعة المجال المدرسي وأصبحت تشكل سياقًا يتبادله جميع المتعايشين داخل الفضاء المدرسي وصار هذا المعجم اللفظي البذيء في السنين الأخيرة من أكثر أشكال التعبير استعمالًا سواء بين التلاميذ أو بين التلاميذ والمربين.

العزلة الاجتماعية
عند النظر إلى طبيعة سير العملية التعليمية التي تتبعها المدارس الإلزامية نجد أنّها تُهيكل حياة الإنسان لتصبح مقتصرة عليها فقط، ويتم عزل الطفل بل حتى الشاب عن الكثير من الأنشطة الاجتماعية الأساسية بحجة الدراسة والتعليم، وتُكرَر على مسامعه من أهله عبارات مثل “أهم شيء دراستك”، “اصرف واشتري ما شئت من أغراض وكتب ولا تبالي بأمر المال”، “لا تفكر في الزواج الآن، يمكنك ذلك بعد إنهاء دراستك الجامعية”، “دعك من الهوايات التي تعطلك في الدراسة”… إلخ، ومع كثرة تكرار هذه العبارات من جهات متعددة وبأنماط وطرق مختلفة، يشعر الشاب والفتاة بالأمان حيال معارك الحياة ويصبان همهما بالفعل في الدراسة أو في أي شيء آخر لا مسئول، لأنهما غير مطالبَين بالمسؤولية، ثم تحدث الصدمة بعد التخرج، فيجدان أنفسهما لا يعرفان شيئًا عن مهارات الحياة ولا عن مسئولياتها، والطامة الكبرى أنّ ذات المجتمع يطالبهم بتحمل المسئولية وأنّ هذا العمر المناسب لحملها، فتكون النتيجة هي الإقدام على خطوات حياتية تحت الضغط المجتمعي دون استعداد كافٍ لها، وبالتالي الكثير من الصدمات والتخبطات والقرارات الخاطئة، وتظل هذه الدائرة في المجتمع لأن هذا النظام التعليمي هو سبب رئيس في وجودها، ولا يزال قائمًا.
البراغماتية والعملية التعليمية
عند إلقاء نظرة على العلاقة بين الطالب والمعلم في التراث الإسلامي نجد أنّ هناك علاقة وثيقة متبادَلة بين الطرفين، ونجد أنّ فكرة ملازمة الطالب للمعلم فكرة منتشرة بين طلاب العلم، فنجد _مثلًا_ أنّ ملازمة الإمام بن القيم رحمه الله لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله استمرت ستة عشر عامًا، حيث إنه التقى به سنة (712هـ) للهجرة، ولازمه إلى سنة (728هـ)، أي إلى أن توفي رحمه الله تعالى تقريبًا، وغيرهم الكثير، بل إننا نجد أنّ ملازمة التلميذ لشيخه من القرائن التي يُعتد بها في علم الحديث.
أما الطريقة المُتّبَعة اليوم في التدريس من مرور الطالب في اليوم الواحد على عدة معلمين مختلفين لوقت محدد وتنتهي علاقة الطالب بالمعلم غالبًا بانتهاء الفصل الدراسي تجعل العلاقة الجامعة بينهم علاقة نفعية محضة، والمعلم كذلك يعمل تابعًا لمؤسسة تؤطّر دوره وحدود وقته مع الطالب، وتحدّد وظيفته معه، ومع تواتُر تلك التبادليّة البراغماتيّة بينهم؛ تتعزّز النزعة الفردانية في المجتمع، إذ إنّ الأفراد نشأوا في تسلسل دراسي يمحورهم حول تحقيق ذواتهم من خلال السلم الدراسي مع تغيُّر متتابع ومستمر فيمن يتلقّون عنهم، فيخرج للمجتمع فرد تضخمت ذاته في ناظريه، وأصبحت مصالحه الشخصية مُقدَمة دائمًا، ويصعُب عليه النظر لمصلحة الغير وتحقيق خُلُق رفيع كالإيثار مثلًا.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله “الشعور مراتب، وقد يشعر الإنسان بالشيء ولا يشعر بغالب لوازمه، ثم قد يشعر ببعض اللوازم دون بعض” [درء تعارض العقل والنقل] فبسبب اعتياد هذا النمط التعليمي أصبح تصور وجود رابط بين إشكالات اجتماعية كشيوع الفردانية وبين النظام التعليمي أمرًا مستبعدًا، ويتم رد هذه الظواهر إلى أسباب أخرى وحصرها فيها دون ملاحظة لوازم الأمور وبقية الأسباب، فمثلًا تُعزى نشوء الفردانية إلى ما حدث في نفسية الجماهير بعد صدمة الحرب العالمية الثانية، حيث نزع الناس إلى التمحور حول الذات والميل إلى الفردانية بسبب خيبة الأمل التي أصابتهم بعدما كانوا ينتظرون رغد العيش نتيجة التقدم التقني.
نعم هذا سبب ممتد ويتجدد جرّاء صدمات أخرى، لكن يجب ملاحظة البواعث الأخرى المُعززِة لهذه الظاهرة، حيث إنّ عدم الشعور بنمو الفردانية من خلال هذه الثنائية البراغماتية، وأنّ كون العلاقة بين الطالب والمعلم باتت براغماتية بحتة، لا يعني عدم وجودها، فالفردانية من لوازم هذه الثنائية البراغماتية.
ختامًا
إنّ موضوع التعليم وعلاقته بالمجتمع سواء من الناحية الفكرية أو النفسية والاجتماعية أمرٌ بالغ الأهمّيّة لكونه يشكّل الوعي العام في المجتمع، والعناية به ومحاولة تفنيد آثاره والبحث عن حلول له من القضايا المركزية الأولى التي يجب أن تكون نصب أعيننا، فكل يوم يمر دون الوصول لحلول حقيقية لهذه القضية يعني تمامًا قولبة المزيد من العقول وطمس الكثير من العبقريات في المجتمع وتعزيز للعديد من النزعات التي تمزق نسيج المجتمع مثل الفردانية أو غيرها من التأثرات الفكرية، وبالرغم من تواجد بعض الأطروحات التي تحاول وضع تصور لحل هذه القضية، إلا أنّ الأبعاد المؤثرة عليها تجعلنا نسأل سؤالًا مشروعًا وهو: في ظل هذا الواقع، ما جدوى هذه الأطروحات؟
هذا ما أسعى للإجابة عنه في مقالٍ لاحق بإذن الله.








































