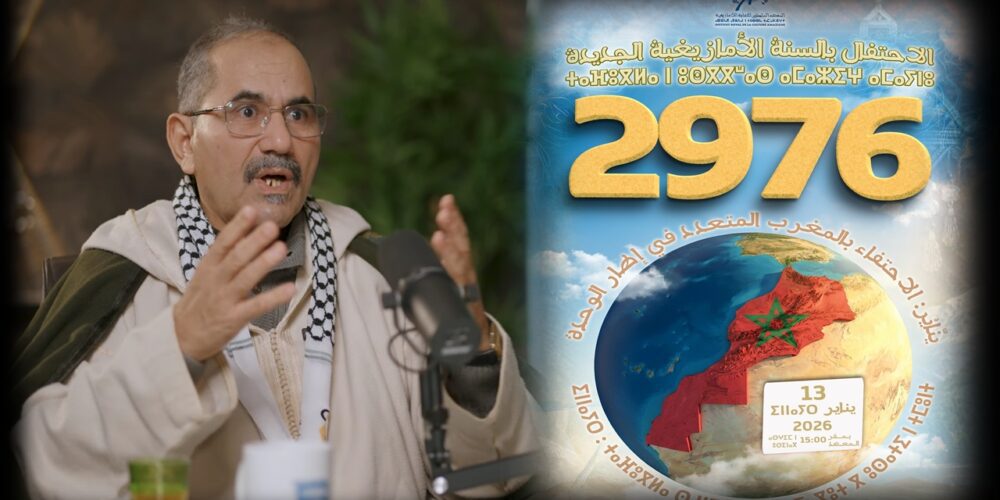المدرسة المغربية ورهان المستقبل

هوية بريس – بلال التليدي
سنكون مضطرين بعد سنوات قليلة قادمة إلى أن ننظر إلى الأمور بمنظار مختلف، بعد أن يكتشف الجميع أن البلايا والمشاكل التي تجد حلها في المدرسة، صارت المدرسة نفسها، هي المتسبب في إنتاجها، أو على الأقل أصبحت ضحيتها الأولى.
يتابع الجميع هذه الأيام، مشاهد متعددة تخرج من الفصل الدراسي، ترسم صورة جيل جديد، يفرض إيقاعه العابث والعنيف ضدا على نظام المدرسة، فينبري البعض إلى سب هذا الجيل، فيما يضع البعض الآخر رجال التربية في دائرة المساءلة، ويرثي البعض المتبقي انهيار منظومة القيم في المجتمع.
السياسيون، كعادتهم في التغطية على المشاكل، وركوب خطاب الطمأنة، يبشرون بالعهد الزاهر، الذي يدخل فيه القانون الإطار حيز التنفيذ، بعد أن يختصروا أزمة التعليم برمتها في وجود وثائق نوعية لم يتوفر الإطار القانوني لإلزام القطاع المعني بمقتضياتها.
الدولة منذ فترة بعيدة، تعي المشكلة، على الأقل في أبعادها الأمنية والاقتصادية، فتدرك من خلال المعطيات الاستشرافية التي لديها أن موت المدرسة، يعني أن الحاجة ستزداد لرجال الأمن لمواجهة الجريمة والتطرف، كما تعني أنه لن يكون بالإمكان مد المحيط الاقتصادي بالخبرات والكفاءات المطلوبة.
لكن مع وعيها بالمشكلة الاستراتيجية، إلا أنها لم تتصرف بعقل استراتيجي، فقد سوت إكراهاتها المالية والاقتصادية أكثر من مرة، بنحو وضع قطاع التعليم في طريق الموت، إذ اقتضى إكراه التقليص من الكتلة الأجرية التخلص من الأعوان والمعيدين والحراس العامين، ثم النظار، فأضحت المدرسة فارغة من الأطر الإدارية، فاقدة للقدرة على السيطرة على مواردها البشرية فضلا عن التحكم في السير التربوي. وتعمقت الأزمة، لما حل نزيف التقاعد الذي كان متوقعا في نسبته وتوقيته، فتم التعاطي معه، بمنطق الفجاءة، فانتهى الأمر بإدخال فوج كبير من المدرسين إلى المدرسة، نجح في الامتحانات بوتيرة كبيرة بسبب الخصاص، فحصل النقص من جهتين: الكفاءة المهنية، ثم التكوين، لتكون النتيجة في المحصلة، فقدان المدرسة للنظام، وفقدان النظام التربوي للاستقرار بسبب عدم القدرة على التعامل مع مشكلة المتعاقدين
ثمة مؤشر مهم يمكن تحكيمه لاستخلاص موت المدرسة، فطلبات التقاعد النسبي، التي كانت بالأمس محدودة وقليلة، حطمت اليوم الأرقام القياسية، مما اضطر الإدارة إلى رفض كل الطلبات التي يقل سنوات تدريس أصحابها عن الثلاثين سنة، وهو مؤشر يفيد تضخم تذمر الأطر التربوية من الحالة التي وصلت إليها المدرسة المغربية، والمفارقة، أن الإدارة التربوية، التي كانت بالأمس طموحا كبيرا لعدد من الأطر التربوية، لم يعد أحد يمني بها نفسه بعد أن تم تجريدها من السكن الوظيفي وبعد أصبحت شيئا مخيفا، واليوم لا يريد البعض أن يستخلص الدروس من الأسباب التي تدفع إلى تكليف مدير واحد بمسؤولية عدد من المؤسسات التعليمية في أكثر من منطقة لاسيما في المدن الكبرى، وهو ما يؤشر على مخاطر كبيرة محتملة في المستقبل من إمكانية نفور جماعي من تحمل المناصب الإدارية في المدرسة العمومية.
موت المدرسة، بدأ في اليوم الذي حكمت الدولة منطقها الاقتصادي، فحلت الكتلة الأجرية محل النظر التربوي البعيد، وترسخ هذا الموت، في اللحظة التي توقف فيها عقلها الاستراتيجي عن استشراف أجوبة ما بعد نزيف الموارد البشرية، فجاء جوابها الفجائي، يضرب في العمق الأساس الأول في المدرسة(المدرس)، فتم تحكيم منطق سد الخصاص على منطق الكفاءة والتكوين.
البعض يعتقد أن مشكلة التعليم تتمثل في عدم التحكم في اللغات، وأن نجاة المدرسة سيكون بعودة الفرنسية إلى عرشها، وتدريس المواد العلمية بها، وهو تشخيص قديم، تحكمه السياسة، بل تحكمه الأبعاد غير المتكافئة في العلاقات الدولية.
المشكلة هي أعقد بذلك بكثير، فعطب المتعلم اليوم، هو أكبر من مجرد عدم تحكمه في لغات أجنبية، إنه فقد الرغبة في التعلم والعلم، وصار لا يتحكم في أي شيء حتى في لغته الأم.
نحتاج أن نقولها بصراحة ومن غير تردد، إن موت المدرسة يعود بالأساس إلى اختيارات أبعدت التربية والتكوين من الحساب، وارتهنت لحسابات الكتلة الأجرية، ومنطق ضغط اللوبي الفرنسي، ثم المنطق الأمني، الذي سحب كل أوراق الاعتماد التي كانت تعتمدها الإدارة التربوية لبناء هيبة المدرسة ورسم صورة النظام في تمثلات المتعلمين.