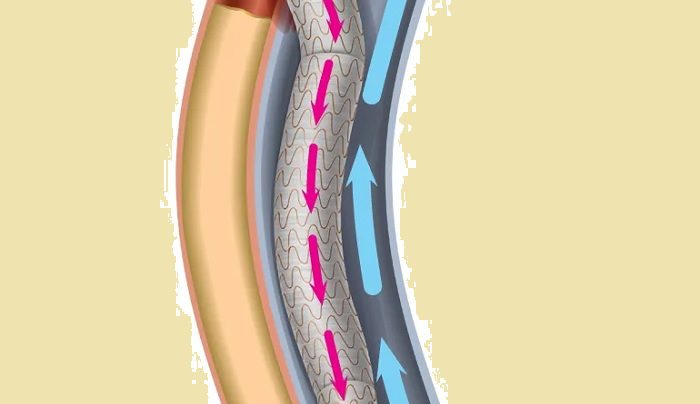جرائم فرنسا الباردة بالمغرب (ج5).. المغرب تركيبة من الغرب والشرق

هوية بريس – ذ.إدريس كرم
المغرب تركيبة من الغرب والشرق!:
نحو تأصيل إحدى جرائم فرنسا الباردة بالمغرب القائلة: (المغرب الجديد صناعة فرنسية)!!
تقديم:
المبحث الذي نقدمه يتطرق لنظرية الطبع الأوربي للمغربي الذي تركه الاحتلال الروماني والذي بقي ثاويا في سكان السهول وحيا لذى سكان الجبال حتى اكتشفته سلطات الحماية بعد 1912 فرعته ولمعته وأرادت أن تبني عليه مغربا جديدا ذا توجه أوربي يحقق الهدف الفرنسي في انشاء إمبراطورية فرنسية مسيحية على أنقاض (إمبراطورية الثراء) المغربية ذات النزوع المشرقي المتواري خلف إسبانيا والمغاير لباقي سمات العالم الإسلامي لارتباطه بالأصل الروماني الذي لم يمت رغم توالي العصور.
وعليه يكون البحث من الأبحاث المؤسسة لتبرير سلخ المغرب من هويته وحضارته وهو ما ظهر في أنظمة التعليم والتمدين والفلاحة والصناعة والتجارة والإدارة والحكم.
نص الموضوع:
“المغرب تركيبة من الشرق والغرب (ص51-56):
إذا كانت حقا -كما أضن- إحدى سمات المغرب المميزة جاءته من الغرب ممثلة في الحياة المدينية، بنت المناخ والتساقطات المطرية الغزيرة والمنتظمة، وسماته الأخرى متأصلة من الشرق الأوسط، الخاضع للتأثير السائد في حياة البدو الناجم عن مناخ جاف بسبب عدم انتظام هطول الأمطار وشحها.
فإن هذا البلد يظهر كانه تركيبة عيش بنوعين من الحياة، واحدة غربية، وأخرى شرقية، لكن التأثير الشرقي تقوى بفضل تواصله المباشر مع الصحراء الكبرى الممتدة بين المحيط الأطلسي والهند، وشبه السهوب المميزة له بالجهة الشرقية الملتصقة بالصحراء، والتأثير الإسلامي منذ القرن السابع، الذي أعقب التأثير الفينيقي والروماني والبزنطي على مدى ألف عام
عندما ظهر بنو هلال وبنو معقل في القرنين الحادي عشر والثالث عشر، لم يأتوا غزاة ولا متسللين، بل جاؤوا بدعوة من سلاطين المغرب، جاؤوا كقبائل بأكملها رجالا ونساء وأطفالا، بأموالهم وذوابهم لاستخدام ميولهم الحربية في نشر الشريعة والمحافظة عليها.
وقد عرفت هذه الحقبة تعريب شمال افريقيا بأتمها، وشيئا فشيئا تحول وجه المغرب نحو الشرق حتى ولو نظر إليه من الباب الخلفي لإسبانيا قل ذلك أو كثر، وهو ما لفت نظر المؤرخ المسلم الكبير ابن خلون، فتناول وصفه في كتابته التي خصها لذلك المرور بعد فترة وجيزة من تنفيذه، حيث كانت ما تزال ذكريات نهبهم وإفسادهم حاضرة في الأذهان، كانوا مثلا إذا احتاجوا حجارة مناصب لقدورهم، حطموا البنايات للحصول عليها، وإذا احتاجوا لحطب يطبخون عليه أو يصنعون منه أوتادا لخيامهم أو أعمدة لنصبها أتلفوا أسطح وأسقف المنازل ليحصلوا عليها، وكلما رأوا قطيعا جيدا أو أثاثا أو آنية عند أحد أو بمنزله، انتزعوها منه غلبة وقهرا.
كما يعتبر التنظيم القبلي بالمغرب، واستمرار العائلة الأبوية، وثنائية المدينة والبادية، وغياب الأثاث والأشجار حتى عند الأغنياء بالبادية معطى إسلامي، وصفات مشرقية بارزة.
لكن هذا ليس سوى جانب واحد من جوانب المغرب، إذ لم يكن الأمر كذلك من قبل لأن المغرب على الأقل في هذه السهول قد تميز بالسلام في الوجود الروماني وحتى بعد الوندال والبزنطيين والفترة المضطربة التي مر بها في القرون الأولى من وصول الفرسان المسلمين، فقد استعاد المغرب ازدهاره بسبب اقتصاده الفلاحي المستقر -وهو ما يبرزه المؤرخ تيراس في كتابه الرائع (تاريخ المغرب)- حيث أظهرت الحفريات سمات من الحياة الريفية في أطلال منازل ومعاصر الزيتون بكل من وليلي وبناسا بسهل الغرب حيث كان يسكن ملاك الأراضي الأغنياء التي تم اكتشافها من قبل خبراء الحماية الفرنسية الذين قاموا بالتنقيب فأثبتوا ما سجله أوائل الجغرافيين المسلمين من قولهم بأن سهول المغرب كانت غنية بالأشجار والمزروعات التي كانت ركيزة لحضارة المغرب الروماني المشيدة من قبل فلاحيه بصبر خلال قرون ماضية، ولما جاء العرب دمروها بيد أن الفلاحين لم يختفوا بل ظلوا أكثر العناصر استقرارا في البلاد الذي تصل مساحته الصالحة للزراعة حوالي 25% تسفيد من التساقطات المطرية الغزيرة التي تعم البلاد كل سنة بفضل جوارها من سلسلة جبال الأطلس والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
يختلف فلاحو المغرب المستقرين عن البدو الرحل، سواء كانوا من العرب أو البربر، إلا أن أدواتهم الفلاحية ظلت بدائية بلا شك لبقائهم غارقين في عالم شرق أوسطي مغلق أمام التكنولوجيا، وإن كانوا عكس القساوسة الملاك من حيث اعتيادهم على العمل بأيديهم في المزارع، مما جعل عقولهم منفتحة لقبول التقنيات المختلف للحضارة الغربية التي تحقق لهم فائدة، ما دامت لم تغرس فيهم بوحشية، بل يتأقلمون معها بسهولة من خلال عائداتها المجزية التي تطلبت250سنة بالغرب لتوليفها، بخلاف ما جرى في المغرب، حيث تم توطينها في أقل من 50سنة بواسطة ضيعات المعمرين الذين حلوا بالمغرب، بعد فرض الحماية عليه.
فتأثروا بها سواء كعمال أو ملاك، من خلال هذا الجانب فإن المغرب قريب جدا من الغرب الأوربي، حيث يبرز فيه الجانب الأوربي من تركيبته المزدوجة التي سبق تبيانها، وهي خصيصة مغربية في العالم الإسلامي؛ على هذا الأساس وجد المغربي مفتاح توازنه الاجتماعي بين ما هو غربي وما هو شرقي.
صحيح أن التاريخ السياسي للبلاد كان مضطربا للغاية لكن مشاكله الصراعية كانت سطحية، لذلك ظل نسيج الحياة عنده متطابقا فيما بين رغباته وواقعه إلى حد ما.
في المدن بقي البرجوازي والتاجر والحرفي يمارسون أعمالهم على مر القرون، في ظلال المآذن التي ساهمت في إعطاء المدن غطاء خاصا في عهود الاضطرابات، هذه المدن التي كانت تغلق أبواب أسوارها على من فيها حتى تمر العاصفة، ثم تعود من جديد لناشطها السابق، وتعاملها مع محيطها.
في السهول بقي السكان يحرثون الأرض بنفس المحراث الذي جلبه الرومان معهم للمغرب وبقيت الفتن، صراع الرواكى، هجمات الجبليين من حين لأخر يشكل سببا للغزو والقتل والنهب، لكن الحياة كانت تعود مجددا للاستقرار ويسود السلام، فيرجع الفلاحون لحراثة أراضيهم والكسابون للإنتجاع بقطعانهم.
أما الجبال البكر فقد حمت العالم الأمازيغي الذي اكتشفنا بعد الحماية، أنه ما يزال كما تركه الرومان إلى حدما، فغالبا ما كانت القبائل تتقاتل فيما بينها من أجل الشرف بيد أنه لم يكن قتالا داميا جدا فالبنادق المستخدمة عندهم فبل 1912 بنادق قديمة تحدث ضوضاء أكثر مما تحدث جراحا وتذميرا، لذلك كانت خسائر المتقاتلين خفيفة يسهل علاجها من الجانبين ولصالحيهما.
وهكذا بقي -طيلة القرون السابقة- نفس المفتاح، يفتح أبواب نفس الحياة التي يحياها المغربي الذي قاوم لغاية 1912 وباستماتة لغاية 1933 ضد كل هجمات الأجانب خوفا من حملهم جديدا يتمكنون من نشره بينهم.
إن القارئ لا يغضب مني لتركيزي على ازدواجية المغرب القديم الذي ما يزال حيا حتى اليوم، لذلك أرجو أن يكون لذى المغاربة ما يكفي من الحكمة والنضج السياسي للاعتراف بتلك الإزدواجية، لأن قبول الانطلاق من هذه النقطة في البداية سينبني عليها المستقبل ويكبر بسهولة كما أن سيراعي الفرنسين سيراعونها من جهتهم في عمليات التطوير الذي يقومون بها منذ أربعين سنة والذي يجب الآن محاولة عرضها للتعرف عليها”.
(بول بيتان في le drame du maroc؛ ص50-56).