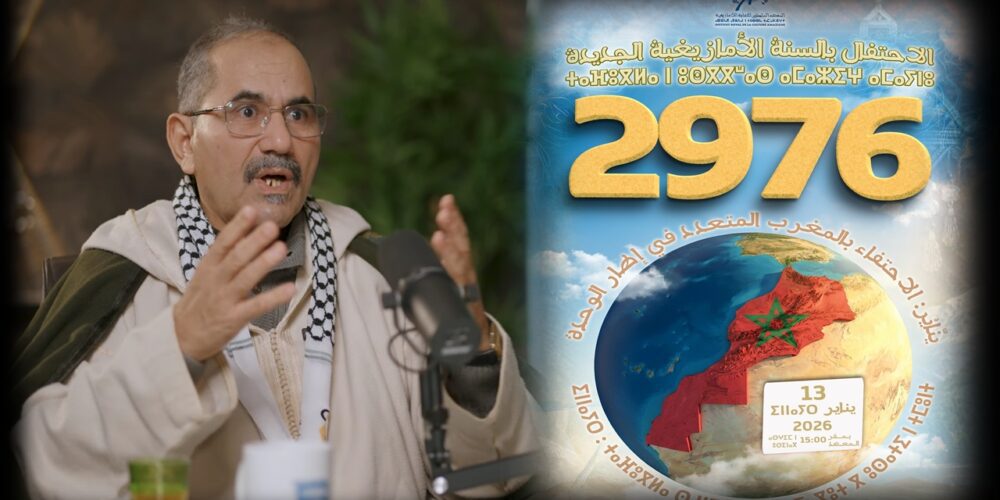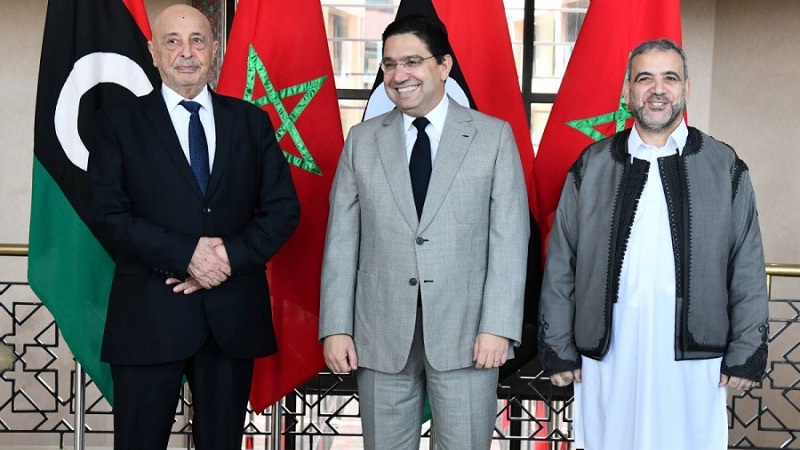“حديقة” بوريل و”أدغال” العالم

هوية بريس – عادل بنحمزة
يُقال إن زلة القدم أسلم من زلة اللسان، هذا المثل ينطبق على مفوض العلاقات الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الذي قال بداية هذا الأسبوع في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الجديدة في بروكسل، إن أوروبا حديقة وبقية العالم مجرد أدغال، وإن على أوروبا أن تحتاط من الأدغال.
هي بلا شك زلة لسان تكشف صحة ما ذهب إليه سيموند فرويد قبل أكثر من مئة سنة، ونشره في كتابه “علم أمراض النفس في الحياة العادية” الصادر سنة 1901، بوصفها خللاً إجرائياً، وهي بمثابة “مرآة تكشف أفكاراً أو دوافع أو أمنيات دفينة في اللاوعي”، وتلك العبارات المجسدة لزلة اللسان، بحسب فرويد دائماً، هي في معظم الحالات، تكون قد “اكتشفت تأثيراً مقلقاً من خارج الحديث المقصود”، وأن “هذا العنصر المقلق هو عبارة عن فكرة واحدة في اللاوعي تخرج إلى النور عبر خطأ لغوي”.
جوزيب بوريل في اعتقادي لم يكن يتحدث فقط عن أوروبا بمنظور الجغرافيا، بل خلفيته أبعد من ذلك، فهي تشمل كل ما يعود إلى أصول أوروبية بالمعنى الحضاري والثقافي، وهنا يمكن إدراج جزء واسع من الغرب مثل الولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا ونيوزيلندا، غير ذلك فهي مجرد أدغال، حتى من يظنون أنفسهم متحضرين وحلفاء، سواء في آسيا أم في أفريقيا، وهذا الأمر فيه استعادة لوهم التفوق من خلال المركزية الأوروبية، وبذلك يكون بوريل قد كشف لا إرادياً عن جزء خفي من حقيقة الفكر الغربي، أو على الأصح ما حاول كثير من الأوروبيين إخفاءه على مدى عقود. البعض يعتبر الأمر وجهاً من وجوه الانتهازية السياسية ونموذجاً من نماذج انحراف جزء من النخبة السياسية الأوروبية ووقوعها رهينة الحسابات الانتخابية، وهو ما جعلها بوعي أو من دونه تسعى، إما إلى مغازلة اليمين المتطرف والتيارات الشعبوية، وإما إلى استنساخ خطابه أمام العجز عن تقديم حلول وأجوبة لواقع اجتماعي واقتصادي وثقافي معقد لم تشهده أوروبا منذ عقود طويلة.
جوزيب بوريل المنبهر إلى حد الثمالة بحديقته الأوروبية، يلحس ذاكرته ويغمض عينيه عن الجرائم التي ارتكبها الأوروبيون والغرب بصفة عامة في مستعمراتهم السابقة، نتذكر هنا جرائم بلجيكا في الكونغو حيث أخضعت بروكسل الكونغو على عهد الملك ليوبولد الثاني بين عامي 1885 و1908 لنظام استغلال بشع، نتج منه ملايين القتلى والمعطوبين، فالجيش البلجيكي سبق بسنوات بشاعة “داعش” في قطع الأطراف والرؤوس وتعليقها وأخذ صور تذكارية معها والإبادة الجماعية للسكان عبر القتل والحرق، إضافة إلى سرقة مقدرات الكونغو، بخاصة من المطاط والعاج، إضافة إلى اغتيال القادة السياسيين والمقاومين الكونغوليين نظير ما تعرض له الزعيم باتريس لومومبا سنة 1961. كل ذلك حدث والأوروبيون لا يملّون من الحديث عن التحضر كما يفعل بوريل اليوم.
في الجزائر حكايات أخرى للإجرام الذي ارتكبته فرنسا على مدى 132 سنة؛ كانت نموذجاً للاستعمار الاستيطاني القائم على الاستغلال المفرط لخيرات البلاد، مرفوقاً بجرائم فظيعة، حتى أن فرنسا المتحضرة جداً، ما زالت تحتفظ بجماجم الجزائريين الذين اغتالتهم الآلة الإجرامية للاستعمار، ورغم بشاعة تلك الجرائم فإن من كانوا قائمين عليها وحتى وهم في أرذل العمر، رفضوا الاعتذار أو الشعور بالندم إزاءها. نستحضر هنا جملة للجنرال الدموي بول أوسارس (2018-2013) قال فيها: “إنني أُعرب عن أسفي، لكن لا يمكنني التعبير عن الندم… أعتقد أنني قمتُ بواجبي الصعب كجندي متورط في مهمة قاسية”، هكذا بكل بساطة يشعر الرجل الأبيض أنه كان في مهمة سامية تخللتها بعض الحوادث القاسية فقط. الجنرال نفسه وفي نموذج لراحة الضمير (…) اعترف قبل وفاته لمجلة “لوبوان” الفرنسية، بأنه هو من قتل الشهيدين علي بومنجل ومحمد العربي بن مهيدي اللذين بقيا مجهولي المصير ومن دون قبر لعقود طويلة. هكذا يتحدث جنرال دموي ويوغل في تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر. لكن واجبه الوطني، وهو من سكان الحديقة والحضارة… يمنعه من الاعتذار والندم، هذه الحالة تهم كثيراً من الوجوه الفرنسية التي تقدم في سياقاتها الخاصة كأيقونات وطنية، لكنها في الواقع كانت متورطة في واحدة من أبشع التجارب الاستعمارية في العالم، نذكر هنا الجنرال ديغول والاشتراكي فرنسوا ميتران عندما كان وزيراً للداخلية والذي قال ذات يوم للصحافة رداً على المطالب الجزائرية بالاستقلال: “أنا لا أقبل التفاوض مع أعداء الوطن، إن المفاوضات الوحيدة هي الحرب”.
أما المغرب الذي عمر فيه الاستعمار الفرنسي 43 سنة (1912-1956)، فلم يكن استثناءً أمام آلة الإجرام الفرنسية القادمة من الحديقة الأوروبية (…)، فقبل 1912 كشفت فرنسا عن وجهها الدموي عندما قصفت الدار البيضاء سنة 1907 لمدة يومين متواصلين بمدافع بوارج “غاليلي”، “فوربين” و”دوشيلا”، وذلك لرفض السكان تدنيس مقبرة سيدي بليوط عبر إنشاء ممر للسكة الحديد بهدف جلب الصخور من منطقة الصخور السوداء لتشييد ميناء في المنطقة، وقد خلّف القصف مدينة مدمرة ومئات القتلى والمعطوبين، ولفترة طويلة ظل الدخان يمتزج بروائح جثث الشهداء.
مجازر الفرنسيين في المغرب استمرت، ففي نيسان (أبريل) 1947 شهدت الدار البيضاء مجزرة جديدة عقب الدينامية التي أطلقتها وثيقة المطالبة بالاستقلال التي قدمها حزب الاستقلال وشخصيات وطنية للإقامة العامة وممثلي الدول الكبرى، إذ قامت القوات الفرنسية باغتيالات جماعية في كاراج علال، مديونة، ابن مسيك ودرب الكبير، وتكررت مجازر الدار البيضاء في أعقاب التظاهرات الحاشدة سنة 1952 احتجاجاً على اغتيال المناضل الوطني النقابي التونسي فرحات حشاد، وتجددت الفظاعات الفرنسية في المنطقة الشرقية في حوادث آب (أغسطس) 1953 في كل من وجدة وبركان والنواحي، ثم سنة 1955 مجزرة وادي زم في إقليم خريبكة، وذلك يوم 19 آب حيث شهدت المنطقة انتفاضة واسعة احتجاجاً على استمرار نفي ملك البلاد محمد الخامس.
المغرب أيضاً، بالنظر إلى أنه كان مقسماً بين قوى استعمارية مختلفة، شهد واحدة من أبشع الجرائم الاستعمارية التي ما زالت آثارها موجودة إلى اليوم بحكم الانتشار الواسع لمرض السرطان، فقد تعرضت منطقة الريف سنة 1924 للإبادة الجماعية من قبل الجيش الإسباني، وذلك عندما ألقيت على التجمعات السكانية الغازات السامة، وبخاصة غاز الخردل، وذلك قبل عام واحد من توقيع اتفاقية جنيف «لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل الحربية البكتريولوجية». هذا الغاز كان ثمرة تعاون بين الإسبان والألمان الذين كانوا يسهرون على برنامج سري للأسلحة الكيماوية. ورغم أن الحكومات الإسبانية حاولت طمس هذه الحقيقة، فإن عسكريين إسباناً ممن شاركوا في تلك الحرب القذرة على شمال المغرب، اعترفوا بذلك. من بين هؤلاء نجد بيدرو توندرا بوينو في سيرته الذاتية التي نشرت عام 1974 تحت عنوان “أنا والحياة”، وإغناسيو هيدالغو دي سيسنيروس في سيرته الذاتية المعنونة “تغيير المسار”، والتي يعترف فيها بوضوح بأنه قاد شخصياً عدداً من تلك الهجمات الكيماوية التي شنها الطيران الإسباني على مناطق واسعة من الريف، ذلك كله كان عقاباً جماعياً للريف على إذلال قوات عبد الكريم الخطابي للإسبان في معركة أنوال. هذه فقط شذرات من “آثار” الرجل الأبيض ساكن الحديقة الأوروبية التي يحرسها جوزيب بوريل ومن على شاكلته، ويمكن أن نضيف إليها جرائم الولايات المتحدة الأميركية في فيتنام والعراق وأفغانستان، إذ إن جرائم الغرب لا سبيل لحصرها لا في التاريخ ولا في الجغرافيا، وهي مستمرة إلى اليوم على مستويات مختلفة، بخاصة على المستوى الاقتصادي والثقافي، لذلك من الصعب الإحاطة بها جميعاً أو حصرها.
إن ما يحدث الآن مع روسيا والصين يرجع في جزء منه إلى هذه العقلية الإقصائية والاستعلائية التي أظهرها بوريل، والتي تؤمن بمركزية الغرب وفي صلبه أوروبا، بل إن أوروبا نفسها تعرف فوارق كبيرة داخلها، علماً أن الحديقة التي يفتخر بها جوزيب بوريل خرجت منها بريطانيا غير آسفة، بوريل الذي يعتقد أن عنوان التحضر والحضارة هو أوروبا، يتجاهل ما كشفته أزمة كورونا التي حملت لنا صوراً مؤسفة عن الصراع الجسدي في الغرب بين سكان “الحديقة” على الورق الصحي في الأسواق الممتازة، كما أن أزمة الطاقة في فرنسا هذه الأيام كشفت لنا عن العنف المتبادل في محطات البنزين، والذي لم يستثن حتى التهجم على النساء، هذا هو الوجه الحضاري لسكان الحديقة الأوروبية… بل إن بوريل دعا أيضاً إلى توسيع الحديقة الأوروبية، وهو بذلك يستعيد النزعة الكولونيالية، فجزء مما يحدث اليوم على الساحة الدولية ليس سوى تكرار لما عرفته بداية القرن الماضي من نزاع وصراع بين القوى العظمى على مواقع النفوذ والمواد الأولية، والذي نتجت منه تفاهمات عبارة عن تقسيم للكعكة الأفريقية والآسيوية. المفارقة اليوم هي أن أوروبا/الحديقة تهرول نحو ما أسماه بوريل الأدغال للحصول على الغاز والنفط لتجنب آثار الصقيع القادم…