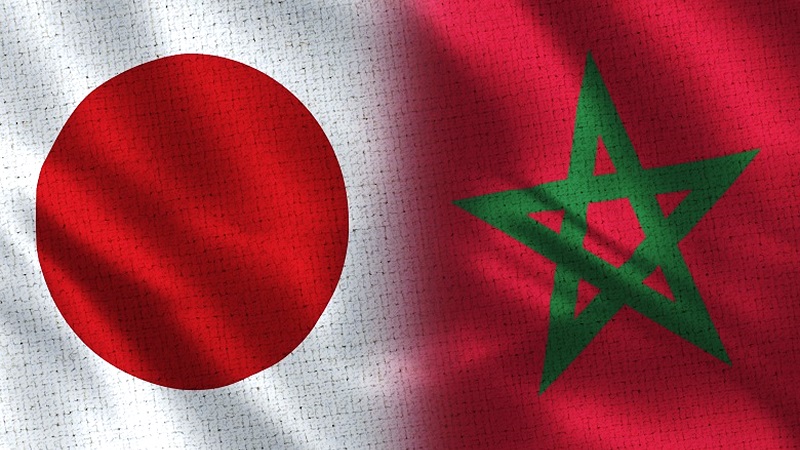حوار شامل حول قضايا منظومة التربية والتعليم مع المفتش التربوي أحمد العبودي

هوية بريس – حاوره: د. عبد الحي الروسي

في هذا الحوار مع المفتش التربوي للتعليم الثانوي السيد أحمد العبودي سنطرح مجموعة من الأسئلة أو التساؤلات، مستمد أساسا من النقاش الدائر حاليا في المنابر التي تهتم بقضايا التربية والتعليم وبعض مستجداتها. وللتذكير فإن أحمد العبودي له تجربة سابقة في التدريس والآن يعمل مفتشا تربويا بمديرية العرائش. وقد حاولنا من خلال الأسئلة مقاربة أربعة محاور أساس وهي على التتابع:
المجال الأول: البيداغوجي والتربوي، والمجال الثاني: الامتحانات والتقويم، والمجال الثالث: التكوين والتأطير، والمجال الرابع: الشأن الإداري والتنظيمي.
الأسئلة:
المجال الأول: البيداغوجي والتربوي:
- ما رأيكم فيمن يترددون على قسمهم الدراسي من غير أي نوع من الإعداد المسبق للدرس سواء كان ذلك إعدادا ذهنيا أو ماديا؟ وما الدافع إلى ذلك؟ هل هي ثقة المدرس في نفسه وقدراته المهنية أم استسهال المهمة، أم هو تمرد على “تعليمات بيداغوجية رسمية”؟ أو بعبارة أخرى ماذا يمثل القسم بالنسبة إليكم؟
- الإجابة عن هذه الأسئلة، تحتاج لشيء من الوضوح، فاشتغالي مع المدرسين والاستفادة من خبراتهم يساعد على وضع الإصبع على مكامن الخلل في منظومتنا التعليمية عموما وعلى جوانب النقص في الممارسة المهنية اليومية خصوصا، ولأحاول أن أجيب عن السؤال دعني أقول لك: إن المسار التدريسي للأستاذ بخصوص موضوع السؤال يمر بأربع مراحل متتابعة لزوما، وكل مرحلة تستغرق سنوات عمل ليست بالضرورة متماثلة بين كافة الممارسين:
- المرحلة الأولى: حيث تهيمن الدهشة ممزوجة بالخوف من التعثر والوقوع في الأخطاء العلمية والبيداغوجية، فضلا عن كون رهبة القسم حاضرة في الرُّوع والخاطر، ولذة البحث عن الذات الفاعلة لا تتوقف، خاصة وأن الأستاذ يكون حديث عهد بمغادرة مقاعد التعليم الجامعي، كل هذا يشكل دافعا قويا، وباعثا محرضا على الإعداد المسبق والجيد للدرس، والاستمتاع بعناء ذلك الجهد. وأنا أسمي هذه المرحلة بمرحلة: “الدهشة والسؤال”.
- المرحلة الثانية: أسميها: “مرحلة البحث الفعلي عن الذات الممارسة”، حيث يسعى المدرس إلى امتلاك ثقة في نفسه، ويحاول ضبط مفردات المنهاج الدراسي، والإحاطة ببعض قواعد صنعة التدريس وفنونها، فتتراكم الجذاذات والإعدادات، ويدرك المدرس بالتجربة والممارسة الفعلية أن مستوى التلاميذ المعرفي، مهما كان، لا يمكن أن يشكل عامل ضغط نفسي أو يسبب إزعاجا، ويصبح أمر الإعداد شكليا وثانويا، يقتصر على إطلالة سريعة على جذاذة درس اليوم، وبحث طفيف في قضايا الدرس ومحاوره.
- المرحلة الثالثة: هي مرحلة تحوّل ملحوظ، فيها ينتقل السيد الأستاذ من الثقة في مهاراته التدريسية إلى ما يشبه “حالة غرور” وإعجاب بالذات، خاصة إذا كان يتلقى إطراء من لدن متعلميه أو أقرانه المدرسين، يحس بتضخم أناه وذاته وإن أظهر التواضع، يعجبه المدح وينتشي بالثناء، فما يلبث أن يتوقف عن الإعداد بالمرة، وكأنه قد وصل سدرة منتهاه. ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة: “الشعور بالرضا والكمال”.
- المرحلة الرابعة: مرحلة أخيرة ، مرحلة تتويج ، حيث تنضج الممارسة الصفية بفعل الاطلاع على تجارب الأقران والاستفادة من بعض التكوينات واللقاءات التربوية حيث يضطر المدرس إلى مراجعة كثير مما كان يعتبره مسلمات ويقينيات بيداغوجية، ومن ذلك طريقته في التنفيذ ومراجعه في الإعداد وطبيعة التواصل البيداغوجي مع التلاميذ، والعلاقة مع الإدارة التربوية، فيعيد النظر في كل ذلك استشعارا لخطورة المهنة، وقداسة المهمة، وسمو المسؤولية، فيصبح إعداد الدرس عنده ليس أمرا روتينيا أو عرفا بيداغوجيا، بل وسيلة ارتقاء في مدارج صناعة الأجيال وتوجيهها. وأسمي هذه المرحلة بمرحلة: “النضج المهني والرهان على المردودية”.
- هل تعذرون المدرس حين يجازف بجواب عن سؤال تلميذ من غير أن يكون موقنا بالإجابة؟ وهل يفعل ذلك السيد الأستاذ حتى يظهر بمظهر المقتدر المالك للمعرفة، أم أنه يلجأ لذلك كي لا تهتز الصورة الأستاذ المثلى/ النموذجية في أعين التلاميذ؟
- قد يقع ذلك فيتصدى المدرس لأسئلة ويجيب إجابات هو عنها غير راض، بلا تثبت ولا تحقق، وقد تدفعه إلى ذلك تجربته الناشئة، والرغبة في إثبات الذات والظهور بمظهر الأستاذ الفارس الذي لا تعجزه كثرة الأسئلة وتنوعها، مع استصغار السائل ومستواه المعرفي، لكن ما يلبث في مرحلة لاحقة أن يدرك أن العلم ضبط وانضباط وحجة وعلامة دالة، فيسرع راجعا إلى الصواب والرشد البيداغوجي المطلوب.
- هل حصل وأنتم تمارسون مهمة التدريس أن كان تصرفكم إزاء تلميذ مجانبا للصواب ومع ذلك أصررتم على فعلتكم انتقاما لذاتكم؟ كيف كان إحساسكم فيما بعد؟ حسرة وندامة أم كبرياء وأنفة؟
- في بداية الأمر، كنت أستاذا تنقصه الخبرة والحنْكَة في التعامل مع التلاميذ، تغلب عليَّ طباع الغضب والانتصار للنفس، مع سرعة تأثر وانفعال واضحين، لا أقبل أن يعلو صوت على صوتي، والتلاميذ مراهقون مطبوعون بطباع التوثب والرعونة والطيش، فكنت أقابلهم بالشدة والحزم، وربما بالغت أحيانا وغاليت، وكثيرا ما استشعرت الندم وتحسرت على كلمة لفظتها أو فعل فعلته، ظهر لي فيما بعد أني كنت أجانب الصواب وأخدش في صورة المدرس الجليلة. طبعا لم يسبق أن اعتذرت علنا لأي تلميذ غير أنني، وقد مكنني منبركم مشكورا، أعتذر الآن لكل من أسأت إليه أو قسوت عليه تلميذا كان أو مدرسا أو إداريا أو حارس أمن مؤسسة…
- هل سبق لكم أن أهنتم تلميذا على مرأى من زملائه أو حرمته من الحصة من غير موجب حقيقي، وماذا كان شعوركم إزاء هذه الحالة؟ شفاء غليل أم تأنيب ضمير؟
ـ- علاقة بما سبق وتحت تأثير الضغوطات المتسارعة، قد يضطر الأستاذ أحيانا إلى حرمان تلميذ من حصة دراسية، ويوجهه إلى الإدارة، لكن ليس من التربية مطلقا أن يهين تلميذا أو يزدريه، سواء منفردا أو أمام زمرة مجتمع القسم الدراسي. فلئن صدر ذلك من مدرس فقد وجب نهج أسلوب مراجعات يتجدد مع الأيام والسنوات على نحو يحقق للتلميذ ذاتيته ويحترمه ككيان واع ومدرك، ومنفعل.
- ما رأيكم فيمن يعرض تلميذا على المجلس الانضباطي للمؤسسة التربوية بناء على مخالفة معينة أو من غير مخالفة حقيقية؟ أليست المقاربة التربوية كافية بدل الزجر والعقاب وفق القوانين الانضباطية؟
- ليس من الحلم ولا من الحكمة عرض تلميذ على المجلس الانضباطي للبث في مخالفة اقترفها، فالوقوف أمام أعضاء المجلس رهيب ومفزع، وقد سبق لي أن عرضت عليه، الموقف يذكر التلميذ بالمحاكمات التي تعقد للنظر في الجنح والجنايات…فمن الأنسب إيجاد حلول داخل القسم دون اللجوء للإدارة أو كتابة التقارير الانضباطية. أنا أومن بفكرة التعاون في إطار تعدد المهام واختلافها، فالإدارة التربوية الحالية لا تنقضي مشاكلها اليومية، وعلاقتها مع المؤسسات المحلية والمجتمع متشابكة، لا تبقي لها وقتا ولا جهدا، أعرف حالات تم عرضها على المجالس التأديبية وصدر في حقها قرار الفصل، طبعا ممن كانو من جيلي، أثق كثيرا في قدرة الطاقم التربوي (المجلس التربوي مثلا) على تأطير التلاميذ والتأثير فيهم، وثنيهم عن كثير من أفعال السوء، لذلك فإن المقاربة التربوية تبقى أنجع وسيلة لتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، كما يقول ابن مسكويه. والحالات الشادة من سلوكات المتعلمين لا تخلو منها مؤسسة تربوية، فمعها نكون ملزمين باعتماد المساطر الانضباطية تحقيقا للمصلحة العامة لأبنائنا.
- هل تؤمنون بثقافة الاعتذار في السياق التربوي؟ بمعنى هل ترون تراجع الأستاذ أمام الملإ عن خطئه وتقديم الاعتذار لتلميذه فضيلة أم منقصة من شخص الأستاذ؟
- في السنوات الأولى من مساره المهني يجد المدرس حرجا شديدا في التكيف مع الحالات الطارئة، فقد يعتبر الاعتذار ضعفا وعجزا ومنقصة كما قلتم، أما حين تنضج التجربة فالتصور يتغير لا محالة ويصبح الاعتذار العلني من مفاتيح النجاح ومن السمات البيداغوجية المفصلية في شخص المدرس، وعلامة من علامات القيادة والقوة المتبصرة، إن الاعتذار أمام جمهور القسم أسلوب ناجع في حمل التلاميذ على التنشئة الاجتماعية السليمة، وعلى القيم العليا والمرجعية.
وبدوره يتعين على الأستاذ أن يقبل اعتذار تلاميذه ويتغاضى عن هفواتهم الصغرى، ويكتفي بالتنبيه الإشاري إليها ويتجنب الفضح المخزي، وذلك أسلوب بليغ بالتربية بالقدوة وتكريم النموذج وتقديره، فلا ينبغي أن ينسى المدرس أن تلاميذ القسم ليسوا على مستوى واحد من الجدية والانضباط، والرغبة في التقبل والاستجابة. وحين يغفل المدرس هذه الحقيقة يوشك أن يقع في مزالق مذمومة.
- عندما كنتم تمارسون مهمة التدريس، هل كنتم من الذين يقيمون علاقتهم التواصلية بمتعلميهم بناء على الثقة المتبادلة، أم أنكم كنتم ترون ذلك أمرا مثاليا قد يؤثر على أداء الواجب المهني، وأن الصرامة والحسم أنجع وسيلة لضبط التواصل مع المراهقين، خاصة منهم الذين ينزعون نحو التفلت وربما التمرد؟
- عادة ما يعتمد المدرسون أول الأمر أسلوب الحزم والصرامة، ربما الصرامة المفرطة، فيرونها من أنفع الوسائل وأنجعها في ضبط تفاعلات جماعة القسم الدراسي، فيتوهم السيد الأستاذ أنها تكفيه شر المشاغب، وتسد أبوابا من الفتن وربما البلايا والمحن، ومع مرور الوقت يدرك بالتجربة أن المبالغة في الصرامة وتصنعها، تكلفه جَهْدا نفسيا، وتحمله مشاقا وحرجا، وتجعل علاقته مع التلاميذ مبنية على الخوف والتهيب ونزع الثقة، لكن ما يلبث أن يكتشف أهمية تغيير نمط المعاملة، فيمزج على الأقل بين اللين والحزم، والتغافل والنباهة، مفضلا الإصغاء للتلميذ، ملتمسا العذر له، طمعا في عودته لرشده والتزامه بميثاق الفصل الدراسي.
- ما رأيكم في لجوء المدرس لإنجاز ساعات تدريسية في المؤسسات الخصوصية؟ بمعنى آخر، هل يؤثر ذلك على مردودية المدرس داخل أقسام التعليم العمومي؟ هل المشكلة تحتاج لتقنين جديد، منضبط، وفعال، أم لا حل يلوح في الأفق مادامت السلطة التربوية المختصة تتعامل مع الموضوع بمنطق اللامبالاة؟
- القانون يسمح للمدرس بإنجاز ساعات تدريسية في مؤسسات التعليم الخصوصي، لكن المشكلة تكمن في أمرين:
أولا: لا يتم الالتزام بالساعات القانونية التي حددها القانون للعمل في القطاع الخاص وهي ثمان ساعات، فكثير من الأساتذة يتجاوزونها، وهذا يؤثر قطعا على مردوديتهم سواء داخل حصص التعليم العمومي أو الخصوصي.
ثانيا: وجب التنسيق بين القطاعين عبر سلطة المديرية الإقليمية لكشف المخالفات القانونية، فليس من مصلحة أبناء المغاربة أن يدرسهم من أنهكه الجهد، واستفرغ طاقته مع فئة من التلاميذ ولم يبق للآخرين إلا التعب والاجترار.
لذا أرى أن الأستاذ إن استطاع أن يلتزم بالقانون المؤطر للعملية، ويكون عادلا في توزيع مجهوده بين القطاعين، منصفا في معاملته بين الفئتين، فلا ضير أن يلجأ لإنجاز سويعات في الخاص. وأما الوزارة فقد تركت الحبل على الغارب في هذا الشأن، ولا تتدخل لضمان التوازن بين الحق والواجب، وعادة ما تتخذ موقع الحياد السلبي إزاء مثل هذه الظواهر.
- كثر الحديث عما يسمى بالنموذج التنموي والنموذج البيداغوجي، فهل الأمر جد وحزم، أم هو شبيه بما سلف من مشاريع الإصلاح الفاشلة التي أهدرت الجهد والمال؟
- المشكلة في نظري ليست في برامج الإصلاح ومشاريعه، فالمطلع على البرامج السابقة وما خصص لها من اعتمادات مالية، يكاد يجزم أن تطبيق نصف ما جاء فيها كفيل بجعل التعليم في بلدنا في مصاف الدول الرائدة، لكن المشكلة تكمن أساسا في تنزيل مشاريع الإصلاح وتطبيقها التطبيق الأمثل، ولعل العامل البشري هو الحاسم في الموضوع. إن برامج الإصلاح تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، وجرأة قوية، مع اعتبار المصلحة الوطنية أولا وأخيرا، وربط العمل بالأجر حقا، لا شعارات للاستهلاك والتعمية، والإصلاح لن يكون بالسياسة التعليمية التبعية، وإنما بالروح الوطنية، التي تعبر عن تطلعات الأسر المغربية في إرساء برامج ومناهج دراسية ذات جدوى، تشبع حاجيات المتعلمين وتتيح لهم إمكانيات التفكير السليم والإبداع المثمر.
المجال الثاني: الامتحانات والتقويم:
- يشاع بين أوساط التلاميذ أن بعض الأساتذة لا يصححون الفروض الكتابية أو يعمدون لتصحيحها دون تدقيق وربما يكتفون بالاطلاع على جزء من الجواب من غير أن يكلفوا أنفسهم عناء الفحص التام لإنتاجات المتعلمين غير أن منهم من يعطيها ما تستحق من الوقت ولو كان ذلك على حساب صحتهم؟ ما الدافع الحقيقي لكل ذلك؟
- لا أقول لك سرا إن أنا أخبرتك بأن تصحيح الفروض الكتابية ومعالجتها عمل مرهِق وشاق، وكذلك بناء أداة التقييم، يتطلب الجهد والدقة والتركيز لتحقيق العدل والإنصاف، قد يجد البعض فيه كلفة ومشقة خاصة مع كثرة الأقسام المسندة، حيث يتطلب الموقف أن يتحول المدرس إلى جهاز أو حاسوب لإنجاز عمليات التصحيح في الوقت المطلوب إداريا، وقد بينت دراسة أنجزها أستاذ للتعليم الثانوي أن كلفة عمليات التقييم البيداغوجي من إعداد الفروض إلى مسك النقط مرورا بالتصحيح والمعالجة والدعم باهظة خاصة على المستوى النفسي والبدني.
ولا شك أن المدرس مطالب أثناء التصحيح باستحضار مجهود التلميذ، والوقت الذي أفناه في الإعداد، وما غشيه من القلق والفزع قبل وأثناء الفرض وفي انتظار النتيجة أيضا، فالتصحيح مسؤولية أدبية كبيرة، تركه جُرم وعيب، وإنجازه بموضوعية إنصاف وإشهاد.
ومن الخطأ والعيب الفظيع ألا ينظم المدرس إنجاز فروض المراقبة المستمرة وفق المذكرات التنظيمية الخاصة، التي تنص على عدد معين وبمواصفات محددة أثبتها الإطار المرجعي المعتمد، ومن العبث ألا يصححها أو لا يُطلع متعلميه عليها ليقفوا على مواطن الخلل والتعثر في إنجازاتهم، قصد معالجتها وتجاوزها وصقل المهارات التي نصت عليها جداول التخصيص في أفق بلورة الكفاية المنهاجية والتحكم في مقتضياتها.
- هل سبق لكم أن كنتم غير منصفين في منح نقطة بسبب علاقة قرابة أو زمالة أو هوى أو مزاجية؟ هل ندمتم على ما كان منكم أم اعتبرتم ذلك مجرد خطأ مهني لا مفر منه؟
_ لا جدال في أن الأستاذ المتطلع إلى تجويد عمله والارتقاء بأدائه، المستحضر لنبل رسالته، يحرص على احترام المذكرات المنظمة، كما يحرص أشد الحرص على إعداد متعلميه لمواجهة محطات التقييم بجاهزية واقتدار علمي معرفي ونفسي، ومعلوم أن التلاميذ عادة ما يضعون المدرس الديمقراطي/المنصف موضع الثقة والتقدير، ويرسمون له صورة مثالية بين زملائهم، ويغدو عنصر مجديا لإجراء المقارنة بينه وبين أقرانه المدرسين. ومن الصعب جدا المفاضلة بين المتعلمين لاعتبارات غير ذات صلة بتحصيلهم وإنتاجاتهم، فلا شك أن لذلك تداعيات هو في غنى عنها.
- هل ترون في الامتحان الموحد الجهوي أو الوطني محطة استحقاق بيداغوجي وفرصة لاختبار نماء كفايات المتعلمين، أم أنكم تعتبر ذلك مجرد مناسبة لهدر الجهد والمال ولذلك وجب إعادة النظر في موضوع هذه الاستحقاقات بما يعيد لها ثقتها وجاذبيتها المفقودة؟
_ أرى أن المشكلة لا تكمن تحديدا في الامتحانات الموحدة كمكونات للتقويم، فالخبراء وأساتذة البيداغوجيا والدسيمولوجي (علم التقويم) مجمعون على أهميتها ودورها في قياس تطور كفايات المتعلمين، ويحسبونها، أي الامتحانات، فرصة لمعرفة مدى ملاءمة البرامج والمناهج التعليمية لمواصفات المتعلم في مرحلة دراسية محددة، ووسيلة من أهم الوسائل التي تساعد على الحكم على المنهاج الدراسي وتحديد نقط القوة فيه والضعف، خاصة إذا تم استثمار نتائجها بطريقة علمية جيدة، لكن المشكلة تكمن في طريقة التنزيل والإجراء، رغم الترسانة القانونية الغنية التي تؤطر مثل الامتحان الوطني والامتحانات الجهوية. لقد أصبح هاجس الجهات المعنية بالنتائج هو الرفع من نسبة معدلات النجاح، أو ما يسمى بالمردودية الداخلية للمؤسسة التربوية، لا الرفع من مستوى كفايات التلميذ، والبحث عن الأرقام، لا البحث عن الجودة، لذا وجب إعادة النظر في الأمر على مستوى التنزيل والأجرأة لخلق مناخ امتحانات نزيهة ومسؤولة، توفر شروط إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة أبناء الشعب المغربي المتبارين، ومن أجل ذلك لزم مشاورة أهل الاختصاص، للخروج بطريقة مثلى لإجراء الامتحانات الموحدة على النحو الذي يراهن على الجودة المنشودة، والإنصاف المطلوب، والجزاءات المناسبة. فلا معنى إطلاقا أن تعيش المؤسسة التربوية تحت هواجس لجان الافتحاص، أو التتبع والمواكبة كلما تدنت نتائجها، من غير أن يتم دراسة حقيقة تلك النتائج والعوامل الموضوعية التي أفرزتها.
- ما موقفكم من ظاهرة الغش في الامتحانات؟ وماهي أسبابها الحقيقية؟ وكيف يمكن محاصرة الظاهرة / الآفة؟ ومن المسؤول عنها؟
-الغش ظاهرة/آفة اجتماعية وسلوك منحرف، أعتبره مثل مشكل تهريب المواد الفاسدة والمحظورات، وقد انتشر في محيطنا انتشارا رهيبا، ولم يعد الناس يهابون اقتحامه، بل تحول إلى ما يشبه الذنب الصغير الذي لا يكاد يلتفت إليه صاحبه، بل الأدهى والأمر كما يحدثني بعض أصدقائي الأساتذة، فإن التلاميذ أضحوا يعتبرونه حقا ومكتسبا، ويرى بعض الآباء أن الغش في الامتحان من غير أن يضبط الغاش مؤشر ذكاء ودهاء، وطبعا التلميذ ابن بيئته ومجتمعه يتأثر بما يرى ويسمع، ومن المؤسف أن نعتبر الغش أمارة على نباهة المتبارين، و دليلا على طيبوبة الأساتذة المكلفين بالإجراء(الحراسة). لقد أصبح الغش في الامتحانات كلها أمرا معتادا، وفي جميع مستويات الأسلاك التعليمية من غير استثناء يذكر، والأستاذ المكلف بالإجراء (الحراسة) يجد حرجا شديدا وهو يؤدي مهمته، قد يتعرض للإيذاء وفي أدنى الحالات للوم والعتاب وربما السب والشتم، وأذكر أن إحدى الأمهات قالت لنا على باب المؤسسة بينما كنا خارجين منها: آه! ما في قلبكم رحمة؟
فالغش معضلة مجتمع متخلف، يعاني من ضمور القيم العليا النبيلة، وأعتبر أننا كلنا مسؤولون عنه مع تفاوت بين مواقع المسؤولية. وقد زادت وسائل الإعلام وتقنياته الحديثة الطين بلة، ويسرت مهمة الغاش، وجعلت المواجهة مع هذه الآفة شرسة وخطيرة. ولا سبيل للخروج من النفق المظلم سوى عبر نهج تنشئة اجتماعية داخل المؤسسات التربوية، تنهل من قيم الحياء، والوفاء، والمسؤولية، والصدق، مع حزم وصرامة في تفعيل القوانين الداخلية للمؤسسات، وكذا المساطر المنظمة للامتحانات. في مقابل ذلك على السلطة التربوية المعنية أن توفر للتلاميذ شروط تمدرس سليم، ومؤسسة تربوية ذات جاذبية فعلية.
- كيف تنظرون لمهمة الأستاذ وهو يزاول “حراسة ” الامتحان؟ هل يجب أن يكون صارما أم مرنا أم يتصرف بحسب الوضع الذي يفرضه المترشحون داخل قاعة الامتحان؟
- لقد غدت حراسة الامتحانات كما أشرت سابقا هاجسا مرعبا، يحسب له الأساتذة ألف حساب، فمنهم من يفضل أن يكون صارما حازما بلا هوادة، ومنهم المرن اللين في صلابة، الذي يؤدي عمله ولا يستفز الممتحن بتصرفاته وأقواله، ومنهم من يسهل المأمورية على الممتحنين، وينسى أنه يجعلها عسيرة على من بعده من أقرانه الأساتذة. والعبارة التي تناسب الحديث عن الامتحانات هي أنه غدا ” شر غائب ينتظر”
فالحراسة، مسؤولية جسيمة والتزام ذو شأن، هي بمثابة الوقوف على ثغر عظيم من ثغور الوطن، ولا شك أن ترك الحبل على الغارب، وسياسة غض الطرف مفسدة عظيمة، يعود ضررها على النظام التعليمي برمته خاصة، وعلى الأمة عامة. فالتعايش مع الغش عبث ينسف مسلسل جهود أعمال شاقة نذكر منها على وجه التحديد اقتراحات السادة الأساتذة للمواضيع ثم أشغال اللجان الإقليمية (امتحان الشهادة الابتدائية) واللجان الجهوية التخصصي (امتحان شهادة التعليم الإعدادي وامتحان السنة الأولى من البكالوريا) وكذلك اللجان المركزية التخصصية (المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه)، فعلى أجهزة الدولة أن تعين رجال التربية والتعليم على أداء واجبهم الرسالي، فتوفر لهم الحماية، ووسائل المراقبة الحديثة، مثل: الكاميرات، وأجهزة كشف الاتصال، وغير ذلك.
- وهل تؤمنون بأن تجهيز القاعات بكاميرات المراقبة خلال أيام الامتحانات إجراء يكفي لتجاوز آفة الغش أو على الأقل هو إجراء كفيل بالحد من الظاهرة المزعجة؟
- نعم كما ذكرت لكم آنفا، لقد أصبح من أوجب الواجبات تزويد القاعات بكاميرات المراقبة، وبكل الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تعين الأستاذ على أداء مهمته على أكمل وجه، وتساعده على ضبط المترشحين، وتأمين زمن اجتياز الامتحانات، أسوة ببعض مؤسساتنا الجامعية وببعض الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا الباب. حقيقة أن الأمر له كلفة مادية كبيرة، لكن نفعه لا يقارن بمخاطر ظاهرة الغش التي اعتبرناها آفة اجتماعية لا تقل خطورة عن فيروس كورونا، الذي تصدت له الدولة بحزم بالغ وبكل أطقمها وكلف الميزانية العامة للدولة ما الله به عليم.
- ألا يمكن أن يكون المدرس نفسه أهم أسباب التعثر الدراسي لدى المتعلمين، وأن يكون أيضا أشد تأثيرا من عوامل الوسط الأسري وطبيعة المنهاج الدراسي…؟
- الدراسات الحديثة المرتبطة بمجال تشخيص التعثرات، والإخفاق الدراسي، عادة ما ترجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة وهي: العوامل الذاتية المتعلقة بالتلميذ، من حيث تاريخ تعلماته، وأسلوبه في كسب التعلم والمعرفة، ثم عامل الوسط الأسري والمحيط السوسيوـ ثقافي الذي ينتمي إليه التلميذ، إذ لاشك أنه يؤثر ويبصم موقف المتعلمين من حيث الحوافز أو العوائق والإكراهات، وأيضا طبيعة الفعل الديداكتيكي الذي يمارسه المدرس، فلكل مدرس ما يطبع ممارسته من سمات الجد أو المرونة، والعمق أو البساطة، والوعي برسالته أو الإعراض عنها… ولا ننسى أيضا العامل المرتبط بطبيعة المنهاج الدراسي المعتمد، فقد يستجيب لشروط بناء المناهج الدراسية الحديثة، وقد يخل بجوانب منها، فيفقد الجاذبية المطلوبة وينسف المعنى والقصد. وفي كثير من الأحوال فإن التعثر الدراسي أو التفوق يرتبط بمجموع العوامل التي ذكرناها مجتمعة من حيث وجودها أو افتقادها.
إن نجاح المتعلم تصنعه جملة عوامل، المدرس جزء واحد منها، ونسبة هذا الفضل له وحده، فيه حيف وظلم لباقي المشاركين في هذا التفوق، وأخيرا لا ننسى دور الإدارة التربوية في المراقبة والتوجيه، وخلق مناخ التنافس البيداغوجي السليم داخل فضاءات المؤسسة، حيث ينبغي أن تكون مفعمة بالحياة، وتنبض بالرغبة في التحصيل المعرفي والتنافس الشريف.
- ما هو المبدأ الأكثر تعرضا للتعسف خلال الامتحانات: تكافؤ الفرص، النزاهة، الكرامة…؟
- هذه المبادئ أو القيم المدرسية نسمع بها ولا نراها إلا قليلا، فكم من حق ضاع تحت مسمى تكافؤ الفرص، أو تحقيق النزاهة أو المطالبة بالكرامة. هي مبادئ/شعارات كل واحد يفهمها بفهمه، ويؤولها كما يحلو له ، ومن أغرب ما سمعته أن أحد المكلفين بالإجراء(الحراسة) طالب زميله بأن يسمح للممتحنين بالغش تحت مبرر، تكافؤ الفرص: ” الكل يغش، فلِمَ نمنع هؤلاء من الغش”، وطبعا الوزارة رائدة في صناعة الشعارات، تجعل لكل موسم دراسي شعاره الخاص: (من أجل نهضة تربوية لتحسين جودة التعليم…) ويبقى الشعار حلم يقظة حتى إشعار آخر، فالأمر يحتاج إلى وقفة تأمل، وإلى مشاركة جماعية من مختلف المتدخلين في العملية التعليمية، لتحديد المفاهيم والمسؤوليات، وتوفير الظروف المناسبة لتمرير الامتحانات، والوقوف سدا منيعا في وجه كل المثبطين، وأصحاب الهمم الدنية، والأفكار الردية.
المجال الثالث: التكوين والتأطير:
- هل ترون أن المدرس في حاجة للمفتش التربوي ولأدواره التأطيرية، والتوجيهية، والتكوينية، والتقويمية، علاقة بمهمته في السهر على تنفيذ المنهاج الدراسي، أم أن وجوده كعدمه، أو أن عدمه خير من وجوده، لأنه غالبا ما يكون أداة ضبط وتحكم، تحد من حرية المدرس وتحجر عليه وتثقل كاهله بالتعليمات “النظرية” و “الشفوية”؟
- مبدئيا الحاجة إلى المفتش التربوي ضرورة لا ينكرها عاقل، ولا يجحدها مدرس مجرب خاصة إن كان ذا تجربة متواضعة أو في بداية مساره المهني، فالمفتش هو الموجه الخبير بدقائق التدريس، والمرشد المتقن لفنونه وأسراره، يختصر الطريق للمدرسين بخبرته ونصائحه، أهّله تكوينه العلمي/ المعرفي ، وتجربته التدريسية، إلى التحكم في ملكات بيداغوجية، ضابطة لعلوم التربية، ينظر بعين الخبير فيبصر ما لا يبصر غيره، أغنى تجربته وعمق رؤيته عبر الاطلاع الواسع على كثير من نماذج السادة الأساتذة وزياراتهم في فصولهم الدراسية، ليدرك مكامن النقص ويقومها، لا غنى عنه، فخبرته مرجعية تعتمد عند كثير من الوضعيات البيداغوجية، وإليه مفزع الأساتذة في الأمور الديداكتيكية، لكن بعض السادة الأساتذة قد لا يرى هذا الرأي، ويقول غير هذا القول، فالمفتش عندهم سلطة إدارية، وحالة نرجسية أكثر مما هي فكرة تأطيرية، كثير الشروط والملاحظات… همه الشكليات، ومراقبة الأوراق والجذاذات، فلا يرى بعض المدرسين في وجوده فائدة، ويتناقلون هذا القول بينهم همسا وجهرا. وأنا أميل إلى تشبيه دور المفتش بدور مدرب فن رياضة من الرياضات (كرة القدم مثلا)، ولا شك أن هذا التشبيه سيساعد على المقارنة وعلى إثبات أهمية دور المفتش. فكما لا يستطيع أحد أن ينكر دور المدرب فكذلك الشأن بالنسبة للمفتش التربوي.
- هل تؤمنون بجدوى عقد الندوات التربوية وتنظيم الدروس التطبيقية التي تدعون إليها؟ وهل ترونها مناسبة للاستفادة وتبادل الخبرات بين أجيال المدرسين، أم أنها مجرد مضيعة للوقت، وأن المجهودات الذاتية التي يبذلها المدرس في القسم كافية لإغنائه عن مثل هذه اللقاءات؟
- قد يظن البعض أنه أصبح مستغنيا عن غيره، فقد اكتسب خبرة عميقة تجعله مكتفيا بما عنده، ولا فائدة تذكر من حضور الندوات التربوية والدروس التطبيقية مثلا، فهي مضيعة للوقت والجهد، وحضوره في قاعة الدرس أفضل له من حضور مثل هذه اللقاءات، فتراه يتعلل ويبدي الأعذار ليتخلف عن الحضور، والصواب أن نفع هذه اللقاءات كبير، وخيرها عظيم، فالندوات التربوية هي ملتقى الأساتذة ومجمع تقاسم خبراتهم؛ فيها تناقش “النوازل” البيداغوجية وبعض الوضعيات المهنية ذوات الصلة بالممارسة التدريسية، أو التقويمية، أو التواصلية التفاعلية. إنها فرصة لتوحيد الرؤى والتفكير الجماعي في مداخل تطوير مهارات المدرسين، لتنزيل مفردات المنهاج تنزيلا سليما، فالمفتش في حقيقة الأمر هو الوجه الخلفي للمدرس، منه يستمد مادته التأطيرية، وإليها يعيدها بحسب الحاجة والاقتضاء. وتشكل الدروس التطبيقية التي ينظمها السادة المفتشون لفائدة المدرسين مناسبة لإبراز كيفية تنزيل النظريات والتعليمات التخصصية على أرض الواقع، يحصل فيها من النفع الشيء الكثير، ويمكن اعتبارها مرآة للحقيقة التي يطمح إليها كل أستاذ، فمنجز الدرس يستفيد من ملاحظات زملائه، والأساتذة الحضور يلاحظون ما تميز به صاحبهم عنهم فيحاولون إدراكه.
وأما التغيب عن الحضور، وهو نادر، فلا يعدو في كثير من الحالات أن يكون سوى أمرا يعزى لطارئ صرف المدرس عن الحضور، وقد يكون أيضا موقفا يرى أن لا فائدة من اللقاء، وفي هذه الحالة نكون أمام نرجسية مفرطة، لا ترى فائدة ترجى حتى من الزملاء الأساتذة.
- هل هناك فائدة ترجى من التكوينات ذات الصلة بعلوم التربية، ومواضيعها المعتادة حول المقاربات، والنظريات، والبيداغوجيات، والمرجعيات التأطيرية…أم أن التحكم النظري في المعارف لا صلة له بالميدان وبقاعة الدرس حيث يسود منطق آخر مغاير تماما؟
- نسمع قول بعض الأساتذة: هناك فرق كبير بين نظريات التعلم التي تدارسوها في مراكز مهن التربية التكوين، والواقع الميداني، وكون قاعة الدرس يحكمها منطق براغماتي آخر، لا دخل فيه للنظريات والبيداغوجيات والمقاربات، وبعض المعتدلين منهم يقول: هذه النظريات قد تصلح لبعض المؤسسات دون غيرها، فالمؤسسات الواقعة في أحياء هامشية وشعبية، أو تستقطب نوعية معينة من التلاميذ، تساس بأساليب أخرى، وطرائق مغايرة لم يتم الكشف عنها في مراكز التكوين، وإنما الممارسة والتجريب هي التي تحتم انتقاء المقاربة المناسبة وملاءمتها مع الحالة .
والصواب في نظري، أن التكوين العلمي المكين، والتحكم الفعلي في المعارف، والاطلاع الواعي على فنون التدريس، وطرائقه، ومناهجه، ونظريات التعلم، تساعد حقا المدرس على تجويد عمله، وخلق جسور تفاعلية مع تلامذته، والرقي بهم إلى المستوى المنشود، والواقع يشهد على نماذج ناجحة لمدرسين وفقوا في تنزيل جوانب مقتضيات بعض النظريات والبيداغوجيات على أرض الواقع، مع أقسام من التلاميذ يقول عنهم غيرهم من الأساتذة: أنهم تلامذة يساسون قهرا ويدرسون قسرا.
- هل أنتم مع الفكرة التي تدعو إلى ربط الترقية بالأداء المهني، أم أن ذلك لن يجدي في منظومة أصلا تعتريها اختلالات، ويصعب معها إنصاف من يستحق الإنصاف والمكافأة؟
- ربط الترقية بالأداء المهني، نهج يتوخى العدل ويسعى إلى الحفز، بحيث أن الربط موضوع حديثنا يجعل المدرس يفكر في الإبداع والتميز، ويطور مستوى أدائه ويصقل مهاراته المهنية، ويبحث عن حلول عملية لمشاكل التعلم والتعليم، وما من شك فإن تطبيق الشعارات أو الآمال، يحتاج إلى وضع نظام تعليمي أساسي منصف، يحدد فيه مفهوم الأداء المهني وحقيقته، ومعايير الأداء الجيد، ومقاييس التباين في الأداء، وعلامات التميز بين المدرسين، ثم إجراء تقويم دقيق عادل ومنصف. مع هذا لا بد أن نشير إلى أن مكانة المدرس الاعتبارية آخذة في التراجع ومكانته في السلم الاجتماعي تتدنى، كل ذلك بفعل محاولات يائسة تسعى لتبخيس دوره الريادي والحيلولة دون قيامه بالواجب المهني وإشغاله بالتضييق على حقوقه المادية باعتباره موظفا.
- هل أنتم مع فكرة توحيد المسار المهني لرجال ونساء التربية والتعليم؟ أم ترون ذلك حيفا يسوي بين فئات مهنية تتفاوت من حيث الجهد المطلوب والطموح المستشرف.
- العبرة بالمجهود والعمل، ثم الأثر والوقع، لا بغيرها من الشكليات الجوفاء، ومع ذلك، فإن توحيد المسار المهني لرجال التعليم أضحى أمرا ضروريا ويكتسي طابعا استراتيجيا، إذ لا فرق، في جوهر المهمة ، بين مدرس سلك الابتدائي أو الثانوي، إلا بمعيار الأداء والإبداع والتميز. أُومن بفكرة وحدة المهام وتعدد الأدوار، والمسميات في كثير من الأحيان تخدع وتخفي الحقيقة المرة، وكما يقول المثال الفرنسي: “ما يلمع ليس دوما ذهبا”.
- كيف تنظرون الى الوثائق التربوية المطلوب الإدلاء بها للجهات المعنية؟ هل تساهم فعلا في ضبط مسارات الإنجاز وتنظمها، أم أنها عبء لا جدوى منه وإنما يراد منها التضييق على المدرس وشغله عما هو أهم وأنفع؟
- من المؤكد أن عدة التخطيط من الوثائق التربوية، ضرورة تدبيرية لا يجوز أن يهملها الأستاذ، فهي علامة دالة على اهتمامه، ووسيلة مساعدة على تجويد عمله، من خلال ضبط مسارات الفعل التعليمي، لكن البعض قد يراها عبئا يجب التخلص منه، فتراه يسارع إلى مواقع الأنترنت ليستنسخ منها، ويقتطع جزءا من جذاذة هنا، وجزءا من جذاذة هناك، فتختفي روح الإبداع وتطمس لمسة الأستاذ، وقس على ذلك عمله في إعداد باقي الوثائق الأخرى. شخصيا يظهر لي أن الإعداد المادي للوثائق التربوية والإدلاء بها للجهة المعنية ليس شرطا في إنجاح الدرس بالتحديد، ولكن بالمقابل نجد أن التعثر في التنفيذ قد يكون مرده وفي كثير من الحالات إلى سوء الإعداد، والاستعداد المعنوي، خاصة مع فئات المدرسين الشباب من ذوي التجارب الناشئة.
- هل تكوين المدرسين العلمي والبيداغوجي كاف لأداء مهامهم على الوجه المطلوب أم ترون لزوم استدراك ما قد يكون فاتهم من التكوين الأساس والمستمر؟
- سقف طلب العلم والمعرفة، لا ينبغي أن يكون واطئا، وتطوير الذات بالتكوين المستمر من أسباب التفوق والتميز المهني، ومتى توقف المدرس عن الطموح العلمي، واكتفى بما عنده، وظن أنه حصل ما يغنيه عن الاستزادة، كان ذلك إيذانا ببداية انتكاسته ونكوصه، وتنكبا عن النهج السليم في تربية الأجيال وتنشئتها التنشئة الاجتماعية المثلى. لقد قيل: “حدود عالمي، هي حدود علمي”، خاصة في مجال التربية والتعليم، فمن دواعي التمدرس أن نتعلم لنعرف، ونتعلم لنعمل، ونتعلم لنكون…وتجويد نظام الحياة رهين بالطفرة العلمية والمعرفية التي تخلق التحولات الحضارية الكبرى.
- هل تؤمنون برسالية التربية والتعليم، أم ترون أن التعليم مهنة ووظيفة كباقي الوظائف تضبطها التشريعات والقوانين؟
- طبعا أومن برسالة التربية والتعليم إيمانا صادقا، لأنها مهنة مقدسة بمعنى نبيلة، حازت شرف القصد والوسيلة، وهي كذلك في كثير من الدول كما كانت في كثير من الحضارات. والمدرس من ورثة التركة النبوية، ومن رواد الإصلاح والتغيير الحضاري، ومدار صلاح المجتمع على التربية والتعليم وصناعة الأجيال.
لقد قيل في البدء كانت الكلمة، ولكن ستبقى ولن ينتهي دورها الخالد والحاسم مهما بدت بسيطة، فهي المادة والسلاح الذي ظل المدرسون عبر التاريخ يتأبطونه كل يوم بإصرار وعناد، ويسعون لتطوير السلاح ذاته بأنفسهم، ليقاتلوا داخل فصولهم الدراسية مظاهر اليأس، والعزوف العلمي، وفقدان الثقة، والإحباط الذي كاد يقضي على تطلعات وآمال فلذات أكبادنا. فالكلمة “سر الأسرار” و”مفتاح الوصول” و”المنقذ من الضلال”، يصوغها المدرسون بدمائهم، وعرقهم، وخيالهم، ليوطنوها واضحة راسخة في نفوس أبنائنا ووجدانهم، أملا في أن يتسلم هؤلاء مشعل التنوير، والتغيير المنشود.
- كيف ترون النزعة التي تظن أن لا جدوى من التضحية في إطار منظومة تحتضر ولا يريد لها أصحاب القرار السياسي أن تتطور؟
- من المفيد جدا هنا أن نذكر بحديث “الفسيلة”، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ” إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها”، ومثله حديث “السفينة” المشهور. إن المهمة الأساس لهذه الفئة من الموظفين هي: “الرسالية” بأبعادها الحضارية، ومضامينها التربوية، والتي تنطلق مدوية من بين جدران الفصل الدراسي، هذا المصنع الآدمي الصغير والحاسم، مادته الدرس التاريخي، والمعلومة الشرعية، وتحليل النص الأدبي، وأطروحات الفلسفة المعاصرة، ومباحث الحقيقة، والدولة، والسلطة السياسية، والدرس اللغوي، والبلاغي العربي…
إن أداء الرسالة، وتبليغ الأمانة وإكساب أبنائنا الكفايات الأساسية ذات الصلة بملمح تخرجهم، وذلك من خلال الفصل الدراسي، لهي أولى رافعات التنمية، وأقواها على الإطلاق، وإن لم يتيسر لكثير من المسؤولين إدراك هذا البعد التنموي لحد الآن. أقصد الإدراك الفعلي والعملي.
فمع ما يواجهه المدرسون داخل المؤسسات التربوية، من ضغوطات الإيقاعات الزمنية المتسارعة، وإكراهات أخرى، إما بسبب ضيق بنيات الاستقبال، أو عقم المناهج والبرامج، أو متاهات المقررات التنظيمية للقطاع، أو بساطة العدة البيداغوجية، وآليات الاشتغال والتنفيذ، أو نقص في التأطير البيداغوجي، أو صعوبات الوضع المادي… فضلا عن ثقافة مجتمع باتت عند البعض تتبلور في اتجاه التشكيك في رساليته، مع جهل البعض منهم بالعمق الرسالي والحضاري لمهامهم، أضحى رجل التعليم كالقابض على الجمر، إن لم يكن كذلك حقا.
- بعض المؤسسات العالمية في مجال تقييم جودة التعلمات، مثل: وكالة EQAA أو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أو برامج PIZA…ترتب المغرب وتصنفه في ذيل القائمة فهل في ذلك تحامل، أم هو ترتيب مستحق وفق معايير علمية ودولية تعكس بؤس المنظومة واختلالاتها؟
تأخر التعليم في البلاد وافتقاده للجودة، أصبح من المسلمات، والدولة معترفة بهذا التأخر، مقرة به، وما كثرة القوانين، والرؤى الاستراتيجية، والمخططات والبرامج الإصلاحية الاستعجالية وغيرها إلا دليل على ذلك، والمتابع للمشهد التربوي في بلادنا، يعرف أن الدولة أنفقت في السنوات الأخيرة أموالا طائلة من أجل إصلاح القطاع التربوي، والوصول للجودة المنشودة، ولكن عجلة الإصلاح بطيئة ودورانها متثاقل، وأسباب هذا الفشل كثيرة ومتداخلة، وأضحت معلومة، وأشهر من نار على علم. طبعا لم تجْدِ في الإصلاح المساحيق، ولا تغطية الشمس بالغربال. حتى أن مؤسسات وطنية كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد حكمت بالفشل على طموحات الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة أداة في النهوض بالقطاع.
المجال الرابع: الإداري والتنظيمي:
- كيف تقيمون عمل من يتغيب عن العمل من غير عذر مقبول، أو يدلي بشهادة طبية من غير وجه حق؟ وما الذي يحمله على ذلك؟ تجنب الاقتطاع أم تفادي أي تأثير على مسار الترقي المهني؟
- قد يضطر الموظف عموما للتغيب، وطبعا المشرع يكفل له حق الغياب وعليه كما تعلمون أن يبرر ذلك بشهادة طبية، أو سبب آخر قانوني ومعتبر، لكن من العاملين في إدارات الوظيفة العمومية من يختلق الأعذار، وقد يدلي بالشواهد في الموضوع لتبرير الغياب عن العمل. ولست هنا مؤهلا للإفتاء في المسألة، لكن أقول: إن قوة المرفق العام، وجودة خدماته، رهينة بأداء موظف عضوي جاد ومنضبط. ولعلكم تعلمون أن الإدارة المغربية على حالتها الراهنة تشكل أحد مداخل عوائق التنمية المستدامة في المغرب، كما جاء في تقارير صادرة عن مؤسسات دولية تعنى بالتنمية الاقتصادية. أما التغيب المتعمد، وهو موجود، فيتنافى وأخلاقيات المهنة ويعتبر هدرا حقيقيا للمال العام وجناية في حق الوطن، وإني لأربأ بالمدرس أن يتغيب من غير عذر حقيقي. ليس بسبب خوف من اقتطاع وإنما مهام التربية تتنافى جوهريا مع ما ليس منها.
- ما الذي يعنيه بالنسبة لكم تأخر المدرس المتكرر عن حضور الحصة في الوقت المحدد؟ هل تلتمسون له أعذارا، أم تعتبر ذلك سلوكا مهنيا غير مقبول يجب أن يواجه بتفعيل المساطر؟
_ التدريس عبادة، والقسم محرابها، والعبادة لها وقت معلوم لا يجوز إخراجها عنه، وإن جاز مرة لعذر مقبول معقول، فالأصل أن تقام في وقتها بلا تأخير، أعتبر المدرس مثالا للانضباط وقدوة لتلامذته في الالتزام، وأول خطوة لإنجاح الدرس وكسب محبة التلاميذ واحترامهم، أن يروه منضبطا في مواعيده، صارما مع نفسه قبل غيره، دائم الحضور المبكر لقاعة الدرس، صاحب همة عالية، متوقد العزيمة، قوي الإرادة، وما دون ذلك لا يليق بالأستاذ الرسالي المتطلع للإصلاح.
- هل من جدوى في الانضباط والنظام باعتبار القانون الداخلي للمؤسسة التربوية، أم ترى ذلك قيدا لحرية المدرس الشخصية؟
- الأسئلة الثلاث الأخيرة مترابطة وذات هدف واحد ، ولذلك دعني أقول لك: عوامل النجاح المهني عديدة، مردها جميعها إلى: الانضباط والنظام والتعاقد المتبصر، والمدرس الناجح هو في المقام الأول إطار تربوي منضبط منتج مبادر، يجوز لغيره أن يتباطأ لكن يُعتبر ذلك في حقه ، بالمعيار الحضاري البناء، أمرا يتنافى ومهمته، لأنه آثر أن يكون قدوة لتلاميذه، ومحط نظر زملائه الأساتذة، وبالتأكيد فإن للانضباط والتزام النظام كلفة مقدرة، غير أنه يختزل جوهر الرسالة التربوية ومقاصدها السامية، وأما من يرى في الانضباط والنظام تقييدا للحرية الشخصية، فلعله أخطأ المسار، أو لم يستوعب بعد حقيقة المهمة الموكلة إليه، ولم يدرك خطورة أن يكون مدرسا على وجه التحديد.
- هل الإدارة التربوية في نظركم أداة تيسير أم أنها تشكل عائقا يحد من فعالية المدرسين ويسعى لضبط تصرفاتهم وتتبع هفواتهم؟
- الأصل في الإدارة أن تكون مساعدة للمدرس، تيسر له الصعاب، وتعينه بما توفر لها من إمكانيات مادية، وبشرية، ومعنوية، على تجويد عمله، فالأطر الإدارية والتربوية غايتهم واحدة، وهدفهم مشترك، غير أن البعض يتوهم أن بين الطاقمين تضاربا واختلافا، حتى ترسخ في ذهن البعض أن الإدارة تحد من فعاليتهم وإبداعاتهم، وتُعاملهم معاملة تراتبية مخزية، قوَّى هذا الوهم سوء تصرف بعض الأطر الإدارية، وعدم انضباط بعض الأطر التربوية. لذلك إن كان بين الطرفين اختلاف فهو مفتعل ويتعين إجراء الحوار بينهما لتذويب الخلافات ولأجل الترقي في مستوى توفير أجواء الاكتساب العلمي، وخلق شروط إبداع المتعلمين وتحقيق تطلعاتهم العلمية في فضاءات الحياة المدرسية.
- هل حقا بإمكان المؤسسة التربوية بما فيها من مجالس ونوادٍ وخلايا وجمعيات شريكة، أن تبني وترسخ قيما نبيلة تؤطر سلوكات المتعلمين وتوجهها، أم هي عاجزة أمام عوامل الميوعة والتشويش الذي يمارس خارج إطار المؤسسة التربوية وتتولاه بعض المنابر الإعلامية التافهة؟
- النوادي في مؤسساتنا التربوية كثيرة، وتوجهاتها عديدة، منها الثقافية، واللغوية، والدينية، والترفيهية، والبيئية، لكن جلها غير مفعل، وإن فُعِّل كان حضور التلاميذ فيها محتشما، ومشاركاتهم محدودة، لذلك يبقى تأثيرها في المحيط المدرسي محصورا على فئة بعينها، ولعزوف التلاميذ عن المشاركة في هذه النوادي أسباب كثيرة، بعضها ذكرتموه في سؤالكم، والبعض الآخر مرده إلى تقاعس كثير من المتدخلين في العملية التربوية عن المشاركة في هذه الأندية، وإنزالها منزلتها الحقيقية، فأصبحت هذه النوادي في كثير من الأحيان جسدا بلا روح، ومسميات بلا نفع، وانصرف المتمدرسون عنها، ولو تأملنا الأمر جيدا لأدركنا أن دور هذه النوادي عظيم، ونفعها جليل، خاصة على مستوى ترسيخ القيم والحفز على التشبع بروح العمل الجماعي التعاوني. ولقد أدركت الوزارة مؤخرا أهمية هذه الفضاءات فوضعت لها تشريعات، ووطنت في جداول حصص السادة الأساتذة ساعات للأنشطة التربوية.
- هل ترون أن المناهج الدراسية للمواد التعليمية منسجمة بحيث تتيح التكوين السليم والمتكامل للمتعلمين، أم أن عناصر التضارب والتضاد واضحة فيها حيث تحتاج إلى إعادة نظر وفق ما يضمن انسجامها وتكاملها؟
- أراد أصحاب القرار والشأن التربوي في بلادنا أن تكون المناهج الدراسية للمواد التعليمية منسجمة متكاملة، تحقيقا لكفايات عرضانية موحدة، فنجد عددا من الدروس المتداخلة المتشابكة بين عدد من المواد خاصة المتآخية منها، والتي تشكل فيما بينها أقطابا معينة، كقطب الإنسانيات، أو قطب اللغات، أو قطب العلوم، أو قطب مواد التفتح، لكن المشكلة تكمن في ضعف التواصل بين أساتذة هذه المواد، فلا تنسيق ولا ترتيب مسبق، و لا تحديد للكفايات العرضانية المشتركة بينها، فأصبحت المواد أو الدروس التي أريد منها الانسجام والتكامل المعرفي أرخبيل زجر منفصلة، قد تأتي بضد المراد أحيانا، فظهرت التناقضات والاختلافات والصراعات ، وكل تخصص يدعي أن الطرف الآخر يتطاول على فنه، والأمثلة لا تعوز القارئ الكريم، والأصل أن يتعالى السادة المدرسون عن كل خلاف يشتت الجهد ويضعف الصف التربوي. فعلينا أن ندرك أن الفعل المبني على أساس تضافر الجهود والانسجام والتكامل مثله مثل الغيث، أينما وقع، نفع.
- ما الذي يمثله الهندام المهني بالنسبة للمؤسسة التربوية؛ شكليات إدارية لا قيمة لها ولا علاقة لها بجوهر العملية أم أن ذلك جزء من عناية المهني بحسن المظهر اللائق بالمؤسسة التربوية؟
- للاعتناء بالمظهر الخارجي دلالة سيميائية بليغة، فلباس المدرس يكتسي بعدا حضاريا، ويبرز الحاجة إلى الانتماء الاجتماعي لفئة من الموظفين، وهو شكل تعبيري فصيح، وجزء من هويته المهنية، فقد يخسر مدرس احترام تلامذته وزملائه بسبب لباسه النشاز، فمظهرك يفصح عن مخبرك، وهو عنوانك الدال عليك قبل أن تتكلم، ووسيلة تعبير عن ذاتك وطبيعة تواصلك، وكاشف لعقلك وانتمائك وتوجهاتك، ويرى علماء النفس أن الداخل يتخارج، بمعنى أن حقيقة الإنسان وجوهره ينكشف ويظهر على شكل ميولات لألبسة معينة، أو ترديد كلام بعينه، أو الإحالة على مرجعية خاصة، فمن الحكمة مراعاة القوانين الداخلية للمؤسسة التربوية، والفقهاء يقولون: العرف محكم، كما أن الأمر بسيط جدا إذ لا يتطلب الأمر في هذا السياق سوى ارتداء وزرة يسيرة هي بمثابة عنوان.
- هل من أمل في إصلاح منظومة التربية والتكوين رغم اختلالاتها العميقة، أم أنكم لا ترجون أملا في الإصلاح باعتبار أن الشأن التعليمي سياسة تبعية رهينة بعوامل خارجية أساسا؟
- أشرنا إلى هذا الجانب سابقا ويمكن أن نقول: إن الإصلاح غاية كل المشتغلين في القطاع وإن بدا الأفق معتما، غير أن فسحة الأمل موجودة وإن كانت ضيقة، حقيقة أن الشأن التعليمي متصل بسياسة تبعية رهينة بعوامل خارجية لا ينفكان عن بعضهما، وأن إصلاح التعليم حتما مرتبط بفك هذا الارتباط التبعي اللئيم، لكن الأمر ليس عذرا يُتعلل به لإبقاء الأمر كما هو عليه، بل نرجو الإصلاح ونعمل من أجل ذلك، ونأمل في معالجة الاختلالات العميقة التي مست المنظومة، وعلى قدر المشقة يكون التوفيق، فنحن مسؤولون عن العمل لا عن النتيجة. ولقد آن الأوان لنهج سياسة وطنية مستقلة، تنشد إقلاعا تربويا حقيقيا، يخرج البلد من ذيل قائمة التنمية البشرية عالميا، إذ نحن مع الأسف خارج قائمة التصنيف ضمن العشر دول الأولى بإفريقيا، أقول بإفريقيا.
- تتردد على مؤسساتنا التربوية خاصة عند بداية ونهاية الموسم الدراسي لجان إقليمية وربما جهوية في إطار مهمات تتبع سير الدراسة ومواكبتها ولا نعرف بالتحديد مخرجات عمل هذه الجهات أو قلْ لا نلمس أثرا لما تنجزه من تقارير، فهل ترون من جدوى في إنجاز تلك التقارير أم أنها كما يشاع “عمل روتيني” هدفه الوحيد هو ” تحرير تقرير”؟
- زيارات اللجان للمؤسسات التعليمية في بداية السنة ونهايتها كثيرة، لكن أثرها قليل جدا، فلا أحد يطلع على تقاريرها ليستفيد منها إلا في القليل النادر، وأحيانا لا يُعرف حقيقة دورها، هل هو المراقبة، أو الإرشاد، أو التأطير، وتظل مهامها لكثير من المتدخلين ضبابية، ونتيجة أعمالها مجهولة، وإن سموها “المواكبة والتتبع” حتى شاع أن عملها “روتيني”، وزياراتها غير ذات أثر يرجى، وهدفها “تحرير تقرير” كما جاء في سؤالك. غير أنها في بعض جوانبها تخلق فرص حقيقية للنقاش والتفكير بصوت مرتفع، حول بعض الإشكالات التدبيرية، والبيداغوجية بين أعضاء اللجنة، وطاقم القيادة الإدارية للمؤسسة التربوية. ويمكن أن نستثني عمل بعض اللجان الإدارية المتعلقة بالإقرار في المنصب الإداري، أو لجان البحث والتقصي…فمهمتها وتقاريرها تنبني عليها قرارات ذات أثر عملي، فلا يجوز أن نبخس الناس أشياءهم، إذ لا يخلو موقع من مواقع كل الإدارة التربوية من غيورين ومخلصين جادين.
- خلف قرار تحديد سن اجتياز مباراة التعليم فيما دون الثلاثين، واشتراط عدم الارتباط بأي علاقة شغل مع أي مؤسسة أو مشغل، فضلا عن اعتماد الانتقاء الأولي، استياء عارما لدى فئات عريضة من الشباب، إذ من شأن القرار أن يقصي أعدادا منهم خاصة حاملي الشهادات الجامعية العليا، ويحرمهم من ولوج سلك الوظيفة في المؤسسات التعليمية، فكيف تقيمون هذا التقنين؟
– الهاجس المتحكم أساسا في اختيارات الوزارة كان هو العامل المادي ذا الصلة بمشكل منظومة التقاعد، فبالتأكيد أن مساهمة من هم دون الثلاثين في صندوق التعاقد، أوفرُ من مساهمة من تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، وأن الحل المناسب لمعضلة الصندوق هو تمديد مدة النشاط ورفع سن التقاعد، إلا أن الجودة أو التحكم الفعلي في الكفايات التدريسية لا يرتبط بالضرورة بعامل السن، لذلك تكون الوزارة قد حجرت وضيقت واسعا، إذ أن توسيع دائرة الاختيار يعطي إمكانيات أوفر لانتقاء متبصر وهادف، خاصة مع استفادة الموظف من التأطير والمواكبة اليقظة، ويتم تقييم أدائه بناء على مقياس المردودية، ولربما عامل السن يؤذن باستكمال التجربة، وامتلاك أهم المهارات الحياتية، وما تقتضيه من رؤية سديدة للذات وللباقي العوالم.
فإن كانت الوزارة صادقة في سعيها لخلق عوامل جذب المتفوقين، والارتقاء بأداء المنظومة التربوية، فعليها أن تعيد النظر في جملة من المداخل الأساسية، التي تخلق أسباب الجذب وتبعد عوامل النفور، ومن ذلك رواتب رجال التعليم وأجورهم، والجانب الاجتماعي لأسرهم وأبنائهم، بما يضمن الإقبال على القطاع، ويخلق التنافس المثمر بين الراغبين في الالتحاق بمهن التربية والتكوين بجميع مسالكها.
- كثر النقاش مؤخرا حول ما عرف بالقانون الإطاررقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وقضية التناوب اللغوي أو الهندسة اللغوية…كيف تقيمون النقاش، وهل هذا القانون فعلا مكسب للمنظومة؟
ـ في جوابي عن سؤالك هذا سأستعين برأي الدكتور عبد العلي الودغيري الأكاديمي والكاتب اللغوي المغربي المعروف، يعتبر اللغوي المغربي عبد العلي الودغيري القانون الإطار “الممسوخ” كما ينعته جناية على الوطن والمواطنين، وخطأ تاريخيا كبيرا، يتعين تصحيحه بالضبط في النقطة المتعلقة بلغات التدريس. ولا يمكن من حيث المبدأ إلا أن نكون مع المدافعين عن الخيار الوطني، وهو خيار التدريس باللغة الوطنية الدستورية، أي العربية والأمازيغية.
فقبل هذا القانونن يرى الودغيري، أننا كنا في وضع مريح نسبيا، إذ كانت العلوم تدرَّس بالعربية وحدها في التعليم العمومي، واللغات الأجنبية تدرَّس بوصفها لغاتٍ أجنبية، وكان المطلب الوحيد هو الانتقال من استعمال العربية في التعليم الثانوي، إلى استعمالها في التعليم العالي والجامعي، لكن القانون الإطار أو “قانون الأضرار” كما يسميه البعض عاد بالسياسة اللغوية خطوات شاسعة إلى الوراء، فضاعت المكتسبات التي تحقّقت للشعب المغربي بفضل نضال طويل، وتجربة دامت أربعين سنة، وهكذا انتقلت السياسة اللغوية، كما يرى الودغيري، من مرحلة القوة، إلى مرحلة الضعف والاستجداء، بعد إقرار العمل بالقانون المذكور.
أما قضية التناوب اللغوي، أو الهندسة اللغوية، فهي كما وصفها اللغوي المذكور ” لعبة ذكية” وقضية ملتبسة، يمكن للطرف الآخر أن يؤولها لصالحه، وهي في أحسن الحالات تضع تدريس بعض المواد بالعربية مجرد خيار، بجانب خيارات أخرى كالتدريس بالفرنسية، أو الإنجليزية، وليست الخيار الوحيد كما كان سابقًا. وهو أيضا لعبة ذكية أو قل ماكرة مكر السياسة في البلدان المتخلفة، ذلك أن المسؤولين على السياسة العمومية راهنوا، أولا وأخيرا، على إقرار القانون بعد أن أثتوه بعناصر الجذب والإغراء الخادع وليس فيه ما يهمهم تنزيله إلا جزئية واحدة (الإزاحة الفورية للعربية لغة التدريس وتثبيت لغة ماكرون) وهذا ما حصل بالتحديد مع القانون الإطار.
هل من خلاصة لمجمل إجاباتكم؟
-كثير من الأسئلة طرحت إشكالات تعيشها المدرسة المغربية حقيقة، وفي كل إشكال تقريبا كان السؤال ذاته يشير إلى ما يمكن أن يعتبر حلا للإشكال أو تنبيها على الحل، بما يعني أن الوعي المهني يتجه حاليا إلى حسن تشخيص الوضع في كثير من القضايا، وأنه في الأفق القريب سيتجاوز عوائق التفكير البيداغوجي السليم، وسيحكم آليات العمل المتبصر المثمر.
-بالنظر إلى مستويات الأسئلة أو التساؤلات ومجالاتها، فإن كثيرا من الإجابات أي الحلول ترتبط بإيمان الفرد (الأستاذ الممارس والإداري المدبر) برسالته المهنية، وبمدى رسوخ يقينه إزاء المرامي والغايات ذات الصلة بفلسفة التربية والتعليم، ومن مقتضيات الإيمان الراسخ أن يضع الممارس صوب عينيك برنامجا للتكوين الذاتي، يرتقي بقدراته المهنية ويعزز تواصله مع المتعلمين، تواصل ينهض على أساس احترام كيان المتعلم وإشباع حاجياته العلمية والمعرفية وحتى العاطفية.
-بعض إشكالات المجال التنظيمي والإداري خصوصا، صعبة المنال، غير أن بعض الجوانب فيها تحتاج إلى صبر وإصرار، إذ الجهاز الإداري كثيرا ما يتفاعل تحت الضغط والاحتجاج، وشيء من نضال ولو قليل.
-إشكالات أخرى ستبقى حلما يراود المدرسين، لأن السياسة التعليمية في المغرب فضلا عن كونها تبعية، فهي مرتجلة، والمسؤولية فيها تكاد تكون منعدمة، لذلك لم ينجح مسلسل برامج الإصلاح. والرهان التنموي لا يتأتى إلا مرورا بمدخل إصلاح ورش منظومة التربية والتعليم.