حول الخطاب التجديدي المعاصر

هوية بريس – هبة النجاعي
“إذا اتبعت الإسلام كما يتحدث عنه أهل الاختصاص في العلوم الإسلامية فلن تخرج من دوامتهم، أنا أتحدث عن جيل جديد حداثيّ في أصله يرمي وراءَه الموروث الذي تسبب في تخلفه، ويعيد النظر في النصوص التي تنادي بالقتل والقطع والرجم وغيرها من الحدود…”.
هذا قول أحد نماذج الفكر الحداثي بالمغرب، المُطالِب بتجديد ما يسمّونه “الموروث الديني”، وسأناقش في هذه السطور بعض أسباب ظهور الدعوات التجديدية السطحية التي تنادي بمثل ما اقتبَستُه الآن، أقول سطحية، وأنا أعني بها خليطا غيرَ متجانس من الثقافات المستوردة المفتقرة إلى التمحيص العلمي والنقد السليم من المؤثرات الذاتية والخارجية.
منذ بدايات القرن العشرين، ظهرت بشكل واضح دعوات التجديد الحداثي للتراث، وكانت استمداداته عائدة في مجملها إلى نقل المجهودات الاستشراقية وإعادة صياغتها بحيث تُضخّم وتُقدّم في قالب مستساغ للنفَس العلماني/الليبرالي الذي بدأ يُعرض كنموذج حضاري بديل لما تمرّ به الأوطان العربية -الإسلامية خصوصا- من انحطاط في ذلك الوقت، أو ما يُعبّر عنه بسؤال النهضة.
وفي ظل تنامي التقنية بمجال الإعلام، تسنّى لتلك الدعواتِ الظّهورُ علَنا بشكل متدرج، ركّز فيه على تنميق الأسلوب ليصل إلى شرائح معيّنة تتأثر بظاهر الخطاب على حساب مضمونه، وبما أن الوعي والدراسة الدينية بدآ يضمحلان بشكل طردي مع نموّ النماذج التغريبيّة، فقد كان (تأنيث الخطاب) الحداثي أو غيره في المجتمع سببًا في استمالة تلك الفئات. “نحن نحمل الفكرة ولا نحمل السيف، ننادي بالتسامح مع جميع المعتقدات في العالم، وإن الحوار هو الحل الأمثل والوحيد لتحضّر المجتمع.”
كثير من هذه العبارات ومثيلاتها غالبا ما تكون خطابات من طرف واحد، يلقي أحدهم الكلام كأنه يردّ فكرة معينة، وعند التدقيق تجد أنه كلام استعراضي لاستمالة “الآخر”، دون أن يكلف نفسه دراسة الجوانب/الرؤية الكاملة للدعوى التي يرفضها، وبالتالي عدم إظهارها أصلا. فعلى سبيل المثال، يستند بعض التنويريين الحداثيين على اقتطاع الأحاديث التي تتحدث عن الحدود الشرعية باقتطاع تام لها من المنظومة السياسية التشريعية، فيزعم أنه في ظل الدولة الحديثة تظل تظيمات مثل داعش تطبيقا فعليًا للشريعة، بينما لو كلّف نفسه دراسة بسيطة لفقه السياسة الشرعية لوجد أن داعش منظمة مارقة عن الدين الإسلامي منقطعة الصلة به حتى لو زعمته شعارها.
وهنا نستطيع أن نلمح بوضوح كيف يمكن لتأنيث الخطاب أن يجعل من كل التفسيرات التأصيلية العلمية محلّ تهمة، ذلك أنها موصومة بعار التطرف لمجرد أنها تتبع ما يسمّونه -تنفيرًا- الموروث الديني، وربطه حصرا بالتصرفات المتطرفة التي تجد المسلمين أنفسهم يستنكرونها.
لا يتوقف الأمر عند ذلك، فالهالات الإعلامية يكفيها الزمن لتبديدها وبيان عوارها، غير أنه لبيان العمق المزعوم، يتم ربط الإسلام بشكل مباشر أو غير مباشر بالمسيحية، حيث يسقطون الثورة العلمية على الكنيسة بكل تفاصيلها ومخلفاتها على مجتمعات مختلفة تمام الاختلاف سواء في ثقافتها أو مرجعيتها الدينية. ولعل من أبرز الأسباب المؤدية إلى هذا الفعل، ما حدث بعد زلزال لشبونة [فترة عصر الأنوار] حيث تزعزع الإيمان المسيحي لما خلفته تلك الكارثة الطبيعية من أضرار مادية. ولغرض تعميم المنهج الغربي على الشريعة الإسلامية، لا يكف أحدهم عن الاستشهاد بـ(الموروث الفلسفي الغربي)، تحديدا أقوال رموز الفلسفة من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر ونحوهم، في مفارقة عجيبة تتنافى مع دعوات القراءة التجديدية الرصينة، فينقلون الإنسان المحافظ المسلم -كما قال الأستاذ إبراهيم السكران- من القراءة في (الموروث) الإسلامي، إلى القراءة في (الموروث) الغربي،
وهذه نتيجة غريبة حقا تدلّ على أن جزءًا كبيرا من الدوافع راجعٌ للغلوّ في الانبهار بالغرب، والذي يقابله من وجه مُغالٍ آخر: إنكار تام لأي حسنة تؤخذ منهم.
في نفس السياق، قال عصيد، أحد الحداثيين المغاربة، ما معناه أن الإسلام في حقيقته دين سمح، لكن البعض يستمر في تشويهه، (وهذا صواب)، ثم اقترَح: “إذن، علينا غربلة القرآن من أي نصوص تدعو للإرهاب، لأنها كانت صالحة لزمن ما، ولم تعد صالحة لزمن التحضر هذا.. إننا نقدّس اليوم نصوصا لا أفكارا.”
لاحظ كيف يمزج مقدمة صحيحة بنتيجة لا علاقة لها بها.
لن أناقش هنا الرد على هذه النتيجة الاختزالية، لكني أود الإشارة -مرة أخرى- إلى العرض الإعلامي للفكرة، فقائل هذا الكلام لم يكن في مناقشة مع صاحب رأي يخالفه، واستضافه ملحد في الحوار، وكما يقول المثل المغربيّ: (طنجرة وجدت غطاءَها)!
يُعرض هذا (الفكر) أمام جمهور أغلبه محافظ، معرفته الدينية لا تتجاوز مقرر التربية الإسلامية في الثانوية.
يقول الدكتور البشير المراكشي: “مضى الزمن الذي كان فيه صراعُ الأفكارِ مُجرّدا إلى حدٍّ بعيد من أسلوب الخطاب.”
كانت الأفكار سابقا تُواجَه بالأفكار، واليوم صارت المواجهةُ بين أفكارٍ بِخطاب، وأفكار أخرى بخطاب آخر، فإن استوى الأسلوبان يُتاح عند ذلك صراع الأفكار، وإن لم يستويا فإنه لا يتاح أصلا، والغَلبة للأسلوب الأقوى تأثيرا حتى لو كانت فكرَتُه خاطئة.
و بمناسبة كلمة “التقديس” التي ذكرَها عصيد في الاقتباس السابق، فإنها شمّاعة يحلو لكثير من الحداثيين تعليق نقدهم حولها، وهم يقصدون بها تحديدا القرآن أو السنة أو كليهما (الدين عموما)، بينما لو راجعنا التاريخ الثقافي للقرون الوسطى مثلا -كما يقول الدكتور الطيب بوعزة- سنلاحظ أن المقدس ليس هو الدين فقط، ولا شكله المؤسسي فقط، بل حتى أرسطو وأفلاطون قد استحالا إلى مقدّسين مانعين للتفكير يكفي الإحالة عليهما ليكتسب القول صفة الحقيقة.
وتلخيصا لما سبق، فإن العرض الإعلامي المتّصف بالأنوثة الخطابية، واختزال المسائل المطروحة مع تغليفها بطابع الموضوعية. واستناد كل ذلك على عوامل منها توفيد الأفكار الاستشراقية، إسقاط المناهج الغربية بكل تفاصيلها على التراث الإسلامي، والاعتماد على أقوال تراثية فلسفية غربية لمحاولة إعطاء بعد عميق للطرح “الأوحد الصحيح”.. في مقابل تدنّ معرفي بالثقافة والعلوم الإسلامية عند الفئة المُخاطَبة، كل ذلك تسبب في ظهور واستعلاء أشخاص لا قِبل لهم ولا علم بالإسلام، يزيدهم ظهورا بريقُ الإعلام لا عُمق الطرح، أما الشباب المتحمّس الفارغ فلا يجد أمامه إلا السبّ والشتم، فيستغل الطرف الآخر ذلك ليقول لنا: هذا هو إسلامكم الإقصائي يا من لا تتقبلون الرأي الآخر ! ويستمر التغييب، صدق الأستاذ علي فريد حين قال:
الفريقُ الذي يَلعبُ منفرداً لن ينهزمَ أبداً.. ولن ينتصرَ أيضاً!!
إذا أردتَ اختبار حَدِّ سَيفك فجالِد به ذَا سَيف، كُلُّ السيوفِ قواطعٌ إنْ ضَربتَ بها الهواء!!














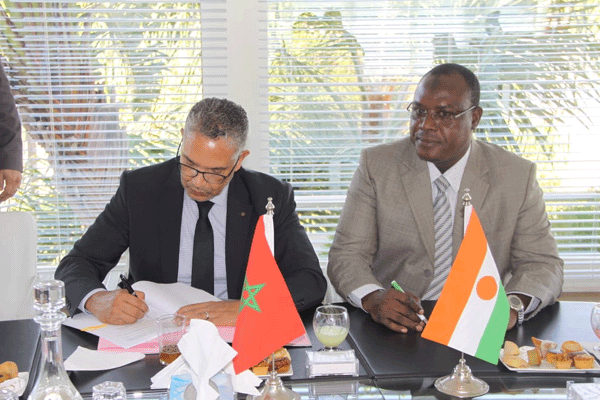
























مقال جيد ولكن الخط المستخدم من طرف أصحاب الصفحة مقلق وغير مريح.
قلم موفق دائما