حول موروث ابن عاشر تدندن وزارة الأوقاف (ح1)

هوية بريس – د. محمد وراضي
لنوضح بعض المفاهيم -وإن بدت في الظاهر غنية عن التوضيح- فنقول: الموروث هو ما ينتقل بالإرث، أي ما يخلفه الميت لورثته، نقصد ما له من مال أو ممتلكات ومتاع، وهو إما مادي وإما روحي. ونحن حين تركيزنا على الإرث الروحي الذي تركه للمغاربة محمد بن أحمد ميارة المالكي في مؤلفه القيم “المرشد المعين على الضروري من علوم الدين”، فلكي نقف على حقيقة تاريخية ثقافية، هي أن ما سلم به علماء الأمة المغربية، بدون ما جدال، وبدون ما اعتراض، لا نقبل به نحن، وكأنه من البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان؟ أو كأنه من المسلمات بالمفهوم العلمي الذي يجعلها أساسا لبناء نظريات رياضية أو طبيعية تجريبية غاية في الدقة. نقصد رفضنا لمحتوى البيت الثاني من هذين البيتين الواردين في أرجوزة ابن عاشر، أو في منظومته الفقهية حيث يقول:
وبعد فالعون من الله المجيد***في نظم أبيات للأمي تفيد
في عقد الأشعري وفقه مالك***وفي طريقة الجنيد السالك
فعند الناظم أن المغاربة يعتمدون في أداء واجباتهم الدينية نظريا وتطبيقا -حسب ترتيبه الخاطئ- على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وعلى فقه مالك بن أنس المدني الأصبحي، وعلى الطريقة الصوفية المنسوبة إلى: الجنيد بن محمد القواريري البغدادي.
فيصبح من حقنا أن نتساءل عما إذا كان واجبا علينا الاقتداء دينيا بمالك والجنيد والأشعري؟ أم إن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، هو الواجب علينا كما أمرنا بنصوص نقلية قطعية الثبوت والدلالة؟
وحتى نبعد أي غموض عن هذين السؤالين، نؤكد أن النصوص القرآنية والحديثية، تحث لفهم ديننا على الاستفادة من العلماء الذين هم بمثابة نواب رسول الله، من حيث وجوب اتصافهم بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. وهذه الصفات أوردها ابن عاشر في منظومته، إنما كصفات لرسول الله دون غيره؟ والحال أن نوابه الذين هم علماء أمته، يلزمهم الاتصاف بها، حتى يتمكنوا أمرا ونهيا وقولا وفعلا من أداء ما عليهم أداؤه بخصوص الدين في السر والعلن، خاصة وأن الله رفع من قدرهم في أكثر من سورة، وفي أكثر من آية، إذ يقول تعالى: “إنما يخشى الله من عباده العلماء”. وإذ يقول سبحانه: “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”.
ولكي ندرك قيمة أي عالم ضمن مجموعته في بلدة، أو في مدينة، أو في دولة، لا بد أن نختبر مدى صدقه الذي يجنبه الوقوع في الكذب والتضليل، وأن نختبر مدى تحمله للأمانة الملقاة على عاتقه، وأن نختبر مدى وضوح بيانه في التبليغ، وأن نختبر مدى فطانته حتى لا يصبح عبارة عن مجرد قطعة شطرنج في يد الحكام، أوفي يد أولي الأمر.
أما ما يطعن في مروءة أي عالم، فأضداد الصفات الأربع الممدوحة المتقدمة الموروثة عن رسول الله. إنها الكذب، والخيانة، والتقصير في التبليغ، والبلادة، أو قصر النظر؟ والرذائل الأربع المذمومة هذه لخصها قوله ص: “ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر، وقال: إني مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان”.
ولم يقف القرآن الكريم عند حد امتداح العلماء، والتنصيص على ما يلزمهم الاتصاف به من صفات إيجابية، في مقدمتها التقوى والورع، بل إن الله سبحانه حذرهم من خيانة الأمانة، والخضوع للأهواء، ونصرة الظالمين، بدلا من نصرة المظلومين، كما حذرهم من الترويج للأباطيل، بعيدا عن حقيقة ما ورد في ذكره الحكيم، وفي سنة مجتباه. قال عز وجل: “ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون”. وقال: “إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون”. وقال: “إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم”.
مما قدناه، يتضح لنا كيف أن الذين يكتمون ما أنزل الله وما جاء به رسوله، هم الذين يعرفون، والذين يعرفون هم علماء الأمة. والكتمان كما هو بين، تقصير متعمد في التبليغ والأداء. والتقصير المتعمد فيهما وراءهما في الغالب دافعان: دافع الخوف، أودافع الطمع والرجاء! إلى حد قول الإمام سحنون القيرواني التونسي: “التكفف باليد، خير من التسول بالقرآن”! فلزم أن يكون الكاتمون للحق المبين ملعونين من الله ومن ملائكته ومن الناس أجمعين! يضاف إلى لعن الكاتمين، لعن من ورد ذكرهم في قول علي بن أبي طالب: “حدثني رسول الله ص بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله (ذبائح عند أضرحة الصالحين؟)، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا (= مبتدعا كمشايخ الطرق الصوفية؟). ولعن الله من غير منار الأرض”.







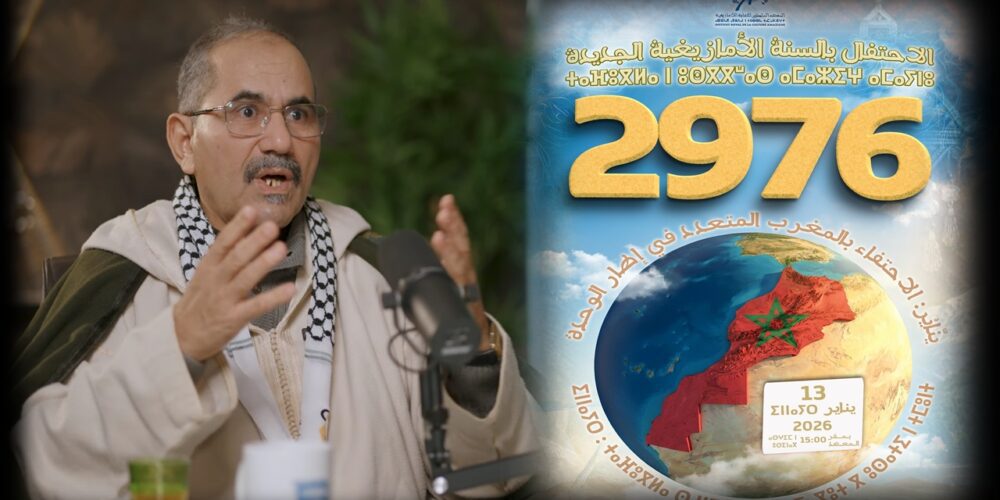

































كلام تافه ممجوج مثل كاتبه، منزوع البركة والعياذ بالله.
منذ مدة وهذا الجلموذ البشري يكتب مثل هذه المواضيع ولكنها ولله الحمد زبد يذهب جفاء لأنها ببساطة مليئة بالحقد والغل في حق عدد كبير من أولياء الله وبذلك آذنه الله بالحرب فجعله ممقوتا وذلك جزاء الظالمين.