د. البشير عصام يكتب: من جنى اليراع.. قصة المقاصد العلمانية

هوية بريس – د. البشير عصام المراكشي
الحديث السادس عشر؛ #من_جنى_اليراع: قصة المقاصد العلمانية
يعرِف أصدقائي المقربون أنني حين بدأت الدراسة في الجامعة منذ سنوات معدودة بعد حصولي على شهادة الهندسة، كنت قد حصّلت قبل ذلك طرفا صالحا من الدراسة الشرعية التقليدية، فكان ولوجي إلى الجامعة لتكميل ذلك بدراسة عصرية، وتحصيل شهادة أكاديمية، صار بعض الناس اليوم لا يرَون التخصص العلمي إلا من منظارها!
وكان من أشد مظاهر عجبي في الجامعة -وقد رأيت فيها عجبا كثيرا لعل لبسطه مقاما آخر- أنني رأيت صغار الطلبة المبتدئين يكثرون الحديث عن المقاصد والشاطبي والموافقات حديثَ عارفٍ مطمئن لما يقول، والحالُ أن معرفتهم بفروع الفقه وأصوله سطحيةٌ لا تجاوز المتلقَّفَ من الدروس الدعوية العامة! وهذا شيء لم أعهده في مجالس العلم التقليدية ..
وكنت أقارن هذه الصورة المأساوية بالكلام الصريح الذي ذكره الإمام الشاطبي في أول كتابه “الموافقات” – الذي هو لعلم المقاصد مثلُ كتاب سيبويه لعلم النحو: (ومن هنا لا يُسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد، حتى يكون ريّان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها..).
ومن مظاهر عجبي أيضا أنني رأيت الأساتذة الجامعيين يتحدثون عن المقاصد في كل مقام مهما بعُد عن مجالها، ويحشرونها في كل موضوع مهما نأى عن ميدانها، حتى صارت المقاصد على طرف اللسان عند كل بيان ..
وفهمت أن هؤلاء إنما يصنعون ذلك، لأنه شيء تعلموه حين كانوا على مقاعد الدراسة الجامعية؛ فأدركت أنها دوامة تدور منذ عقود، وتخرِّج كتائب من “جهلة المقاصديين”!
ولست أحتاج إلى التذكير بأن من المعتنين بالمقاصد قديما وحديثا مَن يُعدّون من العلماء الجهابذة، وأن المشكلة ليست في هذا العلم ولا في أئمة حامليه، وإنما في كونه بُذِل لمن لا يقدر على إدراك دقائقه وتبيّن مزالقه، فانتشر بين الناس انتشار النار في البنزين، والبَرْد في مفاصل المعدَم المسكين (وهذا من التجديد في التشبيه، لعله يشفع لي عند هواة التجديد في كل شيء!)..
وارْجِع اليوم إلى عامة المسلمين من الإعلاميين والسياسيين والمثقفين وطلبة المدارس وغيرهم، واسألهم عن مقاصد الشريعة يجيبوك بثقة العالِم، وطمأنينة المختص؛ ثم اسألهم عن الإيماء والسبر والتقسيم والإخالة والدوران والشبه أو عن النقض وعدم التأثير والقلب والكسر والفرق وفساد الوضع، بل انزل إلى السؤال عن مفهوم الموافقة والمخالفة والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز، تجد عند القوم وُجومَ الجاهل، وحيرةَ خالي الذهن، كأن على رؤوسهم غرابَ جهلٍ عشّش وفرّخ، وامتنع زجره!
ولنا أن نسأل في هذا المقام:
لِمَ بُذل علم المقاصد لعامة الناس وانتشر فيهم، مع أنه في الأصل لخاصة خاصتهم؟
ولعل الجواب الذي يخطر ببال من يتجرد من النظرة الفقهية الضيقة في واقعٍ لم يعد للفقه فيه سلطان، هو:
لأنه علم يصلح – حين يؤخذ شعارا منقطعا عن المضمون الشرعي التراثي – لهذا المزاج الحداثي المهيمن على العالم اليوم، وذلك من وجهين:
أولهما: سهولة ركوبه إذا تجرد عن قيوده الشاطبية الثقيلة. والسعيُ إلى السهولة مرَض عصري، يلائم مزاجَ السرعة التي تميز المجتمعات الحداثية المعاصرة.
فمن الممكن تحصيل معرفة بعض التعبيرات المقاصدية العامة في بضعة أيام أو أسابيع، أما دراسة الفقه وأصولِه، فرحلةُ عمر، ومسيرة دهر ..
والثاني: سهولةُ تطويعِه للآلة الحداثية المهيمنة على الفكر، والتي تطالب الدينَ بأن يخضع لها، ويلتزم بمُخرَجاتها. ولا سبيل إلى هذا الإخضاع، مع الصلابة التي توجد في الالتزام بالنقل والفقه التراثي وقواعدِ الاجتهاد المقررة في علم أصول الفقه.
ولذلك وَجَد “جهلةُ المقاصديين” أنفسَهم أداة لينة في يد الثقافة العلمانية المهيمنة، يجيزون ما تجيزه، ويمنعون ما تمنعه. لا فرق بين الواحد منهم وبين العلماني الحداثي القح، إلا أن الأول يضع بين يدي بحثِه المكتوب أو كلمتِه المنطوقة ألفاظا محفوظة كالمقاصد والإمام الشاطبي وحفظ الكليات وروح النص وإنكار الفهم الحرفي الجامد، وما أشبه هذه الألفاظ. لكن النتيجة واحدة، بل حتى الاستدلال الموصل إليها واحد، إلا أن ألفاظ الخطاب تختلف.
وبالمقابل، وَجَد العلمانيون في “جهلة المقاصديين” بغيتَهم، فإنهم يتيحون لهم تمرير علمانيتهم بغطاء شرعي، دون حاجة إلى مصادمة الشريعة، والمفاصلة مع أهلها، لأنه طريق لا يجنون منه ثمرة، غير المزيد من التوجس منهم، والحذر من مخططاتهم.
أما “علماء المقاصديين” فوجدوا أنفسهم في حيص بيص: فالالتزام التام بالمقاصد على حساب الفهم الحرفي – الذي كانوا ينكرونه – يؤدّي بهم إلى العلمنة الكاسحة؛ والرجوعُ إلى المهيع العلمي التراثي المسلوك يعد تضييعا منهم لهيكلِ المقاصد الذي بنوه، وتفننوا في تزيين معماره على مدى عقود من الزمن ..
فهم تارة نصوصيون، وتارة أخرى مقاصديون ..
وضاع الفقه المنضبط في التأرجح بين هذين، بحسب تقلبات الواقع، وأهواء الناس ..
وهكذا فلا بأس بالاستدلال على إباحة مصافحة الأجنبية بدليل جزئي هو حديث الأَمَة التي تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطلق به حيث شاءت؛ ولو في مواجهة أحاديث أخرى، بل في مواجهة المقصد الشرعي المعروف في مباعدة النساء عن الرجال، ودرء الفتنة بين الجنسين ما أمكن؛ وهو المقصد الكلي الذي يستقريه العالم بالشريعة من أدلة جزئية كثيرة، مثل: تحريم التبرج، ووجوب غض البصر، وتحريم الخضوع بالقول، ومنع خروج المرأة متعطرة، والأمر بالقرار في البيوت، وتحريم الخلوة بالأجنبية، ومنع سفر المرأة دون محرم، وغير ذلك.
ولكن النصوص الجزئية كلها تهدَر وتبطل دلالتها حين يتعلق الأمر بمقصد كلي تحبه الثقافة العلمانية المهيمنة -إلى حد الهوس- هو مقصد الحرية، الذي يقتضي مثلا عدم عقوبة المرتد أو المفطر في نهار رمضان ..
وتفصيل هذه القضية يطول ..
وللمقاصد العلمانية قصة، يحسن أن أسردها عليك، فإن فيها عبرة بالغة ..
بدأ الأمر بإبراز كتاب “الموافقات”، والحث على دراسته -وهذا أمر طيب في ذاته، فحبذا “الموافقاتُ” وحبذا صاحبُها! ومع الإبراز، كثر الحديث في الموضوع حتى تأسس علم قائم مستقل، هو علم المقاصد- وهذا أيضا لا بأس به، فتقسيم العلوم أمر اجتهادي لا مشاحة فيه ..
ثم كانت المرحلة الثانية، بنصب المعارَضة بين العِلمين -علم أصول الفقه وعلم المقاصد- وبين الإمامين: الشافعي والشاطبي. ففي نظر من يدّعي ذلك: لا تجتمع “المقاصد الشاطبية” مع الانضباط الفقهي المعروف في التراث الفقهي للأمة (حتى وجد من يشكك في فتاوى الشاطبي الفقهية، لأنها ليست على وفق طريقته المقاصدية – كما يفهمونها).
وفي ختام هذه المرحلة لدينا إذن علمان وفهمان متعارضان، ولكنهما -على الرغم من ذلك- مهيعان مسلوكان.
وهذا بالطبع لا يلائم الثقافة المهيمنة ..
فلا بد من أن يخلو الجو للمقاصد، حتى لا يظهر الاجتهاد المقاصدي “المعلمن” في صورة الشذوذ العلمي ..
وأفضل طريقة لنفي الشذوذ عن النفس، إلصاقُ تهمة الشذوذ بالغير ..
وهكذا صار “جهلة المقاصديين” ومعهم المتعلقون بأهدابهم من “صرحاء العلمانيين”، ينكرون “طريقة الشافعي” التي عليها جماهير علماء الملة، بل جميعُهم؛ وصاروا ينبزونها بأنها طريقة حرفية نصوصية جامدة لا تلائم العصر، الذي لا بد فيه من الاجتهاد المقاصدي. وعند هؤلاء: يعدّ الثابت على تراث الأمة ومنهج الاستدلال الأصولي المعروف مومياء تاريخية، وصوتا نشازا، لا يناسب العزف العصري!
ثم كانت المرحلة الأخيرة ..
وميزتها الأولى تحريف المقاصد الشاطبية نفسها، وذلك بفتح الباب لزيادة مقاصد أخرى جديدة لم يعرفها الآباء المؤسسون لهذا الفن، كمقصد الحرية والعدالة والمساواة ونحو ذلك.
وليس الإشكال في زيادة المقاصد، ولكن في آلية إنتاجها ..
فالأئمة ينطلقون من الاستقراء الدقيق والشامل لنصوص الوحي، وما تدل عليه من الفروع الجزئية، ليصلوا إلى استنباط مقاصد كلية جاء الشرع باعتبارها. أما هؤلاء القوم، فيثبتون مقاصد كلية -الغالب أنها مأخوذة من الثقافة العلمانية المهيمنة- ثم يلتمسون لها من الشرع ما يلائمها من الجزئيات، مع الإعراض عن جزئيات أخرى تعارضها أو تقيّدها!
والميزة الثانية انتقاء كل ما يساعد على إبطال الأدلة الجزئية من التراث، مهما يكن شذوذه في نفسه، أو سوء فهمه من طرف المعاصرين. فالأول كمذهب الطوفي في المصلحة كما عبر عنه في شرحه لحديث (لا ضرر ولا ضرار) -على أحد القولين في فهم كلامه-، والثاني كمذهب القرافي في تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية.
وهكذا اكتملت فصول هذه القصة الكئيبة ..
واستقر الاستدلال المقاصدي الكلي -عند الكثيرين- على أنه الطريق الوحيد السائغ للاستنباط الشرعي ..
واستقرت القواعد والأصول العلمانية على أنها مقاصد شرعية جاء بها الوحي ..
فعُلمِنَ الاجتهاد، وصار الطريق إلى العلمانية المسيطرة مسلوكا ..
لكن على بساط وثير من الخطاب الشرعي الذي يَطمئن الناسُ إليه!







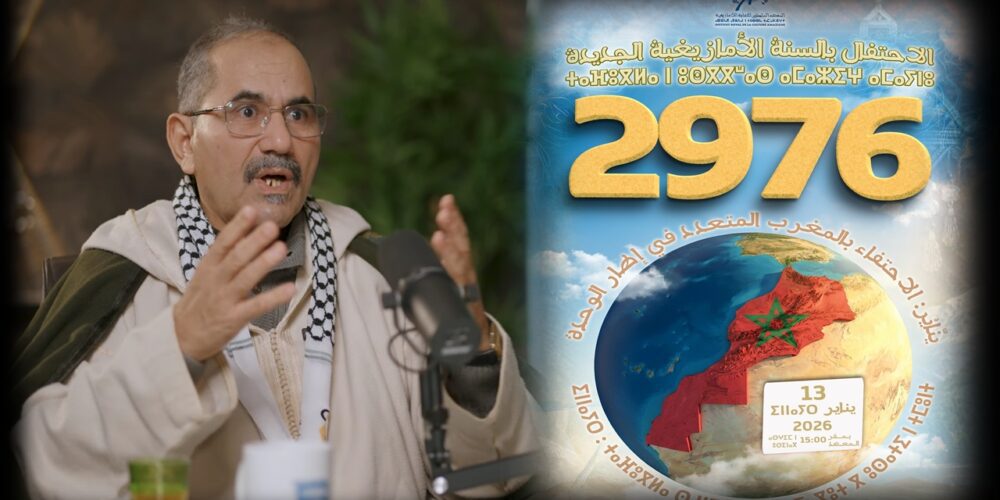

































جزاك الله خيرا .ووفقك لكل خير
جزاك الله خيرا وجعلك بفضله من حراس هذا الدين القويم
يا ليت قومي يقرؤون هذا المقال وأمثاله بعمق… جزاك الله خيرا أستاذنا الدكتور عصام وبارك فيك.
جزاك الله خيرا
و ما العمل إذن؟