ذ. طارق الحمودي: شعوذلوجيا.. «الفراسة» في المغرب

هوية بريس – ذ. طارق الحمودي
صار المغرب اليوم سوقا لكثير من المقاولات الفكرية الغريبة عن ثقافة المغاربة، وقد كنت أشير دائما إلى تسرب بعض أنواع الممارسات القائمة على “الفكر الباطني” مثل اليوغا والعلاج بالطاقة “الريكي”، وبينت بالدليل أنها ممارسات دينية وثنية مستوردة من الشرق الأقصى، تسربت إلى المجتمع الاستهلاكي المغربي عن طريق أفراد تلقوا تعليمهم في الغرب تدربوا على تلك الممارسات لأهداف تجارية وربما فكرية أيضا، واليوم أتحدث عن ممارسة من نوع آخر، تنتمي إلى ما يسميه الناس “التنمية البشرية”، وهو نوع مثير للاهتمام، والقلق أيضا، يسميه أصحابه “البيرسونولجيا” أو على وجه التحديد الفيزيونومونيا، وهي أسماء مغرية بشكلها المثير، إذ توحي بأنها علوم إنسانية خالصة، وهي خلاف ذلك من كل وجه.
ظهرت نابتة في بلاد المسلمين، تلقت تدريبات على هذا النوع من الممارسات، ورجعت به إلى بلادها، وكان المغرب واحدا من تلك البلدان التي تسربت إليها هذه الممارسة، وكالعادة، وحرصا على تسرب لطيف، جعلوا له اسما تراثيا مقبولا عند الناس، وسموه “علم الفراسة” زورا وبهتانا، وسموا الخبير في ذلك فرَّاسا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الفراسة، هي الفطنة القائمة على ملاحظة الأمارات لمعرفة الخفي والمستبطن في النفوس أو مآلات الأحوال، وهي ميزة يمتاز بها الأذكياء الذين يوفقهم الله تعالى بالعناية والهداية، ولعل أفضل من كتب عنها هو العلامة ابن القيم في كتابع اللطيف “الطرق الحكمية”، والذي عقد فيه فصلا خاصا للفراسة، وذكر لها شواهد وحكايات كثيرة لفضلاء المسلمين وأذكيائهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدء بالصحابة، مستجديا حالات تاريخية منصوص عليها في تاريخ الأنبياء.
وبدا واضحا أنها ملكات خاصة وليست علما يدرس، وفي مقابل هذه الفراسة ظهر مفهوم آخر يشبهها ولا يطابقها، جعلوا له علما سموه في المجال التداولي العربي “علم الفراسة الحديث”، كتب فيه جرجي زيدان وغيره، يقوم على اعتقاد ترابط “ما” بين الخلقة الظاهرة، في الوجه خاصة، وبين طبيعة شخصية صاحبها وأخلاقه الأصيلة فيه، فلأشكال الأنف والعين وما حولها والشفتين والأذنين ولون الشعر والجلد دلالات شبه يقينية عندهم على أخلاق الإنسان وخصائص شخصيته.
وبهذا يظهر التمايز الواضح بين الفراسة في التراث الإسلامي وبين هذا النوع المسمى تلبيسا “علم الفراسة الحديث”.
ألف فخر الدين الرازي الأشعري المتفلسف كتابا عن الفراسة، لكنه لم يكن على طريقة المسلمين، بل هو -كما قال الدكتور عبد الحميد حمدان أحد محقيقيه- كان ملخص جامع لما كتبه كل من أرسطو في “فصل في الفراسة” من رسالته للأسكندر المنشورة -بالعربية- المشهورة باسم “السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة”، وما كتبه فيلمون الحكيم والذي نشر مترجما بالعربية باسم “الفراسة”، بين فيها موافقةً لهما كيف يمكن الاستدلال بشكل الخلق على طبيعة الشخصية.
بل ذكر الرازي أن هذا العلم قائم على أساسين، القياس والملاحظة، ويقصد القياس على أشكال الحيوانات، فبقدر شبه الإنسان بحيوان ما في خلقته يكون فيه شبه من أخلاقه وصفاته النفسية كالأسد والذئب والقرد والخنزير والبغل والحمار وغيرها! واللافت للنظر في هذا أن هذا الذي يزعمون أنه علم ليس علما حادثا، بل هو قديم جدا، ففي أية خانة علمية يمكن تصنيفه؟ ومن المسؤول عن امتداده اليوم؟
كتب أحد المنتمين إلى الجماعات الباطنية في أوروبا كتابا سماه “Les Mystéres des Sciences Occultes” “أسرار العلوم الباطنية”، وكان من العلوم التي أدخلها تحت مسماها علم.. الفراسة الحديث، أو الفيزيونموني، وهي فائدة عزيزة، وتنبيه له دلالات عميقة وخطيرة، فهو يؤكد أن هذا العلم علم وثني باطني، وقد وصف هذا المزعوم علما بالشعوذة كما في كتاب “Les Arts Divinatoires” لـ” Papus” الذي كتبه بطلب من صحيفة “LeFigaro”، و”الخرافة العالمة” في مقال السيدة “Martine Dumont” في مجلة “Actes de la Recherche enSciences Sociales”، ومع ذلك يصر مناصروه على جعله علما مع عدم تحقق شرطية العلمية فيه، فليس له قوانين تحكمه وتضبطه، سوى محاولات متضاربة، وانطباعات شخصية، تشبه أن تكون تخمينات وحزرا كما يقول “Papus”!
نحن إذن أمام خرافة باطنية وثنية.. ليس لها من مقومات العلمية شيء! ولذلك آلت إلى الاندثار… إلى أن أحييت من جديد… فمن تولى كبر ذلك؟
مثل نظيراتها من العلوم الوثنية الباطنية، بقي للفيزيونمونيا امتداد إلى العصر الحديث، ورغم أنها كادت أن تتلاشى، إلا أن بعض الرهبان الكنسيين البروتستانت في سويسرا تولى كبر إحيائها والدعوة إليها، بل والتنظير إليها وتغليفها بغلاف العلم التجريبي، مستعملا ما استطاع من الوسائل الممكنة لإدراجها ضمن العلوم الأكاديمية المعترف بها رغم ما وجده من معارضة جادة، وقد استطاع بعد مدة من أن يجد لدعوته آذانا صاغية نصرته وآمنت بنظريته.
كان هذا الرجل هو”Jean Gaspard Lavater”، صاحب كتاب “Essai sur la Physiognomonie”، وتكاد تجمع الدراسات على أنه المسؤول الأول عن ظهور هذا “العلم” في صورته الحديثة، ولعل أكثر الدراسات الجادة التي لامست طبيعة مشروعه، ما ضمن في مقال ممتاز للسيدة “Martine Dumont” منشور في مجلة “Actes de la Recherche en Sciences Sociales”، بدأت فيه بالتهوين من شأن هذا العلم، وذكر من عارضه وسفهه من المفكرين والفلاسفة معتبرين أنه شعوذة، واستعرضت أوجه ضعفه، وحاولت الكشف عن سبب انتشاره في بعض الأوساط المثقفة، وخلصت الباحثة إلى أن سبب تقبل كثير من المثقفين لنظرية “Lavater” هو علمانيتهم ورغبتهم في تحييد “الله” عن الحياة السياسية والعلمية.
ويلفت النظر تنبيهها على الجانب الباطني في شخصية هذا الرجل، والتي كان لها أثر في دفعه لتبني هذه النظرية مع مؤثرات سياسية واجتماعية أخرى يحسن الوقوف عندها خصوصا عند من يعرف فائدة وضع الشخصية في سياقاتها المختلفة بقصد الكشف عن طبيعة المشروع الفكري الذي تتبناه وتدعو إليه، كما نبهت إلى علاقات غريبة بينه وبين الماسونية الأوروبية والتصوف الباطني! والسؤال الأهم في كل هذا، ما هي فائدة هذا العلم المزعوم؟
لابد من التنبيه أولا على المآلات الفكرية لهذه الخرافة، فجزء من قيمة الشيء كائن في مآلاته، وقد نص الباحثون على أن هذه النظرية قائمة على أن الأخلاق في أصلها تابعة لشكل الخلقة، أي أن الإنسان مجبور على نوعية معينة من الأخلاق، وأن التمايز بين الناس فيها بين صالح وطالح راجعة بالأساس إلى شكل خلقتهم التي ليس لهم في اختيارها شيء، وهذا لا يعني إلا أمرا واحدا، وهو أن هذه النظرية نظرية “جبرية”.
ومهما حاول أصحابها دعوى أن الفائدة من هذا “العلم” هو علاج هذه الأخلاق لم يفلحوا، إذ لو كان الأمر كذلك لما استطعنا الجزم بتناسب الخلقة مع الأخلاق، إذ يبقى احتمال كون الشخص قد انصلح حاله بالعلاج على حد زعمهم، فيتلاشى التلازم المزعوم نظريا وعمليا، وقد انبنى على هذه النظرية الجبرية فصول من التمييز العنصري والاجتماعي بدء من واضع هذا العلم كما في مقال للسيدة “Martine Dumont” وانتهاء بالنازية الهتلرية، فهي أساس علمي للعنصرية.
إضافة إلى أنه حصل تقارب واضح بين هذه الخرافة وخرافة التطور الداروينية لما يعرف عن واضع هذه الخرافة أنه بنى النظرية على مشابهة رؤوس الناس ووجوههم لرؤوس ووجوه الحيوانات كما مرّ التنبيه عليه…
ولعل أخطر تفرع لهذه الخرافة هو اندراجها عند بعضهم ضمن أسس علم الجريمة، خاصة عند المدرسة الإيطالية التي أسسها اليهودي الأصل “Cesare Lombroso” والذي زعم أن الإجرام يورث من الآباء إلى الأبناء، جامعا بين نظرية “Lavater” ونظرية التطور الداروينية، وهذا أمر في غاية الخطورة، وهو أن تكون هذه الخرافة من الأدوات المستعملة في التعرف على الجناة، باعتبار أن المجرم يولد مجرما، فإن كانت الأجهزة الأمنية تستعمل هذا، فهذه مصيبة كبرى.
هي إذن نظرية جبرية… لكنها ليست النهاية…
مما يؤكد باطنية هذه الخرافة، أنها في أصولها القديمة قامت على أن شكل الوجه وخطوطه تختزن معلومات عن طبيعة شخصية الإنسان… ومستقبله، وهي مع علم قراءة الكف، إحدى الوسائل القديمة لعلم الغيب عند أصحابها، وهو أمر لا يخفيه بعض الممارسين لهذه الخرافة الوثنية، إضافة إلى انها كانت من العلوم الخاصة المتداولة وسط النخبة كالكهنة والسحرية، ولست أستبعد استعمال الجن في دعوى قراءة الكف والوجه، فإن الساحر يستطيع استنطاق القرين لإطلاعه على معلومات خاصة بالمقترن به، وهذا أمر متواتر عندنا، وتحاول بعض الكتابات اليوم إقناع الوسط العلمي… بعلمية هذه الخرافات إلى الآن، مع نوع من المناورات الطريفة، إذ صاروا يتجنبون اليوم كلمة “Physiognomonie” ويستعملون عوضا عنها كلمة ” Morphopsychologie”.
ثم جانب آخر صادم في قصة هذا الخرافة، وهو كاف في تسويغ الموقف الشرعي والعقلي الرافض لهذا الفكر وممارساته، وهو أنه يعد واحدا من العلوم الباطنية التي احتوى عليها كتاب اليهود الشهير “الزهار- le Zohar” كما في مقال مثير للباحث المتخصص في الفكر الباطني “Spartakus FreeMann”، ويعد “الزهار” عمدة الفكر الباطني القابالي اليهودي، وللكتاب قصة لا أريد تطويل المقال بذكرها، لكنها مثيرة …جدا..جدا!
كانت المفاجأة صادمة، حينما اطلعت على لقاء بمن وصفوها “الفرَّاسة” المغربية “فاطمة ميمون” في برنامج “صباحيات دوزيم” يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2016، وقد تابعت كلماتها وهي تشرح للحاضرات، وكان ما سمعته منها مثيرا ومقلقا.
1- عرَّفت هذا العلم الكذب بأنه فلسفة الكون، وهي بداية كانت كافية لرفع مستوى الانتباه عندي، فمثل هذا الكلام لا يقال عبثا..!
2- زعمت أنه علم يعتمد في القراءة على خلايا الإنسان وعلى الصبغة وعلى الهرمونات، وهذه كلمات تدل على أنها كانت تحاول إيهام المستمعين بعلمية هذه الخرافة.
3- زعمت أن هذا العلم يُمكِّن من معرفة من قد يتعرض للانحراف من خلال الخلقة.
4- زعمت أنه يمكن التعرف بهذا العلم على من قد يصير إرهابيا حاقدا على الدولة، ولست أدري لم الإرهاب مرة أخرى؟
5- زعمت أن هذا العلم يمكن من معرفة ما فعل الشخص وما سيفعله، لكنها حاولت التمويه بالتنبيه على أنه ليس دعوى لعلم الغيب… وليس ينفعها ذلك.
6- زعمت أنها تستطيع معرفة كل شيء عن الإنسان الجالس أمامها في -رمشة عين كما قالت- بالنظر فقط إلى شكل وجهه وشكل أجزائه.
7- زعمت أن فائدة هذا العلم هو استخراج القدرات الدفينة عند الإنسان، والتي لا يعرفها هو ولا غير المتخصص في هذا العلم، لكنها استدركت في محاولة التخفيف من وقع هذه المزاعم بادعائها أنه علم مكمل للعلوم الأخرى.
8- سئلت، هل هذا العلم معترف به؟ فحادت عن الجواب، لأنها تعرف موقف العلم من خرافاتها، وزعمت بأن هذه الخرافات تدرس في البلاد المتقدمة مثل ألمانيا وغيرها، وكأن ذلك دليل على علمية تلك الخرافات وصحتها.
ومن تابع المقالات السابقة، يتبين له جليا، أنها تتحدث عن خرافة علم الفراسة الحديث، الخرافة الباطنية ذات الأصول اليونانية واليهودية القابالية، ويتبين له ما يتعرض له الشعب المغربي من “شعوذة ” عصرية، وإلى جانب اليوغا وغيرها، يتعرض المغرب لمحاولات تخريب متتالية، وحسبنا الله ونعم الوكيل.






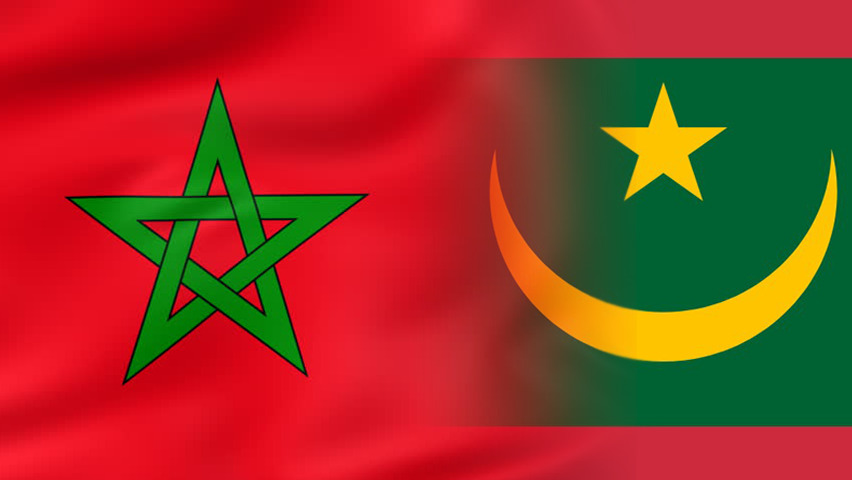


































بارك الله فيك