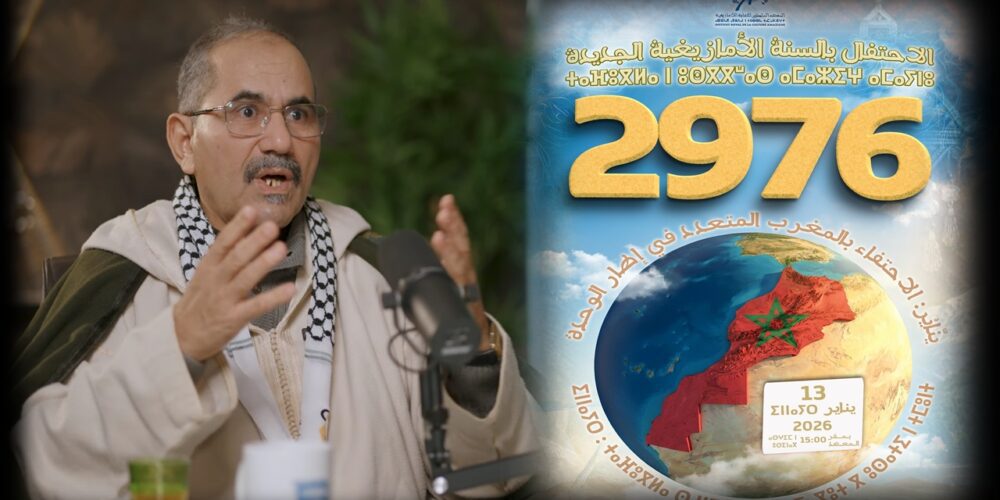رمضان وحكاية الطفل الإمام

هوية بريس – الحبيب عكي
لا أتحدث عما يتلقاه النشء من التربية المتناقضة في البيت والمدرسة والشارع والإعلام، فتلك واضحة ويسهل أمر الاختيار والقرار فيها، إما مع هؤلاء أم مع هؤلاء، وغالبا ما يكون الحسم فيها للتكيف مع المكان أو الأشخاص، فإذا كان الطفل في البيت كان بيتيا.. وإذا كان في المدرسة كان مدرسيا.. وهكذا يمكن أن يجمع هذا الطفل بين العديد من المتضاربات ويمزق بين العديد من التوجهات ولا يجد في ذلك حرجا، إنها التنشئة الاجتماعية تربي النشء على أنه من الصحة النفسية والشخصية المندمجة أن يلبس المرء لكل لبوس لباسه ويعطي لكل مقام مقامه، بغض النظر عن مدى انسجامه أو تعارضه مع الهوية والمعتقد أو المرجعية والانتماء، الذي يظل عند هؤلاء مرنا متغيرا غير صلب ولا ثابت، فلا يجد فيه المرء بعدها – كما يقال – بأسا من أن يخشع يوم الجمعة في المسجد مثلا، ويعربد يوم السبت في الملهى، ويتعرى يوم الأحد في الشاطئ.. وهكذا، إنها تربية “البلغة والجلابة والرزة والقصعة يا بوعزة” إنه الإسلام الذي يقبل عندهم بكل شيء وبمبرر ديني أحيانا “إن لنفسك عليك حقا” أو “المهم هو الإيمان في القلب”؟
بل أتحدث عما هو أخطر، وهي تلك الأشكال التربوية المائعة التي يتلقاها النشء وهي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، كل شيء فيها إلا الموقف العلمي والسلوك العملي، وبسببها تجد النشء في صغره كما في كبره، يعرف وكأنه لا يعرف.. وينحرف وكأنه يستقيم.. يخجل من دينه وكأنه يعتز به.. وقد يهجره ويعاديه وكأنه يلتزم به ويدعو إليه.. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؟. أين نشؤنا من معرفة دينه على حقيقته ومن مصادره المرجعية بدل مجرد التشويش والقصف الإعلامي؟، أين هو من معرفة رتبة هذا الدين ومقامه بين غيره من الدعوات والفلسفات وبأنه مقدم على غيره من المذاهب إذا وقع بينهما احتكام أو تعارض، قال تعالى:” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا” المائدة/3؟. أين نشؤنا من العمل لهذا الدين والدفاع عنه وقد كان من الشباب اليافع في ما مضى (زيد بن ثابت 13 سنة) من تعلم لغة اليهود حتى لا يحرفوا عن رسول الله.. وجاءه – قبل أن يرده (ص) إلى أمه – يطلبه السماح له بالذهاب إلى الجهاد وسيفه أطول منه؟، أينهم من ممارسة العبادات والدعوة إليها بين زملائهم بالحكمة وقد قرأنا عن صبيان صغار صححوا وضوء شيخ كبير لما توضؤوا أمامه بشكل صحيح فأدرك هو خطأه؟
مناسبة هذا القول حكايتين شيقتين ملهمتين أبطالهما أطفال هذا الزمان على ريادتهم وفرادتهم طبعا، أما الأولى فتحكي عن إبان الرسومات الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول (ص) والتي أججتها تصريحات الرئيس “ماكرون” العنصرية والمسيرات الاحتجاجية العارمة التي شهدتها فرنسا إبان الحدث، طلبت المعلمة الفرنسية من تلاميذتها في القسم أن يرسموا الرسول (ص) وكأنه رسم لصورة العدد المقبل من المجلة المسيئة (…Hebdo )، للتو انهمك التلاميذ الأبرياء في رسم شطحاتهم إلا طفلا مسلما -لعله من المغاربيين- فقد رفع أصبعه ليسأل المعلمة ولم تسمح له بالحوار، فالوقت عندها وقت الرسم فحسب وعليه أن يرسم كما يرسم الجميع، لم يرسم الطفل المسلم شيئا ولكنه سرح في جولة تفكير داخلي يسترجع فيها ويستعرض خيرية رسول الله (ص) وفضل قيمه وتوجيهاته على أفراد أسرته.. فتذكر كيف أن أمه كانت تحب قراءة السيرة وكلما فرغت من ذلك أذرفت دمعة حب وشوق حارة.. كيف أن أباه كان يترك دفىء الفراش وينهض للصلاة خاشعا ساجدا راكعا في جوف الليل.. وكيف أن أخته ورغم كل ما كانت تتلقاه في الشارع من سخرية وانتقادات بسبب حجابها، كانت لا ترد إلا بابتسامتها المعهودة..، من علمهم ذلك غير حب رسول الله.. وكيف أحبوه وأحببناه ولم نراه.. ليخط على إثر ذلك رسالته إلى معلمته قال فيها: “معلمتي، هل سبق لك وأن أحببت شخصا لم ترينه؟، هل حقا تعرفين رسول الله؟، حبيبي يا رسول الله ليتك تعود إلينا ساعة بل ثواني حتى تراك وتعرفك معلمتي”؟. وكانت تلك رسالة مؤثرة قوية أبكت المعلمة الفرنسية وكانت لها سببا في رحلة بحث جاد عن رسول اله وعن دين الإسلام، انتهت بها – كما تحكي الحكاية – إلى إسلامها وحب رسول الله؟
والحكاية الثانية وهي حكاية الطفل الإمام الذي شد الرحال من بلده جنوب الصحراء إلى مملكة القرآن المغرب، لم يتجاوز عمره العشر سنوات وهو يتقن الحديث بالعربية وكأنه لغته الأصلية، وحلمه الذي من أجله ترك أهله وبلده هو أن يحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ويلتحق بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين الأفارقة ليتفقه في الدين، لعله يوما يعود إلى بلاده بذخيرة ثرية تمكنه وترجحه من أن يكون إماما في المسجد الأعظم، أكبر مسجد عامر في عاصمة بلاده، يصلي بالناس.. يرشدهم في دينهم.. يفتيهم في شؤون دنياهم.. ومحبوبا لدى الجميع.. وقورا مهابا بسمت ولباس محترم.. يحضر أفراحهم ومأتمهم.. ويفصل في عوارض الحياة بينهم.. إنه الطفل الموهوب.. الطفل المعجزة.. كان مع الله فكان معه وجمع له بفضل القرآن خير الدين والدنيا فكان -كما تحكي السادسة- كذلك؟
وآلاف الأطفال الأبطال مثله يحفظون القرآن في الزوايا والمدارس العتيقة والتعليم الأصيل وبعض الجمعيات بدوراتها الصيفية، وينبغ منهم العشرات والمئات.. وهم في كل رمضان يصلون بالناس صلاة التراويح.. يشنفون – ما شاء الله – بأصواتهم العذبة الندية جنبات المساجد العامرة وباحاتها وشوارعها المجاورة وهي تغص بالناس يحجون إليها من كل حدب وصوب، ليستمتعوا بالقراءة الخاشعة للأطفال الأئمة الأبطال.. في الشرق والغرب، على هدي النبي لقوم “عمرو بن سلمة”: “صلوا صلاة كذا وكذا.. وليصل بكم أكثركم قرآنا” رواه البخاري، وإذ به هو الطفل “عمرو” في حوالي السابعة من عمره، كان يسمع القرآن من الصحابة المارة.. يحفظه عنهم.. وكذلك بعض نجوم الأطفال الأبطال اليوم، لألاء المساجد في رمضان وأترجتها في ليلة القدر ومناجاتهم تلامس عنان السماء وتدعو برفع البلاء.. لقد كان لهم حفظ في صغرهم.. استثمار في عطلهم.. بل مزاوجة موفقة بين الدراسة والحفظ وحتى بين اللعب كغيرهم من الأطفال، وقبل ذلك كان لآبائهم الصالحون.. اهتمام واغتنام.. توجيه وتربية.. تكوين وعناية.. ترسيخ هواية وصقل مواهب، وفعلا يسر الله لهم ولأبنائهم خير الدين والدنيا؟
والسؤال الآن، أن بعضهم يعتب على التعليم الحديث في العديد من الدول، تغييب مثل هذا التوجه القرآني الأساسي الذي هو كل شيء وعليه ينبني كل شيء، في حين يرى البعض الآخر أن ذلك وصاية قاهرة ستجبر الأطفال الأبرياء على حشو عقولهم بالحفظ وتحرمهم من أن يعيشوا طفولتهم بالمرح واللعب حرة وممتعة؟. والنتيجة أن خراج تعليمنا الحديث لا يخفى فيه ضعف في القيم.. تدني في المستوى.. وتواضع في النجاعة التربوية إلى درجة يسمي البعض تربيته بتربية “البهلال”، ويسوق في ذلك حالات وحالات فقدان النجاعة والمناعة من مثل: أطفال وتلاميذ يفرطون في عباداتهم.. لا يصلون ولا يصومون أو يصلون بعضهم بلا وضوء ويصومون بعوارض الحيض.. يرهنون حظهم بترجي الأستاذ واستعطافه بدل بذل الجهد وفرض الذات.. يعتمدون الغش في امتحاناتهم ويتعاونون عليه.. يعنفون على الكثيرين ولا يحبون أن يعنف عليهم أحد.. في غير ما مرة تنزع منهم أدواتهم ولا يستطيعون الحفاظ عليها من زملائهم.. يتحرش ببعضهن أو بعضهم ولا يدركون معنى ذلك ولا خطورته فبالأحرى أن يحموا منه أنفسهم وينقدوها.. يقضون عطلتهم في الفراغ بدل تعلم مهارة تؤهلهم لابتضاع سخرة أو طهي شيء يشتهونه؟
وهكذا تظل حاجتنا إلى قيم القرآن أساسية وفي كل المراحل العمرية ، صحيح أنها مسلك الدين، ولكنها أيضا مسلك الدنيا، ورحم الله إماما فقيها جاءته أم تريد توقيف ابنها عما كان يحفظ عنده كأقرانه من القرآن ويفقهونه عنه من الدين، زاعمة في ظنها أن ذلك لا يضمن الخبز ورغد العيش، أثناها الفقيه عن رغبتها وعزمها وقال لها بل اتركيه وسترين أن القرآن الكريم سيجمع له خير الدين والدنيا، وأكد لها ذلك وستراه رأي العين، وفعلا تركت المرأة ابنها عند الفقيه، وإذ به ينبغ في حفظ القرآن وعلوم الدين، وتسري سمعته بمهارته في تجويده، وإذا بأكبر المجامع وأرقى المناسبات تستدعيه ليجود فيها، ويفقه بمواعظه الناس في دينهم، ويجتهد في حل المنهال عليه من قضاياهم، إلى أن كان ذلك سببا في تبنيه من طرف موكب السلطان فكان من أكبر علماء البلاط، يخشع الناس لتلاوته ويتشوقون لفقهه وينزلون عند اجتهاده..، إنه الطفل الإمام أتروجة مجالس السلطان بالأمس.. أتروجة مجامع القرآن باليوم، يفوز بجوائزه العالمية هنا وهناك.. والأطفال الأبطال المغاربة الأئمة النجباء على رأس ذلك.. حفظ الله الجميع؟