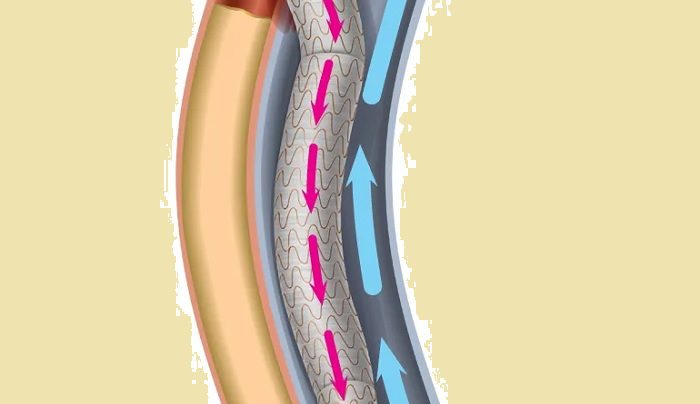سلسلة ذ. الحسن شهبار (ح.الأخيرة): ملف السلفية الجهادية بين مراجعات المعتقلين ومراجعات الدولة

هوية بريس – ذ. الحسن شهبار
مما يجب التنبيه إليه والتنبه له ونحن نتحدث في موضوع (السلفية الجهادية) بالمغرب، أن المعتقلين ضمن هذا الملف ليسوا فئة واحدة منسجمة في الفكر، وموحدة في المنهج، وإنما كانوا طرائق قددا قبل السجن وداخله وخارجه، ولا يُوحدهم إلا شيء واحد، وهو أنهم مُجرد كبش فداء، قُدموا قربانا لإله العصر، ونفذت فيهم محاكمات صورية بتهم غليظة، ونالوا سنوات متفاوتة من السجن.
إن المعتقلين في ملف (السلفية الجهادية) لا يُشكلون وحدة تنظيمية منسجمة، وإنما يجمعهم في الغالب الولاء الفكري لطريقة معينة من الاجتهاد الفقهي، وتستمد أحكامها ومنهجها من بعض دعاة المنابر بالمشرق الإسلامي، أو من بعض العلماء الذين نفروا للجهاد في سبيل الله، أو الذين يُناصرون المجاهدين في سبيل الله.. بل إن من المعتقلين على إثر أحداث 16 ماي الإرهابية من لا ينتمي لجماعة ولا حزب ولا تيار، ومنهم تارك الصلاة الذي يشرب الدخان ويزني ويُعاقر الخمر، وإنما وجد نفسه فجأة سلفيا جهاديا يُخطط لتفجير أو انتحار بسبب جلسة ليلية مع شخص مُلتح للسمر وشُرب كؤوس الشاي المنعنع، ومنهم أشخاص ينتمون للسلفية التقليدية لم يشفع لهم حضورهم لدروس المغراوي ولا استماعهم للشيخ الألباني، ومنهم من ينتمي إلى حركة التوحيد والإصلاح أو جماعة الدعوة والتبليغ، ومنهم من وجد نفسه خلف القضبان بسبب وشاية من عدو أو حاقد.. منهم من قضى نحبه أثناء فترة التحقيق، ومنهم من مات داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي.. منهم من حُكم عليه بعقود، ومنهم من نال البراءة أو أخلي سبيله بكفالة.. منهم من يعترف بما ارتكبه من جرائم؛ بل ويفخر به، ويعتبر ذلك نوعا من الجهاد في سبيل الله، ومنهم –وهم الأكثر- من لم يقم بأي عمل يُجرمه القانون، بل ويخاف الله في أن يُزهق نفس بعوضة.. منهم الحاصل على شهادة الدكتوراه أو الماستر أو الإجازة وما دونها، ومنهم الذي لا يفقه شيئا، ولا يعرف الضمة من الكسرة، ولا يُميز بين يديه اليمنى عن اليسرى.. منهم من قضى مدة عقوبته، أو صدر في حقه عفو ملكي، ومنهم من ينتظر خلف القضبان فرج الله القريب.. منهم من خرج سليم العقل معافى البدن، ومنهم من خرج من السجن بعاهات جسمية أو اضطرابات نفسية أو هما معا.. منهم من يُرحب بأي مبادرة تنهي هذا الملف، ومنهم من يُبدي تحفظه من كل مبادرة.. منهم من امتلك الشجاعة للحديث عن أخطائه بكل صدق وعفوية، ومنهم من راوغ ودلس، ومنهم من لا يعترف بأي خطأ، ومنهم من لا خطأ له ابتداء وانتهاء.. منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله.. منهم الشاب الذي لما يبلغ سن الرشد بعدُ، ومنهم الشيخ الهرم الذي اشتعل رأسه شيبا، وقلبه ألما.. منهم المفارق لأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، ومنهم المشتاق لعروسه وحِبه.. منهم الفظ غليظ القلب، عديم المشاعر، ومنهم الرقيق اللين السهل، الذي تسبقه دمعته، وينكسر قلبه، ويبتسم للجميع بلطف، ويبذل المعروف للكل بإحسان..
هؤلاء باختصار هم من أُطلق عليهم في يوم من الأيام (السلفية الجهادية)، وأطلقوا على أنفسهم معتقلو الرأي والعقيدة.. وليس غرضنا الآن تتبع أحوالهم واستقصاء أخبارهم، وإنما أود أن أشير إلى أن معظمهم نال أحكاما قاسية لا تُناسب ما ارتكبه من جُرم.. وبيان ذلك أن الذين ارتكبوا أفعالا إجرامية واعترفوا بذلك هم قلة قليلة، معدودة على رؤوس الأصابع، ومنهجهم شاذ ومرفوض حتى داخل أبناء التيار السلفي الجهادي، والذين ارتكبوا هذه الحماقات ينتمون لجماعة الهجرة والتكفير الذين يُكفرون المجتمع كله، حتى إذا انتهوا من ذلك انقلبوا على أنفسهم يُكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، حتى ينتهي المطاف بأحدهم أن يُكفر نفسه في اليوم مائة مرة، وهؤلاء عقلاء المجانين، أو مجانين العقلاء، وقلة قليلة منهم من يُؤمن بخيار العمل المسلح أو القتل، وهم الذين ارتكبوا تلك الجرائم واعترفوا بها في كل جلسات المحاكمة، بل ونشروها في الصحف والمجلات، وكلهم صدرت في حقهم أحكام بالإعدام أو المؤبد.. وأما أغلب هؤلاء التكفيريون فلا يُترجمون أفكارهم إلى أعمال مسلحة، وإنما يكتفون بتكفير الناس وعدم قراءة السلام عليهم، وهم من أجهل من مشى على الأرض، وقصصهم خارج السجن وداخله غريبة وعجيبة، ومُضحكة ومبكية، فمنهم من يرى تحريم مناداة الشخص الذي يُصلح الدراجات باسم (سي كْليس)، وإنما تقتصر في مناداته على اسم (كْليس) فقط، وإلا كفرت لأنك سيدته !! ورأيت بعضهم في السجن عندما تحسنت أحوال السجناء بعد الإضراب العام، ونالوا بعض حقوقهم، وأهدتهم إدارة السجن أجهزة التلفاز، رأينا بعض هؤلاء التكفيريين يُتابعون المسلسلات الماجنة والرقصات الفاضحة، ويتلذذون بالنظر إلى النساء العاريات بحجة أن هؤلاء النسوة الكافرات سبايا يحل النظر إليهن والاستمتاع بحُسنهن وجمالهن!! فهذه بعض حماقاتهم..
وأما بقية المعتقلين فمعظمهم لم يقم بأي عمل يُجرمه القانون أو يُعاقب عليه، وإنما حوكموا بسبب أفكارهم وآرائهم، ومعلوم أن الفكر لا يُواجه إلا بالفكر، والكلمة لا تُقاومها إلا الكلمة، والحجة لا تُقارع إلا بالحجة، وأما الذين ارتكبوا أعمالا يُجرمها القانون، فهم بعض الإخوة الذين كانوا يُمارسون عمليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، ومخالفات هؤلاء في القانون الجنائي المغربي لا تتجاوز السنتين أو الثلاث، ويشهد لهذا أن الذين حوكموا قبل أحداث 16 ماي الإجرامية لم تتجاوز عقوباتهم ثلاث سنوات ونصف، وأما الذين حوكموا بعد أحداث 16 ماي فقد وصلت عقوباتهم إلى ثلاثين سنة، والتهمة واحدة !! ولست أحتاج إلى أن أؤكد هنا أن كل المعتقلين أنكروا صلتهم بأحداث 16 ماي؛ ولا زالوا إلى الآن يصرخون بأصواتهم العالية بفتح تحقيق يبين الفاعل الحقيقي لهذه الأحداث التي كانوا هم أكبر ضحية لها؛ وإن العاقل لا يمكن أن يُصدق أن هذه الأحداث نفذها كل هؤلاء المعتقلين الذين تجاوزوا الثلاثة آلاف معتقل، وقد تنبهت الشرطة القضائية لهذا الأمر فجعلت التهمة هي: التهليل والتكبير عند سماع أحداث 16 ماي الإرهابية فرحا بها !! ولا تسألني كيف عرفوا ذلك، فأنا أيضا لست أدري، ولم أعلم بأنني فرحت بهذه الأحداث الأليمة إلا عندما مثلت أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وقرأ علي محضر الضابطة القضائية !!
إنني لا زلت أذكر صبيحة يوم السبت السابع عشر من شهر ماي سنة ثلاث وألفين ميلادية؛ حينما استيقظت على سماع أخبار تلك الأحداث الأليمة التي وقعت بالدار البيضاء، جلست حينها بالمقهى لأتناول فطوري، وكانت المذيعة تذيع بصوت حزين أن أربعة عشر انتحاريا تتراوح أعمارهم بين عشرين وأربع وعشرين سنة قد استهدفوا عدة أماكن حساسة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في تلك الليلة في أسوأ هجوم وأكثره دموية بالبلاد.. توقفت عن إتمام فطوري، وأرخيت سمعي للتلفاز أتابع تعليق المذيعة وأشاهد الصور الأولى للهجمات الإجرامية..
كانت الحصيلة ثقيلة؛ فقد قُتل منفذو التفجيرات الاثنى عشر، وقُتل أيضا ما يزيد على ثلاثين مدنيا معظمهم مغاربة.. في حين اعتُقل ثلاثة من المهاجمين قبل أن يقوموا بتفجير أنفسهم، كما جُرح ما يزيد عن مئة شخص..
كنت أتابع التلفاز وأنا أُتمتم مع نفسي: هل أنا أمام حقيقة أم خيال.. هل هو كابوس يُراودني في المنام أم هو واقع مؤلم قد ألم بالبلاد، تحسست نفسي؛ فإذا بي مستيقظ وما أراه ليس حُلما ولا خيالا.. ما دار بخلدي ولا مرة أنه سيأتي يوم على المغرب ليكون هدفا لعمليات انتحارية.. نسيت ما أنا فيه، وما كنت سأفعله في ذلك اليوم، ورُحت أسائل نفسي بمجموعة من التساؤلات المحيرة:
من يكون هؤلاء الشباب؟ وماذا يريدون؟ وكيف خططوا لعملياتهم؟ ومن مولهم؟ وما الهدف من تفجير مقبرة لا ينام بها إلا الموتى؟
هل يكون هؤلاء الشباب أُلعوبة بيد جهات معينة تريد زعزعة أمن البلاد واستقرارها، أو تقصد إلى التضييق على العمل الإسلامي والدعوة إلى الله تعالى؟
هل سيدخل المغرب مرحلة جديدة وغير مسبوقة في تاريخه الأمني والاجتماعي، وهل ستنجر البلاد وراء المغرضين الذين يعملون في الخفاء لتهديد السلم الاجتماعي والتعايش المجتمعي؟
هل ما حدث في تلك الليلة هو حلقة أولى في مسلسل الضغط على الحركات والأحزاب الإسلامية، والتضييق على الدعاة والعلماء والنشطاء الإسلاميين؟ أم أنها لا تعدو أن تكون فعلا إجراميا معزولا قام به مجموعة من الشباب المهمش والمحروم الذي لم يتلق تربية دينية سليمة؟
ارتسمت حينها بين عيني أياما سوداوية تنتظر البلاد، وكثيرا من العباد.. كانت الاعتقالات العشوائية قد بدأت بُعيد التفجيرات الإرهابية مباشرة؛ فاعتقل بسببها ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص.. وأصبح لا حديث في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية إلا عن الإرهاب والإرهابيين، ومُرر قانون مكافحة الإرهاب بسرعة البرق وبالإجماع، وحتى في الشوارع والمقاهي والنوادي والتجمعات، كُنت أمر بالشارع فتُلاحقني الأعين بنظراتها الساخرة، وأسمع تمتمات الناس وهم يقولون: لا زال أصحاب اللحى يذهبون ويجيئون، كيف لم يُعتقل هذا؟ ومرة سمعتُ أحدهم يقول بصوت مسموع وكأنه يوجه كلامه إلي: لعنة الله على الإرهابيين حولوا حياتنا إلى جحيم !!
كنت أمر بالشارع وأنا خائف أترقب؛ فرجال الأمن لا يُفلتون من رأوا شعرا نابتا على ذقنه، يتجولون بالشوارع ويُنزلون الناس من الباصات وسيارات الأجرة في الحواجز الأمنية التي انتشرت بكل شوارع مدينة فاس، ويقفون بأبواب المساجد ينتظرون خروج المصلين الملتحين..
كُنت أحيانا أمر ببعض المحلات لتصفح الجرائد والتقاط آخر الأخبار، فلا أقرأ إلا خبر اعتقال شخص هنا أو هناك، أو نبأ تفكيك خلية نائمة أوشكت على الاستيقاظ !! أو عصابة إرهابية كانت تُخطط لاستهداف أماكن حساسة بالبلاد.. فأتساءل مع نفسي: أين كانت هذه الخلايا كُلها؟ وكيف ظهرت فجأة بهذه السرعة الخيالية؟ هل هي حقا خلايا إرهابية، أم هو أسلوب لإرهاب الخلايا والبرايا؟ !
ضاقت علي الأرض بما رحُبت، وتنكرت في نفسي الأرض التي أصبحت أمشي فوقها؛ فلم تعد الأرض التي كنت أعرفها، ولا المساجد التي كنت أرتادها، ولا الشوارع التي كنت أتجول فيها..
ثم جاءت لحظة الابتلاء، ففي ذات مساء حزين من شهر أكتوبر من نفس السنة ألحت علي أمي وبالغت في الإلحاح على غير عادتها أن أُؤجل الذهاب لفاس إلى الصباح.. لا أدري لماذا؟ هل لأن قلب الأم يشعر ويُحس.. أم أن الأخبار التي كانت تسمعها تلك الأيام زادت من مخاوفها؟ كانت السماء حزينة وكئيبة.. ولا أدري أيضا لماذا؟ هل لأن فصل الخريف هو موسم الكآبة والحزن كما يقولون، أم أن السماء كانت تُشارك أمي بعض مخاوفها..
في المحطة الطرقية استوقفني شرطي وطلب مني بطاقة تعريفي الشخصية، ثم احتجزني داخل غرفة ضيقة بالمحطة مع شخص آخر كان فاقدا لوعيه بفعل المخدرات والكحول، كانت الغرفة شبه مظلمة، ورائحة البول تنبعث من أركانها، ولم تكن رائحة صاحبي داخلها أقل قذارة منها، لقد كانت رائحته كريهة كرائحة منبعثة من كنيف في ليلة صائفة اشتد حرها، وبعد مرور هُنيهة انضمت إلينا فتاة في مُقتبل عمرها، ممشوقة القامة، سوداء العينين، قد انشق الثوب في أعلى صدرها، فعلمت أنها من بائعات الهوى المحترفات في بيع دفئهن ونعومة أجسادهن بدراهم معدودات، لسماسرة العشق وأرباب المسامرات..
في مركز ولاية الأمن سألني المحقق عن اسمي واسم أبي وأمي وإخوتي، وطلب مني أن أحدثه عن حياتي كلها، من يوم حملت بي أمي إلى حين مثولي أمامه، وألا أذر صغيرة ولا كبيرة، وألا أهمل شيئا مهما كان تافها.. وأمضيت هناك أسبوعا كاملا لا يعرف بمكاني أحد، وبت ليلتين بغرفة لا يُطفأ نورها، بها فراش رث قديم تنبعث منه رائحة العرق والبول، فاستلقيت فوقه مُعصب العينين ومُقيد اليدين إلى الخلف، لا ماء ولا طعام، وكم دندنت مصاريني في تلك الليلتين الكئيبتين من نغمات ومقامات موسيقية حزينة، كنت أصلي بلا طهارة عندما أسمع الآذان، حاولت أن أرى بأذني، وأتسمع من حولي الهمسات ووقع الأقدام، ومرت بذهني حينها أشياء كثيرة، ذكريات جميلة وأخرى حزينة، وكان أشدها حزنا وألما مشهد والدتي وهي تقف مودعة لي في ذلك المساء الحزين، فبدا لي وجهها من وراء ظلماتي الثلاث شاحبا من الحزن والألم، وحدثني قلبي أن قلبها أخبرها بما قد وقع لي، وسمعت صوت والدي وهو يهمس في أذني بلطف وود أن أحلق لحيتي وأكتم إيماني في قلبي، فراودني إحساس بالذنب بسبب ما سببته لوالدي من ألم وحزن، ولم يكن يُسلني عنه إلا اعتقادي الجازم بأنه لا مفر من قضاء الله وقدره، وأن الأمور ستسير سيرها الذي كتبه الله لها في الأزل، ولم يؤنسني حينها إلا ترديدي سرا لآيات من القرآن الكريم، ولم يكن لي حل آخر سوى الانتظار، انتظار الحمل المسكين لما سيقرره في حقه الذئب الجزار.. ثم جاء الفرج وأُلحقت بمجموعة من المعتقلين احتياطيا وأزيلت عصابة عيني وفُك قيد يدي، وشاركني بعض المعتقلين من مروجي المخدرات طعامه وشرابه..
انتهى التحقيق بعد خمسة أيام ونصف اليوم، ومع أن قانون المسطرة الجنائية كان ينص على أن المعتقل احتياطيا لا يتعدى 48 ساعة؛ فإن رجال الضابطة القضائية كانوا أكرم من أن يتقيدوا بهذه المدة القليلة، فآثروا أن يُضعفوها لي.. لقد ظلت كلمات المحقق تتردد في ذهني في ظلمة تلك الليالي، وكانت تبدو لي ساذجة تافهة لا قيمة لها، لكن صوتا كان يرد علي من داخلي: ألم تُوزع آلاف السنوات من السجن على مئات الأشخاص بسبب ما تعتقد أنت أنه تافه وساذج؟ ألم يقل لك المحقق: إن هذه الكتب ما سمحنا ببيعها إلا لنصطاد بها الطرائد مثلك؟ ألم يبشرك ضابط الشرطة القضائية بأنه أعد لك تُهما لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات سجنا؟ فلا تسمح لنفسك أن تكون أنت الساذج الأبله، وفوض أمرك لله تعالى، ثم استسلم للأمر الواقع..
تلا علي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التهم المنسوبة إلي، كانت ثقيلة جدا تصل عقوبتها إلى المؤبد؛ أذكر منها الآن: تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والسرقة الموصوفة، والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، وتوزيع منشورات تدعو للعنف، وانتحال وظيفة نظمها القانون… وفي اللائحة ستة وثلاثون ضحية !! تحديته أن يُواجهني مع واحد منهم !! ونفيت كل المنسوب لي، لكن الوكيل العام قال لي: لماذا وقعت المحضر إذا كان هذا كله كذبا؟ فقلت له: لقد أُرغمت على توقيع المحضر دون أن أطلع عليه، ويجب أن أحال على قاضي التحقيق لأن الجرائم المنسوبة إلي خطيرة جدا، وأنا بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.. لم يجبني لطلبي وأحالني مباشرة إلى السجن المحلي عين قادوس بفاس.. وعندما ولجت تلك البوابة العالية الزرقاء، تناهت إلى سمعي أصوات السجناء من وراء الأبواب الحديدية، ووصلني ضجيج الأصوات وصخب الحياة من وراء الأسوار؛ فزال خوفي، وزادت عزيمتي، وقويت همتي وأنا أهيئ نفسي لاستكشاف ما وراء هذه الأسوار العالية التي كنت أمر بجانبها مرارا دون أن يدور بخلدي أنه سيأتي علي يوم من الأيام فأصير داخلها، وما هي إلا لحظات حتى صرت وسطهم، واكتشفت بنفسي ذلك العالم البئيس الذي يحيا وراء الطبيعة، صحيح أنني وجدت نفسي بداية في وسط غريب لم أعهده ولم أألفه، ولكن لم ألبث إلا بضعة أيام حتى انصهرت في بوتقته، وليس حديث العهد بالسجن كمن بعُد عهده به حتى أصبح من أهله ورُواده، وورث لغته واكتسب عاداته..
وبعد جلسات مارطونية بمحكمة الاستئناف كانت العقوبة كما وعدني ضابط الشرطة القضائية: خمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، ثم خُففت العقوبة إلى سنتين وزادت الغرامة إلى ثلاثة آلاف درهم.. وكانت العقوبة الكبرى اغتصاب مكتبتي التي أنفقت فيها كل ما أملك في سنوات الدراسة..
هناك داخل السجن التقيت أصنافا من الناس، وفي لحظة واحدة وجدت نفسي بين أصناف من البشر، فيهم الشريف الكبير والوضيع الحقير، فأحسست كطائر وديع وُضع في قفص حديدي مع السباع الضارية والطيور الجارحة، وعاشرت كل أصناف المجرمين، من قتلة ومروجي مخدرات وسراق وزناة، ورويدا رويدا بدأت أعتاد حياتي الجديدة.. وكان أبشع ما رأيت هو ذلك الشاب الذي حُكم بالإعدام بسبب قتله أمه، كان منبوذا داخل السجن لا يُكلمه أحد، تلاحقه نظرات السجناء الساخرة وكلماتهم الجارحة.. ولم يكن السجان بأحسن حال من المسجون، وكان أولئك السجانون يختلفون فيما بينهم اختلافا شديدا؛ فمنهم اللين الهين، والحازم الصارم، ومنهم المازح الباسم، والعبوس الكاشر، ومنهم المثقف العالم، والأمي الجاهل، ومنهم اللبيب الذكي، والأحمق الغبي، ومنهم الظلوم الغاشم، والمنصف العادل.. وهناك بالسجن المحلي أوطيطة 2 كانت المعاناة أقل؛ فكل السجناء سجناء رأي، لا تسمع إلا الأصوات وهي تعلو بتلاوة القرآن وحفظه، وليالي رمضان كانت لها نكهة خاصة بفضل صلاة التراويح بساحة السجن.. هناك كل سجين له قصة خاصة، يبدؤها بالبكاء ويختمها بالضحك.. ومضت السنتان بحلوها ومرها، بآلامها وآمالها.. وعانقت الحرية من جديد، وليس عندي شيء أقبح من الزج بمظلوم في السجن بلا جريرة ولا جريمة..
واليوم، وبعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة عجاف على تلك الأحداث الأليمة، لا زال هناك داخل السجون ضحايا لهذه الأحداث الإجرامية، لم يقترفوها بأيديهم ولم يرضوها بقلوبهم.. ولم يعرفوا إلى الآن من هو فاعلها الحقيقي.. هؤلاء الضحايا المنسيون وراء القضبان خلفوا وراءهم ضحايا أبرياء من النساء والأطفال.. لا ندري كيف يعيشون، ولا كيف يدرسون، ولا كيف يشعرون وهم يكبرون بعيدا عن حنان آبائهم وعطفهم ورعايتهم.. ألم يأن للمسؤولين بعد أن يعملوا بجد لوضع قطيعة مع هذا التاريخ الحزين من تاريخ المغرب الحديث، وإصلاح الأخطاء الجسيمة التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء، وعقد مصالحة وطنية تجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارت وتحفظ حقوق المواطن وتضمن كرامته؟
لقد أقر ملك البلاد بوجود خروقات قانونية في هذا الملف في تصريحه لجريدة ألباييس سنة 2005، ووصف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد العفو الملكي الصادر في حق الكتاني والحدوشي وأبي حفص بأنه تصحيح لخطإ ارتكبته العدالة، فهل نستبشر خيرا بطي كامل لهذا الملف الذي عمر قرابة عقدين من الزمن؟ وإلى متى سيظل أولئك الضحايا المنسيون خلف القضبان ينتظرون تصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها العدالة في حقهم؟ ومتى سيعرفون من خطط لتلك الأحداث الإرهابية التي قبرتهم في السجون والمعتقلات؟ ومتى ستشكل لهم هيئة إنصاف ومصالحة تُرغمهم على مسامحة الجلاد؟ وكيف صدر العفو في حق الرؤوس والقادة، وحُرم من ذلك الأتباع والضعفاء؟
إنني أومن بأن الحوار هو الخيار الأنسب لحل هذه الأزمة؛ فلسنا نرغب في تفريخ خلايا تؤمن بخيار التكفير والتفجير، ولسنا نرضى ببقاء ضحايا برآء خلف القضبان.. وإن الدولة لتعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء المعتقلين أبرياء، وأن المخالفات التي ارتكبتها قلة قليلة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات كأقصى تقدير؛ فهل تملك الدولة الشجاعة لتصحيح ما ارتكبته في حق فئة من أبنائها وفلذات كبدها؟ وإن قرارا شجاعا واحدا لكفيل بإنهاء الكثير من الآلام والأحزان.