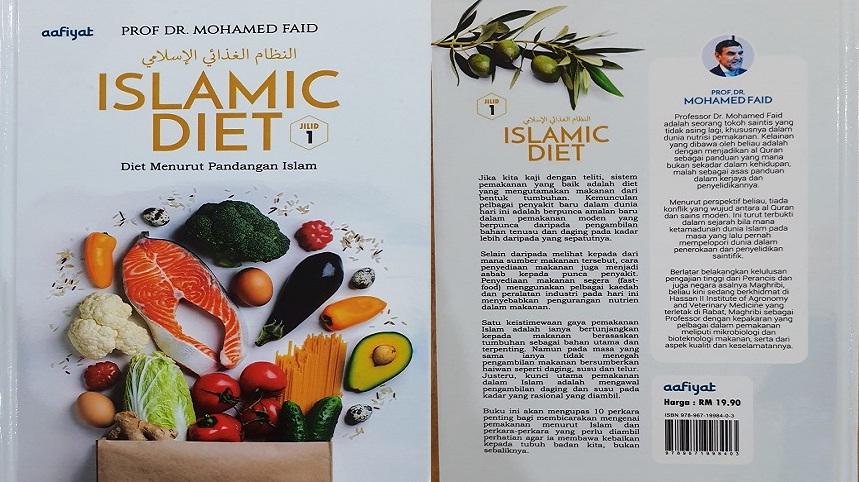عيدُ المسلم

هوية بريس – أيوب بولعيون
اعتادت الشعوب والمجتمعات والأمم منذ القدم، باختلاف ألوانهم، وأجناسهم، وأديانهم، وثقافاتهم المتنوعة، على تخصيص مناسبات خاصة، سواء كان لها ارتباط بالدين أو بالثقافة والتاريخ، والموروث القديم عامة، أو مزيج من هذا و ذاك، لأجل الاحتفال والفرح، وتمتين علاقة الإنسان كظاهرة مركبة، بالماضي والحاضر والمستقبل، وإثارة مشاعر البهجة والسرور في القلوب، بما يسمح بتجديد الحياة الفردية والجماعية ومواصلتها بروح فتية، مشبعة بالمعاني الجليلة، الدافعة للإستمرار في العيش كاستحضار معاني المجد، و التضحية، والحب، والغيرية، والوطنية، والبطولة، والفداء، والمقاومة، والوفاء، والإخاء، الصدق…، التي وسمت الملاحم التاريخية الكبرى، و خلدتها في سجل التاريخ، و كذا قصص وسير العظماء الزاخرة بالدروس، والعبر، والقيم، إلى غيرها من معاني الأخوة الإنسانية، والتسامح، والتعايش، والترابط الأسري / القبائلي، والتضامن، والتكافل، والتآزر الاجتماعي…، فلكل أمة مسلكها الثقافي التاريخي الذي تعزز به انتمائها لنفسها و تقوية المناعة الثقافية و تحصين الهوية الحضارية.
في كل عيد ومناسبة احتفالية، قيم كثيرة يتم إحياؤها “لِمَعْننة” الحياة، عبر مجموعة من الطقوس، والممارسات، والمظاهر الاحتفالية، سواء لها خلفيات دينية تعبدية، أو تاريخية، واجتماعية محضة، تجعل من الشخص يتشبث ويتشبع بهُويته، ويتفرد بها، مع ما يمنحه ذلك من شعور أصيل بالحضور في الوجود، والاختلاف مع الآخرين من الشعوب والقبائل، والمجتمعات، ما يتيح للإنسان فرصة التواصل والتعارف والتثاقف في جو من الثقة و الحرية، بعيدا عن مظاهر الانغلاق والتعصب العرقي والديني…؛ التي تؤدي لإقصاء الآخر بدافع أفضلية النَّحن على الهُم ، وهو الخطاب الذي يوَلّد العنف و الاضطهاد في أبشع صوره، كما سجل لنا التاريخ في ذلك كثيرا من الشواهد. من جهة أخرى يسعى تعُّرف المرء على هُويته بطرق سليمة تحفظ للإنسان حجمه، إلى سد منافذ الانسلاخ والانصهار في “ثقافة غالبة “أو مستوردة من الخارج، وأحيانا _وهو الأمرُّ_ تحت دعوات الانفتاح على العالم، إلا أن الانفتاح بمعناه الحقيقي من ذلك براء، بل هي مسالك تقود الذات إلى غياهب ” المجهول والاغتراب”، وتجتثها من جذورها و تربتها. إن كل تخلٍّ عن الهوية الأصلية، أو التنكر لها، انتحار هوياتي، تيهان، ومساسٌ بحرمة “الاختلاف”، والتنوع الثقافي الذي يجمعنا و يوحدنا و يحمي وجودنا من الانقراض . يقول الله تعالى في كتابه المبين : (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير(الحجرات الآية 13.
نظراً لما تلعبه الأعياد بصفة عامة، من دور كبير في إضفاء البهجة والجمالية على الحياة، وإحياء روح الفرح بين الناس، وترسيخ الهوية وتجذيرها في تربة الإنسان الثقافية، والتاريخية، والدينية العقدية، والحفاظ عليها من التلف، والذبول، و الموت، خصوصا في عصر غطرسة وزحف العولمة، على كل ما هو محلي وخصوصي في بلاد العالم، سواء فيما يتعلق بالشق المادي الاقتصادي أو الفكري والثقافي، فقد أعطى الإسلام مكانة مرموقة للإحتفال بأعياد لها رمزيتها ودلالاتها وحمولتها الدينية والهوياتية. أعيادٌ خاصة بالمسلمين في كل زمان ومكان، تشكل عندهم فرصة لإحياء ثلة من القيم، والمعاني النبيلة، وتصيغ الشخصية الإسلامية في مظهرها وجوهرها، انطلاقا من روح القرآن الكريم، والسنة المطهرة.
لهذه الأعياد الدينية السامية، جانب اجتماعي كبير داخل حياة المسلم، وهو ما يتجلى في المشاعر الدافئة الرابطة بين مختلف أفراد المجتمع، والأمة الإسلامية قاطبة، باختلاف طبقاتهم، ومناصبهم، وعرقياتهم، ليكون العيد بهذا المعنى مناسبة لتوحيد الجميع تحت عقيدة واحدة ومصير مشترك، دون أن يقود ذلك لتنميطهم، وقتل اختلافاتهم الفرعية. كما أن لها جانبا تعبديا، مرتبط بالشعائر التي أمر الله المسلم بإحيائها، وإقامتها كما يجب، وعدم إفراغها من معانيها الأصيلة المقصودة، وتحويلها إلى أشكال وطقوس نمطية، اجتماعية محضة، يسري عليها قانون التكرار والإعادة الميكانيكية، ما يمكن أن يؤول إلى آبتذال هذه المناسبات، وآستصغار شأنها وقيمتها، بالأخص في زمن “الجهل والتجهيل”؛ زمن احتقار الذات وتبخيسها، في مقابل الانبهار بالآخر والتعلق بثقافته ومظاهر حياته. يقول الله تعالى في سورة الحج (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ) الآية 30.
إن عيدَ المسلم، هو فرصة لإشاعة روح الفرح، والسعادة بين الأقارب والجيران، والأحبة والأصدقاء، فرحٌ بشكر الله على النعمة والعطية، والاعتراف بالمِنح الإلهية، ما علمنا منها وما جهلنا، التي تحيط بنا دون أن نستشعرها ونبصرها (وأما بنعمة ربك فحدث) الضحى، الآية 11. فرصة سانحة لتبديد الغشاوة التي تلف بصائرنا وقلوبنا المتشعبة التائهة؛ تحت ضغط الأيام الرأسمالية، وعجلة انشغالات الدنيا اللاهثة، التي تجعلنا في حالة شكوى، وقلق وتذمر، وتبلُّد الإحساس، مما يصيب الانسان بعمى التكيف؛ ليكون حينها عاجزا عن إدراك قيم الأشياء الحقة. بهذا المعنى، يكون العيد يقظة في لحظة صفاء وجلاء، ينظر فيها المرء بعين الباصرة ونور العقل، لتجديد الرؤية و تكسير بنية التفكير الاجتراري الذي أزال الروعة و الرونق من الحياة.
العيد أيضا، عودة للحياة الأسرية والاجتماعية التي تشكل النواة الأولى لقيام المجتمع المسلم على أسس ومبادئ أخلاقية صلبة، تُكسبه المناعة الثقافية اللازمة لمواجهة كل غزو خارجي محتمل، فلا معنى للعبادة دون الصّلح مع الآخر، جارا كان أو أخا أو صاحبا… وتجاوز الحقد والبغضاء والعداوة، وكل الأفكار والمشاعر التي تُسعر نيران الفتن وتعيث فسادا وخرابا. عُموما، لا تستقيم علاقة جيدة مع الله، ما لم ترافقها علاقة مع الإنسان، يُنظمها الاحترام المتبادل، و تنسجها لغة التراحم و التعاون، سواء كانت تجمعنا معه العقيدة، أو الثقافة، أو الوطن… أو تجمعنا معه النفس الواحدة، مصداقا لقوله تعالى في مطلع سورة النساء : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا). إن كرامة الإنسان، ليست حكرا على أصحاب عقيدة ما دون أخرى، ولا نصيب مذهب دون آخر، ولا نتاج ثقافة دون غيرها من الثقافات، ولكنها لبنى آدم كافة دون تمييز أو تصنيف. يقول عز من قائل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) سورة الإسراء الآية 70.
إن العيد في الإسلام ليس عيد الفرد الواحد، بله عيد الأمة بأفرادها جميعا، الذين يجمعهم رابط الدين و العقيدة.
أعيادٌ نتقرب فيها وبها إلى الله، وإلى بعضنا البعض، بتقليص الهوة التي أحدثها عصر “الفردانية و موت الحميمية”، وذلك بالرفع من جودة مشاعرنا الإنسانية الدفينة الراقدة في كهف “التقنية و الآلة”، هذه التقنية المهيمنة، التي عبر عنها بودريار “بالانتاج الدائري للعزلة”. والنظر للحياة “كقيمة” نفيسة، لا تُشترى ولا تباع، ولا يمكن استبدالها بما هو أدنى خاضع لسلطة الثمن. الحياة كأعظم النعم التي أهداها الله لنا، لنفرح بوجودنا، وبما عندنا من هُوية بمعناها الواسع، ونتموضع داخل الإطار المحدد لغائية عيشنا، على نقيض كل معاني العبث و السيزيفية التي تقطر بها بعض الفلسفات الوضعية، للإعتزاز والاعتداد بالذات، مصدرهُ العبودية لله، و التحرر من عبودية “الرأسمالية المتوحشة ” التي سلَّعت الإنسان، وحولته لكائن استهلاكي ينتصر فيه البُعد الحيواني، وتحركه بواعث الشهوة و اللذة الآنية. إن المتأمل في الإسلام يجد أنه ليس فلسفة للاستهلاك و اتباع الشهوات و لكنه فلسفة إنتاج للقيم و المعاني، فلسفة تؤمن أن الوسيلة في خدمة الغاية وليس العكس.
إن الفرحَ الذي يصاحب العيد هنا، ليس عاطفةً مؤقتة تثيرها طقوس فلكلورية، بل خيار، وفعل إرادي، ومهمة إيمانية، مطلوبة وشاقة، تمزج بين الايمان والشكر والحمد والأمل، يؤجر عليها العبد كما يأثم على القنوط والجحود، وذلك ضدا في كل الفلسفات الباطلة، الداعية للتشاؤم واليأس كرد فعل انهزامي سلبي تجاه مآسي الحياة ومصائبها. يقول الله تعالى في مُحكم تنزيله :(وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) سورة يوسف،.
فما هي أعياد المسلمين، وكيف نستثمرها لترسيخ قيم هويتنا وثقافتنا التي تؤطر حياتنا؟
جعل الله للمسلمين عيدين اثنين كل عام هجري، فيهما يعبر الإنسان المسلم عن هويته وفرادته الفكرية والدينية، في زمن يكاد يكون كل أفراده نسخة واحدة، أتباع نظام عالمي عولمي أحادي، يسعى بكل الطرق والوسائل للهيمنة، عبر تسويق صِنعته، والتحكم الثقافي والاقتصادي على بلدان العالم. هذان العيدان هما : عيد الفطر وعيد الأضحى، وتجدر الإشارة أنهما مرتبطان بركنين من أركان الإسلام الخمسة، وقد نفهم من هذا الارتباط الوثيق، أن الله يدعونا للاعتزاز بهذا الدين العظيم، لأنه أعطى الإنسان الحق أن يفرح بعبادته، ويعبد بفرح وحب، بفطرته السليمة التي فُطر عليها، لا أن يعبد ويتقرب إلى الله مُكرهاً، بوجه عبوس يقطر تجهما وقسوة، يثير في النفوس النفور والحيرة، لأن الرسالة في أصلها و نبعها الصافي، رسالة رحمة ويسر وإقناع، لا رسالة إكراه وعسر.
إن كلمة « العيد » في التصور الإسلامي، جامعة لكل معاني العبادة وتقدير الحياة وآحترامها، وإعمارها بالخير والاصلاح، بما يجعلها نعمة إلهية جديرة بالشكر، باعثة على الامتنان. كما أن العيد هنا يجمع بين علاقة الإنسان بأخيه، التي تضبطها علاقة الإنسان بالله، وذلك في صورة بديعة متماسكة ينسجها خيط الإيمان والإحسان.
عيدُ الفِطر مناسبة دينية تعبدية، يشترك فيها جميع المسلمين من كل بقاع المعمورة بمختلف جنسياتهم وألوانهم ولغاتهم…، فُرصة يفرح فيها المُسلم بصيامه وقيامه وعبادته طيلة شهر رمضان الأبرك الأغر، بعد إخلاص النية لله وحده، وضبط النفس، وتطويعها استجابة للأمر الالهي، ليكون العيد احتفالا و اعترافا إلهيا جليلا بمجهود و” ميلاد “عمل يستحق الذكر والتقدير، هي آية يقرأ فيها المرء هذه العلاقة الرابطة الحية التفاعلية بين العبد وربه، تجعل من الإيمان والرضا والعبودية لله، معانٍ تتجاوز كل مظاهر الوثنية الجافة التي تعود بالإنسان للجاهلية الأولى و تسجنه في الحيز المادي الجامد.
مناسبةٌ جعلها الله هدية للمسلم الموقن، يفرح فيها الأطفال بصدق حقيقي مع بعضهم، يجتمع فيها الكبار العقلاء الراشدين، ذوي القلب السليم، متحابين في الأصل الديني الواحد و العقيدة الغراء، لإحياء المعاني الجليلة التي ينضح و يزخر بها دين الإسلام العظيم، وإعادة ربط العلاقة بين جميع فئات المجتمع و بين الأجيال التي باعدت بينها التكنلوجيا ومواقع الانفصال الاجتماعي، ربطا يقوي عرى المجتمع و يحميه من دواعي التشرذم و الانهيار والخبط، وذلك بإفشاء السلام، صلة الرحم، التسامح، الكلمة الطيبة، تجاوز الخصومات و العداوات والبغضاء، إسعاد الفقراء والمحتاجين(زكاة الفطر) ، تقديم الهدايا، نشر الابتسامة كأعظم الصدقات…،وغيرها من السنن التي تقوي أواصر المجتمع المسلم وتجمع بين الأطفال و الشباب و الآباء والأجداد في صور أسرية منسجمة مترابطة صلبة، معاني تقي المجتمع من التيهان والتفكك والتشرذم في عالم تعصف به رياح العولمة التي تستهدف الأسرة وتسعى لتقويض أركانها عبر أفكار مسمومة هدامة تبدو في ظاهرها جذابة مغرية. عالم يواجه نزعة التنميط وقتل الهويات، وتوحيد الجميع على أساس نموذج واحد متغطرس يسعى لنزع الأفراد من التاريخ والثقافة والقيم ، وكل ما بإمكانه أن يشكل شرطا ضروريا للحفاظ على تنوع الحياة، وفتح المجال للتواصل والتعارف بين الشعوب و الأمم. إن كل أمة مطالبة في هذا العصر أكثر من أي وقت آخر، بالحفاظ على هُويتها التي تشكل أصالتها وتصون وجودها ضد تيارات الغزو الرأسمالي.
إلى جانب عيد الفطر، جعل الله عيد الأضحى، فرصة ليتعرف الإنسان المسلم على هويته الزاخرة بالمعاني والقيم، خصوصا لارتباطه بركن الحج، حيث يحتفل الحجاج – والمسلمون قدوة بهم – كل سنة هجرية من ذي الحجة، بعد أداء جميع المناسك والشعائر (الطواف، السعي بين الصفا و المروة، رمي الجمرات، يوم عرفة..) بشعور الصدق والإخلاص، مستحضرين رمزية القصة الابراهيمية التي خلدها القرآن الكريم، لما لها من أهمية في مَوْضعة حياة الإنسان أمام أسئلة الإيمان الكبرى، وتوجيهه نحو إعادة النظر في حياته التي تتأرجح بين الأنا والإيثار، بين نزعة التملك و الحيازة و بين روح فدائية تتجاوز جمود المادة. إبراهيم الذي كان نموذجا ودرسا عظيما في الاستجابة لأمر ربه دون اعتراض أو استنكار، إبراهيم خليل الله المعجزة الذي ضحى بأغلى وأعز ما يملكه رجلٌ بلغ به العمر عتيا. إن المعجزة الحقيقية التي تشكل أمامنا تحديا للفهم، هو إبراهيم الخليل واسماعيل الذبيح، إنه منطق الإيمان الذي يتجاوز حسابات العقل المحدودة الضيقة.
ينظم هذا العيد العلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه وبينه وبين الإنسان الآخر، وذلك عبر منظومة قيمية أخلاقية تعطي لكل ذي حق حقه عملا بالعدل الذي جعله الله قانونا وسنة تحفظ للحياة استمرارها. وينضاف لهذا المثلث بُعد آخر، وهو طبيعة العلاقة التي يجب أن ينسجها الإنسان مع الحيوان، فعلى عكس ما يدعيه البعض – وهم يجهلون أو بالأحرى يتجاهلون حقيقة الإسلام – أن هذه المناسبة تعبير عن القسوة، والتعطش لتعذيب الحيوان وإراقة الدماء، فإن المسلم العارف بدينه، الدارس لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعي جيدا أن الإسلام كفل للحيوان حقوقه، وأن الحضارة الاسلامية في أوج ازدهارها مقارنة بالحضارات الأخرى، كانت نموذجا مشرفا في التعامل مع الحيوان، ولا يكفينا المقام هنا لذكر النصوص والمواقف التي تفيض بمعاني الرفق والحنو والرحمة على الحيوان، بل يكفي التذكير بالحديث النبوي الشريف، الذي أعلن فيه النبي الكريم قواعد و آداب الذبح، حيث يقول: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته). عموما، كانت الحضارة الإسلامية تقيم مؤسسات اجتماعية للعناية بالحيوان و تطبيبه وتأمين معيشته عند العجز و المرض، ونهى الإسلام وتوعد من يقسو على الحيوان بكل أشكال التعذيب والإرهاق والتحقير و اللهو به، فالحيوان في الشريعة كيان، له أيضا خصائص وشعور و طبائع يجب الاعتراف به و احترامه. يقول الله تعالى في سورة الأنعام الآية 38 {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ).
خلاصة القول، أن ديننا الحنيف الذي يعتبر من مبادئ وجودنا و مرتكزات حياتنا، ومكونا من مكونات هويتنا التي نتعرف من خلالها على أنفسنا والآخرين، جاء بكل أسباب العيش الكريم و بجميع مقومات الشخصية الإسلامية بجميع أبعادها العاطفية الاجتماعية، الاقتصادية، الأخلاقية…، و بكل ما يمكن أن يُشبع الإنسان هُوياتيا ،ويدرأ عنه أسباب الخواء و التفكك والتيهان الوجودي و السيولة و الذوبان…، وعليه يجب أن ندرس ونفهم أن واجبنا الآن أمام أنفسنا وأمام الأجيال القادمة هو توجيه بوصلة التفكير نحو ما يمكن أن يصنع لنا صورة واضحة أمام العالم، في زمن التشتت و التشبه بأقوام أخرى، زمن تصارع القيم و الهويات الجديدة العابرة التي تنتشر وتتكاثر بسبب الفراغ، زمن بزوغ عالم بلا تاريخ ولا هوية ولا ثقافة ولا دين يرشح لنا أنماطه و نماذجه، وهو ما يمكن أن ينتهك غنى الحياة، ويحولها لسوق تجارية يخضع فيها الجميع لسلطة المادة بما في ذلك الإنسان.
إن أكبر تحدي يواجهنا هو أن نقرأ لنعرف، لأن المعرفة قوة وثقة، وهي الجديرة بإنقاذنا أكثر من أي شيء آخر، قراءة تجعل من صاحبها يقف مقتنعا أمام العالم قائلا : لكم دينكم ولي دين. مسؤوليتنا أن نتعلم ونعمل، لأن الإنسان عدو ما جهل.