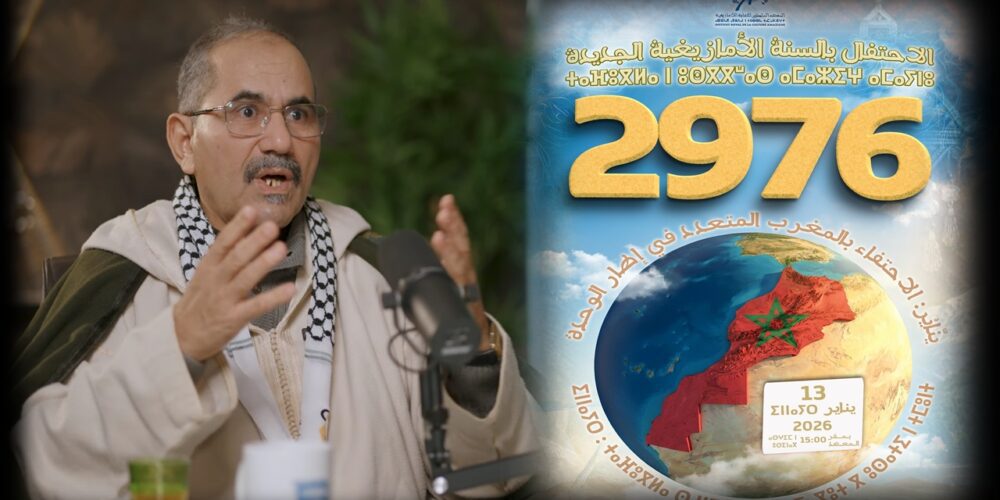كرة القدم وسؤال الهوية

هوية بريس – حسن المرابطي
اِعلم أن تنظيم كأس العالم لسنة 2022 بدولة قطر أثار من الانتباه ما لم يحظ به من قبل في النسخ الأخرى، وذلك لعدة أسباب؛ فمنها ما كان مباشرة بعد قبول ملف الترشيح من دولة إسلامية عربية، ومنها ما كان قبيل الافتتاح؛ لكن ما كان له وقع خاص، ويبدو أنه سيساهم في تغيير مجموعة من الأمور، وربما سيقلب بعض المواقف ويؤسس لمفاهيم جديدة في التشريعات القانونية مستقبلا، هو ما كان بعد تحقيق المنتخب الوطني المغربي نتائج غير متوقعة وما صاحبه من تعاطف جميع الشعوب الإسلامية والإفريقية، حيث بلغ المربع الذهبي واحتل بذلك الرتبة الرابعة.
رغم ما يقال أن كرة القدم، والرياضة عموما، يجب إبعادها عن السياسة والدين، إلا أن واقع الأمر يثبت غير ذلك؛ بل نجد أن مثل هذه التظاهرات يتم استغلالها أبشع استغلال لتمرير بعض المواقف السياسية، فضلا عن تنافس كل الأطراف في نشر ثقافتهم وقيمهم؛ لذلك لم يكن من الغريب أن نشهد من يدافع عن نشر ثقافة الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية كما يصطلح عليه حتى يخففوا من وقع الرذيلة )، ولا من يحاول قدر الإمكان التعريف بثقافته وقيمه الدينية؛ وخلاصة القول: إن تنظيم كأس العالم يعتبر فرصة مهمة لكل من يحمل رسالة في هذه الحياة من أجل إيصالها للآخر؛ ولا بأس من أن نذكر بمبدأ قرآني وهو أن الإنسان من عادته تمني أن يكون غيره مثله ومقتنع بما اقتنع من الأفكار والقيم؛ وربما يمكن صياغة ذلك على الشكل التالي: “إن الإنسان يذكر غيره إن هو ذكر الله، ويدعو لنسيانه إن هو نسي“.
وعليه، فإن تأمل كل الأحداث التي صاحبت تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم تبين أن الجميع يحاول، بشكل أو بآخر، فرض هويته بالصيغة التي يؤمن بها؛ بل إن حفل الافتتاح الذي يعتبره البعض متحكم فيه لنشر القيم الإسلامية لم يسلم من الانتقاد لأنه تضمن الكثير من الأشياء والاشارات التي تخالف الإسلام؛ ولا شك أن من تابع الأحداث حينئذ تفطن لذلك، لأن اختيار الشخصيات التي افتتحت الحفل وكذا ما قيل من الكلمات يوحي بوجود من يحاول ترسيخ ثقافة غريبة وبعدها تشكيل هوية إنسان معاصر لا يفرق بين القيم، حتى خرجوا من يعتبرون التسامح والتعايش هو التخلي عن القيم الإسلامية والتسليم بصحة كل الأفكار مهما بدت متناقضة ومتضادة؛ وهذا الموضوع يحتاج لكثير من النقاش، ولعل المقال لا يتسع لذلك، لكن نكتفي بالإشارة حتى يتم التأمل في ذلك.
وبالعودة لما بدأنا به مقالنا، فإن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني ساهم في فتح النقاش عن مسألة الانتماء، وبالتبع التطرق إلى قضية الهوية؛ ولعل كل الشعارات، التي رفعت وترفع إلى حدود الآن، وكذا مجموعة من المفاهيم، يجب إعادة النظر فيها، من قبيل القيم الكونية، كما يسوق لها، بعيدا عن الخصوصية الدينية والإقليمية أو الثقافية بشكل عام؛ لأن الواقع أثبت أن الدعاة إلى هذه القيم فشلوا في تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما تبين خلال مباريات بطولة كأس العالم؛ حيث وجدنا من يُخِّون كل فرد يحمل جنسية ثانية شجع غير فريق وطنه الأصلي؛ بل الكثير من هؤلاء عابوا على أبناء البلاد الإسلامية والإفريقية، العربية منها وغيرها، لأنهم لم يتعاطفو مع المنتخب المغربي (الذي يعتنق الدين الإسلامي، والمنتمي إلى القارة الإفريقية، والأمازيغي أصلا المختلط بالعرق العربي).
وبالتالي، إن التوقف عند بعض الإشارات فقط، دون الإحاطة بجميع الجوانب، تجعلنا ننتبه إلى أن الإنسان، سواء الغربي منه أو الإسلامي، متشبث بأمرين أساسيين لا يمكن له أن ينفك عنهما بسهولة، ويظهر ذلك جليا في أوقات الفرح أو الحزن، بشكل عفوي، لا يمكنه إخفاء ذلك، وهما: انتماؤه الديني والعرقي، وهذا لا يمنع من وجود حالات مخالفة للتصور السائد الذي نأخذ به، لكن الشاذ لا حكم له كما يقال؛ وعليه، فإن المواطن العربي عندما تعاطف مع المنتخب المغربي، وتمنى له الفوز في اللعبة التي تعتبر هامشية، كان وراءه الانتصار للإخوة الدينية أصالة، ومنهم من أخذته الحمية العرقية لاعتبار أن المغرب بلد عربي؛ ونجد نفس الأمر عند أشقائنا الأندونيسيين والماليزيين وغيرهم، فرغم البعد الجغرافي، إلا أن الأخوة الدينية جعلتهم يبتهلون ويدعون بالفوز للمنتخب الإسلامي المغربي.
وهكذا، لو توقفنا مع مجموعة من الإشارات لوجدنا أن تشجيع المنتخب المغربي نابع من هذا الأساس بالدرجة الأولى؛ ولعل أهم ما يقوي هذا الطرح، إضافة لما ذكرناه أعلاه، هو العودة إلى التاريخ واستذكار المعارك التي جمعت بين المغرب وبعض البلدان الأخرى، كالحديث عن معركة الزلاقة وواد المخازن وغيرها؛ في حين أن الأمر لا يستحق كل هذا، لأن مباراة كرة القدم لا تعدو أن تكون لعبة مسلية لا أقل ولا أكثر؛ لكن، ربما، إحساس المواطن -المسلم أو العربي أو الإفريقي- بظلم الدول الغربية، لاسيما دول أوروبا بالتحديد، يجعله يتمنى تحقيق التغلب عليهم ولو في لعبة أسست للتسلية أصلا.
وعلى سبيل الختم، نقول: قد لا يكفي المقام لفتح النقاش أكثر، فاكتفينا ببعض الإشارات فقط حتى نساهم في تأسيس نقاش عقلاني بعيد عن لغة العواطف؛ لذا، فمن مخرجات ما تطرقنا إليه أعلاه، يمكن التنبؤ بحدوث بعض التغيرات في قادم الأيام تكون ردة فعل لما شاهدناه خلال تنظيم بطولة كأس العالم في قطر سنة 2022؛ ولو أننا مقتنعون أن الإنسان الغربي صاحب القرار السياسي الحقيقي، ويدخل ضمن هؤلاء أصحاب التنظير السياسي والفلسفي، لم يكن يغفل تلك الجوانب المشار إليها أعلاه، وأنه مقتنع سيأتي ذلك اليوم الذي يبحث فيه المسلم أو الإفريقي وغيرهم، ممن تعرض للظلم من طرفهم، عن ذاته لإثبات هويته، ولما الانتقام من المستعمر إن لم ينضبط بالقيم الإسلامية التي تسعى لنشر الحرية والحب والسلام.
وعليه فإن أهم التغيرات التي سنشهدها، منها ما يكون في جانب المستضعفين وأخرى عند الغربيين، ولو أننا نميل إلى ظهورها أولا عند الإنسان الغربي وتأخرها عند الآخر؛ حيث سنشهد المطالبة بالنظر في التشريعات المتعلقة بالمهاجرين في الدول الأوروبية بعدما تبين أن الوافد على دولهم يبقى وفيا لوطنه الأصلي رغم كل الإكراهات وينسى الدولة المحتضنة عند أول اختبار؛ ولما فتح نقاش مجتمعي وأكاديمي يبحث في الأسباب التي جعلت كل السياسات لم تفلح في كسب قلوب الوافدين إليهم، وهل ذلك راجع إلى الإبقاء على فكرة المواطن من الدرجة الثانية رغم كل الشعارات المرفوعة والقوانين المسنة في هذا الشأن؟ أم أن الإنسان عصي عن التخلي عن أصله العرقي وكذا دين أجداده رغم كل الفلسفات المنادية إلى المساواة والقيم الإنسانية المشتركة كما يقدمها الإنسان الغربي والمسيطر على المشهد الفلسفي والإعلامي؟
وكل هذا يعيدنا إلى فتح النقاش عن هوية الإنسان التي تتحدد بالدين أولا، وتتأثر بالعرق ثانيا، وأن كل المحاولات الفلسفية المعاصرة لتجاوز هذين المحددين يصعب نجاحها، أو إنجاحها، بل حتى تنزيلها ممن يدعو ليل نهار إلى ذلك.
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.