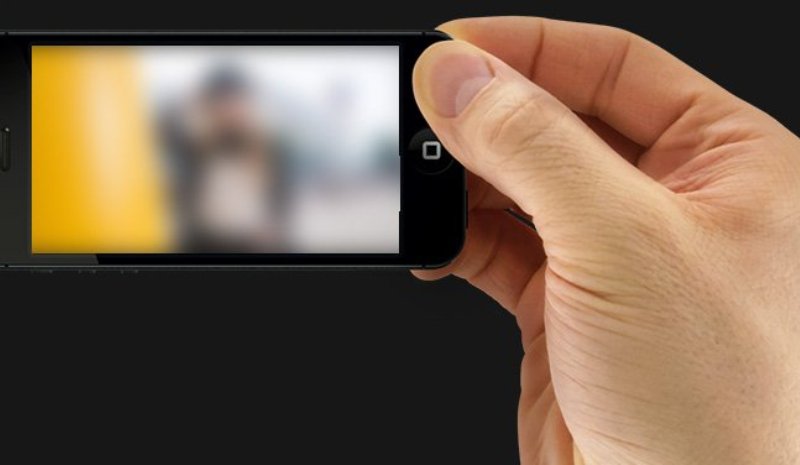كيف فضح إبراهيم السكران تتلمذ الحداثيين العرب على المستشرقين؟

هوية بريس – عاتكة عمر
في كتابه “التأويل الحداثي للتراث” يضع الأستاذ إبراهيم السكران بين يدي القارئ وثيقة متقنة في نقد الاستشراق والأجواء التي رافقت نشوءه في الغرب، ثم يعمد إلى عقد مقارنات بين ما جاء به المستشرقون وما توصل إليه الحداثيون العرب، ليخلص إلى وصف الحداثيين العرب بـ”الشرّاح”، وهو لفظ لا يخلو من تهكم.
وهو في سرده لأقوال الحداثيين العرب وتبيان حالة الانبهار التي كانت واضحة في كتبهم، على اختلاف مشاربهم، يأخذ بيد القارئ ليوصله بنفسه إلى أن النتاج الحداثي العربي ودعوات إعادة قراءة التراث في مجملها إن لم يكن كلّها صورة مكررة لما جاء به المستشرقون، وتلقفها الحداثي العربي.
يقع الكتاب في حوالي 448 صفحة، بوّبه في أربعة أبواب، جعل الأول توطئة للحديث عن الأجواء التي سبقت الحالة التأويلية التي سلكها الحداثيون العرب، مبينًا أن الخطة التي كان من المفترض أن يسير عليها “الشرّاح”، إعادة قراءة التراث بمعنى إعادة صياغة العلوم الإسلامية بالمناهج الإنسانية الحديثة، إلا أن المسار انحرف عن غايته لينصبّ على قراءة الموروث الفلسفي الغربي وتبني نظرياته برمتها.
وهو إذ يعرض في كتابه للكثير من اقتباسات عرّابي التراث الفلسفي الغربي، فهو يعرض في مقابلها منابعها الرئيسية في كتب المستشرقين ويسبكها في النص سبكًا متقنًا، ومع أن الكاتب أسرف بإيراد النقولات والأسماء، إلا أن مهارة السبك ووضوح الفكرة والغاية حالت دون ملل القارئ.
يخلُص الكاتب إلى أن المشاريع التأويلية للتراث مستمدة من أعمال المستشرقين استمداد المقلّد الذي لم يأت بجديد، بل تجاوز الأوائل في نسف الكليّات، فكان من الطبيعي جدًا أن يتبنى الحداثيون العرب موقف الحداثيين الغربيين ويخلصوا إلى إحدى نتيجتين:
– التوفيد: بمعنى رد التراث الإسلامي إلى كونه اقتراضا من حضارات سابقة كتابية أو فارسية، وهذا كلّه إنما يخضع للهوى بلا دليل يدعم فرضيتهم.
– التسييس: أي ردّ التراث الإسلامي إلى كونه حصيلة صراع سياسي، فرض أجوائه على كل مجالات العلوم الإسلامية في العقيدة والفقه وعلوم الحديث.
وقد أسهب الكاتب في شرح هاتين النتيجتين “التوفيد والتسييس” وأفرد لهما بابين في كتابه.
ويتحدث الكاتب عن تألق علم “الفيلولوجيا” في القرن التاسع عشر في الأوساط الغربية، وتوظيفهم لأدوات هذا العلم في دراسة الشرق وثقافته، بل إن المستشرق غولدزيهر يرى أن دراسة الشعوب الشرقية وثقافتها بأداة فيلولوجية هي مهمة المستشرق الرئيسية.
ويتساءل عن السبب الذي جعل المستشرقين منكبين على الأداة الفيلولوجية في دراسة الشرق، إذ يعيد السبب إلى ضيق الوقت، فالمستشرق يتفرغ لتعلم لغة أجنبية ودراسة المخطوطات ما يأخذ منه وقتًا وجهدًا كبيرين.
جعل السكران التعاطي مع العلوم الإسلامية في قسمين:
– المحور الموضوعي: وهو تحليل أفراد مسائل العلم واحدة واحدة، وهو مجال اهتمام طالب العلم الشرعي.
– المحور التاريخي: وهو مراقبة سير وتطورات هذا العلم، وهو مجال اهتمام المثقف العام الذي يهتم بنشأة علم ما، والمراحل التي مرّ بها.
واعتبر الكاتب أن أهم مؤسسي ومنظري “التاريخ الثقافي”: بوركهارت، ديلتاي، رودي بارت، ألفرد فون كريمر، وواردنبرج.
ثم يسهب الكاتب في الحديث عمّا سمّاه البرامج العربية الشاملة لتاريخ التراث، والتي يرى أن رائدها اللبناني جورجي زيدان الذي لا يخفي اقتباساته عن المستشرقين، ومن بعده المصري أحمد أمين في سلسلته الشهيرة “فجر الإسلام” التي يرى السكران أنها كادت أن تكون إضافة رصينة في “تأريخ التراث”، لولا الحالة الانهزامية التي تلبّست أحمد أمين في نقوله عن المستشرقين[1]، ويؤخذ على الكاتب تطرقه لحياة أحمد أمين الدينية الخاصة، والتي نقلها ابنه جلال أمين، وعن الجدوى من ذكرها في معرض نقد منهجية أحمد أمين.
ثم ينتقل إلى الحديث عن مرحلة ما بعد جرجي زيدان وأحمد أمين، في مرحلة السبعينات والثمانينات، والتي كانت مشروعات يسارية جاء أصحابها من خلفيات ماركسية أشهرهم: الطيب تيزيني، حسين مروة، أدونيس، حسن حنفي، ومحمد عابد الجابري.
أمّا روّاد القراءات الحديثة الجزئية، التي أخذت حقلًا محددًا فهم: محمد أركون، فهمي جدعان، عبد المجيد الشرفي، عبد المجيد الصغير، ووائل حلّاق.
ويعرّج الكاتب في الفصل الأخير من الباب الأول للحديث عن التطورات التي طرأت على الاستشراق في مرحلته الأخيرة، أي في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي برزت فيها مدرستا “انثربولوجيا الإسلام”، والتي تهتم بدراسة المجتمعات المسلمة المعاصرة بتوظيف بعض النماذج التفسيرية في العلوم الاجتماعية، و”مدرسة المراجعين الشكوكيين” التي تقوم أساسًا على الشك في كل المصادر الإسلامية، والبحث في مصادر تاريخية أخرى رافقت الحقبة الزمنية لظهور الإسلام، مما يدفعنا للعجب من هذا المنهج الذي يرفض الأخذ بالمصادر التاريخية الإسلامية، في حين أنه يقبل بالمصادر اليهودية أو النصرانية، (مدرسة المراجعين في حقيقتها هي مستوى من المزايدة في الشكيّة على دراسات المستشرقين الفيلولوجيين).[2]
ثم يعرض الكاتب لمجموعة من الآراء التي تتناقلها أوساط مدرسة المراجعين، والتي تدعو للعجب من الجرأة التي يتمتع بها أصحاب المدرسة حين يطرحون آراءهم الشاذة، مثل “إنكار وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاريخيًا، وأن مكة ليست في الحجاز وإنما في الأردن، والقرآن من بنات أفكار الحجاج”، معتمدين في ذلك على لعبة التشابهات اللغوية.[3]
تقنية التوفيد
تتلخص فكرة التوفيد في نسب كل العلوم الإسلامية لحضارات وأديان سابقة على ظهور الإسلام، وهو ما يعرف “بالنظرية الإرجاعية”، وأن المسلمين أعجز من أن يأتوا بمثل تلك العلوم.
ولم يقتصر الأمر على عزو العلوم الإسلامية في كلّياتها إلى من سبق، بل أرجعوا العلوم الحقلية أيضًا، حتى وصل الأمر إلى الادعاء بأن كل مسألة في الفقه الإسلامي يلمس فيها القارئ أعمدة اليونان، فالمستشرق بروكلمان يرجع الشعائر الدينية الإسلامية للاقتباس من أهل الكتاب، وحتى حين عجز عن التبرير لاختلاف كيفية الصوم الإسلامي عن المسيحي، برّر قوله بأنه لا يدري ممن اقتبس النبي محمد فريضة الصوم، هل من الفرق الغنوصية أم المانيين؟
إن القارئ لهذه السياسة الإرجاعية يلمس تكلفًا واضحًا وسمجًا في عملية الإرجاع، فقد وصل الغلو ببعض المستشرقين إلى أن أرجع بعض المواقف العاطفية التي مرّ بها الصحابة إلى أصول نصرانية، على اعتبار أن تلك المشاعر الرقيقة لا تتناسب مع مزاج العرب الغزاة، وهو ما يمثل ذروة التطرف لدى المستشرقين، وقد أسهب الكاتب في هذا الفصل بذكر أمثلة عن هذه السياسة التكلّفيّة، التي لا تخضع لأية معايير منهجية.
يعرّج بعدها على فصل أفرده للحديث عن إعادة التصنيع العربي للتراث، وقاد تلك التعميمات المستهلكة -كما يصفها- محمد الجابري الذي قال إن علوم الكتاب والسنة في عصر الصحابة إنما هي صادرة عن الموروث الجاهلي.
أمّا أحمد أمين فقد جعل عقيدة السلف في إثبات الصفات الإلهية الاختيارية نظرية مستوردة من اللاهوت اليهودي، وغيرها.
تقنية التسييس
من الأقسام المهمة في الكتاب، والتي يرصد فيها الكاتب الأداة التفسيرية الثانية عند المستشرقين وشرّاحهم الحداثيين العرب، وهو افتعال خلفيات وأغراض سياسية خلف العلوم الإسلامية التي فرضتها المعطيات الموضوعية في التراث الإسلامي.[4]
وهم في هذه التّهم يجرّدون علماء المسلمين من وازعهم الأخلاقي والديني، ويجعلونهم ورقة سهلة في يد الحكّام، يوجّهونهم حيث يريدون من غير أن يخرج أحد عن طوقهم، مع أن المنطق يرفض مثل هذا الطرح، إلا أن تلك النظريات راجت بين أواسط الحداثيين العرب، وتشرّبتها كتبهم ومؤتمراتهم.
ولربما كان الفصل الثالث من هذا الباب من أمتع الفصول حين أورد عدة مسائل وضعها تحت عنوان “مناقشات”، وإنّ القارئ ليتمنى أن يطول النقاش فيها أكثر، على أن غاية الكتاب لم تكن مناقشة تلك المسائل بشكل تفصيلي.[5]
استشراقيات المحنة
وهو الفصل الأخير من الكتاب، والذي أفرده للحديث عن محنة الإمام أحمد بن حنبل، والأطوار التاريخية التي تناولت قضية الإمام من جهة، وقضية المعتزلة من جهة أخرى، حيث أرجع التعامل الاستشراقي مع المعتزلة إلى عدة أطوار:
– تعامل المستشرقين مع المعتزلة بوصفهم نسخة تجسدهم في تاريخ التراث، حتى شاع بين أوساطهم مساواتهم بين الليبرالية والمعتزلة.
– مرحلة وولتر باتون المستشرق الكندي، الذي طرح رسالته للدكتوراه بعنوان “أحمد بن حنبل والمحنة”، الكتاب الذي صار له ثقله بين أوساطهم، والذي كان المحرك الأساسي لتغيير النظرة السابقة التي صورت الفكر الاعتزالي فكرًا يوازي الحرية الليبرالية، حيث كشفت عن الطرق التفتيشية التي فرضتها السلطة الحاكمة آنذاك.
– تشييع المحنة: مصطلح أطلقه الفرنسي سوردل، والذي تبنى نظرية “المحرك الأساسي لحكم المأمون كان خلفيته الشيعية”، والتي مهدت لنظرية الألماني فان إس.
– جوزيف فان إس: يعتبر المبرئ لسياسة المعتزلة، والذي قدم نظرية تقوم على أركان ثلاثة، تبرئة المعتزلة من عار المحنة، التشكيك في بسالة الإمام أحمد، تسييس محركات المحنة.
وأخيرًا يعرض الكاتب للمستورد العربي لنظرية فان إس، التي نقلها عنه تلميذه رضوان السيد، وتلقفها عنه فهمي جدعان، وإني هنا أحيل القارئ لقراءة هذا الفصل من الكتاب كاملًا ليدرك الحالة الانهزامية، والاستلاب الواضح الذي يصطبغ به جدعان في تناوله لقضية المحنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التأويل الحداثي للتراث، ص:55.
[2] المصدر السابق، ص:118.
[3]المصدر السابق، ص:120-121-122-123.
[4] المصدر السابق، ص:197.
[5] المصدر السابق، ناقش فيها عدة مسائل، مثل تسييس حديث شدّ الرحال، تسييس الظاهرية وغيرها من المسائل، ص:198.
المصدر: (موقع السبيل).