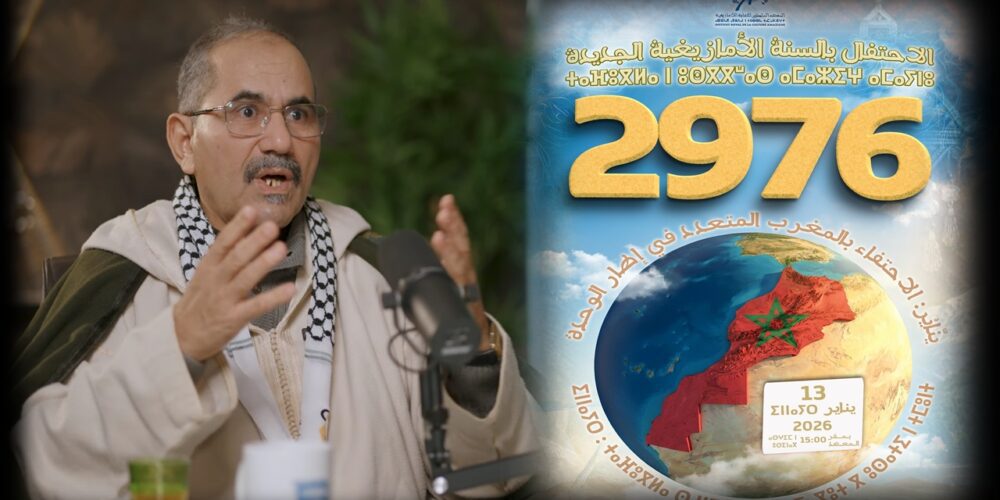لماذا الحديث عن القيم أولا وأخيرا؟

هوية بريس – د. محمد علواش
عند النظر في مكونات المجتمع المختلفة، وما تصدر عليه من ثقافات متنوعة ومختلفة، نعلم أن هذه المكونات تنطلق من تصورات للقيم التي تؤمن بها، ومكونات المجتمع مختلفة طبعا مما يفسر اختلاف القيم عند كل اتجاه أو مكون، وإذا كانت هذه النظرة بمثابة مسلمة بديهية يعترف بها الجميع، فلماذا نلاحظ اختلاف القيم إلى درجة التضارب والتناقض بينها ؟ هل الخلل في القيم السائدة التي نعيش في ظلالها ؟ أم إن الخلل يعود إلى المنطلقات والمرجعيات المؤطرة لهذه القيم والتي تفرز لنا من حين لآخر قيما جديدة تحت مسميات ومفاهيم براقة بدعوى مواكبة العصر والانفتاح على زمن العولمة المعاصرة.
إن مناقشة هذه الفكرة وغيرها يستحق منا أن نقف أولا عند إشكالية طرحها أحد المفكرين المعاصرين- وهو من رواد الثقافة الفرنسية- والمتمثلة في صعوبة الحسم في بيان القيم المهمة والتي يقبلها المجتمع، والقيم التي يرفضها، يقول: “يجب أن نعرف –بكل السبل- ما الذي نريد أن نحافظ عليه، وهذا هو مشكل القيم التي تهمنا، بالنسبة لي أعتبر أن القيم لا يمكن أن تكون إلا مطلقة، لأنها لو كانت نسبية لما كانت لها صبغة إجبارية، يجب أن نكون متفقين حول القيم التي يجب أن نحافظ عليها ، والتي يجب نبني على أساسها الإنسان ومجتمع الغد، حسب اعتقادنا[1]“.
إننا نلاحظ أنه منذ أواخر القرن العشرين وقضية القيم كانت مطروحة للنقاش في الثقافة الفرنسية ، بل وقبل ذلك بكثير ، لأن إشكالية القيم هي قضية وجود الإنسانـ ولقد ظلت مرتبطة به منذ وجوده على هذه الأرض، وفتح المجال للنقاش في الموضوع دليل على حركيته الثقافية ووعيه بخطورة الموضوع، بل إنه يدل على أن مكونات المجتمع المتعددة دخلت في أزمة القيم أو بدأت تستشعر ذلك، وهذا ما جعل الكاتب الفرنسي يطرح الموضوع بهذه الطريقة.
إننا بدورنا في المجتمع العربي نعيش مثل هذه الأزمة التي هزت القيم من مكانتها الطبيعية وساهمت في خلخلة موازينها خاصة في زمن العولمة والانفتاح على الآخر وغياب الحدود والحواجز الثقافية، ومن تجليات ذلك انحراف المجتمع عن وظائفه وملاحظة مظاهر التفكك بين أواصره مما جعل التفكير بشكل منهجي من الواجبات حتى تتم إعادة النظر في القيم التي يجب الاتفاق حولها من غيرها، وهذا لا يكون إلا في ظل توحيد الرؤية التي نعالج بها موضوع القيم أو التأكيد على النظام المعرفي الذي يعتبر إطارا ومرجعا للإشكال الذي نعرضه اليوم.
إذن ما دام مفهوم الإنسانية يجمعنا، وموضوع القيم يؤطرنا، فإننا نحتاج إلى بيان الإطار العام لهذه المنظومة، والتي من تجلياتها أن يؤدي المجتمع وظيفته بشكل سليم، وتكون حركية الناس الفردية والجماعية أكثر فعالية، ومعلوم أنه في هذا السياق العام تتبلور أهمية القيم لأنها تساهم في التخفيف من المفارقات بين مكونات المجتمع وتلك التناقضات بين عناصره، سواء على المستوى السلوكي أو الثقافي عموما، كما تقوم بدور فعال في تشكيل الهوية الثقافية الموحدة لدى مكونات المجتمع، ولتفعيل هذه المعاني نركز على الخصائص المهمة لهذه المنظومة، وهي كما يلي:
1-إطلاقية القيم: ومعنى ذلك أن أهم خاصية للقيم هي أنها قيم مطلقة تتجاوز حدود الزمان والمكان والإنسان، لأنه ملازمة للسلوك الإنساني بغض النظر عن معتقده أو لونه أو جنسه ، وهي مؤطرة لأبعاده كلها، سواء في البعد البدني، أو البعد الديني، أو البعد العقلي، أو البعد الأخلاقي. ومسألة الإطلاق في القيم هي التي حصل فيها إشكال عند الثقافة الغربية، لأن المرجع في تحديد القيم المشتركة يعود إلى اتفاق مكونات المجتمع وتواطئه على قيم معينة ورفض أخرى، وهذا المعنى سيؤدي منطقيا إلى نقض هذه الخاصية وهدمها، لأن المجتمع هو الوعاء الحاضن لتطبيقات القيم على مساحاته المختلفة والمتعددة المشارب، لا أنه المنتج لهذه القيم؟؟ فالمنهج العقلي لا يقبل أن يكون المجتمع هو الوعاء والمنتج في نفس الوقت إلا إذا كانت القيم تتميز بخاصية النسبية، وهنا سنكون أمام دلالات مخالفة تماما لما أشرت إليه قبل، أهما الوقوع في خاصية التغير للقيم في مقابل دلالة الثبات ، وطبعا هذا التصور له انعكاسات سلبية على مكونات المجتمع الواحد ، من تجلياتها اختفاء مفهوم الالتزام بالقيم والخضوع لرياح التغيير التي تصيبها من حين لآخر، وهذا ما يجعلنا نعيش في ظل أزمة القيم فعلا.
2- خاصية المعيارية: لا يمكننا أن نتحدث عن قيم مطلقة إلا إذا كانت معيارية، فهما خاصيتان متلازمتان، كل منهما يكمل الآخر ويفسره ويعطيه دلالات واضحة، خاصة في موضوع القيم، ومعنى كونها معيارية أي تعتبر هي النموذج والمرجع المؤطر لمختلف السلوكات الثقافية التي قد تظهر في المجتمع من خلال سلوكات الأفراد والجماعات، وهي التي قد تتحول مع الزمن إلى عادات وأعراف إذا وجدت قبولا وتراضيا من الناس. وهنا نتساءل كيف تكون القيم معيارية وهي من إنتاج المجتمع ؟ إن المحدد العقلي لا يمكن أن يقبل بهذا المعنى إلا على سبيل العبث، أو على سبيل تفتيت وحدته التي يعيش في ظلالها والسعي وراء تفكيكه ثقافيا وقيميا كما هو حال المجنمع العربي عموما.
إن خاصية المعيارية لا يمكن الحديث عنها إلا في ظل الوحي الإلهي المتعالي عن المجتمع ومكوناته، والذي من مقاصده تغييره نحو الأفضل ، والسمو به نحو القيم التي جاء بها، وأعظمها تحقيق العبودية لله تعالى عوض ترسيخ القيم السائدة والرضى بأمر الواقع المرير الذي نعيش فيه استجابة لعدد من الدعاوى والمبررات، وبكلمة أخرى لا يمكن لفصل بين القيم مصدرية الدين لها، لأنه هو وحده –فقط- الذي يعطي لها معنى جماليا ويبعث في صاحبها طاقة روحية تجعله يحاول مهما اعترضته العوائق والابتلاءات أن يمارسها ويتشبث بها، بل وقبل ذلك كله أن يعتقد بصلاحيتها وصوابها المطلق الذي يعلو ويتجاوز النسبية التي تقوم عليها المجتمعات، وفي هذا السياق يقول أحد التربويين: ” إن الإسلام يربط الأخلاق بالشرع، فالشرع هو الذي يحسن ويقبح.. وليست الأخلاق متروكة للإنسان ينظر فيها بعقله، لأنه فضلا عن كونه بطبيعة آفاقه المحدودة عاجز عن العثور على نسق شمولي يستجيب لحاجيات الإنسان وتطلعاته الحضارية، فضلا عن ذلك، فإن نسقه ذاك حتى وإن كان فيه قدر من الصواب، فإنه يظل جسدا راكدا لا حياة فيه”[2]، وحينما نشير إلى مصدرية الدين للقيم نكون فعلا أمام نسق متكامل ونظام معرفي يستجيب لتطلعات الإنسان في ضوء ما أشرنا إليه من خاصيتي الإطلاق والمعيارية، فواضح جدا أن العقيدة هي الباعث على الإيمان بالفكرة والدفاع عن المبدأ الذي يؤمن به الإنسان ويلتزم من أجله بالقيم التي يدعو إليها ذاك المعتقد، وهذا لا يحتاج إلى بيان، سواء كانت تلك العقيدة صحيحة أو فاسدة.
3-الفطرية: من معاني هذه الخاصية أن أصل القيم يرجع إلى الفطرة البشرية، فهي الجهاز الذي يستوعب القيم ويحتضنها، وبفضل ذلك تكون للإنسان القابلية لتطبيق تلك القيم التي يؤمن بها، وهنا طبعا نتحدث عن الفطرة السوية التى خلقها الله تعالى ووهبها لكل الناس، حيث لا يجد الإنسان أدمى تعارض بين قيم فطرته وبين ما أنزل الله تعالى على رسوله من مضامين الوحي الإلهي المتجلي في القرآن المجيد والسنة النبوية، قال تعالى: ” فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون” ( الروم: 30)، يقول الطاهر بن عاشور: ” ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها، غير نائين عنه ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله، لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح، حتى لو ترك الإنسان وتفكيره ولم يلقن اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته[3]“.
إن هذه الآية تكشف بوضوح عن خاصية الفطرية الملازمة للقيم، وما على الإنسان إلا أن يكون متناسقا مع عقله وما تقبله فطرته السوية والسليمة، حتى وإن حصل في المجتمع ما حصل من تغير للقيم، لأن الله تعالى الذي خلق الإنسان بهذه الفطرة هو سبحانه الذي أنزل الوحي يتضمن تصورا شموليا عن الخلق والمصير ، وما على الإنسان إلا أن يستجيب لمعطياته وأوامره ونواهيه،” وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من صنع الله وكلاهما موافق لناموس الوجود وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه. والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف. وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت: «لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» . فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة. فطرة البشر وفطرة الوجود[4]“. وبهذا يتبين ذلك الترابط إلى درجة التلاحم بين الدين والفطرة، أو قل بين الدين والقيم الذي يستحيل أن يحصل معه انفصال إلا على سبيل الإنكار أو الجهالة مصداقا لقوله تعالى:” ولكن أكثر الناس لا يعلمون” فهم لا يعلمون حقيقة هذا الدين وما جاء به من خير للبشرية جميعا، ولا يعلمون حقيقة هذه الفطرة التي هي من صنع الله الحكيم، ولا يعلمون حقيقة التلاحم بين الدين والفطرة باعتبار مصدريتهما الربانية الواحدة. فالفطرة تعتبر بمثابة ” الخزان أو الينبوع الذي يصدر عنه السلوك الإنساني، مدعوما في ذلك بضوابط الإرادة والحرية التي لا تتعارض في شيء مع الالتزام بضوابط الشرع[5]“.
وبالجملة لا يمكن الحديث عن الإنسان مجردا عن القيم التي تؤطره والتصور المعرفي الذي ينطلق منه، وعلى حسب مكونات هذا التصور تتبلور القيم التي يؤمن بها ويدافع عنها، وبذلك يقدم شخصيته للمجتمع، ونظرا للوضع الراهن الذي بين نحيى بين عتباته صار النموذج الإسلامي محتشما في الساحة إن لم نقل مختفيا، وما ذلك إلا بسبب التغير الطارئ على سلوكاتنا والثقافة السائدة المؤطرة له عموما، ومن تم فإننا نعيش في ظل أزمة قيم حقيقية تحتاج إلى تضافر الجهود لإيجاد حلول عاجلة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– Jacques Bourdon-Bousset-dans ETAPES DE LA PROSPECTIVES,paris.P.U.F-1964-p173
[2] – عبد المجيد بن مسعود، القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر، كتاب الأمة، ع 67، 1419، ص122
[3] – الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 1984، ج21، ص90
[4] – سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، بيروت، ط17،1412،ج 5، ص 2767.
[5] – عبد المجيد بن مسعود، نفس المرجع، ص91.