“مات من أجل فرنسا”.. عندما يتساوى الطبيب والراهب والمقاتل

هوية بريس – إبراهيم الطالب
في حضارتنا الإسلامية الخالدة نماذج كثيرة يمكن أن نضرب بها المثل في استرخاص الأرواح فداء للقضية، قضية نشر الإسلام، ابتداء بجيل الصحابة الذين سجل التاريخ بطولاتهم وتفانيهم في نشر العدل والعدالة وعقيدة الإسلام التحررية، التي تجعل من الإنسان كائنا حرا، لا يرضى أن تقيده حتى نفسه بشهواتها، بله أن يتحكم فيه مخلوق فيستعبده، هكذا فهم الجيل الأول الإسلام، فانطلقوا محررين لشعوب العالم من أغلال الأديان المحرفة، وجور الظلَمة المستغلين للعباد، فدخلت تلك الشعوب في الإسلام، وشاركت العربَ في بناء حضارة حكمت العالم 13 قرنا.
حضارة بنيت على أساس عقيدة وشريعة وقيم لا تفرق بين الإخلاص في العمل في المسجد والمصنع والمستشفى، حضارة تعلي من قيمة العدل والحرية والعبادة والدين كما تعلي من قيمة العمل والبذل لإسعاد الناس ورفع المعاناة عنهم.
ثم لما ابتعدت الأمة الإسلامية عن مصدر وحدتها وقوتها وغَلبت عليها الخرافة والشعوذة هيمن عليها التخلف والضعف والفقر؛ وركن شبابها إلى الدعة والسلبية والخمول، وأصبحت شعوبها قاطبة تستمد القوة والعون من موتاها، تطوف بقبورهم وأضرحتهم تستغيث بهم وتذبح لهم النذور حتى يشفوا من مرض أو يستغنوا من فاقة، وبلغ من سيطرة الخرافة على بعض أبنائها وطوائفها، أن اعتقدوا أن الاحتلال الذي هيمن على أراضي المسلمين وسامهم الخسف والقهر، قدر مقدور من عند الله، وجب عليهم التسليم له وعدم مقاومته، ولم يفطنوا إلى أنهم توفروا على كل الشروط لكي يكونوا مستعبدين تابعين بعد أن كانوا سادة العالَم وقادته.
وكان من نصيب المغرب أن يشمله الاحتلال الفرنسي البغيض، وكان قائد القوات الفرنسية يجمع إلى جانب الحنكة العسكرية فلسفة توسعية لا تنبني على القوة المدمرة الفتاكة فقط، بل تجعلها آخر ما يستعمل للإخضاع، حين تعجز الآليات السلمية برمتها؛ ويتساوى في فكره التوسعي دور الطبيب والراهب والمقاتل، المهم أن تكون النهاية عنوانها: “مات من أجل فرنسا“.
“مات من أجل فرنسا” عبارة احتلت واجهات شواهد المغاربة والجزائريين الذين ماتوا في ساحات المعارك تحت الراية الفرنسية، عبارة تختزل كل فظاعات الاحتلال كما تختزل كل معالم الضعف والهوان الذي عاشه المسلمون خلال القرنين التاسع عشر وجزء مهم من القرن العشرين.
قبل الحرب العالمية الأولى كان إخواننا الجزائريون الذين كانوا يموتون دفاعا عن الراية الفرنسية يدفنون في مقابر جماعية وبعد نضال وجهد جهيد تفضلت فرنسا الديمقراطية -بلد الأنوار والفلسفة والتنوير- عليهم وعلى مسلمي مستعمراتها بسن قانون بتاريخ 02 يوليوز 1915، الذي أنشَأ مفهوم “مات من أجل فرنسا” وقانون 39 دجنبر 1915؛ القاضي بتكفل الدولة بمصاريف ورسوم قبر وشاهد من “مات من أجل فرنسا”.
إلا أن هذه العبارة لم تكتب فقط على شواهد قبور المغاربة والجزائريين الذين ماتوا من أجل فرنسا، بل كتبت كذلك على قبر في المغرب لا زال شاهدا على هذا المفهوم الذي ابتكرته الآلة الفكرية الخادمة للإمبريالية الفرنسية، قبر لإنسان نصراني يقف فوقه صليب ضخم كتبت العبارة على شاهده، هو قبر ليس لمقاتل أرداه الرصاص، بل لطبيب فرنسي فضل العمل إلى جانب الجنرال ليوطي، مات في تارودانت بسبب وباء التيفوس، اسمه بول شاتينييرPaul Chatiniéres)، (1884-1928، أنشأ مستوصفا للخدمات الطبية، شارك في البعثة العسكرية (يونيو/يوليوز 1914) التي جابت قرى ومداشر سوس برئاسة الجنرال دولاموط السفاح، ترك لنا كتابا مفيدا جدا عنوانه: “في الأطلس الكبير” يروي فيه تفاصيل عن كل ما رآه في المنطقة كأنه مخبر وليس طبيبا، ولا عيب في ذلك فهو في خدمة جيوش بلاده الغازية، التي استفاد قادتها من المعلومات التي تضمنها كتابه الذي قدم له الجنرال ليوطي بتاريخ 1 يوليوز 1919، بكلمة مقتضبة لكنها عميقة الدلالة، منوها بجهود الطبيب شاتينيير، أقتطف منها ما يُظهر لنا دور الطبيب الفرنسي في اختراق المغرب، الذي كان يعيش أفظع مراحل الانحطاط والتخلف ساعتها يقول ليوطي:
“تعرفون أفكاري حول أهمية الطبيب في المستعمرات التي يمكن أن يقدمها لتهدئة بلد ما. كثير من الخلافات تنتهي بمجرد أن نتعارف؛ والحالة هذه، ما الذي تعنيه التهدئة في الغالب، إن لم تكن نهاية سوء التفاهم؟
فقط هو التفسير الأول الذي عادة ما يكون عسيرا، لابد من شخص يبعث على ثقة مسبقة؛ والحال أنه ليس هناك من يستجيب لهذا الشرط أحسن من طبيب؛ فيوم يعقد العزم أحد الأعيان أو قائد ما أو مجرد رجل مسكين يعاني، على زيارة طبيب فرنسي ويخرج من عنده معافى، يذوب الجليد، تكون الخطوة الأولى قد تمت وبدأ ربط العلاقات.
لكن ليتم هذا الأمر يلزم الطبيب كما ضابط الاستخبارات، فضلا عن قيمته التقنية، مميزات خاصة من الفطنة والإدراك، يلزم أيضا أن يكون مقتنعا.
كل هذه المزايا، عزيزي شاتينيير، تمتلكونها؛ وكل الذين سيقرؤون كتابكم، سينتبهون إليها بسرعة، سيجدون فيها أيضا الأصالة، الملاحظة المنصفة، والإحساس، في قالب فاتن سيضاعف من جاذبيته ويضمن لكم نجاحا جد مستحق، أنا سعيد بأن أكفله”. انتهى كلام ليوطي.
هكذا استعمل قادة فرنسا من أجل رفعتها الطبيب والراهب والعسكري والفنان والتاجر في بناء مجد بلادهم؛ وفي تكريس تخلفنا في حين لا زلنا نحن إلى اليوم نلهث وراء فرنسا، لا زلنا لم نتحرر من تبعيتها.
كلام ليوطي هذا، عميق الدلالة كما قلنا، فهو يؤكد على أهمية دور الطبيب في عملية التهدئة، و”التهدئة” هي مفهوم سياسي عسكري صاغه ليوطي، ويعني إخضاع القبائل المجاهدة بالقوة أو بالسياسة أو بالخدمات، حتى لا يستعمل مصطلحات إخضاع حرب احتلال، وحتى يبقى منسجما مع مفهوم السيبة الذي استغله أكبر استغلال في نشر جيوشه في المغرب.
وقد كان دقيقا عندما ساوى بين الطبيب وضابط المخابرات في ضرورة استعمال وظيفتهما في سبيل ربط العلاقات بين الدولة الغازية والشعب الذي يراد له أن يخضع للغزاة.
قد يعتقد بعض السذج أن هؤلاء يجب أن يكرموا ويشكروا على خدماتهم، إنهم لم يكونوا هنا في خدمة المغاربة بل كانوا في خدمة وطنهم، ومن أجل إخضاع المغاربة ونهب ثروات بلادهم، لا يفرقون بين مبضع الطبيب ورصاص المقاتل.
لقد كرست فرنسا الجهل، وامتنعت عن تكوين المغاربة في الميادين الحيوية خصوصا في مجال الطب نظرا لأهميته في التأثير على الشعب، وذلك حتى تضمن استمرار خضوع الشعب المغربي لها، وافتقاره لنخبها، وكانت تفتح مدارس التكوين المهني لتخرج مهنيين توظفهم في شركاتها التي استحوذت على منابع الثروة في البلاد، ويخبرنا بهذا ميشيل بيير روكس وهو مدير الجمعية الفرنسية لتاريخ الطب، في تقديمه للترجمة العربية التي نشرت في 2015 للجزء المتعلق بسوس من كتاب شاتينيير “في الأطلس الكبير” حيث قال: “إحدى هذه الوثائق التاريخية -إحصائية من مستشفى شاتينيير تعود لأواخر 1939- تأسف لعدم توفر سوى طبيب واحد في تارودانت؛ قدر غير كاف بصراحة، ولا يمكّن من الإسعاف الصحي؛ في المناطق الخلفية.
-يتساءل مدير الجمعية الفرنسية للطب-:
لمن يعود الخطأ؟؟
فيجيب نفسه:
إن الانتقاد موجه لفرنسا لكونها لم تسهل تكوين أطباء مغاربة في الوقت المناسب”. انتهى كلامه.
أظن أننا اليوم في بعض المناطق لا زلنا نعيش الوضعية نفسها في كثير من القطاعات، وعلى وجه الخصوص في قطاع الصحة وقطاع التعليم.
نحن اليوم نحتاج مَن يموت من أجل أن تعود حضارتنا لتحكم شعوبها، كما كان آباؤنا يموتون، لكن الموت هنا أشمل من أن يكون قاصرا على بذل الروح في ساحات الدفاع عن حوزة الدين والوطن، نحتاج من يسكب في قلوب الأجيال القناعة بأن الموت في سبيل المبدأ والعقيدة والدين والوطن ربما يتساوى، فيكون بنفس الفضل سواء سقطتَ في ساحات الدفاع العسكري أو في خدمة دينك وعقيدتك ووطنك في المستشفيات والمراكز العلمية، ما دام محياك ومماتك لله رب العاملين، وما دام هدفك هو عزة المسلمين وتمتين قوتهم وغايتك هي وجه الله تعالى.
فلن تستأنف الشعوب الإسلامية ريادتها للعالم وهي بعيدة عن التفوق والريادة في أغلب مناحي الحياة.
إن على الأجيال ألا تميز بين إحراز القوة في الدين وعلومه وبين إحرازها في الدنيا وعلومها، المهم أن يكون ذلك باسم الله وفِي خدمة الإسلام؛ وبعدها فليستفذ منه المسلم وغير المسلم.
نحتاج الطبيب المسلم وكذا المهندس والتاجر الذي تتجلى فيه قيم الإسلام وهو يمارس حرفته ومسؤوليته، يسخِّر علمه وقوته ووقته وماله خدمة لدينه وأمته ووطنه.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
إبراهيم الطالب.



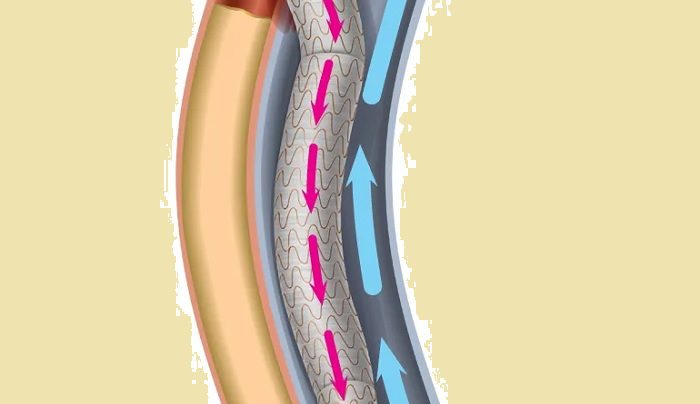





































الله المستعان
يا ليت قومي يعلمون.