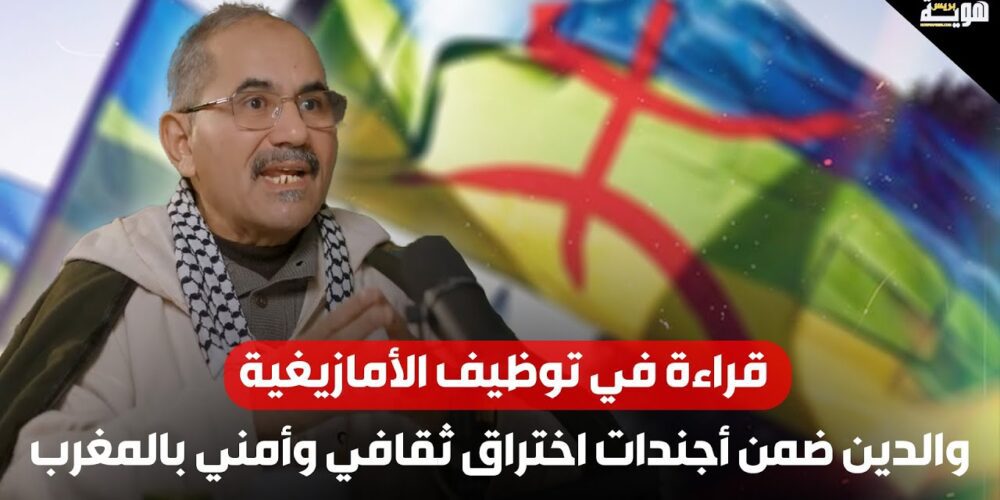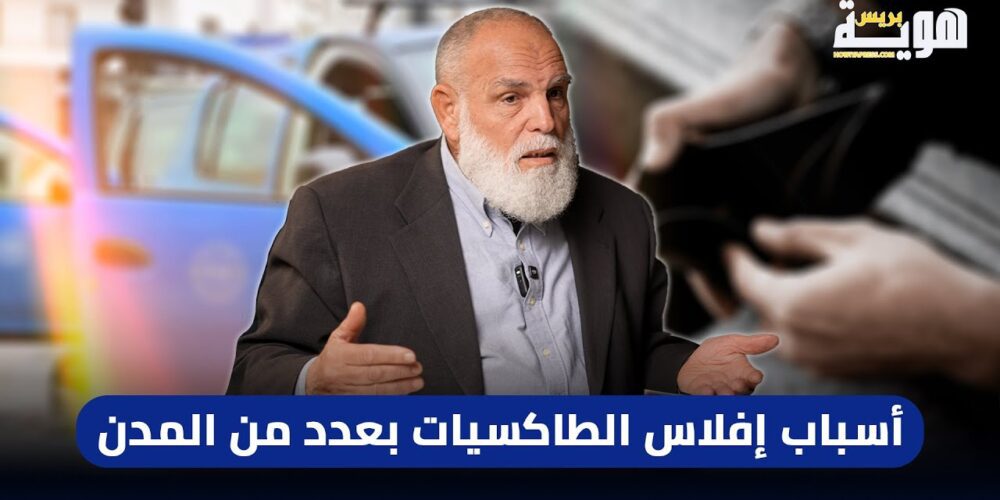ما التنوير.. في شرط الاستعمار والتغرير؟
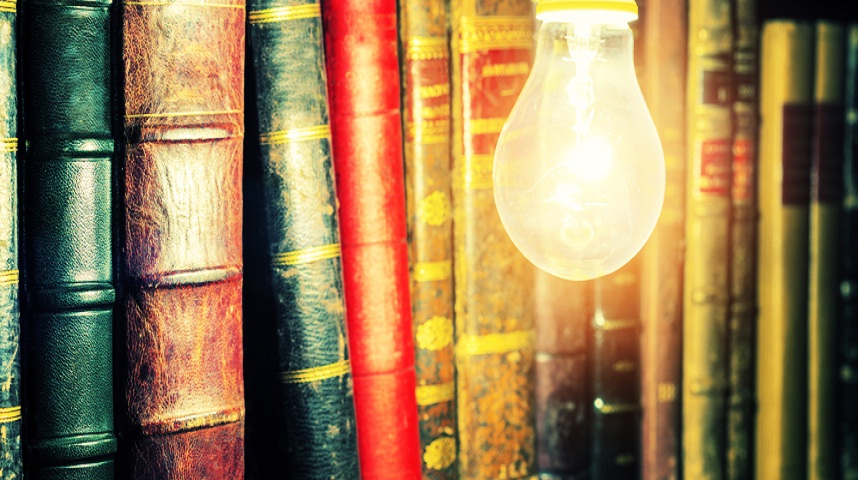
هوية بريس- محمد زاوي
كان “عصر التنوير” عصرا بورجوازيا في أوروبا القرن 18 م، حيث انبعث يحمل معه آمالا واقعية لفئات اجتماعية صاعدة في طريقها للانتشار والتوسع. يعبّر “التنوير” بهذا المعنى عن حركة اجتماعية قبل أن تكون ثقافية، ويعكس مطالبَ اقتصادية تبحث عن خطاب جديدة في عالمي السياسة والثقافة. وهكذا فإن “التنوير” في الغرب لم يكن ترفا فكريا، ولا هو كان قراءة جديدة -وأحيانا ثورية متمردة- للنص في ذاته ولذاته.
في نفس الواقع الأوروبي، تعددت الأجوبة على سؤال “ما التنوير؟”. فإذا كان ر. ديكارت قد أجاب على هذا السؤال بتخليص مجال العلم من يد الكنيسة، فإن إ. كانط أجاب عنه بتمكين الإنسان بإعمال عقله في الكشف عن التناقض. وإذا كانت البورجوازية الفرنسية قد أنتجت بدائل مادية ميتافيزيقية للخروج من نمط الإنتاج القديم، وبالتالي من الفكر القديم؛ فإن البورجوازية الألمانية “المترددة” والمهدَّدة داخليا وخارجيا قد خرجت منه بفكر جدلي يكشف التناقض ويثبت حقيقته المثالية، ثم المادية فيما بعد. وهذا دون الحديث عن بورجوازيات أخرى في هولندا وبريطانيا وإيطاليا ودول اسكندنافيا، أوجدت صيغة تنويرية خاصة بها في كل بلد.
لا حاجة لنا الآن لإثبات زيف الدعوات التي تطالب ب”تنوير فوقي” منفصل عن أصله الاجتماعي العربي. إن زيفها هو ما يفسر عجزها عن اختراق المجتمعات العربية، وإن مارست بعض “التشغيب الثقافي” المزدوج. فهودي من جهة تعبر عن حاجة إنسانية للمعرفة والفهم والانعتاق من “الوعي التقليدي السائد”، إلا أنها من جهة ثانية -وهذا هو الأخطر- تعبر عن وجهة نظر “استشراقية جديدة”. لا يهم الأدوات المعرفية التي تستعملها هذه الدعوات لقراءة النص الديني وملحقاته التراثية، ما يهم هو: إلى أي حدّ نحن في حاجة إلى هذا النوع من القراءة النقدية؟
تعيش المجتمعات العربية الإسلامية واقعا تناقضيا متداخلا؛ فهي من جهة خاضعة لتفاوت اجتماعي داخلي، ومن جهة أخرى لاستهداف أجنبي واضح ومُثبَت في السياسة والثقافة والاقتصاد. وفي كل من هذين التناقضين، لا يلعب الدين دورا سلبيا بالضرورة، بل قد يخرج -وهو الحاصل- من منطقة الحياد و”الخلاص الفردي” ليكتسب معنى اجتماعيا وسياسيا بغايتين:
-حفظ استقرار المجتمعات ومطالبها السياسية والاجتماعية الداخلية.
-وحفظ وحدتها السياسية وقدرتها على المقاومة والمدافعة الخارجية.
لا يوافق “التنوير” شرطه التاريخي في المجتمعات العربية إلا بقدر ما يقترب من هاتين الغايتين. كما أنه يصبح ضد مبتغاه إذا هو جرّد الدين من فاعليته ك”لاهوت تحرير” وك”عامل وحدة واستقرار”. وإن القراءات الرائجة اليوم كقراءات “تنويرية” تفتقر إلى هذا البعد التاريخي والواقعي في النظر، فتُعمِل في النص الديني نظرا مطلوبا في حدود ضيقة (في المختبر)، وتجعل منه لغةً للشارع والرأي العام وسياسةً وثقافةً للمجتمع. وهي قراءة فضلا عن أنها “لا تنويرية” في الوطن العربي والإسلامي، تحول دون تقدم الوعي الديني عند أهله. فيكتفي هؤلاء بالتحصن خلف الحصون، كما فعل ابن حزم الأندلسي في زمن فتنة وفوضى، وكما فعل ابن تيمية في زمن استهداف وفرقة؛ عوض التقدم في كشف “خزائن التنوير” في النص الديني نفسه.
هذا وإن دعاة “التنوير” اليوم لا يبدون أي استعداد للوقوف عند “خطيئة التنوير الغربي”، وهي ماديته -الطبيعية والتاريخية- اللاكونية. إن هذه المادية، بقدر ما هي ناجعة في التحليل الاجتماعي العيني والتاريخي، وبقدر ما هي مطلوبة لدرء العمى النظري في “الممارسة العملية”؛ إلا أنها محدودة بحدود التاريخ ولا تنفذ إلى عوالم أخرى وجودية وكونية، ربما يفتح البحث فيها آفاقا جديدة للإنسان. بالإضافة إلى ما أنتجته هذه “المادية المحدودة” من “مادية لا أخلاقية” قائمة على تكريس التفاوت والقهر والاستغلال الاجتماعي.
إن “التنوير العربي” اليوم في حاجة إلى استحضار بعدين في قراءة النص الديني، هما: البعد الاجتماعي والبعد الوجودي. وهو استحضار يجب أن يكون سديدا بالمعنى التاريخي لهذا السداد، أي في إطار الإشكالية التالية: كيف السبيل لتحرير الإنسان العربي تحريرا واقعيا لا مثاليا؟ فالتحرير ليس مِلك اليد الفردية، ولا حتى ملك اليد الاجتماعية الفئوية. إنها بنية اجتماعية مركبة تملأها التناقضات الاجتماعية، “التنوير” فيها ليس محض اختيار، وإنما تكبحه الضرورة من كل جهة، بل وتفرض عليه أن يلزم غرز “التقليد” في عدة مواقف ووقائع. من يستهويه الحلم الفكري والسياسي لا يروقه هذا الكلام، ولكننا لا نتحرك ولا نتكلم إلا في الواقع الذي أملاه. أما محض الحقيقة فجنة في النظر، ولضرورة الواقع فيها “نظر”!