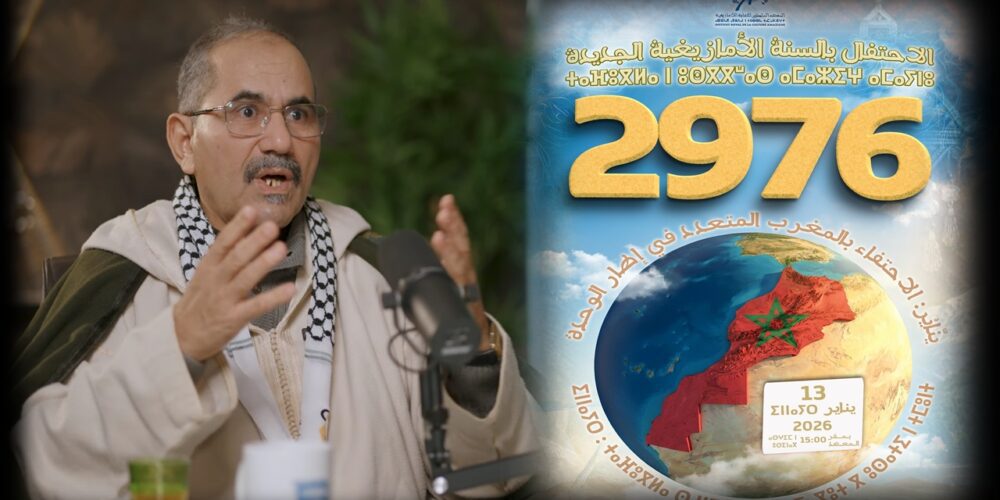مشروع القانون رقم 22.20 وفقد ثقافة صناعة القانون

هوية بريس – حسن المرابطي
اِعلم أن المداد لم يبقى يسيل بعدما تقدم الإنسان حتى خلال مناقشة القضايا القديمة، فكيف إن تعلق الأمر بمشروع قانون أتى ليوقف استهلاك الأنترنت بدعوى تقنين نشر الأخبار والأفكار والآراء من طرف مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث والشبكات المماثلة، حتى رأينا من الآراء والأفكار والأخبار المنشورة بسبب هذا المشروع سببا لإعادة النظر في توقيت المصادقة على المشروع، بل كاد الواحد منا يتمنى إجهاض المشروع، ولو أن الإجهاض يُمنع بعد نفخ الروح في الجنين، ما جعلنا نتمنى الترخيص للإجهاض ولو هذه المرة فقط، حتى إن كان مشروعنا المثير للجدل سارت الروح فيه بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه.
وعليه، فإن المشروع لم ينشر بشكل رسمي، إلى حدود كتابة هذه الكلمات، بيد أن بعض المضامين التي سربت خلقت الجدل والنقاش، ما يعني أن رواد شبكات التواصل الاجتماعي على وعي تام بما تعرفه الساحة القانونية المغربية، كما حمل هذا النقاش تخوف الجميع من نص المشروع، بما فيهم من عُرف بهدوئه وحكمته، ما جعل الواحد منا يتريث قبل اتخاذ أي موقف، سيما موقفا مؤيدا للمشروع، لأنه من الصعب اجتماع رواد الشبكات على رأي واحد. الشيء الذي جعل الاهتمام ينصب في تأمل طرق إصدار القوانين، بدل التعمق والتأمل وتقديم قراءة في نصوصها، بعدما تأكد للجميع تكرار مثل هذه الردود من عموم الشعب، دون التفريق بين السياسي والمتخصص والمواطن المغلوب عن أمره.
وعليه، فإن إصدار القوانين من اختصاص السلطة التشريعية كما هو معلوم، والتي يمثلها البرلمان، رغم أن في كثير من الدول، والمغرب من بينها، يقتصر فيه دور البرلمان التصويت على المشاريع القانونية المحالة من طرف السلطة التنفيذية، ونادرا جدا ما يكون فيه البرلمان صاحب المبادرة، أو قل أن مبادراته لا تكون محل اهتمام ويطالها التجاهل، وما أرشيف مقترحات القوانين في البرلمان خير دليل. لهذا، صار لزاما منا إعادة مناقشة طرق إصدار القوانين من خلال تجديد فلسفة صناعتها.
ما أشرنا إليه أعلاه، لا يعني بالضرورة تبخيس جهود السلطة التنفيذية، لكن هذا يجعلنا نتساءل عن مدى تطبيقها لنصوص الدستور، قبل النظر في استيعاب القائمين على الجهاز التنفيذي المبادئ التي ميزت دستور 2011 عن باقي الدساتير السابقة، أما أن نلمس منهم تنزيل روح الدستور والتعبير عنه من خلال قراراتهم يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن. لهذا، لم يكن مشروع قانون 22.20 أول مشروع أثار الجدال والجدل في الساحة السياسية، لكون المعنيين بالأمر لم يلتزموا، ولو بالقدر الأدنى، بمبادئ الدستور، يأتي في أولها مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور في أكثر من فصل (الفصل 12 نموذجا). بل بعض الأحيان، نكاد نجزم بعدم إيمانهم واقتناعهم بهذه الديمقراطية التشاركية، باعتبارها منافسا لهم وليست مساعدا في تجويد العمل السياسي والرقي به.
إن أهمية الديمقراطية التشاركية تكمن في تجويد القرارات والقوانين، بل إن تعدد الآراء وزوايا النظر يقلل من الوقوع في الهفوات والأخطاء، ذلك أنه كلما تعددت الرؤى واختلفت، أنتجت قوانين يصعب انتقادها، فضلا عن مهاجمتها. هذا إن كنا أخذنا بمبدأ معالجة بعض الآفات وأخطاء بعض رواد شبكات التواصل الاجتماعي بقانون رادع وصارم، لكن الأفضل والأصح في عصر التكنولوجيا هو الانكباب على معالجة الأسباب الحقيقية في ظهور تلك الدعوات التي من أجلها سارعوا إلى إصدار قوانين، لأن الدعوة إلى فعل المقاطعة أو التشكيك في جودة المنتوجات لم يكن وليد الصدفة أو صدوره من شخص غير عاقل.
حتى نُبصر أصحاب القرار أكثر بأهمية الديمقراطية التشاركية في صناعة القوانين (نقصد بالديمقراطية التشاركية هنا المبدأ بشكل عام، وليس بعض الإجراءات المحدودة فقط)، لابد من التنبيه إلى أن إصدار القانون بشكل أحادي يفقده الكثير، بل إن أهم شيء توفره الديمقراطية التشاركية هو “ثقافة صناعة القانون”، بحيث أن المواطن بدل مهاجمة مشروع القانون وهو في طوره الأول، يتشوق إلى يوم صدوره وتنزيله على أرض الواقع؛ وحتى نُفهم سعادة المسؤول أكثر، نقول: إن خلق جو من النقاش العمومي حول تصرفات، يقال عنها أنها سلبية، وفتح قنوات للمناظرة والحجاج، سيما أن من يقود الحكومة ذو مرجعية إسلامية يدرك قيمة هذا النوع من الأسلوب في إفحام “الخصم”، تجعل الجميع متحد وباحث عن الحل، بدل خلق مواجهة مع شريحة كبيرة من المجتمع، أثبتت في عز أزمة كورونا نبذها للإشاعة والأخبار الزائفة، بل قاومت الإشاعة وغيرها دون الحاجة إلى تنبيه المسؤول من عدمه.
بدون شك، أنهم لن يتوانوا في الدفاع عن مشروعهم بدعوى اتخاذ جميع المشاورات، وأن المؤسسة التشريعية هي صاحبة القول الفصل، وإنما الحملة القائمة وتفاعل رواد الفايس مع ما تسرب من معلومات هو نتيجة تسرعهم وجهلهم بالأمور، الأمر الذي يجعلنا نذكرهم، مرة أخرى، بحال مؤسستنا التشريعية التي أثبتت عدم تحقيق ما يتطلع إليه المجتمع، ولعل أصدق شهادة على ذلك خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان السنة الماضية. بل إن بعض المنتسبين إليها، صرحوا في أكثر من مناسبة، أن التصويت يكون تحت تعليمات بالهاتف، بل لن نتردد في القول أن بعضهم يصوت ولا يدري على أي شيء يصوت، إما لجهل وقلة زاد أو لكثرة مشاغله وقضاء بعض مآربه، ما يلقى في تنفيذ أوامر الهاتف خير أسلوب، لأنه لا يملك قرار نفسه، بالأحرى التعبير عن قرار من يمثل.
وعلى سبيل الختم، إننا لا نقبل في صفوفنا أو بينها من ينشر الأخبار الزائفة والسلبية والتي تضر بالغير، ونحن ضد كل سلوك سلبي مهما بدا صغيرا، وهذا مبدأ لا يحتاج للنقاش، وبعض فصول القانون الجنائي كفيلة بمعالجة ما شذ هنا وهناك، لكن إصرارهم في إصدار قانون خاص، يجعلنا نذكرهم ونطالبهم بضرورة إضافة بعض المواد حتى يستقيم الأمر، لأنهم أغفلوا بعض التصرفات التي تسبب الضرر بشكل يومي.
لعل الانشغال بتكميم أفواه رواد شبكات التواصل الاجتماعي، لم يترك لهم متسعا لدراسة التصرفات التي أشرنا إليها، ما جعلنا نأخذ على عاتقنا مهمة حصر بعض التصرفات، لعل خلال مناقشة المشروع إضافتها إلى المواد 14 و15 و18 أو جعلها في باب خاص لخطورتها. وتأتي في مقدمة هذه التصرفات تصريحات بعض الفاعلين السياسيين والصراعات الحزبية الضيقة، التي بسببها، يجعلون من الحبة قبة، دون مراعاة نفسية المواطن البسيط، مع تشويه صورة الوطن بين الأمم بسبب تفاهاتهم وحماقتهم، وأيضا تبادل الاتهام في حالة الخلافات بأخطر الجرائم، سواء خلال حملاتهم الانتخابية أو تحت قبة البرلمان، بل حتى خلال الانفلاتات التي تحدث بعض الأحيان هنا وهنا، دون تقديم أي دلائل وحجج مع تقديمها للنيابة العامة لما تشكله من خطر على مصلحة البلاد والعباد حسب ادعاءاتهم.
اللهم ثبت مسؤولينا وارزقهم بمن يرشدهم لما فيه خير،
اللهم اهدي كل ناشر للإشاعات واحفظ بلادنا من الفتن والفتانين،
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.