معركة tik tok .. محلنا من إعرابها

هوية بريس – بوسلهام عميمر
سابقا كان يقال من يملك المال يملك سلطة القرار، اليوم من يملك المعلومة هو سيد الميدان.
“تيك توك” اليوم يحظى بشعبية كبيرة إذ وصل عدد مستخدميه 1،8 مليار عبر العالم، أمريكا على رأس القائمة عالميا والعربية السعودية عربيا. فالحرب تستعر مجددا بين الصين من جهة و من جهة ثانية أمريكا وكندا والمفوضية الأوربية والهند التي منذ مدة حظرت التطبيق لدواعي أمنية، حسب ما أعلنت عنه. فهي اليوم على أشدها لما أمهل البيت الأبيض الولايات ثلاثين يوما للتأكد من خلو الأجهزة والأنظمة التابعة للحكومة من هذا التطبيق ومنع تحميله مستقبلا لما يشكله، حسبها، من خطورة على أمنها القومي وتهديده، وأنه أداة للتجسس و توفير قاعدة كبيرة للبيانات وانتهاك للخصوصيات.
فيما إدارة شركة المنصة تنفي الاتهامات جملة وتفصيلا وتدعو الخارجية الصينية الولايات المتحدة أن توفر بيئة منفتحة وعادلة للشركات من جميع البلدان للاستثمار على أراضيها، وتحترم اقتصاد السوق والمنافسة الشريفة. أما مستعملو هذه التطبيقات، فرؤاهم تتوزع بين من يعتبر حربهم لها علاقة بالصراع الأمريكي الصيني على ريادة العالم، تتخذ أشكالا متنوعة وأساليب مختلفة، وبعضهم يرى أن الصين نفسها تمارس التضييق على المنصات داخل أراضيها لأسباب سياسية تتعلق بحرية التعبير. مهما كانت دفوعات هذا الطرف أو ذاك، فماذا عنا نحن في خضم هذه الحرب السيبرانية؟ إننا ك”الأصم في الزفة” كما يقال، أم ليس لدينا ما نخشى عليه؟ ألا يغزونا “تيك توك” وغيرها من المنصات بكل فئاتنا العمرية حتى النخاع؟
فهل نستطيع الاستغناء عنها ولو لساعات أو دقائق؟
إذا كان صحيحا كل ما يروج من اقتحام الخصوصيات، ألا يمكننا أن نجزم أنه لا أحد فينا ولا منا، يمكنه أن يدعي حرمة أو خصوصية. إننا عرايا لدى مالكي هذه التطبيقات والقائمين عليها. فكم منا نحن قبيلة المستهلكين بالملايين داخل الوطن، له الحد الأدنى من معرفة كنه هذه التطبيقات وطرق اشتغالها وأهدافها و المساحات التي تتحرك على أرضيتها وحدود صلاحياتها والقوانين المؤطرة لها، يمكن اللجوء إليها عند الحاجة؟
و ما هي علاقاتها المتشعبة بنوادي صناع القرار على المستوى العالمي والجهوي والإقليمي؟
والغريب، على الرغم من خطورة ما يتم الحديث عنه والتصارع حوله، فلا إعلامنا يولي أهمية لخطورته، فيعمد إلى تخصيص برامج توعوية خاصة في صفوف الشباب، بأساليب مبسطة تقرب المواطنين من هذه التكنولوجيا، ليكتسبوا الحد الأدنى من المعرفة بهذه المنصات، حتى يتم التعامل معها بقليل من العلم والمعرفة، و لا وزارة التربية والتعليم تنزل بثقلها لتخصها بأنشطة ملائمة، كما الشأن بالنسبة لمجموعة كبيرة من المناسبات طيلة الموسم الدراسي؟
فإلى متى نظل نغمض أعيننا ونصم آذاننا على ما يدور حولنا، مما تعج به قنوات غيرنا من مثل هذه الأحداث الراهنة، وفي الأخير نؤاخذ مواطنينا ونعيب عليهم هروبهم إليها واستهلاك موادها الإعلامية بنهم؟ فما الذي نقدمه لهم يجعلهم في صلب الحدث باحترافية عالية وبمهنية كبيرة؟ أين خبراؤنا ومتخصصونا وأساتذتنا بالجامعات، فيتم استدعاؤهم ليوضحوا للمواطنين ما يستشكل عليهم بخصوص مخاطر هذه المنصات، بدل ترك حبلهم على غاربه؟ فهل من دراسات علمية دقيقة، ترصد مدى تأثيرها على سلوك المغاربة وتشكيل مواقفهم من قضايانا الوطنية و هويتهم وتفردهم في تدينهم وفي عاداتهم الإيجابية وفي علاقاتهم الاجتماعية، أم دفن الرؤوس في الرمال والعمل بالقول الأثير “كم حاجة قضيناها بتركها”، هي سيدة الميدان، غير مكترثين بالعواقب، فلا ننتبه إلا بعد وقوع فأس الكوارث في رأسهم، فنجد عددا منهم يسقط في براثن العصابات الإرهابية لا قدر الله، ويعلق آخرون في شباك عصابات المخدرات والاتجار في البشر، ببيعهم وهم الهجرة نحو الفردوس المزعوم، و كم منهم بفعل تأثيرها لم يعد يربطه ببلده غير خيوط واهية أوهن من بيت العنكبوت، أما عقله ووعيه فإنه يشكل هناك، تصوغه هذه المنصات وفق ما يحقق أهدافها الآنية والاستراتيجية. فأكيد ما يظهر مما يتم نشره من محتويات ويتم تداولها على أوسع نطاق أعظم بكثير مما يخفى. فلا منطق يعلو على منطق الربح ف”الغاية تبرر الوسيلة”.







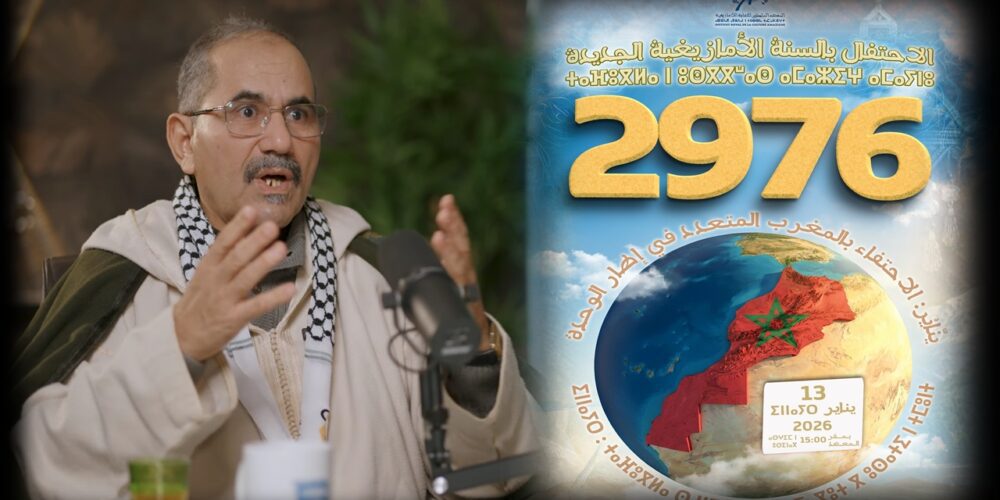

































أظن أن من الأسباب التي تجعل الإمساك أو تجاهل الإعلام لِ ”محلنا من إعراب” هذا السجال المتجدد ودوره في عدم تحسيس الشباب خاصة، (والذي صارت رحاه تدور على أرض وسائط التواصل الاج. بداية بالتضييق على جوجل ثم الرد بتحجيم اكتساح ”هواوي”…) أن غالبية الشباب سيرون في ذلك تدخلا في أذواقهم (مهما اختلفنا حول المحتوى الذي يهمه)، وقد يكون له الأثر العكسي : مزيد من الإقبال على التك توك، قياسا على علاقتنا كمستهلكين بالسلع الصينية الرخيصة ذات الوبال الوخيم أحياناً على البيئة وعلى صحة المستهلك وراحته رغم تحذير المختصين والمجرِّبين على حد سواء!!