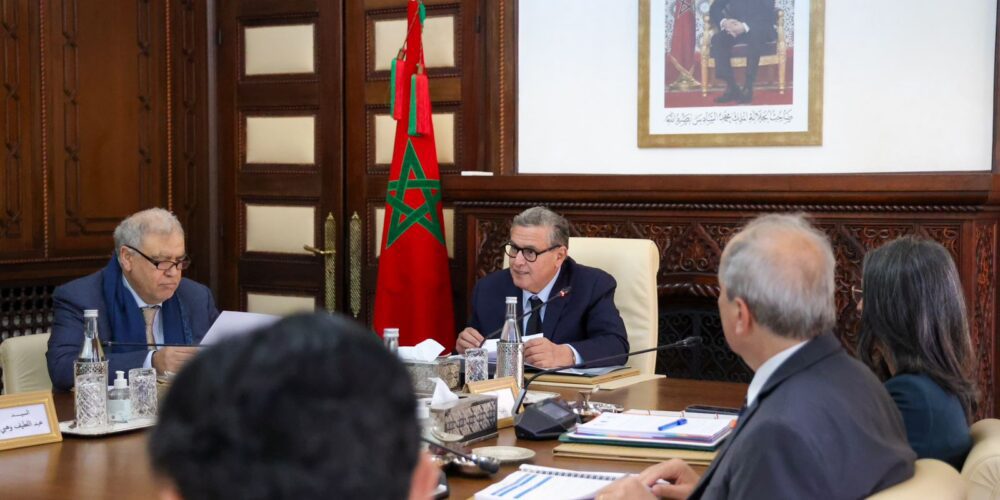معضلة ازدواجية لغة التعليم (دراسة نقدية)

هوية بريس – إعداد: مؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث
الإثنين 23 نونبر 2015
أصدر نادي الفكر الإسلامي سنة 1982؛ دراسة للدكتور إدريس الكتاني تحت عنوان: “النظام التربوي في المغرب بعد ربع قرن من عهد الاستقلال: 1956-1982″.
وتتناول عرضا ومناقشة لمشروع إصلاح التعليم المقترح عام 1980 من طرف وزارة التربية الوطنية..
جاء في مقدمة الدراسة:
“بعد سنوات طويلة من الاضطرابات والإضرابات، وبعد تأجج مشاعر الخيبة والتذمر واليأس، بسبب الأوضاع التي انتهت إليها سياسة التبعية الثقافية واللغوية في التعليم، قامت وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر بوضع مشروع إصلاح للتعليم الابتدائي والثانوي في أكتوبر 1980، تحت عنوان: “نحو نظام تربوي جديد”، ومشروع آخر لإصلاح التعليم العالي، وقد عرض المشروعان على أنظار لجنة مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض الهيئات والجمعيات، بينما تم إغفال المعنيين المباشرين بالأمر، من رجال التعليم، والخبراء بسياسة التربية، ومن الجمعيات الإسلامية والثقافية، وخاصة أولئك الذين ظلوا منهم يطالبون بتغيير سياسة الحماية في التعليم منذ سنة 1960، وبوضع حد لمخططات وأهداف السياسة الاستعمارية التي قامت عليها (مدرسة الحماية الفرنسية) التي ورثها المغرب المستقل.
وإن نادي الفكر الإسلامي، الذي هو أحد المؤسسات الثقافية الحديثة التي لم تدع للمشاركة في أعمال هذه اللجنة؛ يضم صوته للأحزاب الوطنية والمنظمات التعليمية والثقافية والإسلامية، التي أجمعت على رفض مشروع إصلاح التعليم المذكور بقسميه.
ويقدم فيما يلي أسباب هذا الرفض، مقتصرا فقط على ما تضمنه المشروع من أفكار وتوجيهات غريبة عن الفكر الإسلامي الأصيل، ومتعارضة مع المبادئ الوطنية التي أجمع عليها الشعب المغربي في سياسة التعليم، ومع القواعد التربوية المعمول بها في أنظمة التعليم العالمية ..
ومتناقضة مع نفسها لأنها تحاول عبثا أن توفق – بأسلوب خاص تكرر عشرات المرات، وأعلن المشروع نفسه عن فشله وعن نتائجه المأساوية – بين المبادئ الوطنية في سياسة التعليم التي تظل حبرا على ورق، وبين الاختيارات السياسية التي تهدف للمحافظة على مكتسبات التسلط الثقافي، والغزو اللغوي والفكري، الذي اكتسح الإدارة المغربية، وسيطر على التعليم والإعلام والثقافة، وأصبحت مكاسبه في عهد الاستقلال، تفوق عشرات المرات ما حققه في عهد الحماية، بفضل سياسة “التفتح” و”المعاصرة” و”عدم التعصب”، التي تبناها جيل التبعية في عهد الاستقلال، زاعما أنه لم يعد يشعر بـ“عقدة النقص” إزاء المستعمر القديم، وأنه الآن يختار لغته وحضارته بكامل الحرية وتمام الوعي”!
خلاصة الدراسة النقدية:
1- اللعبة الماهرة في المشروع أنه أغفل الإشارة تماما إلى “تحديد وتخطيط السياسة العامة للتعليم” التي هي محل خلاف دائم بين الشعب والحكومة، لمناقشتها والمصادقة عليها قبل الدخول في دراسة “هيكل النظام التربوي” الجديد المقترح، ذلك أن المشكلة الخطيرة التي عانى منها المغرب الأمرين، ليست مشكلة “الهيكلة”، بقدر ما هي مشكلة “محتوى التعليم وهدفه”.
2- المشروع كله يقوم على تغيير هيكل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، دون المساس بمحتوياتها الرئيسية، وخاصة منها ما يتعلق:
أ- بالفرنسية وازدواجية لغة التعليم.
ب- بالاتجاهات المادية العلمانية.
ج- بتطويق ومحاصرة الثقافة العربية الإسلامية.
3- أشار المشروع في المقدمة إلى مبادئ التعليم والتوحيد والمغربة كمبادئ متفق عليها، ولكن يصعب تحقيقها!، إلا أنه تغافل عنها بعد ذلك، ولم يقدم أي خطة لتطبيقها.
4- سكت المشروع كلية عن الدور الخطير الذي لا تزال مدارس (البعثة الثقافية الفرنسية) تواصله في تكوين أجيال مغربية فرنسية اللغة والفكر والعاطفة، بهدف تمزيق وحدة الفكر المغربي، وتأجيج الصراع الطبقي، وكأن الأمر لا يتعلق بمبدأ “توحيد التعليم”، وذلك من باب “يجب السكوت عما يكره”.
5- يحاول المشروع إغراء قرائه بأنه يهتم بالدرجة الأولى بتطوير التعليم حتى يصبح المغرب سنة 2000 في مستوى التقدم العلمي والتقني لحضارة الغرب، مع العلم بأن سياسة أصحاب هذا المشروع هي التي جعلت المغرب – حسب الإحصاءات الرسمية لليونسكو – في مؤخرة الدول العربية.
6- يلاحظ أن الذين حرروا الجزء الأول من المشروع في 23 صفحة، وهو المتعلق “بالتحليل النقدي للنظام التربوي القائم”، واستنتجوا “عدم قابليته للإصلاح”، هو غير الذين قاموا بوضع الجزء الثاني الخاص (بمشروع الإصلاح الجديد) في 53 صفحة، ذلك أن المشاكل التربوية في التحليل النقدي المذكور كانت تتطلب حلولا تربوية، بينما مشروع الإصلاح يتغافل نهائيا عن أسباب وعلل تلك المشاكل، وحلولها الموضوعية العلمية، ليقترح حلولا سياسية، هدفها تغطية تلك المشاكل، بالاعتماد فقط على تغيير الهياكل، دون المحتوى.
7- ومما يؤكد الملاحظة السابقة أن من بين الانتقادات الهامة التي وجهها محرر “التحليل النقدي” المذكور، للنظام التربوي الحالي، “ضعف الأبحاث التربوية الميدانية والتطبيقية أو (فقدانها بالمرة)، وهو الشيء الذي يترتب عليه اتخاذ قرارات أو حلول جزئية وظرفية لمواجة المشاكل، عوض إقرار الحلول العلمية المترتبة عن الدراسة العميقة للقضايا المطروحة” (ص10)
وقد جاء المشروع الجديد ليرتكب نفس الخطأ بإقراره عدة تنظيمات وتغييرات بطريقة مرتجلة، ولغايات سياسية، دون القيام بأية أبحاث ميدانية عن أسبابا المشاكل لتشخيصها قبل وصف الحلول الملائمة لها؛
فهل بهذه العقلية الإدارية، وهذا الأسلوب اللاعلمي، سيحقق المسؤولون عن التعليم دخول المغرب إلى عصر التقنية والفضاء سنة 2000؟!
الازدواجية الاستعمارية أخطر كارثة في عهد الاستقلال:
لعله لأول مرة، منذ عشرين عاما، يضطر المسؤولون عن التعليم للاعتراف علنا بأن التعليم الحالي يحتضر بسبب سرطان استحال علاجه، هذا السرطان يكلف الدولة ميزانية سبع سنوات إضافية للتعليمين الابتدائي والثانوي في كل اثني عشر عاما، بسبب تكرار التلاميذ للسنوات، وطردهم إذا لم ينجحوا في السنة الثانية، كما أنه يستنزف من أعمار التلاميذ سبع سنوات إضافية؛
فبدلا من أن يحصلوا على الثانوية العامة في سن 18 عاما، كنظرائهم في أغلب دول العالم، يشاء لهم نظام التعليم المزدوج أن يمكثوا في هذا التعليم سبع سنوات أخرى حتى يبلغ عمرهم 25 عاما، يتم خلالها استنزاف طاقاتهم الاقتصادية والنفسية والشبابية، فيتوقفون تلقائيا عن متابعة تعليمهم العالي.
ومع ذلك فإن أحد المسؤولين عن التعليم لم يجرؤ أن يذكر اسم هذا السرطان، أو يبحث عن سبب ظاهرة التكرار والانفصال، بحثا علميا، إلى أن جاء وزير التعليم الحالي عز الدين العراقي فاعترف بالحقيقة العلمية التي تختفي خلف الظاهرة في تصريح له بجريدة (العلم) في 20 دجنبر 1977، قائلا:
“… وقد أثبتت الدراسات التقنية أن أسباب انخفاض مستوى التعليم ترجه لازدواجية لغة التعليم”.
وقد شرحت معلمة فرنسية في مدارس البعثة الفرنسية، وفي مدرسة حرة عربية، بكل بساطة، مشكل الازدواجية في نظام التعليم المغربي قائلة:
“أن التلميذ المغربي يطلب منه أن يدرس جميع المواد التي يدرسها التلميذ الفرنسي وباللغة الفرنسية، وفي نفس الوقت عليه أن يدرس المواد العربية والدينية باللغة العربية، وكلا اللغتين يختلفان عن لغة أمومته، وأحيانا، عن لهجتي تخاطبه الإقليمية والوطنية، وهذا شيء إذا كان في مقدور الأذكياء جدا، فإنه فوق طاقة التلميذ العادي بكل تأكيد”.
ونظرا لأن هذه المشكلة قد قتلت بحثا من طرف الخبراء المغاربة[1]، فإننا نكتفي بنقل فقرات من محاضرة لم تنشر لخبير في شؤون التربية هو الأستاذ محمد السرغيني المفتش الأول السابق لوزارة التعليم عن أثر “الازدواجية الاستعمارية وتعدد اللهجات واللغات في التربية والتعليم” جاء فيها:
“… فما مصير الطفل في ذلك كله؟
إنه بالطبع مسير لا مخير، فها هو بعد ازدواجيته الأصلية (عامية وفصحى)، أو ازدواجيته الخاصة (لهجة محلية وفصحى عامية)، مطالب بتحمل ازدواجية استعمارية جديدة…
تصوروا معي لحظة واحدة، ما يتطلبه اكتساب لغة واحدة، والتصرف فيها، من استعدادات فطرية، ومواهب عقلية، وجهود مضنية، من المعلمين والتلاميذ على السواء، فضلا إذا الأمر يتعلق بتعلم ثلاث لغات بالنسبة للبعض، وأربع لغات بالنسبة للبعض الآخر.
إن ازدواجنا الأصلي، له وحده من العواقب ما يكفي، وطفلنا المغرب، كسائر أطفال العالم، لا يمكن أن نحمله أكثر مما يطيق، وفوق ما يطيق.
ولنترك الآن الكلام لألبير ميمي، يصف لنا الازدواجية الاستعمارية في كتيبه المعنون (وصف المستعمر) صفحة 135-145، والذي كتب مقدمته الكاتب الفرنسي الشهير جان بول سارتر:
“إن التمزق الأساسي عند المستعمر (بالفتح) يظهر بصورة بارزة في الازدواجية الاستعمارية، إذ بمجرد ما يتخلص الشخص المستعمر من الأمية، يسقط في هوة الازدواجية اللغوية، وذلك إذا كان من زمرة المحظوظين، لأن أغلبية المستعمرين لا تواتيهم الظروف مطلقا حتى لتكبد مشاق تلك الازدواجية، فيتمسكون دوما بلغتهم الأم، أعني بلغة لا تقرأ ولا تكتب، ولا تمكن صاحبها إلا من تثقيف شفوي ضعيف، مشكوك في فعاليته…”.
ويا حبذا لو كانت اللغة الأم تتمتع بجذور قوية في الحياة الاجتماعية مخترقة شبابيك الإدارة، ومتحكمة في المواصلات البريدية، فحتى مثل هذا لا يتحقق في النظام الاستعماري بحيث كل مصلحة إدارية أو قضائية أو فنية لا تريد باستعمال لغة المستعمر بديلا، فتراها على الأنصاب الكيلومترية، وواجهات المحطات، وعلامات الطرق والأزقة، والتواصيل وغيرها، فالمستعمر المتكلم بلغة الأم لا غير، يصبح أجنبيا في بلده، إن الازدواجية ضرورية في الوضع الاستعماري، لأنها شرط أساسي لكل معاشرة وثقافة وتقدم، ولكن بمجرد ما يتخلص الفرد المستعمر المزدوج اللغة، من قفص العزلة، يجد نفسه معرضا لكارثة فكرية، يصبح من الصعب التغلب عليها بكيفية نهائية.
نعم، إن عدم الانسجام الموجود بين اللغة الأم ولغة التثقيف، ليس خاصا بالمستعمر وحده، وكيفما كان الحال، فالازدواجية الاستعمارية لا يمكن أن تمثل بأية ازدواجية لغوية أخرى، والسبب في ذلك أن التحصيل على لغتين، ليس معناه في الحقيقة التمكن من استعمال أداتين لغويتين اثنتين لا غير، بل إنه أيضا المشاركة في عالمين فكريين ونفسانيين اثنين، أضف إلى ذلك أن هذين العالمين المشخصين في لغتيهما، هما عالما المستعمر (بالكسر) والمستعمر (بالفتح) القائم بينهما الصراع من أجل البقاء.
هذا، واللغة الأم التي تغذيها أحاسيس المستعمر (بالفتح) وميوله وآماله، والتي عن طريقها ينفجر عطفه وحنانه، وبها يتحرر من القيود اندهاشه وإعجابه، تلك اللغة التي تكتنز في ثناياها أقوى طاقة عاطفية، هي التي تكون محتقرة بالذات، فلا كرامة لها بالمرة في البلاد، ولا شرف لها بين الناس.
وإذا ما أراد المستعمر (بالفتح) الحصول على مهنة من المهن، أو وظيفة من الوظائف يبرر بها وجوده في وسطه وبين أفراد جنسه، فلابد من الاستسلام قبل كل شيء للغة الآخرين، لغة الأسياد والمستعمرين، فلا غرابة إذا خرجت اللغة الأم من هذه المعركة اللغوية ذليلة ومنهزمة.
ولا تقف المسألة عند هذا الحد، بل تتعداه فيصير الازدراء باللغة الأم ثابت الأركان، راسخا في الأذهان، يحتضنه المستعمر (بالفتح) نفسه حيث تراه يتجنب استعمال تلك اللغة المستضعفة، حاجيا إياها عن أسماع الأجانب، ولا يشعر بالراحة والاطمئنان إلا بتقمص لغة مستعمره!”.
ويختم ميمي وصفه الدقيق قائلا:
“والخلاصة أن (الازدواجية الاستعمارية) ليست من النوع الذي تتعايش فيه لهجة شعبية ولغة فصحى راقية، تنتسب كل منهما إلى عالم عاطفي واحد، وليست كذلك مجرد ثروة للمتكلم بعدة لغات، يستفيد منها كملمس إضافي في جهازه الكلامي، محايد على قدر الإمكان، إنها، والحق يقال، مأساة لغوية”.
والغريب في هذا الوصف العام أنه، بالنسبة للمغرب، لا ينطبق فقط على عهد الحماية الفرنسية، بل حتى على عهد الاستقلال، وبعد مرور ربع قرن من هذا العهد.
ولعلنا لا نحتاج للتذكير بأن الكاتب التونسي المذكور لم يشرح في وصفه هذا أخطار الازدواجية الاستعمارية على الشخصية القومية للبلاد، وعلى دينها وقيمها وأخلاقها، فقد ترك تحليل هذه الموضوعات للذين يعنيهم الأمر مباشرة، واقتصر على ما يتعلق بموضوعه الخاص وهو: (وصف المستعمر) “بالفتح” من الناحية الثقافية، وكيف تذوب شخصيته ومقومات ثقافته في ثقافة المستعمر.
ويتابع الخبير المغربي الأستاذ السرغيني بعد ذلك تعليقه قائلا:
“ولنرجع إلى ما نحن بصدده، ألا وهو التأثير اللغوي في التكوين التربوي، (عامية وفصحى) أو (لهجة محلية وفصحى) أو (عامية ولهجة فصحى)، ثم (ازدواجية دخيلة)، هذا هو نصيب تلميذنا المغربي في الابتدائي العصري العمومي.
أما إذا ابتسم له الحظ، وعبر الطور الأول من الثانوي، ثم وصل إلى الطور الثاني منه، فيصبح “بوليكلوت” أي متعدد اللغات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بحيث يتحتم عليه أن يلم بلغة أجنبية ثانية، تختلف عن سابقتها.
فلا غرابة إذن أن يصل طفلنا في آخر سفره الدراسي الطويل، المملوء ببعض العجائب والغرائب، وقد أخذ التعب منه مأخذه، منهوك القوى، محصلا على قشور من تلك اللغات، التي إنما هي أدوات لنقل العلم والعرفان، لا غاية في حد ذاتها …
مقارنة دامغة بين الدول العربية المزدوجة اللغة والدول الموحدة:
ولعل من المفيد أن نقوم بمقارنة علمية دامغة لنسبة التحاق التلاميذ بالتعليمين الثانوي والعالي سنة 1974-1975، بين مجموعتين من الدول العربية، مقتبسة من جدول عام أعدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دراستها “استراتيجية تطوير التربية العربية” ص:386، حسبما يلي:
| نوعية لغة التعليم | القطر | نسبة التحاق التلاميذ بالتعليم الثانوي | معدل النسبة | نسبة التحاقهم بالتعليم العالي | معدل النسبة |
| دول عربية مزدوجة لغة التعليم | المغرب | 14 |
16.7 |
2.42 |
2.70 |
| الجزائر | 16.2 | 2.66 | |||
| تونس | 20 | 3.03 | |||
| دول عربية موحدة لغة التعليم | مصر | 38.5 |
40.5 |
12.95 |
10.3 |
| ليبيا | 44.5 | 11.11 | |||
| سوريا | 44.7 | 9.86 | |||
| الأردن | 41.6 | 9.92 | |||
| العراق | 32.6 | 7.87 |
إن إلقاء نظرة علمية فاحصة على هذا الجدول تجعل أي باحث تربوي يندهش للفرق الكبير بين نتائج نوعين من التعليم، في مجموعتين من الدول العربية، إحداهما خضعت في نظامها التربوي لاستعمال لغة مستعمرها السابق، كلغة تعليم، ابتداء من تعليمها الابتدائي، بجانب لغتها الوطنية، والأخرى وجدت لغة التعليم التي هي اللغة العربية، وكانت النتيجة انخفاض نسبة النجاح والانتقال إلى الثانوي، ثم إلى العالي في المجموعة المزدوجة اللغة، إلى أقل أو أكثر من ثلث نظيرتها فقط في المجموعة الموحدة اللغة.
إن هذه المقارنة تتحدى جميع خبراء التربية والتعليم في دول المغرب العربي، وفي فرنسا نفسها، أن يثبتوا علميا، أن هذا الانخفاض الخطير يرجع إلى عامل آخر غير عامل (ازدواج لغة التعليم).
وقد سبق أن شرحنا في غير هذا البحث؛ أن إدراك المفاهيم والمعلومات باللغة الوطنية أسرع وأقوى منه باللغة الأجنبية، حيث أتينا بعدد من نتائج البحوث التربوية الدالة على دور وتأثير اللغات الوطنية في تنمية الطاقات البشرية.
وأضيف إليها هنا ما حدثنا به الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية في الأردن، في عرض إلقاء أمام أعضاء المؤتمر الأول للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمان يوم 12 أبريل 1982، عن نتائج التعريب بالجامعة الأردنية، حيث لأبرز حقائق باهرة، منها مثلا، أن تعريب علم الأحياء جعل نسبة الرسوب تنخفض من 25 في المائة إلى 4 في المائة.
وإذا كنا نأسف لشيء -ولا نستغربه- فمن موقف بعض الهيئات السياسية والثقافية في (لجنة إصلاح التعليم)، فبعضها اختفى صوته في الدفاع عن المبادئ والبعض الآخر استسلم للاتجاه العلماني الذي بدأ يفرض نفسه على نظام التعليم، وبعض الذين ظلوا صامدين في المعارضة، اقتصر في نقده للمشروع على مشكل التعميم، ولم يعرج إطلاقا على مشاكل الازدواجية والتعريب والمغربة وتوحيد التعليم، وكأنه لا شأن لها في إصلاح التعليم، أو كأن المشروع قد أعطى حلولا مقبولة لها، فلم تعد هناك حاجة لإثارتها، مع أن التعميم نفسه يستحيل مع الازدواجية، وبدون التعريب، حتى ولو بعد مائة عام، لا من الوجهة التربوية البحتة، بالنظر للواقع اللغوي للتلاميذ المغاربة فقط، حسبما أشرنا إليه آنفا، ولكن أيضا بحكم التجربة الفعلية لمدة ربع قرن، والتي جعلت المغرب في الدرجة السفلة من نسبة تعميم التعليم” اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النظام التربوي في المغرب ص: 20-25 باختصار
[1] انظر ما كتبته عن الموضوع في مجلة اللسان العربي عدد 1 يونيو 1964، وعدد 3 غشت 1965. وجريدة الميثاق عدد 18 في 13 نونبر 1964 وعدد 58 في 25 يوليه 1964. ومجلة ((cafrad بالفرنسية والإنجليزية عدد 8 غشت 1972، ومجلة اللسان العربي ج 1 مجلد 10 يناير 1973، وغيرها مما نشر في جريدة العلم وفي مذكرات ونشرات متعددة خلال الستينات والسبعينات.