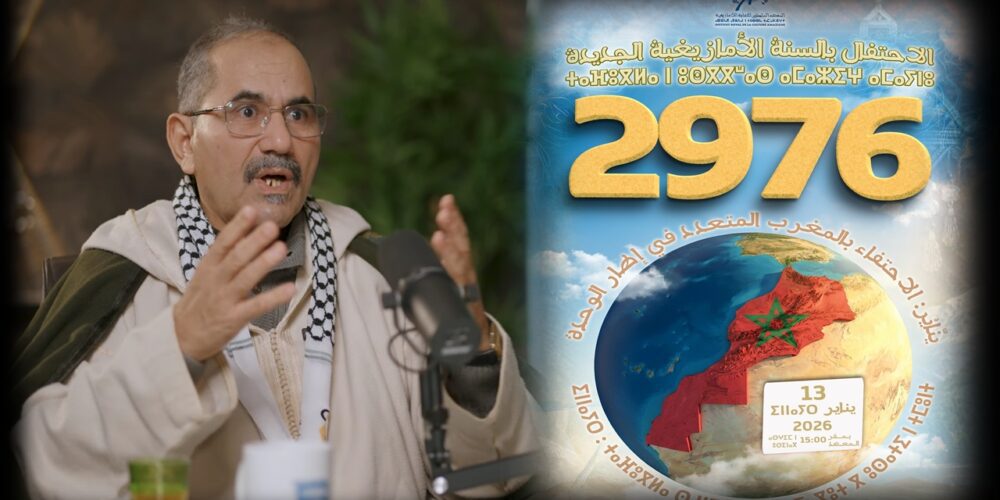من تحريف “دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر” إلى تحريف “الدين لله والوطن للجميع”

من تحريف “دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر” إلى تحريف “الدين لله والوطن للجميع”
هوية بريس – عبد الرحمن ورشيد
رُوي في الحديث النبوي: (يَحملُ هذا العلمَ من كلّ خلفٍ عُدولُه، ينفونَ عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين).
إن التاريخ الإنساني فائض بالأمثلة التي تدل على هذه الآفات الكبرى التي نحن أمامها:
آفة الانتحال الإبطالي.
آفة التأويل الجاهل.
آفة التحريف الغالي.
هذه الآفات الثلاث -والتي استخرجها أستاذنا ميمون نكاز في محاضرته الماتعة بعنوان: “تحرير الشريعة الواصلة من الآفات الفاصلة“- تُفسّر لنا تزييف المعاني الأصلية للمقولات الكبرى لتَصُبّ في أغراض وأهواء بعيدة عن مقصدها الأصلي.
ومن هنا ننتقل إلى البحث في التأويليْن، وذلك من خلال تحليل أثر هذه الآفات الثلاث على المقولات الكبرى: التّحريف الغالي، والانتحال الإبطالي، والتّأويل الجاهل.
أولا: مقولة “دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر”
ناقش محمد قطب -رحمه الله- هذه المسألة في كتابه “مذاهب فكرية معاصرة” في التمهيد الأول، عندما عقد مقارنة تاريخية بين الدين والكنيسة، والآفة التي نتجت عن هذا التفاعل، وهي آفة تحريف الدين.
فقال: “جاء في أناجيلهم هذه القصة: ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه (أي السيد المسيح) بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودوسيين قائلين: يا معلم، إنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارًا فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا.”
ثم شكك محمد قطب في نسبة هذه المقولة إلى سيدنا عيسى عليه السلام، ولكنه افترض حدوثها جدلا فقال: “هل يمكن أن يكون قصده منها إعطاء الشّرعية لأمر قيصر الذي لا يؤمن بالله ورسوله ولا يتحاكم إلى شريعة الله، وقِسمة شؤون الحياة بين قيصر وبين الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون لقيصر نطاق يتصرف فيه على هواه ويطاع فيما يأمر به، وتكون بقية الشؤون التي لا يهتم بها قيصر هي النطاق المتروك لله؟
وما الشّرك إذن في أجلى صوره؟
إنّ أقصى ما يمكن أن تدل عليه القصة -على فرض صحتها جدلا- أن المسيح عليه السلام يقول لهم: إننا لم نؤمر الآن بقتال قيصر، فإذا فُرضت عليكم الجزية ولا قِبل لكم اليوم برد سطوته عنكم فادفعوا له الجزية، حتى يأتي اليوم الذي يؤذن لكم فيه بالقتال لإخضاع قيصر لشريعة الله.
وهذا كما قيل للمؤمنين في مكة: {كُفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، حتى جاءهم الإذن بالقتال في قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}، ثم جاء الأمر بالقتال لإخضاع الأرض كلها لشريعة الله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}.
ولكن الكنيسة حملة هذه القصة -على فرض صحتها- فوق ما تحتمل، وزعمت أن معناها أن من حق قيصر أن يحكم عالم الأرض، على أن يحكم الله عالم السماء. أو أن الأبدان لقيصر يفعل بها ما يشاء في الحياة الدنيا، ولله الأرواح في الآخرة. وهكذا سمحت للعالم المسيحي أن يحكمه القانون الروماني في كل شؤونه، ما عدا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغير ذلك، وأن ينحصر سلطان الله على عباده في مشاعر الخشوع والتقوى والشعائر التعبدية والأحوال الشخصية. وتم بذلك فصل العقيدة عن الشريعة، وتم المسخ الكامل لدين الله.” ا.هـ
وهذا عين ما يدعيه أصحاب التيار المقابل للتصور الإسلامي مع بعض التطورات التي نشهدها، والتي اقتحمت لمحاولة التضييق عن شريعة الله في الأرض حتى في مجال الأسرة التي هي أساس المجتمع.
ومن هنا كان ذلك الدين -وفقا لتصور “دع ما لقيصر لقيصر” “الوطن للجميع”- غير صالح لا للدنيا ولا للآخرة، لأن الدين الصالح دنيا وآخرة هو الدين الذي يكون فيه كل شيء لله، هو الدين الذي تكون فيه الحاكمية لله، هو الدين الذي تكون فيه –كما قال أستاذنا ميمون نكاز- “السيادة الأصلية العالية للشرع”.
{قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57)} [سورة الأنعام]
{ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40)} [سورة يوسف].
{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [سورة المائدة].
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: “(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله [صلى الله عليه وسلم] فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ، قال الله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون) أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون . (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء.
ثانيا: مقولة “الدين لله والوطن للجميع”
هذه المقولة حُمّلت دلالات متعددة:
1) قد تفيد التعايش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في إطار وطني واحد، وهذا المحمل حق وما دام كذلك فهذا يعني أن الأصول الكلية للدين الإسلامي تستوعبها {لكم دينكم ولي دين} {فمن شاء منكم فليومن ومن شاء منكم فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها}، ووثيقة أو “دستور” المدينة يشهد بذلك.
2) قد يفهم منها أنها فصل بين العقيدة والانتماء الوطني، بحيث يبقى الدين أمرا شخصيا بينما الوطن جامع مشترك للجميع.
3) قد تستخدم لإعادة تعريف الولاء من الانتماء العقدي إلى الانتماء الترابي.
4) وكثيرا ما يتم استثمارها –وهذا هو توظيفها والذي يلتقي مع تزييف “دع لله ما لله وما لقيصر ما لقيصر”- في اتجاه إقصاء وإبادة الدين عن الشأن العام، أو بتعبير أستاذنا ميمون نكاز “فصل الدين عن الوجود الموضوعي للإنسان”، بحجة أن الوطن للجميع، مما يُحصر الدين في دائرة الشعائر الفردية، أو بتعبير أستاذنا “محاصرة الدين في دائرة الضمير الضيق”، والسلطة في الأرض لقيصر.
ولفهم هذه المقولة وحملها على محملها لابد من الرجوع إلى سياقها التاريخي، من حيث الإنسان والزمان والمكان والحدث:
أ) السياق التاريخي من حيث الإنسان: اختلف فيمن قال هذه المقولة أولا، لكن الإجماع واقع على أن الذي اشتهر بتفعيلها على أرض الواقع هو سعد زغلول، زعيم حزب الوفد في مصر.
ب) السياق التاريخي من حيث الزمان والمكان والحدث: ظهرت هذه الفكرة في ثورة 1919م المصرية، حيث استُخدمت لتوحيد المصريين متعددي الديانات ضد الاحتلال العسكري البريطاني.
فنحن نرى أن هذه المقولة “الدين لله والوطن للجميع” فُعّلت على أرض الواقع من أجل سببين:
السبب الأول الأصلي هو توحيد متعددي العقائد.
والسبب الثاني التابع هو محاربة الاحتلال العسكري البريطاني.
فهي هنا قد أفادت واحتملت دلالة التعايش والمناصرة والالتحام… ضد العدو الخارجي الذي سيهلك ويبيد المسلم والمسيحي القبطي واليهودي والمشرك والمنافق، الأبيض والأسود والأحمر، الغني والفقير ومن بينهما، الرجال والنساء…، وهذا أمر معلوم في السيرة النوبية التي هي مصدر تشريعي، وبنود “دستور المدينة” يحفظها الصبية.
فهذا هو أصل المقولتين وسياقهما التاريخي، ولكن ماذا يفعل “المتذبذبون” و”المنسلخون” و”أعداء الدين” غير الانتحال الإبطالي والتأويل الجاهلي والتحريف الغالي.
ثالثا: المقولة في الخطاب القانوني والحقوقي المعاصر:
ملاحظات تمهيدية:
أ) كلتا المقولتين مورس عليهما التزييف من خلال الآفات الثلاث، فبينما نجدهما تحتملان دلالة اللحمة الداخلية والانسجام الاجتماعي، نجد “اللاعبين العابثين” يحملونها على التفتيت والتفكيك من أجل الرضوخ تحت حمى القوة المهيمنة.
ب) المعاصرون هم فقط امتداد للمتقدمين، لا جديد عندهم سوى الوسائل التي يوظفونها.
ت) هذه الفكرة يحملها كثير من “المتذبذبين” و”المنسلخين” و”أعداء الدين”، ونحن هنا نناقش دلالاتهم المعروفة لها، دون أن نلتفت إلى قائلها.
لقد اطلعتُ على المقال الذي هو بعنوان “الدين لله والوطن للجميع”، والذي نُشر على خلفية اعتقال إحدى المسيئات لإنسانيتها المتجرئات على الذات القدسية من خلال إيحاءات التّعيس إبليس لجنوده المناحيس، والمقال يعكس اتجاها عاما وممتدا منذ بداية ضلال الإنسان، والذي يسعى إلى نزع القضايا من سياقها العقدي والشرعي وحصرها في النقاش القانوني الإجرائي أو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها المرجعية العليا، على نهج “دع ما لقيصر لقيصر”.
1) ملامح هذه المقاربة:
اعتبر الكاتب أن النقاش قانوني حقوقي، لا علاقة له بالدين أو العقيدة.
رفض إدخال الفقهاء والعلماء، بحجة أن ذلك يؤدي إلى اعتبار الفعل ردة وما يستتبعه من أحكام شرعية.
استند إلى المرجعيات الدولية، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخطة عمل الرباط (2012م) ليستنتج أن العقوبة بالسجن لا سند لها، [وأن أقصى ما يمكن حدوثه هو التغريم].
اعتبر أن العودة للنقاش الديني “إغراق للنقاش العمومي في متاهات الهوية والرموز”.
2) إشكالية هذا الإطار:
يظهر لنا هنا وجه من أوجه الآفات الثلاث وهي آفة التأويل الجاهل، إذ تُستعمل مقولة “الدين لله والوطن للجميع” لإقصاء البعد الشرعي عن النقاش العمومي [خليونا حنا القانونيين الناقشو فهاد الأمور يا الفقها وسيرو شوفو أحكام الوضو]. بينما الواقع أن المساس بالمقدسات ليس مجرد فعل قانوني، بل هو مساس بجوهر التعاقد الديني والاجتماعي للأمة، وهو يمس أصل وجودها الإنساني.
3) بين السيادة الشرعية والمرجعة الدولية:
القول بأن المرجعية الدولة “ملك للإنسانية” تحريف غالٍ، لأنه يجعلها أسمى من الشرع، بينما السيادة في مجتمعاتنا الإسلامية تعود ابتداء بالضرورة واللزوم إلى الشريعة.
{قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} [سورة الأنعام 162-163].
4) إعادة توظيف المقولة:
آفة الانتحال الإبطالي تتجلى في جعل الشعار مبرّرًا لفصل الدين عن الشأن العام، بينما أصل المقولة كان ظرفيا مخصوصا لتوحيد صفوف المتضادين في العقيدة ضد الاحتلال، في حين أصبحت وظيفتها الآن تشتيت وتفكيك وتفتيت من هو داخل العقيدة الواحدة لدخول الاحتلال، فبينما بنى الباني جسرا لدخول العلمانية في ذلك الزمن نجد اليوم من يُمتّن ويُشرْعِن وجود هذا الكيان الغريب في فكر الأمة الإسلامية.
ختاما:
إن هذا الفكر يعكس أزمة تأويل معاصر يستمد اشتغاله بأسلافه الضاربين في عمق التاريخ على امتداد بداية الضلال في الوجود الإنساني، حيث تُحوّل القضايا الشرعية إلى ملفات قانونية صرفة، وتُستدعى المرجعيات الدولية لتصبح بديلا عن السيادة الشرعية، وهذا الأمر يعيد إنتاج الآفات التي حذر منها الحديث: تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. أما التصور الإسلامي فيقدم تصوراته الأصلية الواضحة:
1) الدين لله عبادة وشرعا وسيادة.
2) السيادة للشريعة: فهي المرجع الأعلى الذي يحتكم إليه الناس في التشريع والقضاء والسياسة.
3) الوطن إطار للعمران البشري: مجال للاستخلاف والعمل والإصلاح، لا يُعبد ولا يُؤلّه، بل تضبط حدوده بمقاصد الشريعة وقيمها.
{قالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف 128].