هل ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نصد هجوم الحملات التطبيعية؟

هوية بريس – إبراهيم الطالب
القوة الإيمانية، والوعي الكامل بالذات والآخر والواقع، والقدرة على الفعل القوي المؤثر على الأرض، كل هذه الأمور الثلاثة يجب أن يتوفر عليها مَن يهمه أمر وطنه وأمته، حتى يضع المنهج الأمثل في العمل، ليصل إلى التقليل من الأخطاء المنهجية التي تؤثر على مشاريع الإصلاح ومدافعة الفساد.
ونحتاج هذا المنهج بالخصوص عندما تتزاحم الملفات الكبرى الملحة، فيضطر الإنسانُ العاملُ إلى أن يختار في أيها يشتغل؟ أو كيف يجمع بينها كلها؟ وما هي شروط هذا الجمع حتى لا يسقط في الإخلال بحق الجميع؟ وإن استحال الجمع يلزمه أن يحدد أيهما يمكن تخصيصه أكثر بالجهد والعمل أكثر من الآخر، وإخضاعه للمعالجة المرجوة من أجل إيجاد الحلول.
ومثال هذا الوضع -أي التزاحم بين الملفات الكبرى- نجد قضية الرسوم المسيئة وما التف بها من قضايا مثل اضطهاد مسلمي فرنسا، وإدارة حملات الإسلاموفوبيا بغية الحد من التمدد الإسلامي، الذي يكتسح أوربا، بحيث أصبح يُعتبر عند حُماة العَلمانية مهددا للوجود العلماني في أوربا، فهذه القضية تتزاحم مع قضية أكبر وأشمل ولا تقل عنها خطورة، وهي قضية الهجوم الجارف لحملات التطبيع التي تقودها أمريكا في العالم الإسلامي، إذ أصبحت الدول الإسلامية تتساقط واحدة تلو الأخرى بين أرجل الصهاينة، الأمر الذي يُعد من الأخطار العظيمة التي تهدد الأجيال القادمة، بحيث يمكن اعتباره أشد من حملات الاحتلال التي مرت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
العقل الغربي الصهيوني يعلم أن شعوب العالم الإسلامي يستبد بها الحماس وفيها غيرة جامحة إذا أسيء تدبيرها يكون من أهم نتائجها تعطيل العقل الجمعي في المجتمعات المسلمة من التفكير فيما هو أولى وبذلك نضيع واجب الوقت.
فعلا المسلمون حماسيون إلى النخاع، والنخبة فيهم تتبع العامة عندما تتحرك مشاعرهم فتصير الشعوب المتحمسة هي القائدة للفعل على الأرض لا النخب؛ وغالبا ما لا يستمر ذلك الحماس طويلا لهذا العيب، والذي يزيد من استفحاله ضعف المؤسسات المؤطرة للشعوب، فبعد تفكك القبائل والزوايا التي كانت تؤطر القوى الشعبية لم تستطع الأحزاب والجمعيات التي خلفتها في التأطير الاجتماعي أن تقوم بوظيفتها، نظرا لفقدانها الشرعية لدى الشعوب، جراء التدخلات الأمنية للسلطة الإدارية في توجيه نشاطها وإفسادها، بل وصل الأمر إلى خلق أحزاب إدارية وظيفية لإرباك المشهد السياسي والتحكم فيه.
فالمقاطعة لفرنسا مثلا ستعطي أكلها في الإضرار بالمصالح الاقتصادية لفرنسا، لكنها لن تحدث التغيير، للأسباب التي ذكرناها آنفا.
ويبقى السؤال الذي يُلح على كل باحث هو:
هل هذا التصرف الأرعن للرئيس ماكرون وتأييده للصور المسيئة لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وللمسلمين جميعا، يندرج فقط ضمن حملة محاربة التمدد الهائل الذي يعرفه الوجود الإسلامي في فرنسا؟ هذا الوجود الذي تمثله اليوم ستة ملايين نسمة، يمده كل سنة مئات الفرنسيين الذين يتحولون سنويا من النصرانية أو العلمانية إلى الإسلام.
أم أن الأمر مرتبط بالحملة التطبيعية المسعورة التي يقودها كبير مستشاري البيت الأبيض الصهيوني “كوشنر” صهر الرئيس ترامب؟
فحملة التطبيع الأمريكية لصالح الصهيونية تستفيد بقوة من أمرين مهمين يشتركان في كونهما محل شبهة “الافتعال” لقضاء مصالح استراتيجية كبرى، فكوفيد 19، والذي يتهم في تطويره “بيل غيت” خلق البيئة المثلى لتوسيع عضوية نادي المطبعين، أمن سدنة التطبيع معها ردود فعلٍ جماهرية لمليار و600 مليون مسلم، وذلك لأنهم يوجدون في حالة تكميم وتكبيل، تكميم للأفواه وتكبيل للأرجل والأيدي، بموجب قوانين حالة الطوارئ الصحية التي هيمنت على الدول الإسلامية جميعها، والتي مَنعت الشعوب من حق التظاهر للتعبير عن الرفض الجماعي لسياسات التطبيع، وحرمت النخبة ومؤسساتها من الاجتماع والتنسيق، ومنعتهم من التنقل خارج البلاد لتنظيم المؤتمرات والتظاهرات، هذا ناهيك عن حالة الذعر والخوف التي تجعل الإنسان مكبل العقل والتفكير أيضا.
ومن يستطيع أن يفكر من النخبة افتُعِل له الأمر الثاني لصرفه عن الاشتغال بمناهضة التطبيع: وهو التصريحات الرعناء لرئيس فرنسا الموظف السامي في شركة روتشيلد الصهيوني قبل أن يصبح رئيسا، حيث اتجهت أغلب النخب بفعل الحماسة الجماهرية إلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإدارة المقاطعة الشعبية للاقتصاد الفرنسي، والدفاع عن المسلمين الفرنسيين المستهدفين من طرف الحكومة الفرنسية الخاضعة لمنظمات الإسلاموفوبيا، والتي تتقاطع معها في الكراهية للمسلمين والخوف من تمدد وجودهم.
فكورنا وحملة ماكرون على الإسلام يبدوان في ظل تساقط الدول العربية، كأنهما يشكلان سرب طائرات مقاتلة لتوفير الحماية والتغطية الجوية لمليشيا التطبيع التي تكتسح كل يوم بلدا جديدا دون أية مقاومة تذكر.
يجب أن نقر أن لِلعقل “الصهيونصراني” ذكاءً كبيرا وخبثا ماكرا، في تدبير الملفات الكبرى المتعلقة بالحرب على الإسلام، ذكاءٌ وخبث يَستِغلان الفسادَ والاستبداد في بلداننا الإسلامية، ليتدخلوا في القرارات السيادية، فتصبح الدول الخاضعة المطبّعة أدواتٍ توظف في تدبير الصراع الدولي بين الكبار، فـ”إسرائيل” وأمريكا استطاعا مزاحمة الصين في إفريقيا بـ”فتح” السودان وضمه إلى جوقتهما؛ وتسخيره لفائدة البنتاغون لتأسيس قاعدة عسكرية تحرس العمق الإسرائيلي في إفريقيا، وتحفظ المصالح الاستراتيجية الأمريكية فيها، فأمريكا تقوم خلال العقد الأخير بعملية حاسمة لتَخْلُف فرنسا في مستعمراتها القديمة، ولهذا سنرى توسعا صهيو-أمريكيا كبيرا في القارة السمراء من شمالها إلى جنوبها.
هذا النفوذ الأمريكي مثلا في السودان الذي جاء ردا سريعا على اهتمام تركيا وتحركها فيه في 2018، حيث سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن خلال زيارةٍ للخرطوم، أن السودان خصص جزيرة “سواكن”، الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان، لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، والعجيب أن الدول المطبعة اليوم هي من رفضت التواجد التركي آنذاك في السودان وصرحت بأن تركيا تريد بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة.
فمباشرة بعد هذا التصريح بدأ العالم يتابع كيف تحركت الثورة على البشير رويدا رويدا، ليصبح السودان اليوم مثل مصر، يحكمه العسكر الذي لا يتوانى في إعطاء الطاعة والولاء للرايتين الإسرائيلية والأمريكية، ويعمل حارسا للمصالح الاستراتيجية للدولتين، ويقف سدا دون تقديم أي شيء لصالح قضاياه القومية، سوى كلام للاستهلاك الإعلامي من قبيل: “نحن سنطبع مع إسرائيل، لكن نبقى مع مصلحة فلسطين وحل الدولتين، والذي ستكون فيه القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية”.
أمريكا لعبت دور شرطي العالم في نظام ما بعد الحرب الباردة، استطاعت أن تعربد في العالم كيف تشاء، وضعت القوانين التي تسمح لها بوضع من تشاء على قائمة الإرهاب، سواء كان شخصا أو دولة، فالسودان اليوم نراه بكل ألمٍ يركع أمام قدمي أمريكا/كوشنر، مقابل مجرد حذف اسمه من قائمة الإرهاب.
أمريكا استطاعت أن تجعل البشير وحكوماته ومواطنيه طيلة عقود مديدة يعيشون حصارا اقتصاديا خانقا لم يستطع السودان معه بيع نفطه بِحرية ولا استغلال مناجم الذهب وثرواته الطبيعية، في إقامة نهضة اقتصادية، رغم أن أرضه تستطيع وحدها فقط أن تطعم العالم الإسلامي كله لشساعتها وخصوبتها، وبهذا استطاعت أن تجعله من الدول القابلة للتطبيع مباشرة بعد الانقلاب العسكري.
لا أحد سيذكر هذا كله، الجميع سيركز على فساد البشير وإخوانه، بعد أن سقطوا، لكن ما يجب أن ينتبه إليه الدارس هو الكيفية التي أدارت بها الصهيونية الأمريكية قضية دارفور، وقضية جنوب السودان واستغلال الخلاف النصراني الإسلامي بين مكونات الشعب السوداني، ووجود بن لادن واستثماراته السلمية هناك في بناء النهضة بالاقتصاد السوداني، لإنجاح تجربة استئناف العمل بالشريعة الإسلامية، وفسخ العقود المتعلقة باستغلال النفط مع السودان بقرار سيادي أمريكي، بعد نجاح شركة شيفرون الأمريكية في استخراج النفط السوداني، ثم جاء الاتهام بالإرهاب وفرضُ الحصار، لتنتهي فصول هذه القصة أليمة، بالخضوع للابتزاز الأمريكي الصهيوني والركوع أمام “إسرائيل” ليُكَفّر العسكر عن ذنوب الإسلاميين في حق صهانية يهود.
الابتزاز نفسه يعيشه المغرب اليوم، بحيث يقوم زعماء نادي التطبيع الصهيو-أمريكي وعلى رأسهم الإمارات بأخس محاولات إخضاع الإرادة السيادية لتقبل بإعلان التطبيع رسميا، وذلك بالضغط على ملف الصحراء الذي ظل مفتعلا طيلة عقود ما بعد الاحتلال الفرنسي والإسباني للمغرب، مع دوام مماطلة منظمتهم المسماة “الأمم المتحدة” في اتخاذ قرار فاصل في القضية الأولى للمغرب، والتي تحول دون انطلاقة بلادنا اقتصاديا، والخروج من حالة الارتهان مرة لفرنسا وأخرى لأمريكا، فكيف يمكن أن نقرأ قرار الإمارات فتح قنصلية في مدينة العيون، مباشرة بعد التطبيع الوقح الفج؟ ما يؤكد أن هذا القرار هو بمثابة الجزرة التي تحذر من العصا في حالة العصيان، هو أن البحرين تعتزم هي أيضا أخذ نفس الخطوة.
وهل يعقل أن هذا التأييد العظيم حصل دون أمر أو إذنٍ من إسرائيل وأمريكا لجر المغرب إلى مستنقع العهر التطبيعي؟
هذا الابتزاز السياسي يجعل المغرب أمام مقايضة خسيسة بين التفريط في القدس ليربح قضيته الوطنية المزمنة؛ أو الانتصار للأقصى وفلسطين والصمود مقابل أن تستمر المعاناة القابلة للاستفحال.
بعد هذا الكلام نرجع لسؤال العنوان: فهل ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نصد هجوم الحملات التطبيعية؟
الجواب نقوم بالواجبين كِليهما، وكل حسب ما يحتاج من جهد، وحسب تقدير النتائج المرجوة من الاشتغال عليهما؛ فالأمر يخضع للميزان الشرعي الذي توزن به المصالح والمفاسد.
لكن القبيح الذي لا يليق بمن لا يزال يؤمن بقضايا الأمة إيمانا لم تزعزعه الخيانات، ولم تَفُل عزمه النكسات، هو إهمال قضية فلسطين والأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك فيه ضياع لما تبقى من الدين ومقدساته والدنيا ومقوماتها.
فإن لم يواجه العقلاء من حكام المسلمين إلى جانب شعوبهم المسلمة هذه الحملة التطبيعية المسعورة، فإننا سنكون أمام غزو صهيوأمريكي لا مثيل له، بدأت بوادره تظهر في أول قرار فعلي سيحرك التريليونات الأمريكية لترسو في الأراضي المحتلة بعد 1967، حيث وقَّع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والسفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني “دفيد فريدمان” مجموعة اتفاقيات توسع التعاون العلمي بين الجانبين ليشمل المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، وتم في الاتفاقيات الجديدة شطب البند الذي كان يحظر على المنظمات والصناديق الحكومية الأمريكية الاستثمار في المستوطنات بالأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وصرح “بنيامين نتنياهو” تصريحا بالغ الدلالة، يعطي فكرة عن مآلات حملة التطبيع المحمومة حيث قال: “إن لتوقيع هذه الاتفاقيات (أي مع أمريكا) دلالة بالغة الأهمية إذ يأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة مع الإمارات والبحرين والسودان، وهو أمر ما كان ليتحقق لولا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه.
فهل فهِم المسلمون تلك الدلالة المهمة التي أشار إليها نتنياهو؟
وهل بعد إطلاق الإدارة الأمريكية ليد الصناديق والمنظمات لتمويل المزيد من المستوطنات والمشاريع الاستيطانية، سيبقى مجال للحديث عن حق اللاجئين في العودة لديارهم وأراضيهم المغتصبة؟
وهل يبقى كذلك معنى لحل الدولتين؟
من هنا نوقن أن الخريطة التي تحتل جدار الكينيست الصهيوني والتي تضمنت صورة إسرائيل الكبرى الخاضعة للتأويل الصهيوني لما جاء في سفر التكوين، إنما يضعه قيد التنفيذ في واقع العالم الإسلامي مَن يسارع إلى التطبيع أو يرضى به أو يشارك فيه ويدعمه، ويصدق فيهم قول بن غوريون في الاجتماع التنفيذي للوكالة اليهودية في يونيو 1938: “سنحطم هذه الحدود التي تفرض علينا، وليس بالضرورة عن طريق الحرب، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بيننا وبين الدول العربية في مستقبل غير بعيد”.
كل ما سبق ذكره هو ما دفعنا إلى تخصيص هذا العدد لمعضلة التطبيع تنويرا للرأي العام وقياما بما يمليه الواجب.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.



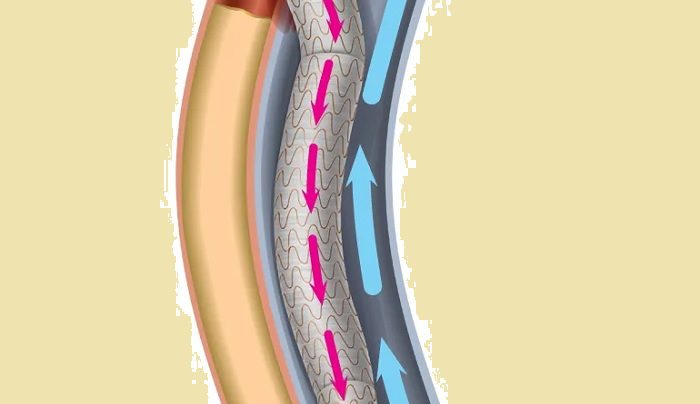





































لا ارى مجالا للترجيح بين الامرين، اذ لا تعارض بينهما اصلا، فصد الاساءة الى النبي صلى الله عليه وسلم شعبية، يملك كل أحد المشاركة فيها بالمقاطعة مثلا، واما مسألة التطبييع مسالة نخبة سواء الحاكمة وهذه تتجه الى التطبييع حاليا ولن يوقفها شيئ لضغيانها، واما الثقافية او العلمية فتستطيع الجمع بين الامرين