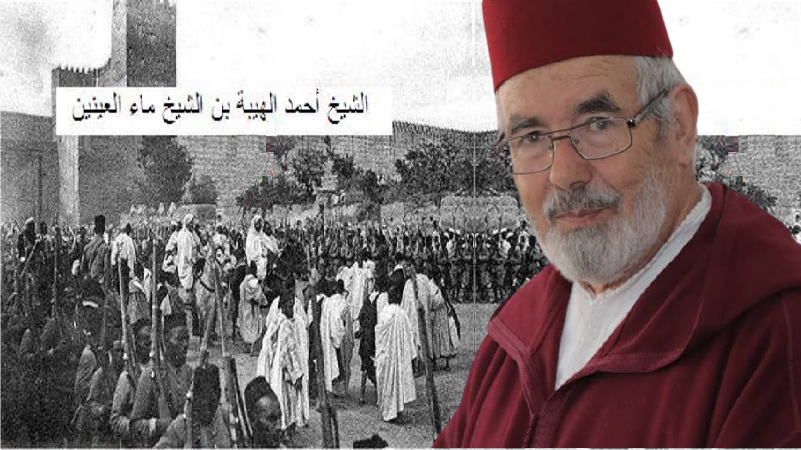المرأة والإرث والمساواة.. استصنام المفهوم الغربي وإلغاء العقل الصريح


ذ. إبراهيم الطالب (أسبوعية جريدة السبيل)
هوية بريس – الأحد 01 نونبر 2015
المساواة ليست غاية في ذاتها، بل هي آلية تستعمل في مكانها الذي يستدعيها له مفهوم العدل بين الناس، ولا تكون في حالات كثيرة محققة له، بل على العكس ربما كانت عاملا وسببا للظلم، لهذا لا أحد من العقلاء يطالب بالمساواة في الأجور مثلا، رغم أن كل المأجورين مواطنون، ويتقاضون أجورهم من مقدرات البلاد ومحاصيل ثرواته التي هم فيها شركاء، وذلك اعتبارا للوظائف التي يقوم بها كل فرد.
لهذا ينطلق نظام الإرث في الشريعة الإسلامية في مفهوم توزيع الميراث بين أصحاب الحقوق، من مفهوم العدل، وليس من مفهوم المساواة الكمي والعددي، لأن أساس التشريع وغايته هو الرحمة والتكامل الاجتماعي والوظيفي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الحفاظ على النظام الاجتماعي التقليدي الذي يحقق السعادة للإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا لا يمكن أن يستمر دون أسرة مبنية بين رجل وامرأة يتكاثرون بالأولاد، للحفاظ على استمرار البشرية في عمارة الأرض.
لذا نجد أحكام الإسلام وتعاليمَه قد خصت الأسرة -وهي من أهم مؤسسات المجتمع، بل تعتبر في الإسلام أسه وأساسه-، بأحكام خاصة تولى الله سبحانه بذاته وضعها، لعلمه بما يحقق العدل والسعادة للإنسان، وجعلها غير قابلة للاجتهاد. «وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» (البقرة:220).
في حين نجد مطلب المساواة في الإرث -بالشكل الذي يطالب به العلمانيون- فضلا عن كونه مناقضا للشريعة الإسلامية، ولمعتقدات عموم الشعب المغربي، يبقى مطلبا غير منطقي وبعيدا عن العقل والحكمة.
فإذا كان الغرض من تحقيق المساواة في بعض الحالات هو العدل، فإن العدل في بعضها الآخر يختل إذا ما حُكِم بمفهوم المساواة العددي والكمّي.
ورغم وضوح هذا المعطى نجد العلمانيين يستصنمون هذا المفهوم العددي والكمي للمساواة، حيث يجعلونه أساسا يبنون عليه مطالبهم في كل ما يتعلق بالمناصفة، وخصوصا منها مطلب المساواة في الإرث، حتى يُظهروا ما يزعمونه من عدم إنصاف النص القرآني للمرأة، مستغلين خفاء الحكمة عن عموم الشعب من التفاوت في بعض الحالات من الإرث بين الذكر والأنثى، في حين عند التمعن والتفكر تنجلي حقيقة المساواة المادية والمظهرية، وينكشف ألاّ علاقة لها بمفهوم العدل.
ثم إن نظام الإرث ليس فيه ما يمكن أن نحكم عليه بأنه شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، حيث نجد المرأة في حالات عديدة ترث مثل الرجل أو أكثر، الأمر الذي يقوم دليلا قاطعا على أن الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل ليس فيها تمييزا بين ذكر وأنثى، بل هو اعتبار للوظائف الاجتماعية لأفراد الأسرة.
أما السبب في إصرار العلمانيين على المطلب رغم وضوح فساده، فيرجع إلى تعصبهم -العاري عن العقل- للأساس الفلسفي الذي ينطلق منه مفهوم المساواة في المرجعية العلمانية.
فكل المذاهب العلمانية تتأسس على النزعة الفردية، وترى أن الأصل في المجتمع هو الفرد، دون تمييز بين ذكر وأنثى، وتجعل تقسيم الوظائف بينهما -كما هو في الواقع- ظلم يجب أن يُرفع، لتحل محله المساواة العددية أو الكمية الكاملة، دون أي اهتمام بمفهوم العدل الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمعات الإسلامية، مثل المجتمع المغربي الذي لا زالت القوامة فيه قويةً مفهومًا وأداءً، إذ الرجل يعطي الصداق ويتجشم عناء النفقة على البيت والأسرة ولا يستغني عن أخته وأمه إذا مات الأب، فضلا عن بناته، فكيف يمكن الحديث هنا عن مساواة عددية كمية حسابية صماء.
إن النزعة الفردية التي تحكم المطالب العلمانية في العالم، تؤدي إلى أنانية تقتل التكافل الاجتماعي والإحساس بالمسؤولية عن الأسرة، بحيث لا يمكن أن تبقى الأم أو البنت أو الأخت في المجتمع الغربي مع ابنها أو أبيها أو أخيها، بعد وصولها سنا معينة، غالبا ما لا تتعدى الثامنة عشر، وهذا ما يفسر تفكك الأسر وسَيْرَها نحو الانقراض في كل المجتمعات الغربية، الأمر الذي حرك حكومات ومنظمات لتشجيع الإنجاب والتكاثر، وللمطالبة بالرجوع إلى مفهوم القيم الأخلاقية خصوصا القيم الأسرية منها.
وإذَا رجعنا إلى المنظمات النسوية الغربية التي ترفع شعار المساواة المطلقة، نجدها تنطلق من تصور للإنسان مغرق في التعصب للمرأة، بلغ حدَّ التسوية الكاملة بينها وبين الرجل حتى على مستوى الطبيعة، التي خلق الله عليها كلا من الذكر والأنثى، حيث ادعى أصحابها أن عملية الزواج بين ذكر وأنثى تكرس الـلامساواة، لأن المرأة تحمل وتلد، والرجل لا يحمل ولا يلد، ويعتبرون هذا تمظهرا نشأ عن الوظائف التي أنيطت بكل واحد منهما وجعلت المرأة امرأة والرجل رجلا، وبالتالي فهم يروِّجون لفكرة التخلي عن مؤسسة الزواج التقليدي، ويدعون إلى زواج المرأة بالمرأة والاستغناء الكلي عن الرجل، ويمنعون من الحديث مع الطفل بصفته ذكرا أو مع الطفلة بصفتها أنثى، حتى لا يؤثروا على اختياراتهما الجنسية، ولهذا نرى الدعوة المحمومة إلى حماية حقوق الشواذ واختراقها للقوانين في أغلب الدول الغربية، بل أصبحت حتى الكنائس تؤيدها وتعمل على ترسيمها.
وما دام العلمانيون عندنا مجرد رجع صدى لما ينتجه الفكر الغربي، فلا نعجب إذاً، إذا رأيناهم يدافعون عن حقوق الشواذ من السحاقيات واللواطيين، ويحاربون كل الأحكام الإسلامية التي تناقض ما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
ولا عجب إذً، إذا سمعنا تصريحاتهم تندد بالنظم الاجتماعية الإسلامية ومنها نظام الإرث، وتعتبرها شيئا لا يليق بالدولة الديمقراطية، والحل في نظرهم هو تغيير سلوكيات الناس وقناعاتهم ليقبلوا بالمفاهيم الغربية للمساواة والحريات الفردية بصفة عامة، ثم الضغط على الحكومة والدولة والاستقواء بالمنظمات الدولية والدول الغربية لفرض توصياتهم، كما فعل اليساريون والعلمانيون المهيمنون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
لكن إذا كان لا عجب من أن يطالب العلمانيون بمثل هذه توصيات، فالعجب كل العجب من سكوت العلماء في المجلس الأعلى العلمي، وهم يرون مؤسسة دستورية بحجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بيد العلمانيين يتَحَّدون من خلالها الشرع الله والقانون وأمير المؤمنين والشعب والهوية ثم يفضلون السكوت، في حين نجدهم هم أيضاً لديهم المجلس الأعلى وهو كذلك مؤسسة دستورية.
وأقصد بالسكوت هنا عدم تفعيل قوة مجلسهم في الدفاع عن الشرع والهوية، ضد استهداف العلمانيين لهما، لذا يبقى تصريح السيد يسف مع أهميته لا يخرج عن معنى السكوت، لأنه لا يفي بالواجب، ولا يشفي صدور المغاربة.
فالمغاربة -كما هو مشاهد- يعتبرون المطالب العلمانية -خصوصا ما كان منها يهم الأسرة- مصادمة للشريعة الإسلامية، سواء تلك التي تم ترسيمها تحت ضغط العلمانيين واستقوائهم بالخارج، مثل شرط الولي في عقد الزواج، أم تلك التي لا زالت موضوع مطالب وتوصيات للمنظمات العلمانية مثل الإرث.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ettalebibrahim@gmail.com