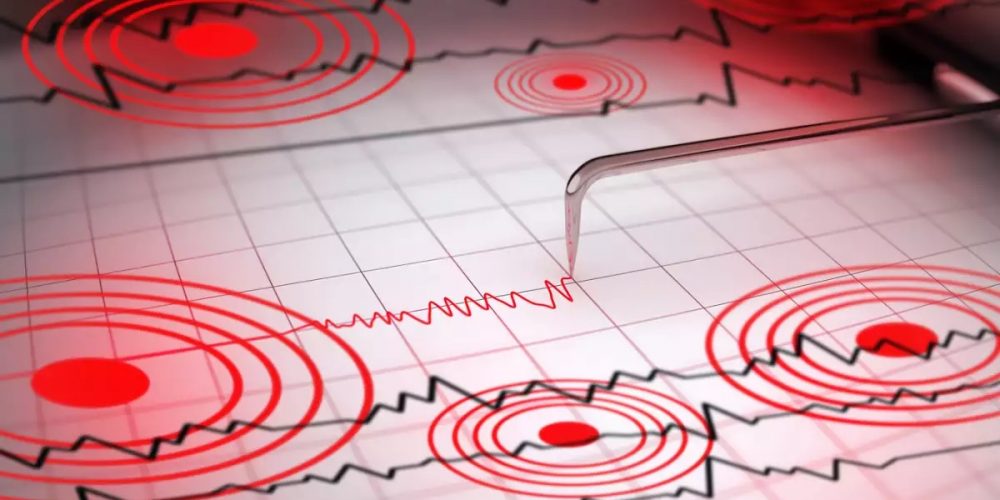ملاحظات على مقال للأستاذ صلاح بوسريف


ذ. عبد المجيد آيت عبو
هوية بريس – الجمعة 22 نونبر 2013م
نشر الأستاذ صلاح بوسريف بإحدى الجرائد اليومية مقالا بعنوان: (بيـن «التَّرْبِيَـة الإسلاميـة» والثَّقـافَــة الدِّينِيَـة)، مقترحا أن يُدَرَّسَ التلاميذُ مادة “الثقافة الدينية”، بدل “التربية الإسلامية”، فالثقافة أعَمُّ مما تُحيل عليه التربية، لأن التربية “مسألة ترتبط، في هذه المرحلة بالذَّات، بالأسرة، وبدورها المجتمعي، باعتبارها خليَّةً من خلاياه، في تقريب أبنائهم من الدين”، كما أن نسبة هذه التربية إلى الإسلام وحْدَه فيها إقصاءٌ لغيره من الأديان الأخرى التي ينبغي أن ينفتح عليها التلميذ، وخصوصا ما سماه الكاتب “الديانات التوحيدية”. يضاف إلى ذلك أن مادة التربية الإسلامية “تملأ التلاميذ بالخوف، وبالوَعيد، ويوم العِقاب، والحساب، أو السَّعِير”، وتجعله يسقط في أوحال “التَّطَرُّف، والتَّكْفِير”..
ولا شك أن في كلام الأستاذ كثيرا من الملاحظات العقدية والمنهجية والتربوية والعلمية والفكرية. وسأحاول في هذا المقال أن أسجل بعضها، متجاوزا ما يتعلق بالمناقشة الشرعية لقضايا المقال، لقناعتي بأنه جانب سيتصدى له الكثير من الغيورين على دين الإسلام.
– تناقض ظاهر:
أظن أن الأستاذ وقع في نوع من التناقض حين اقترح مفهوم “الثقافة الدينية” في مقابل ربط الإسلام بالتطرف والتكفير والخوف والوعيد والعقاب، فالذي يُفهم من الثقافة الدينية هو أن يُدرَّس الإسلام إلى جَنْب اليهودية والنصرانية والبوذية وغيرها، فإذا كان الإسلام -في نظره- مفرِّخا للتطرف والتكفير، فما الفائدة من تدريسه مع بقية الأديان؟! إلا أن يكون قصدُ الأستاذ إقصاء الإسلام من التدريس جملة، على أن يلقّن التلميذ ما سواه من الديانات ويقارِن بينها، لأنها كفيلة بأن تقوِّم سلوكه، وتجعله يقبل الآخر، وتصيِّره منفتحا على قضايا العصر ومتطلبات الحداثة والتجديد، ولا ضير أن يدرَّس: الثقافة اليهودية، والثقافة المسيحية، والثقافة البودية، والثقافة الهندوسية، والثقافة الفرعونية.. وهلم جرا.
– لماذا الإصرار على ربط الإسلام بمعاني التطرف والعنف؟
لم يَبْنِ الأستاذ ثنائية: الإسلام/التطرف أو: الإسلام/الخوف والعقاب، على أساس علمي موضوعي، وإنما يلقي الكلام على عواهنه كما يقال، وكان حَرِيًّا به أن يسوق بعض النماذج من مقررات المادة تقضي بهذا الزعم، وهل المقررات عامرة إلا بقيم التسامح والإخاء، والتربية الصحية، والتربية النفسية، والوسطية والاعتدال، والمحافظة على البيئة، وعناية الإسلام بالذوق السليم، وفضل الإنفاق على المحتاجين، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وبر الوالدين، والإسلام دين العقل والعلم، ودعوة الإسلام إلى العمل، وعلاقة الإسلام بالشرائع السماوية السابقة، والتجديد والانفتاح على قضايا معاصرة، وآداب الاختلاف وتدبيره، وقيم التواصل وضوابطه، والتفكر في الكون وأثره في ترسيخ الإيمان، وخصائص التفكير المنهجي في الإسلام.. وغيرها من الموضوعات؟َ! عجبا إذا كان هذا هو الذي ينتج التطرف والعنف، ويحمل على الخوف والرعب!! إن الأستاذ لم يكن همه أن يتأكد من حقيقة هذه المحاور، أو أن يتفحص مقرر المادة بتجرد وإنصاف، فهو مشحون بفكرة، ومنقاد لخلفية كانت تتحكم في كل سطر كتبه في هذا المقال، فالموضوع وإن وقعت جزئياته في تخبط وتخليط وتغليط، إلا أنه واضح المرامي والأهداف، فهو جس للنبض مرة أخرى، هذا النبض الذي لا يزال يتلاشى ويخفت صداه.
– تدريس الإسلام واجب وضرورة:
إن تدريس مادة التربية الإسلامية لتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي ضروري وواجب في هذه المرحلة، لا أقول هذا انطلاقا من أهمية الإسلام في تنشئة الفرد والجماعة، وعظم مكانته في تهذيب النفوس وتربيتها، لأن هذا أوضح من أن يستدل عليه، ولأن هذا جانب قد يعرض له الكثير من الباحثين الغيورين على هذه المادة، وإنما أؤكد عليه لأنه السبيل إلى الحفاظ على الهوية الدينية للتلميذ المغربي، فإذا كان الإسلام هو دين الدولة، فمن واجب المنهاج الدراسي أن يوليه العناية في مقرراته، ليتعرف التلميذ على هذا الدين عقيدة ومنهجا وسلوكا. وما أنصف الأستاذ حين ألزم التلاميذ في هذه المراحل دراسة الأديان دراسة مقارنة، فإن ذلك جناية في حقهم، وتشتيت لأفهامهم، وتشويه لهويتهم، وتشويش على سلوكهم، وتخليط لمعارفهم، فيوشك أن يمتزج في عقولهم التوحيد بالتثليث، ويستوي عندهم رفع المسيح وصلبه. إذا سلمنا للأستاذ بتدريس الأديان والمقارنة بينها، فإن ضرورة التدرج في العلم تفرض أن يكون ذلك في مراحل دراسية متأخرة، يكون فيها التلميذ على جانب من التأصيل في فهم الإسلام وقضاياه، يحمله هذا التأصيل على عدم الخلط بين مسلمات الإسلام، وبين معتقدات الأديان الأخرى التي امتزج فيها الوحي بتحريفات البشر وتخاريفهم.
– التربية الإسلامية والمواد الأخرى:
قال الأستاذ: “التلاميذ في هذه المرحلة من التعليم، يحتاجون لمعرفة اللغة والحساب”، وقال: “هُم في حاجة لِتَعَلُّم اللغة، أوَّلاً، قبل حِفْظ نُصُوص وفرائض”، لا أدري لماذا يصر الأستاذ على إقامة هذه القطيعة بين التربية الإسلامية وغيرها من المواد؟ إذا كان هذا الرفض مردُّه إلى صعوبة المادة وعسرها، فلَأَن يقال ذلك في الحساب واللغة أولى، فالتلميذ يعاني من الحساب والإعراب واللغات الأجنبية ما لا يعانيه مع العقائد والعبادات وحفظ الأحاديث والآيات. وإذا كان السبب ازدحام المواد على التلميذ، فلماذا نرهق كاهله بالثقافة التشكيلية، والثقافة الموسيقية، والمزج بين اللغة الفرنسية والإنجليزية..؟! إلا أن يكون السبب هو حاجة في نفس الكاتب لم يبدها صريحا، لكنه أومأ بها إلينا من بين السطور، قد أدركناها وتبيَّناها.
– ما جدوى التربية الإسلامية؟
يجيب الأستاذ عن هذا السؤال بألا جدوى من تدريس هذه المادة؛ فحسبها “شَحن التلاميذ، ومَلْء رؤوسهم، بكلام هُم، في هذه المرحلة من حياتهم، في حاجة لغيره”، وهو جواب قد يكون منسجما إذا قطعنا بأن فرائض الوضوء، وأركان الإسلام، وشروط الصلاة، ومراعاة حقوق الأقارب والجيران… أقل شأنا من الدارة الكهربائية، وجدول الضرب، وألوان الطيف، وتعليم الرقص والغناء… ألا ترى أيها الأستاذ أن هذه المادة تُحقَّق بها كفايات ممتدة، تروم تقويم سلوك التلميذ وتهذيبه، وترشيد علاقته بنفسه وبأسرته ومجتمعه ومحيطه؟ ألا ترى أيضا أنها تحقق كفايات معرفية ومنهجية تتمثل فيما يحفظه التلميذ من القرآن الكريم، فينعكس أسلوبه الفصيح على تعبيره الشفوي وتعبيره الكتابي؟ ألا ترى أن ذلك خير من أن يكتب التلميذ إنشاءه بالدارجة المغربية، أو بالعامية المصرية أو السورية أو اللبنانية؟ فذلك ثمرة ما يستهلكه من أفلام ومسلسلات.
أما ما ذكره الأستاذ من “حفظ التلاميذ، في سِنٍّ مبكِّرَة لآيات تَفُوق وعيهم، وتفوق قدراتهم الذهنية”، و”حِفْظ التلميذ لآيات مليئة بمفردات، لا يفهمها”، فليس ذلك مانعا من تحفيظهم مع شرح المفردات، وتقريب المعاني الإجمالية للآيات. ثم إن كثيرا من الآيات التي يحفظها التلميذ يدرك معناها من أول وهلة دون الرجوع إلى مفرداتها وتفسيرها، فهو يفهم جيدا معنى قول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ}، وقوله: {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا}، وقوله: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ}، وقوله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}ن وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا}، وقوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}، وقوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ}.. فأمثال هذه الآيات تؤكد في نفسه عظمة الإيمان وما يترتب عليه من السكينة، وقبح الكفر وما لصاحبه من العذاب، وإخلاص الدين لله وحده، والبراءة من الكفر وأهله..
– أبناؤكم ليسوا معيارا:
يذكر الأستاذ أنه “عانَى مع أبنائه مشاكل مادة «التربية الإسلامية»”، كما استدل بتجربة صديقه “في ما عاشه مع ابنته، في حفظها لآية قرآنية، لم تَفْهَم منها شيئاً”، والواقع أن هذه النماذج لا يمكن أن تُتَّخذ معيارا للحكم على موقف التلميذ من المادة، بل الغالب هو حب التلاميذ لهذه المادة واحترامها وتقديرها، فهم يرتاحون لها ويأنوسون بها ما لا يأنسون بغيرها، حتى إن بعضهم يسارع من تلقاء نفسه إلى إنجاز عروض متصلة بالمادة.. وإذا كانت النماذج التي أوردها الأستاذ لم تأنس بهذه المادة، وعانت معها، وتجرعت المرارة من مفرداتها ومفاهيمها، فليس ذلك بمستغرب منها إذا كانت منفتحة على كل ثقافة في الكون إلا ثقافة تتنسم فيها عبير تلك المفردات فتألفها وتستأنس بها ولا تستوحش منها.
– ربّ ضارة نافعة:
جدير بسهام الطعن التي تطال هذه المادة الشريفة أن تُقَوِّي عزائم الغيورين عليها، وتستفزهم للنهوض بها ونصرتها، وتستنهض هممهم لتتويجها ووضعها في مكانتها السامية التي تليق بها، وإحياء قيمتها التي كانت تنعم بها في عقود مضت، وذلك بتعميمها على كل الأسلاك التعليمية، وتوسيع حيزها الزمني، وإعادة النظر في محاورها وموضوعاتها وعدم تفريغها من محتواها العقدي والمنهجي والتربوي، وتحسيس الأجيال بعظم منزلتها، ورفض كل تهميش يطالها. وإذا كان الأستاذ ينتقد برامج المادة “لِما فيها من ارْتِباكٍ، ومن ارتجال، في الاختيارات”، فإننا نوافقه على ذلك في بعض مقررات المادة التي يغيب في بعض محاورها الدرس الإسلامي، وتحضر موضوعات أخرى بعيدة الصلة بالمادة.
– نصراني يعتز بالإسلام، ومسلم يقلقه وجوده في مناهج التدريس:
يستغرب القارئ حين يجد نصرانيا كالشاعر رشيد سليم الخوري يعتز بالعروبة والإسلام، ويفتخر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيقول رادا على طه حسين احتفاءه بأمجاد الفراعنة وإحياء تاريخهم:
مَن يَبْكِ عَهدَ الـمَوَامِي والدُّمَى فَأَنَا = والحَمْدُ لِلَّهِ قد حَطَّمْتُ أَصْنَامِي
شَغَلْتُ قَلبِي بِحُبِّ المصطَفَى وَغَدَت = عُرُوبَتِي مَـثـلِـي الأَعْلَى وَإِسْلاَمِي
وقال: “إذا دعونا إلى العروبة، فنحن لا نأتي ببدعة، ولا نتحدى أقلية، ولا نحتقر طائفة، بل ننزل على حكم أكثرية مطلقة.. في تأييدها أعظم مظهر من مظاهر اتحادنا، وأقوى سبب من أسباب قوتنا. وعلى الأقليات التي يُحرجها ذكرُ العروبة، ويؤلمها التغني بمناقب الإسلام، واحد من ثلاثة: فإما اعتناق دين الأكثرية، وإما الإخلاص لأهله، أو الرحيل إلى بلد آخر.. فأما أن تبقى سوسة في شجرة العروبة، وشوكة في جنب الإسلام، ومفشلة لقضية العربية.. فذلك ما لا يُطاق!”. وقال عن الإسلام: “إنه الدين الوحيد الذي يجمع إلى محامد المسيحية محامد العروبة، الدين الوحيد الذي يؤلف بين الفضائل المتفرعة من الشجاعة، والمتفرعة عن المحبة”.
فمن عجيب المفارقات أن نرى نصرانيا يعتز بالإسلام ويحترمه ويجله، ومسلما أرقه تدريس الإسلام، وتربية الأجيال على مبادئه، وأزعجته مقررات مادة التربية الإسلامية، وأقضت مضجعه، كأني به يَنظُرُ إليها قنابل أو بنادق ورشاشات يودعها التلميذ محفظته.
وفي الختام أدعو صاحب المقال وغيره من دعاة الفكر الحر، والمنطق، والموضوعية، والتفكير المنهجي، والبحث العلمي، أن يُلزِمُوا أنفسهم أولا بهذه الـمقومات، قبل أن يُلزموا بها خصومهم، فكم رأينا في مقالاتهم من خلط وخبط، وحيف وشطط، وانتقاء واجتزاء، وادعاء وافتراء، ومبالغات ومغالطات.