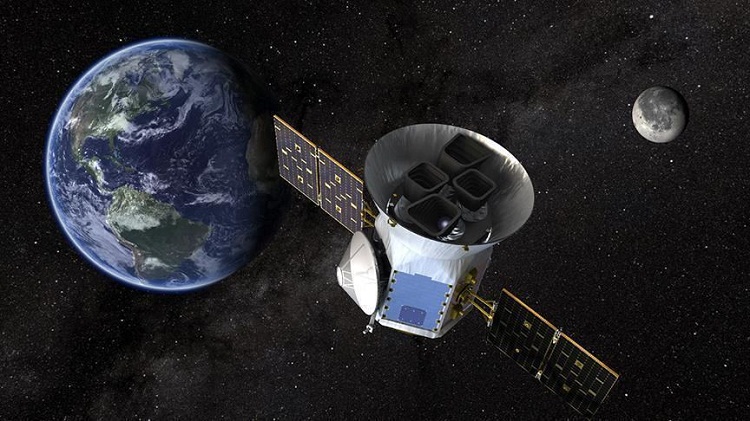بين صلاة الاستسقاء وبين صلاة الشكر بون شاسع!!


د. محمد وراضي
الأربعاء 15 يناير 2014م
منذ أزيد من عقد زمني كتبت مقالا مطولا من أربع حلقات في موضوع الاستسقاء. ويبدو أن الدافع من وراء كتابته حينها هو نفس الدافع الذي حرك الكاتب عبد المغيث جبران، ليعنون مقاله عن ذات الموضوع بـ”ملوك المغرب وصلاة الاستسقاء: البركة والدهاء وأشياء أخرى”!
غير أنني لست مرتاحا لا إلى التعميم، ولا إلى إدخال الدهاء في الدعوة إلى الصلاة لطلب الغيث في هذا الوقت بالذات. بل لا بد من التمييز بين مرحلتين: مرحلة ما قبل محمد الخامس، ومرحلة ما بعده حتى الآن! فصلاة الاستسقاء، كان الأئمة في كل أرجاء بلادنا يؤدونها دون ما انتظار منهم لأوامر تصدر من الأعلى! أما الحديث عن الدهاء، فأظن أنه غير وارد لانتفاء ظهور مناسبته، ما دام الاطلاع على الأحوال الجوية متاحا حتى للعجائز داخل البيوت!
أما “أشياء أخرى”، فوضع اليد على حقيقتها أصبح بإمكان الجيل الجديد من المغاربة! هذا الجيل الذي لا يرى وسيلة ناجعة لكسب التأييد الشعبي غير تلبية المتطلبات الحقوقية لكافة المواطنين والمواطنات! مما يعني أن زمن البركة السلطانية -كمفهوم غامض- قد ولى إلى غير رجعة! مع أن البركة (المبهم معناها) طوال تاريخ المغرب المديد، لم تكن أبدا ملاذا آمنا للتخلص من القحط، الذي طالما عانى المغاربة من ويلاته في كل العصور “سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا“! وما جفاف الثمانينيات من القرن الماضي عنا ببعيد؟
نقول: إن كانت الصلاة على العموم دعاء وابتهالا وتضرعا، وكانت على الخصوص عبادة واجبة مؤقتة موجهة إلى الله وحده سبحانه، فإن الاستسقاء قديم قدم البشرية. غير أنه لا بد من التمييز بين صلاة الفرد وبين صلاة الجماعة فيما يتصل باستدرار الرحمات.
وأنا أعيش وسط الفلاحين، أقابلهم صباح مساء، وأقف على ما منه يعانون، والمطر متأخر عن مواعيده المعروفة. فقد يزرعون مآت الهكتارات عندما ينزل من الغيث ما يشجعهم على الحرث وإلقاء البذور. وأملهم في ربهم كي يعجل بسقي ما تم لهم زرعه. فتكون صلواتهم أو أدعيتهم متواصلة لا تنقطع، قبل الشتاء الأولى وبعدها إلى حين اكتمال نضج ما يرجون أن يحصلوا منه على الربح الوفير. هذا الربح الذي سوف يتقاسمونه مع غير الفلاحين الذين تعتمد معيشتهم أساسا على منتوج الأرض المتنوع. أما إن تأخر الغيث وأصيبت الأرض بالجفاف أو بما يشبهه، فإن الوضع السيء سوف ينعكس مباشرة لا محالة على الأسر الفلاحية، دون أن ينجو الاقتصاد الوطني من انعكاساته التي ينجم عنها البحث عن الشعير والقمح والذرة في الأسواق الخارجية. مما ينقص من مدخرات الخزينة العامة. إذ كل نقص من مدخراتها يساهم سلبيا في إحداث أزمة مالية. أما إن كانت الأزمة قائمة بالفعل، فإنه سوف يساهم في تعميقها!
وحتى لا ننسى كون صلاة الاستسقاء شعيرة دينية، مدلولها الأساسي يكمن في ارتباط المؤمنين بتأكيد الربوبية وبتأكيد الألوهية، فنحن لا نسوق القربان -كما تفعل بعض القبائل البدائية مع مقدسيها- إلى أضرحة المعروفين عندنا بأولياء الله الصالحين (بعض الجهات تفعل ذلك) كي نتوسل إليهم حتى نتخلص بفضلهم وببركتهم من القحط الذي يجثم على صدورنا! والتخلص منه، يخص كل واحد منا على حدة (ندعو في أنفسنا)، لكن الإنسان بمفرده بعيدا عن التعاون حتى في الاستسقاء، غير قادر على تأمين كل ما هو ضروري له. فقط نريد القول بأن كل واحد منا يدعو في قرارة نفسه بالفرج بعد الشدة، لا بعد اليأس الشديد أو الخفيف ما دمنا مدعوين دينيا إلى عدم القنوط من رحمة الله، لأن التعلق به سبحانه، إنما يتأتى بالتزام ما هو مفروض علينا، حتى لا نصبح ممن قال فيهم عز وجل: “أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون“.
فيكون علينا كمسلمين أن لا نربط دعوتنا بإقامة صلاة الاستسقاء بالأنواء! فالأرصاد الجوية كمجال علمي متقدم إلى حد ما، بحيث إنه يضعنا أمام تنبؤات، لا نتردد في القول: إنها في بعض الأحيان أشبه ما تكون بنبوءات العرافين!
فقد ورد في “موطأ” مالك عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله ص صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل (أي على إثر مطر نزل)، فلما انصرف (انتهى من الصلاة)، أقبل على الناس فقال: “أتدرون ماذا قال ربكم“؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: “قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب“!
فإذا كان النوء ريحا شديدة حيث يقال “سفينة تتقاذفها الأنواء” فإن النوء كذلك سحب ماطرة، مما يفهم من المقولة السائرة “صدق النوء ورويت الأرض”، بينما الكواكب تشير إلى دورها في المناخ الطبيعي الذي يشمل الكون في مجمله. فيكون قصد الرسول من حديثه المتقدم وجوب إسناد نزول المطر إلى الله سبحانه، لا إلى ما يشاهد في العالم من تغيرات، على إثرها أو بسببها ينزل بعيدا عن رعايته وبعيدا عن حفظه جلت قدرته. فهناك من يرجع كل ما يحدث في الكون إلى بارئه وهناك من يرجعه إلى الأنواء! فنكون بصدد ما يجري في العالم إما مؤمنين وإما جاحدين. وفي الحالتين كلتيهما – إن نحن تحلينا بالكافي من الموضوعية والنزاهة الفكرية – ندرك كيف أن الأنواء في معانيها الشاملة، مجرد ظواهر طبيعية، لا تصدق نتائجها على الدوام لأنها نسبية. وحكمة الله في مخلوقاته، لا تتخلف، ولا تعتريها الغفلة أو يعتريها الكذب وتعلوها الأخطاء! وها نحن نختبر ما يدعونا إلى التنبؤ بكون السماء سوف تتلبد بالغيوم وتنزل الأمطار عما قريب.
إن نحن اختصرنا مسمى الحتمية الطبيعية في قولنا: كلما توفرت شروط معينة تمام التعيين، أدت إلى ظاهرة معينة تمام التعيين. وكلما غابت الشروط غابت الظاهرة، فإن النتيجة نختصرها في الآتي:
بما أن المطر ظاهرة طبيعية، فإن التنبؤ بحدوثها يتوقف على شروط هي هذه: توفر كتل من السحب في الفضاء. وضغط جوي منخفض. ورياح سرعتها معروفة في الاتجاه الذي تدفع إليه السحب. والحرارة الضرورية لإذابة كتل السحب تلك. فاعتمادا على هذه الشروط المتوفرة، يخبر قسم الأرصاد الجوية بقناة تلفزية ما بأن السماء سوف تكون غائمة مساء غد الأحد، وأنه ابتداء من الساعة الثامنة، ستنزل زخات مطرية محدودة متفرقة، لكنه ابتداء من الساعة العاشرة ستنزل بغزارة.
إنما هل هذا يعني أن الإنسان يتحكم في الطبيعة، ويفرض عليها سيادته، ويسخرها لفائدته ولخدمته كما قال ديكارت؟
إن الواقع يجيب بأن ما ذهب إليه الرجل غير وارد بإطلاق، وإن ورد، فإنما يرد في حدود نسبية كما هو حالنا مع كافة معارفنا. فكثيرا ما انتظر الناس -وفي مقدمتهم الفلاحون- نزول الأمطار بناء منهم على نشرة جوية. فإذا بالتنبؤ يتحول إلى مجرد نبوءة! لأن شروط نزول المطر المذكورة قبله، عبارة هي كذلك عن ظواهر طبيعية، تتحكم في حدوثها شروط خاصة بها، فالرياح لحدوثها شروط لا بد من توفرها. وما قيل عنها يقال عن السحب المنطلقة من الأرض بفعل البخار الطبيعي في البحار والمحيطات والوديان والأنهار. والضغط الجوي المرتفع حين يكون مرتفعا له شروطه. ونفس الشيء بالنسبة للضغط الجوي المنخفض. فمتى تأخرت شروط الرياح، أو شروط تكتل السحب، أو شروط حدوث الضغط الجوي المنخفض، ذهب التنبؤ الذي تم التصريح به سدى كما يقال! وذهبت معه الدعوة إلى أداء صلاة الاستسقاء، كلما لاح في الأفق ما يشير إلى أن هطول الأمطار وشيك الحدوث! وهذه الدعوة تحديدا هي التي حذر منها الحديث النبوي المتقدم؟ فالاستسقاء لا يتم إلا بالاعتماد على الله، لا بالاعتماد على الأنواء التي يمكن تغيرها بسهولة. ومتى تم تغيرها تأكد لدينا مرة أخرى أن الطبيعة ليست بإطلاق في يد الإنسان! ولن تكون أبدا في يده بهذه الصفة!
وإن كنا لا ننكر بأن الطبيعة تخدمه. لكن خدمتها له حقيقة دينية لدى المؤمنين بالله وبرسالته. فالله في الواقع سخرها ويسخرها للإنسان ولباقي مخلوقاته، ما ظهر منها للعيان، وما بطن منها إلى حد أن اكتشافه لا يتم إلا بالعلوم والعقول والحدوس والبصائر! “سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق“!
أو لم نقرأ قوله تعالى: “وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الانسان لظلوم كفار“؟ وقوله سبحانه: “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون“. وقوله عز وجل: “ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار“!
إن من يعترضون الوارد في هذه الآيات، لا يستطيعون الادعاء بأن الإنسان قادر على التحكم في مختلف مظاهر الطبيعة، حتى إذا ما كشف عن ابتكاراته لقامت في وجهه عقبات تتحداه: أعاصير، وزلازل، وبراكين، وجفاف، وزحف الرمال، وأمراض فتاكة مفاجئة، وتغيرات مناخية طارئة، بحيث تذهب الحتمية التي يدعيها -مع رفضه للصدفة- أدراج الرياح كما يقال!
ولتكذيب قدرة العلم المعاصر على معرفة كافة الحتميات المتحكمة في كافة الظواهر الطبيعية والإنسانية وغيرها، ساق عالم غربي -لم أعد أتذكر اسمه- مثالا يريد به إرجاع التحكم في كل شيء إلى بارئه سبحانه: رجل أحس بألم شديد في ضرس من أضراسه، فاتصل بالطبيب الذي حدد له موعدا في الساعة العاشرة من اليوم الموالي، فبات ينتظر الموعد بلهفة قوية وهو يعاني من الألم. وفي حدود التاسعة والنصف، غادر منزله، وقبيل الوصول إلى عيادة الطبيب، مر تحت عمارة تبنى حديثا، فكان أن اشتدت الرياح، مما أدى إلى سقوط خشبة على رأسه فمات لحينه! فيكون هكذا ضحية لأكثر من حتمية، لكننا كعلماء معاصرين نفاة الصدفة لا نستطيع تحديد الحتمية التي أدت إلى وفاته. ألم الضرس حتمية فيزيولوجية. والرغبة الملحة في زيارة الطبيب حتمية نفسانية. وسقوط خشبة ثقيلة على رأسه حتمية فيزيائية تلتقي بحتمية فيزيولوجية عند وقوع الخشبة على رأسه. والسؤال المطروح هنا تحديدا هو: أية حتمية وراء موت الرجل؟ فلو لم يؤلمه الضرس ما اتصل بالطبيب؟ ولو تأخر الموعد لساعة ما حصل له ما حصل؟ ولو لم يمر تحت تلك العمارة ما تعرض للموت؟ وحتى لو مر تحتها ولم تهب الرياح ولا وقعت الخشبة على رأسه ما مات للتو؟
فلنقل إذن بأن الحتمية التي كانت وراء وفاته لا يدركها غير خالقه سبحانه! مما يعني أن المتحكم في الكون هو الذي يرسل الأمطار متى شاء وأنى شاء. في بلد النصارى وفي بلد البوذييين وفي بلد المسلمين. وفي بلد اللادينيين بإطلاق. ثم إنه هو الذي يوقف هطولها متى شاء، ووراء كل تصرفاته في الكون حكمته التي نحن عاجزون عن استيعاب مدلولاتها. “فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون“.
فلنؤد إذن -عند توصلنا بفحوى النشرة الجوية- صلاة الشكر، بدلا من صلاة الاستسقاء. ونؤدي صلاة الاستسقاء قبل اطلاعنا على التغير المفاجئ أو غير المفاجئ في المناخ حيث إننا نتوقع المطر. وإلا فإن دعوتنا لإقامة الصلاة طلبا للغيث، لا تتضمن دهاء لأننا لم نعد نحيا حياة الادعاء بكون حكامنا محاطين بمسمى البركة! والحال أن التاريخ يخبرنا بأيام عجاف عرفتها بلادنا، وعلى رأسها حملة البركة كما يزعم الزاعمون! ومع ذلك لم تنفع مشاركتهم في صلاة الاستسقاء ولا في الدعوة إليها!!!
فكيف إذن نصلي صلاة الشكر في حالة ما إذا علمنا من الأرصاد الجوية؟ كيف أن أيام نزول الغيث لا يفصلنا عنها غير أسبوع أو أسبوعين؟
في كتاب “الأم” للإمام الشافعي رحمه الله نقرأ: “وإذا تهيأ الإمام للخروج فمطر الناس مطرا قليلا أو كثيرا، أحببت أن يمضي والناس على الخروج، فيشكروا الله على سقياه، ويسألوا الله زيادته وعموم خلقه بالغيث، وأن لا يتخلفوا، فإن فعلوا فلا كفارة عليهم ولا قضاء عليهم”!
فلو نوى إمام مسجد ما الخروج بالناس يوم الثلاثاء لأداء صلاة الاستسقاء -وهم في يوم السبت- ثم نزل المطر صباح يوم الأحد، فإن عليه أن يخرج بهم في نفس الموعد المحدد (أي يوم الثلاثاء) إنما لأداء صلاة الشكر، لا لأداء صلاة الاستسقاء. وفي الوقت ذاته يطلبون منه سبحانه مزيدا من المطر وعمومها حيث تمتد إلى كافة بلدان العالم. بلدان المسلمين وبلدان غير المسلمين. فيكون علينا اقتداء بالشافعي وهو من أنجب تلامذة إمامنا مالك، أن ندعو إلى أداء صلاة الشكر لمجرد ما نعرف عن طريق الأرصاد الجوية، أن الأمطار قادمة بعد أسبوعين أو أقل، لا أن ندعو إلى صلاة الاستسقاء، وقد عرفنا ما عرفناه وتأكدنا منه! لأننا في هذه الحالة، لا نستسقي بالله، وإنما نستسقي بالأنواء والكواكب والنجوم!
www.islamthinking.blog.com
mohamedouradi@yahoo.fr