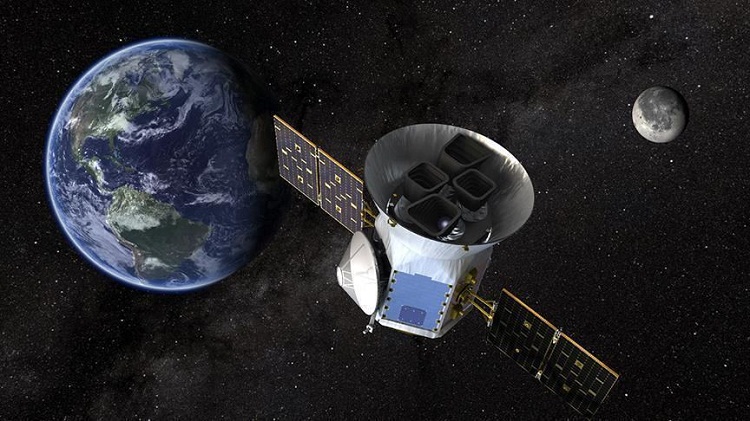نعم.. «العلمانية انتشرت بالسيف»


ذ. نبيل غزال
هوية بريس – الخميس 05 يونيو 2014
من جملة الافتراءات التي روجها المستشرقون المغرضون، وتلقفها من بعدهم -بعد أن صارت مبتذلة- العلمانيون المستلبون، أن الإسلام انتشر بالسيف، وأن الناس أكرهوا على الدخول فيه عنوة! وانتهكت في سبيل ذلك حقوق الإنسان! وأزهقت الأرواح! ومنعت حرية المعتقد..! ولا زال هذا الهراء يكرره إلى اليوم من يدعي الثقافة والدفاع عن الحقوق والحريات.
ولم يأل العلماء والمفكرون المسلمون -عبر التاريخ- جهدا في الرد على شبهات المغرضين والجاهلين؛ ومن ضمنها شبهة انتشار الإسلام بالسيف، ونكتفي ها هنا لكشف هذه الفرية باعتراف واحد فقط لمؤرخ فرنسي غير مسلم، عني بالحضارة الشرقية زمنا طويلا، وقام برحلات ودراسات وأبحاث اجتماعية في العديد من بلاد المسلمين، إنه الطبيب والمؤرخ «غوستاف لوبون» الذي قال في كتابه (حضارة العرب) وهو يتحدث عن سر انتشار الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عصور الفتوحات من بعده:
«قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، ولم ينتشر الإسلام إذن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب.. كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند -التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل- ما زاد عدد المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيها.. ولم يكن الإسلام أقل انتشاراً في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط..».
وإذا كان الإسلام قد انتشر بالدعوة والحجة والإقناع، كما هو الحال في إندونيسيا والهند والصين التي لم تصلها جنود المسلمين أصلا، فإننا بمقابل ذلك نتساءل كيف انتشرت العلمانية في العالم الإسلامي والإفريقي والشرقي؟
وما هي السبل التي سلكها المبشرون بها والوسائل التي استخدموها للإقناع بهذا الفكر والمعتقد الجديد؟
فلم تكد الدول الغربية تنفض يدها من ثوراتها التي تبنت بعدها العلمانية، وتشربت من خلالها «بعمق» قيم (الحرية والأخوة والمساواة)!! بعد أن تخلصت من ظلم الإقطاع والإكليروس، حتى بادرت بالهجوم على جل الدول الإسلامية والإفريقية والشرقية، فنهبت خيراتها، وخربت مقدراتها، وطمست هويتها.
ولم تكتمل عشر سنوات على الثورة الفرنسية 1789م، حتى وصل نابليون يقود الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798م، ثم حاول السيطرة بعدها على بلاد الشام.
وقد كانت حملته حافلة بالجرائم والمجازر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونفسح المجال ههنا للمؤرخ الجبرتي ليحكي لنا كيف دخل جنود الثورة العلمانية المفعمين بقيمها إلى مصر وما الذي فعلوه بأهلها.
يقول الجبرتي في تاريخه: «وبعد هجعةٍ من الليل، دخل الإفرنج المدينة كالسيل، ومروا في الأزقَّة والشوارع، لا يجدون لهم ممانع، كأنهم الشياطين أو جُند إبليس، وهدموا ما وجدوه من المتاريس.. ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر، وهم راكبون الخيول، وبينهم المشاة كالوعول، وتفوَّقوا (أي قاءوا) بصحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهَّارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكَتَبَة، ونهبوا ما وجدوه من المتاع، والأواني والقِصاع، والودائع والمخبَّآت بالدواليب والخزانات، ودَشَتوا الكتب والمصاحف (أي: مزقوها تمزيقًا)، وعلى الأرض طرحوها، وبأرجلهم ونعالهم داسوها.. وشربوا الشراب وكسروا أوانيه، وألقوها بصَحْنِه ونواحيه، وكُلُّ من صادفوه به عرُّوه، ومن ثيابه أخرجوه» اهـ.
وليقارن القارئ الكريم بين هذه الصورة الوحشية الهمجية وبين ما كان يوصي به الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيوشه وهو يبعثها لفتح الشام، وليحكم بنفسه من هم الهمج ومن ينشر دعوته بالسيف وينتهك حقوق الإنسان.
فقد خرج الصديق يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل، فقال أبو بكر: ما أنت بنازل، وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. ثم قال له: (إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له.. وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن) موطأ الإمام مالك، كتاب الجهاد.
إنها أخلاق الإسلام وتربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما الغرب فقد كان ولازال يعتمد التهديد والإرهاب للإقناع بأفكاره، ولم تتوقف حملاته الوحشية الإمبريالية على بلاد المسلمين أبدا.
وقد ارتكبت جيوشه التي خرجت من رحم الثورات؛ بتنظير وتخطيط من قادة ومفكرين علمانيين بارزين؛ مجازر مروعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويسجل القائد البرتغالي «البوكيرك» بعضها بفخر واعتزاز مخاطبا ملك البرتغال ومهنئا إياه بالسيطرة على مقاطعة جوا الهندية قائلا: «وبعد ذلك أحرقت المدينة، وأعملت السيف في كل الرقاب، وأخذت دماء الناس تراق أياماً عدة، وحيثما وجدنا المسلمين لم نوقر معهم نفسا، فكنا نملأ بهم مساجدهم، ونشعل فيها النار، حتى أحصينا ستة آلاف روح (6.000) هلكت، وقد كان ذلك يا سيدي عملا عظيما رائعا أجدنا بدايته وأحسنا نهايته».
وفي مدغشقر قتلت القوات الفرنسية 80.000 في ضربة واحدة للثائرين من سكان الجزيرة، فيما أعمل الإنجليز القتل في قبائل ماو الأفريقية، ثم ادعوا أن وحوشا مفترسة ظهرت في المنطقة وتخطفت الآلاف إلى مصارعهم.
وفي الجزائر يقول الجنرال الفرنسي شان: «إن رجاله وجدوا التسلية في جز رقاب المواطنين من رجال القبائل الثائرة في بلدتي الحواش وبورقيبة». وقد بلغ عدد القتلى في مدينة سطيف في مايو 1945م ما يقرب 40.000.
ويروي العقيد الفرنسي مونتانياك 🙁Montagnac) أخبرني بعض الجنود أن ضباطهم يلحون عليهم ألا يتركوا أحدا حيا بين العرب.. وكل العسكريين الذين تشرفت بقيادتهم يخافون إذا أحضروا عربيا حيا أن يجلدوا.
وقال: «إن الجنرال لاموريسيير يهاجم العرب ويأخذ منهم كل شيء: نساء وأطفالا ومواش. يخطف النساء، ويحتفظ ببعضهن رهائن، والبعض الآخر يستبدلهن بالخيول، والباقي تباع في المزاد كالحيوانات، أما الجميلات منهن فنصيب للضباط».
وقال: «لقد محا الجنرال لاموريسيير La Moricière من الوجود خمسة وعشرين (25) قرية في خرجة واحدة، إنه عمل أكثر انعداما للإنسانية».
«..فبمجرد أن حدد موقع القبيلة انطلق سائر الجنود نحوه ووصلنا الخيام التي صحا سكانها على اقتراب الجنود فخرجوا هاربين نساء وأطفالا ورجالا مع قطعان ماشيتهم في سائر الاتجاهات، هذا جندي يقتل نعجة، وبعض الجنود يدخلون الخيام ويخرجون منها حاملين زرابي على أكتافهم، بعضهم يحمل دجاجة، تضرم النار في كل شيء، يلاحق الناس والحيوانات وسط صراخ وغثاء وخوار، إنها ضجة تصم الآذان».
ويروي الضابط المراسل تارنو: «إن بلاد بني مناصر رائعة، لقد أحرقنا كل شيء، ودمرنا كل شيء.. آه من الحرب! كم من نساء وأطفال هربوا منا إلى ثلوج الأطلس ماتوا بالبرد والجوع، إننا ندمر، ونحرق، وننهب، ونخرب البيوت، ونحرق الشجر المثمر، أنا على رأس جيشي أحرق الدواوير والأكواخ ونفرغ المطامير من الحبوب».
وفي المغرب قنبل الجيش الفرنسي الهمجي مدينة الدار البيضاء، وقتل الفرنسيون المتحضرون ما بين 600 و1500 مغربي بالدار البيضاء وحدها داخل الأسوار وخارجها وهدموا ثلثي المدينة، وأطلقوا 600 طلقة مدفع من عيار 14 سنتم و47 ملم، في غضون 36 ساعة من بينها قنابل الميناليت الحارقة التي كانت تقذفها البارجة «دوشيلا».. (انظر مقاومة غزو المغرب للأستاذ إدريس كرم).
واستعمل الجيش الإسباني خلال حرب الريف الثالثة في المغرب 1921-1927 لإخماد مقاومة الريف بقيادة المجاهد عبد الكريم الخطابي رحمه الله تعالى الأسلحة الكيماوية، وكانت القوات الإسبانية تختار بعناية المناطق الآهلة والمكتظة بالسكان كأهداف لإطلاق قنابل غاز الخردل السامة التي تسبب السرطان والتغيرات الوراثية، وحروقا وتقرحات خطيرة على مستوى الجلد، إضافة إلى الإسهال والتقيؤ، وتضرر العين والأغشية المخاطية والرئتين..
ولم تكن الجيوش التي مارست هذا الإرهاب وانتهكت حقوق الإنسان تنسب حقيقة إلى النصرانية أو أي ديانة سماوية أخرى، بل كانوا كما وصفهم بدقة المؤرخ الجبرتي عليه رحمة الله في «مظاهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس» بقوله: (فلقد خالفوا النصارى والمسلمين، ولم يتمسكوا من الأديان بدين، وهم دهرية معطلون، وللمعاد والحشر منكرون، وللنبوة والرسالة جاحدون)اهـ.
فقد كانوا علمانيين برجماتيين ميكيافليين، استخدموا القوة المفرطة والاستشراق والدين، والجواسيس والمنافقين..، وكل ما يخدم مشروعهم الإمبريالي ويحقق مصالحهم في المنطقة.
ولم تكتف جنود الغرب وآلته الحربية بالبطش واستعمال السيف والبارود للتبشير بالعقيدة العلمانية الجديدة، بل استعملوا ترسانة من الوسائل والآليات المستحدثة، استهدفوا بواسطتها العقيدة والشريعة، فغيروا بعد احتلالهم بلاد المسلمين مناهج التعليم وحشوها بالنظريات والفلسفات المادية، واستحوذوا على المشهد الإعلامي وسوقوا من خلاله للنموذج والثقافة الغربية، وعبثوا بالمشهد السياسي عن طريق إنشاء ودعم أحزاب متناحرة ذات مرجعيات علمانية متعددة المشرب مختلفة الهوى، وزينوا للمرأة التبرج والسفور وأرهبوها من العفة والحجاب وربات الخدور، ودجنوا الشباب والنشء وشغلوه بسفاسف الأمور، وطرحوا في قرارة قلبه وساوس وشبهات جعلته أول الواقفين ضد استرجاع أمته حقوقها وقيمها وهويتها.
إنها باختصار قصة طويلة وطويلة جدا من المضحكات والمبكيات، والحسرات والآهات، كما قال الراحل محمود شاكر رحمه الله..
قصة صارت الضحية فيها هي الجاني، والمجرم هو الضحية، وصرنا نشهد اليوم تلبيسا، ونسمع من أفراخ الفكر الغربي وسحرة فرعون كلاما، أو قل هراء، يحرك الحليمُ رأسَه عند سماعه يمنة ويسرة، ويتساءل مع نفسه بهدوء: هل أنا في عالم الأحياء أم عالم الأموات؟ هل بلغ الغرور بهؤلاء الأفراد إلى هذا الحد؟!
لكن مأساة الكذاب كما قال «جورج برنارد شو» ليست في أن أحدا لا يصدقه، وإنما في أنه لا يصدق أحدا.
Gnabil76@gmail.com