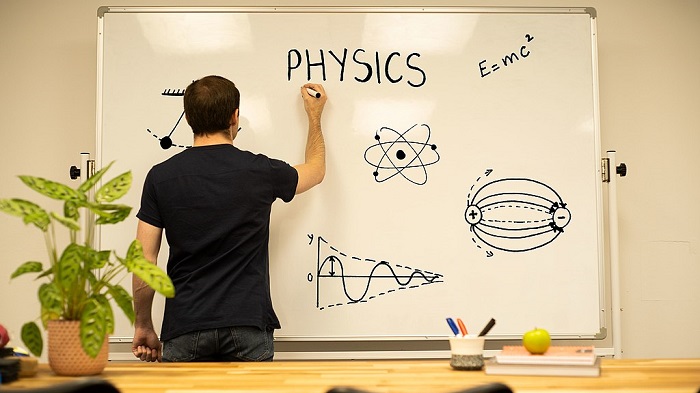فقه الإصلاح والتغيير ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾

ذوالفقار بلعويدي
هوية بريس – الثلاثاء 29 شتنبر 2015
واقعنا المعاصر تشخيص الداء ووصف الدواء
كما هو معلوم سلفا أن التغيير سنة كونية لازمة للإنسان بطبعه وفطرته، وهو في اصطلاح الناس يقصد به بصفة عامة استبدال حال جديد بحال قديم ووضع بوضع، الغاية منه إصلاح حالة فاسدة. ولا يلزم من هذا أن يكون القديم كله فاسدا وسيئا والجديد صالحا وحسنا. والتغيير هو أنواع وله وسائل ويحدث في مجالات.
ومَن هذا الذي يجرؤ على جحد الحاجة الماسة والضرورية لإصلاح شامل للأحوال الفاسدة التي لازمت مجتمعاتنا، وهذا الحضيض الذي لا تدانيها فيه أمة في زمنها الحاضر. حيث شمل الفساد كل مجالاتها؛ العقدية والعلمية والأخلاقية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والدستورية. وجمعت من أفرادها بين أحضانها كل رطب ويابس وغث وسمين. وفي مثل هذا الحال يتعين لزاما عند عملية الإصلاح تحديد نوع الظلم ومصدر الفساد، وإلا التبست السبل واختلطت الرايات وتشابهت الشارات. فلا يجدي والحال هذه في تغيير الوضع هتاف أو صياح أو عويل أو صراخ. فإنه لا يتم إصلاح شامل أو أقرب إلى الكمال لأمر غير مستبان وجهه. فكما أن المسببات دائما تابعة لأسبابها، فإن النتائج دائما تابعة لمقدماتها.
وإذا ما كانت المقدمات غير صحيحة كانت النتائج وخيمة؛ وسنة الله لا تحابي أحداً. وبدون حسم في مثل ظروف كهذه التي تستدعي الوضوح الكامل، ومعرفة طبيعة المعركة بلا مجاملة ولا مداهنة، ودون تلفيق ولا ترقيع، هو ضرب من العبث وتمييع لا يقوم به إلا خادع أو مخدوع، ولا يقدم عليه من يريد إصلاحا وتغييرا حقيقيين. لا يقدم عليه إلا من يريد تضليل الأمة عن وجهتها الحقيقية في الإصلاح والتغيير. وما لم يستيقن المسلم هذه الحقيقة فلا فلاح ولا نجاح ولا تغيير ولا إصلاح.
لنكن صرحاء…
إن ما تعانيه الأمة الإسلامية في زمنها هذا هو أكبر من أن تغيره مقاعد برلمانية أو مسيرات أو مظاهرات أو إضرابات أو إنزالات أو اعتصامات أو وقفات تضامنية أو ترقيع دساتير أو تلفيق أفكار بل حتى الانقلابات أو الثورات لا تقوى على تغيير ما تعانيه أمة الإسلام.
إنها أمة تعاني من أزمة تحقيق الذات، أزمة التنكر لهويتها، أزمة الجهل بحقيقة نفسها وحقيقة خصمها، أزمة جهلها بالغاية من وجودها وما هو مطلوب منها، أزمة جهلها بما هي في حاجة إليه. أزمة صراع بين الأصيل والدخيل، أزمة انشقاقات فكرية؛ صراع بين خلوف الاستعمار الغربي الذين يقومون مقامه بعد استقلالهم -زعموا- ينبذون الدين، ويطالبون في وقاحة علنا بعزل سلطان الإسلام عن تنظيم حياة المسلمين؛ يطالبون بدولة للمسلمين بلا إسلام. وبين جيل يعمل على استرداد استقلاليته الفكرية ويرفض كل أنواع التبعية الفكرية للغرب، جيل يعتز بانتمائه الإسلامي، ويتخذ الإسلام دينا ومنهجا وخريطة عمل في الحياة.
نحن أمة أزمتها ليست حكومة ومعارضة، وإنما أزمتها معارضتين. معارضة إسلامية ومعارضة علمانية، معارضة ترضى بالإسلام عقيدة وشرعة ومنهجا ومرجعا سياسيا، ومعارضة ترفض شريعة الإسلام والاهتداء بهديه. إنها أزمة مرجعيات. أزمة إما أن يسود الإسلام أو تسود العلمانية.
وما أحداث ما أطلق عليها اسم الربيع العربي -كذبا وزورا- في كل من تونس ومصر إضافة إلى ليبيا ثم سوريا واليمن. حيث لم يتغير شيء، إلا أنه هلك الناس، وذل الرجال، وترملت النساء، وتيتم الأبناء، ولم يرفع ظلم، كما لم تَزُل سطوة النظام الفاسد، بل بقيت وزادت سطوته على ما كانت عليه. ولم يُجن إلا الدمار.
إنها البلاهة البلهاء حين نظن أن الباطل سوف يكون نزيها ويلتزم بمبادئ اللعبة إذا ما كانت الغلبة للحق.
نعم إنها البلاهة البلهاء حين نتجاهل ونحن نروم إصلاحا كل ما فعله الاستعمار الصليبي من شرخ بالمجتمع الإسلامي وزرعه مبادئ العلمانية في جسم الأمة. حتى انتهى بنا الحال إلى ما نحن عليه من انقسام المجتمع الواحد إلى منظمتين، أو قل فصيلين؛ فصيل إسلامي بكل شرائحه، وفصيل علماني بكل أطيافه. هذه هي الصورة الواقعية ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تلقى مراء ولا جدالا. لأن من مقتضيات الإصلاح تحديد مرجع الفساد، وذلك حتى يتسنى تحديد أسبابه وسبل إصلاحه. والذين يحاولون غض الطرف عن هذه القضية وتمييعها لا يحققون نجاحا يرقى إلى مستوى تحقيق تغيير هادف. الشيء الذي يجعل كل محاولة إصلاح داخل المجتمعات الإسلامية على غير أساس المفاصلة بين علمانييها ومسلميها، بين من يريدها لا دينية وبين من يريدها إسلامية، هي محاولة فاشلة لا تحقق تغييرا ولا إصلاحا. لأن المجتمع المسلم لا إصلاح له إلا بالإسلام. و من ثم لا يمكن تحقيق إصلاح شامل لمجتمع مسلم إلا بمن يريد الإسلام، وتَطَبَّع بطابعه وأُشرب في قلبه عقيدة التوحيد. هذا أولا وهي قضية أساسية في غاية الأهمية لمن يريد إصلاحا إسلاميا. وصدق الله العظيم القائل: ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب﴾1.
أما التغيير الذي يحشر في زمرته من أفراده الموحد والملحد، هو تغيير لا يلائم بطبيعته طبيعة التغيير الذي يريده الإسلام؛ من إعلاء كلمة الله وإقامة دينه. لأن التغيير الذي يريده الإسلام هو تغيير على مستوى الفكر والاعتقاد أولاً، ومن ثم فكل أنواع الفساد التي تحدث في عالم الإنسان، إن منشأها في منظور الإسلام علة واحدة. وهي أن يتخذ الإنسان آمرا ومطاعا ومشرعا من دون الله، يخضع لشرعه وينقاد لأمره ويحتكم بحكمه؛ أيا كان هذا الآمر، وأيا كانت صورته. سواء كانت على صورة حاكم أو صورة حزب أو هيئة أو طبقة أو شعب أو أمة أو مجتمع أو الناس أجمعين. فكل من اتخذه الإنسان مشرعا له فقد اتخذه ربا من دون الله.
إنه لا تغيير ولا إصلاح على الإطلاق، ثم لا تغيير، ثم لا تغيير، إلا إذا سبقه تغيير في الحياة الاجتماعية على مستوى التصور والفكر واعتقاد وحدانية الله المطلقة في الأمر والتشريع، مع إظهار أفراد المجتمع استعدادهم الكامل للامتثال والالتزام بالمبادئ التي تقوم على أساسها عقائدهم وتصوراتهم في الذي يومنون بوحدانيته. وذلك حتى يظهر للمتتبع في كل ما يصدر عنهم من سلوك ومبادرات وإنجازات ومواقف وعطاءات وتضحيات نوع المجتمع الذي يطمحون لإنشائه. لأن نوع الأفكار والمبادئ والقيم والعقائد هي التي تصنع التغيير وليس العكس ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾2. فإن النفس البشرية إذا ما أشربت فعل الشر واستلذت به، فلا يمكنها هجره إلا بتغيير نظامها الفكري؛ مما يجعل أي إصلاح أو تغيير يجري في حياة الناس هو تابع لسلوكهم وأعمالهم النابعة عن نوع عقائدهم ومبادئهم في إطار قانون كوني وسنة جارية بشكل متلازم تلازم الجزاء بالعمل ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون﴾3.
فالإنسان يملك تحديد مصير نفسه، ومصير الأحداث من حوله، بل ونوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه. وقد قضت مشيئة الله بعدله سبحانه أن تترتب أحوال الناس تبعا لتصرفاتهم. وهذا يعني أنه كلما غير الناس من أعمالهم، غير الله من أحوالهم قدرا وفق ما غيروا من أعمالهم. حتى إذا ما تخدر شعورهم، وتأصلت شرورهم، وتبلدت أحاسيسهم، وأعلنوا الفواحش، وأظهروا القبائح، وصاروا يشهرونها ولا يرونها شيئا منكرا معيبا، وتخذوها منهجا عاما في حياتهم، أصابهم من الشر والفساد والدمار والهلاك وظلم بعضهم البعض، بقدر ما تركوا من الخير والصلاح ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾4.
هذا من حيث المبدإ، أما سبل تحقيق التغيير والإصلاح من حيث الممارسة، فهي تكمن في اشتغال الفرد أولاً بأداء ما هو واجب عليه، قبل اشتغاله بالمطالبة بما هو حق له. لأن العلاقة بين أداء الواجبات وضمان الحقوق علاقة متلازمة، بحيث حين يؤدي كل فرد في المجتمع واجبه يضمن تلقائيا حق الآخر. فمثلا ما هو واجب على الحاكم هو حق للمحكوم، وما هو واجب على المحكوم هو حق للحاكم، وما هو واجب على الرجل هو حق للمرأة، وما هو واجب على المرأة هو حق للرجل، وما هو واجب على الأسرة هو حق للأبناء، وما هو واجب على الأبناء هو حق للأسرة، وما هو واجب على المشغل هو حق للأجير، وما هو واجب على الأجير هو حق للمشغل،… وهكذا فإن جميع الحقوق تنبني على أداء الواجبات. ولو اشتغل أفراد المجتمع بأداء واجباتهم لضمنوا حقوقهم تلقائيا. فترك الواجبات من أكبر دوافع تأزم الأمم وفسادها وضياع حقوق أفرادها. وليت شعري كيف يصلح أمر مع تقصير أكثر المشتغلين بمطالبة حقوقهم في أداء واجباتهم، وصدق القائل: مَا يُصلحُ المِلْحَ إذا المِلحُ فسدْ!
ــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة آل عمران الآية:179.
(2) سورة الرعد الآية:11.
(3) سورة الأعراف الآية:58.
(4) سورة الأنفال الآية:53.
Douelfikar@hotmail.com