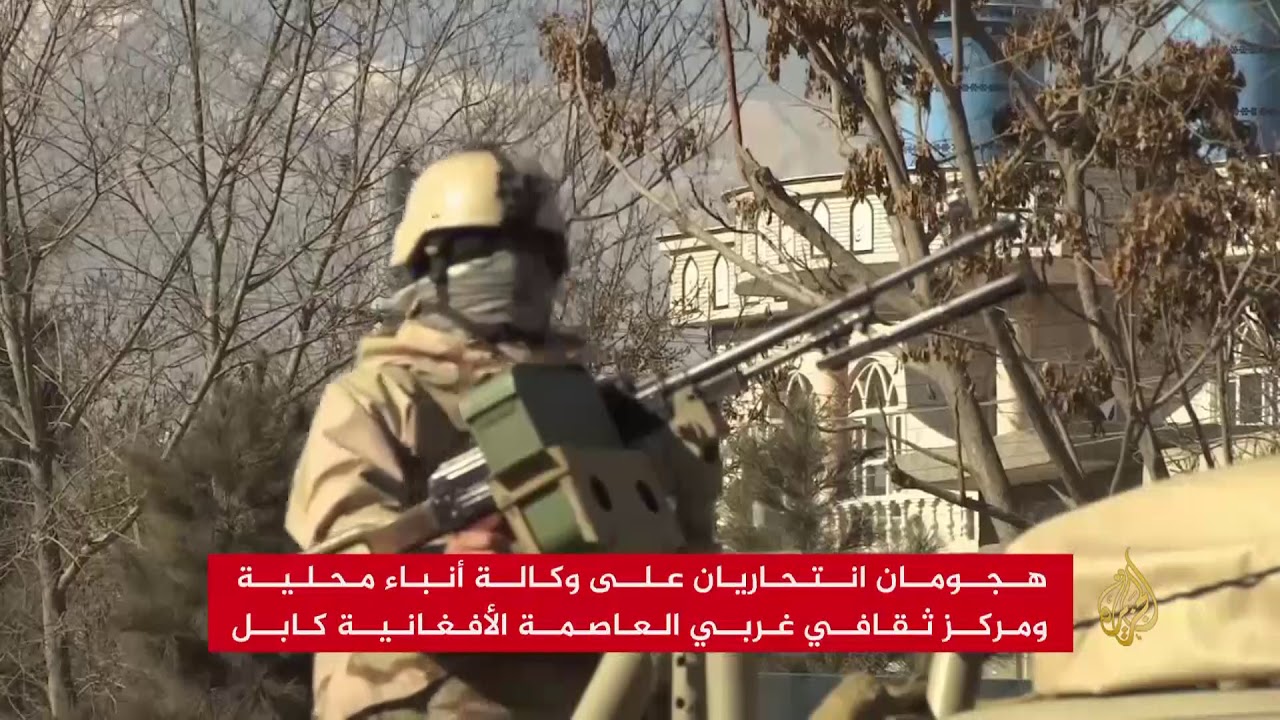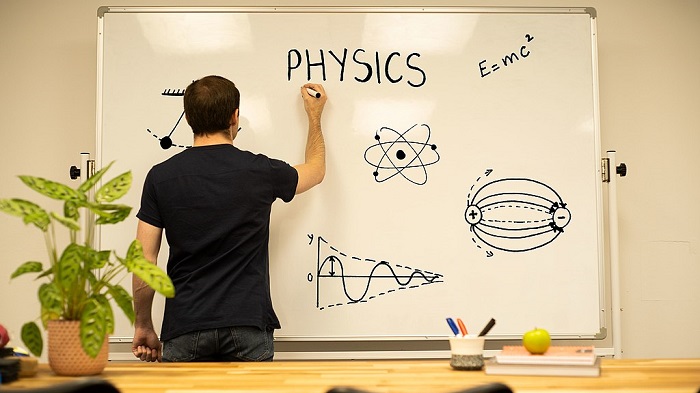فضائح الفنانين

هوية بريس – حميد بن خيبش
عشنا لأمد طويل ضمن ما يشبه القناعة بأن الفنان صاحب رسالة، وأن ما يقوده ويحدد خطواته هو إحساسه المرهف؛ كأن وجدانه يستشف ما وراء الوجود والأحداث من معان إنسانية، نحتاج، نحن الذين تخشبت قلوبهم، إلى من يدلنا عليها. لم نكن ندرك بعد خطورة وسائل الإعلام في تكييف المواقف والآراء مع هذا التوجه أو ذاك. لكن حين قرر الفنان أن يضع “رسالته” في مظروف، ويختم عليها بالشمع الأحمر ليصبح أداة من أدوات الأنظمة السياسية، ويستغل جماهيريته لينسف ما تبقى من الفضائل الإنسانية، فإن الفن نفسه أصبح “سائلا” لا مركز له، ومدعاة للتساؤل والشك حول قدرته على إشباع حاجتنا للحق، والخير، والجمال.
نشر فيصل القاسم، الإعلامي بقناة الجزيرة، قائمة على حسابه بمنصة إكس، تضم عشرات الفنانين السوريين الذين أيدوا صراحة، وبوقاحة وعنجهية نظام بشار الأسد، ودافعوا بشكل أو بآخر عن جرائمه ومذابحه التي ارتكبها في حق الشعب السوري، والتي فضحت بشاعتها مشاهد السجون والمعتقلات بعد سقوطه.
ضمت القائمة أسماء لها تاريخ فني معروف، وارتبطت في ذهن المشاهد العربي بتجسيد قيم الحق والشجاعة، والدفاع عن المظلومين. وفي تعليق على المنشور، تندر أحد المعلقين بأن القائمة ضمت أبطال مسلسل “باب الحارة”، ذاك العمل الدرامي الضخم الذي أحيا في نفوس العرب عموما قيما كادت تندثر، ومعاني إنسانية تهفو إليها قلوب الملايين أمام ضراوة العولمة وماديتها الفاحشة.
تخصص البعض منهم في أدوار الزعامة المتماهية بشكل مفرط أحيانا مع قيم الشهامة والمروءة، والتصدي للظلم وأعوانه. أما البعض الآخر فكان تعبيرا عن الرجولة والأنوثة الممتزجتين بمعاني الفضيلة والحشمة، والتربية المحافظة التي تعنى بالأصول والسمعة الحسنة. خلق الأمر التباسا لدى المشاهد العربي المحتفظ دوما بسذاجته أمام بريق الكاميرا، وتوهمنا هشاشة الفرق بين سلوك الفنان داخل الأستوديو وخارجه. صحيح أن للفنانين سقطاتهم الأخلاقية التي تتفجر بين حين وآخر على صفحات المجلات والمواقع، لكنها ظلت في نطاق ما يعتري الإنسان من عيوب مردها إلى تكوينه الطيني؛ فلكل منا قيمه العليا وشهواته السفلى، وجلّ من لا يخطئ! لكن أن يلطخ الفن رسالته بدماء الأبرياء، ويدعو لسفاح بطول البقاء، فهذا ما لا يتسع له صدر ولا يُقبل له عذر!
يسعى الفنان إلى القمة في عمله، وهي قمة معنوية ليس لها آخر، ويُعبّر عنها بمحبة الناس، ونجاح الأعمال التي يقدمها، والصدى الذي تُخلّفه في نفوس معجبيه. وما إن تبدأ رحلة الصعود حتى يصير قوله وفعله في دائرة الضوء، ويكون لمواقفه من الأحداث الجارية أثر ينعكس سلبا أو إيجابا على الرسالة التي ينتسب إليها. لكن حين تتداخل دائرة الفن مع دوائر السياسة والسلطة، فغالبا ما يكتوي الفنان بنارها، ويدفع نجوميته ورمزية حضوره في الوجدان الشعبي ثمنا لتأييد قرار جائر أو نظام ساقط.
تختزن الذاكرة أسماء فنانين اكتووا بنار السياسة لأنهم انحازوا إلى الهموم الإنسانية والقضايا العادلة. منهم من تم تقييد ظهوره على الشاشة أو إحالته على التقاعد الفني المبكر، ومنهم من اضطر للمغادرة بحثا عن رسالته في بلد آخر. وفي الحوارات التي تناولت تجاربهم ومسيراتهم الفنية، كانت الرسالة تعبيرا عن توق الإنسان الدائم للحب والجمال والحق، وانتصارا للحياة على شهوات الدم والإفناء والقتل. ولأن الفن في جوهره محصلة للتجربة الإنسانية، فقد كانت أدواته خادمة للرسالة وموجهة لها للارتقاء بالإنسان، وإثراء عالم أفكاره وأحاسيسه.
اعتاد المشاهد العربي في العقود الأخيرة على انقسام المشهد الفني بين فن دعائي يكرس الوضع القائم، ويهتف للنظام وإنجازاته، وبين فن مضاد يحاول تشكيل وعي نقدي ولو من وراء حجاب. وخلال المسافة المتوترة بين الرسالتين تفجرت فضائح عديدة للفنانين، تعلقت غالبا بسلوكهم الاجتماعي وعلاقاتهم داخل الوسط الفني وخارجه. ولأن المُشاهد قد يغفر لكنه لا ينسى، فقد استمر العطاء الفني لهم متذرعا بالشائعات تارة وبالخصومات تارة أخرى. أما وقد تجرد الفنان من أي حس أخلاقي وإنساني، وتغاضى عن شلال الدم وخارطة المقابر في بلده، ليدافع عن الديكتاتور وأعوانه بهذه الفجاجة، فإن كل الذرائع الممكنة تتبخر أمام هذا الانفصام غير المسبوق.
وفي الختام فإن الحديث موجه للفنان الذي يتمتع بحاضنة شعبية، ومسار فني ظل لسنوات “محترما”، ومرآة للهم الإنساني والآمال الخالصة. أما الفنان الافتراضي الذي يبحث عن نجوميته في علب الصابون والعطور، والتهريج الفارغ في برامج التوك شو فلا يقع بأية حال تحت طائلة العتاب أو المساءلة!