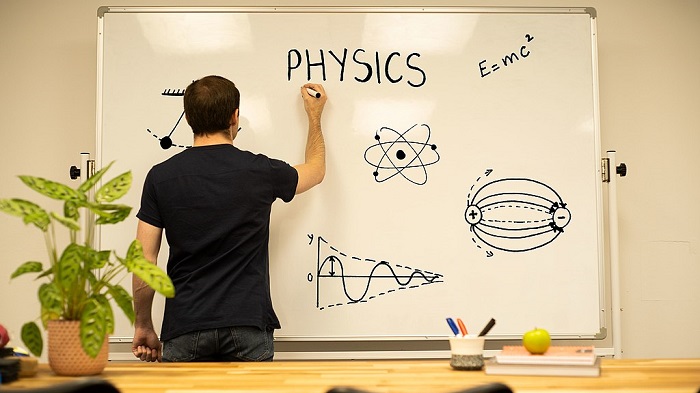“عقدة الهولوكوست” The Holocaust Complex ذنبٌ أوروبي وتوظيف صهيوني

“عقدة الهولوكوست” The Holocaust Complex ذنبٌ أوروبي وتوظيف صهيوني
هوية بريس – د. الحضري لطفي
“عقدة الهولوكوست” تمثل إحدى أكثر البُنى النفسية-السياسية تعقيدًا في الوعي الغربي الحديث. فهي لا تُختزل في حدث دموي موغل في القسوة، بل تُشكّل نظامًا داخليًا من الذنب المزمن، يُنتج انحرافًا خارجيًا في موازين السياسة والأخلاق. لقد بلغت المحرقة ذروة الهمجية الأوروبية تجاه اليهود، لكنها في الوجدان الغربي لم تُفتح على مسار تطهيرٍ أخلاقيٍ صادق، بل انزلقت إلى وظيفة أعمق: إنتاج عدالة مقلوبة تُبرّر بها مآسٍ جديدة، وتُصاغ عبرها سرديات الهيمنة والشرعية وتوزيع الأدوار في العالم.
ومع ذلك، لا يمكن فهم هذا السلوك الغربي المعقّد-خصوصًا فيما يرتبط بالإبادة الممنهجة التي تُمارَس في فلسطين- من زاوية نفسية واحدة فقط. نحن لا نختزل أداء دولة أو منظومة بوزن الغرب في تحليل نفسي أحادي. فثمة عناصر أخرى سياسية، تاريخية، ثقافية، واستراتيجية، تتداخل في تشكيل هذا الأداء. غير أن ما نؤكده هو أن البنيان النفسي يشكّل المحرّك الأعمق في اتخاذ القرارات وفي توليد السلوكيات الخارجة عن المألوف، وخاصة حين تتكرّر بأشكالٍ تبدو غير عقلانية أو منافية للعدالة والاتزان.
إن عقدة الهولوكوست، بوصفها جرحًا نفسيًّا غير معالَج، ليست السبب الوحيد، لكنها تمثل المنصة المركزية التي تتحرّك فوقها بقية العناصر. فهي التي تمنح الغطاء الرمزي، والدافع اللاشعوري، والمبرّر الأخلاقي الزائف، لسياسات التواطؤ، والانتقائية الأخلاقية، والانحياز المزمن، في التعامل مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
تعريف:
عقدة الهولوكوست هي بنية نفسية سياسية مزدوجة، ناتجة عن تداخل عقدتين جماعيتين:
1. عقدة الذنب الغربي المزمن.
2. عقدة التوحش الصهيوني.
1. عقدة الذنب الغربي المزمن، حيث لم تُعالج جريمة الهولوكوست عبر الاعتراف الصريح والمسؤول، (تاريخ بل جرى ترحيلها إلى الخارج، فصار الذنب يُفرَغ عبر تكرار الألم نفسه على شعوب أخرى، مع نزعة لاشعورية لإخضاعها، وإهانة مقاومتها، وفرض شعور الدونية الأخلاقية عليها، في فترات متعاقبة من التاريخ: (1096-1099: حملة الصليبيين الأولى ومذابح الراين – (1182: طرد اليهود من فرنسا (الملك فيليب الثاني أغسطس) –( 1290: طرد اليهود من إنجلترا (الملك إدوارد الأول) –( 1306: طرد اليهود من فرنسا (الملك فيليب الرابع “الجميل”) –( 1348-1351: اتهامات الطاعون الأسود (مذابح وطرد متفرق) –( 1394: طرد اليهود النهائي من فرنسا (الملك تشارلز السادس) – (1421: طرد اليهود من النمسا (ألبيرت الخامس) –( 1492: طرد اليهود من إسبانيا (الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا) –( 1497: طرد اليهود من البرتغال (الملك مانويل الأول) – (القرن السادس عشر – الثامن عشر: طرد متقطع من دويلات ومدن ألمانية وإيطالية –( القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: تفشي بروجرومات في الإمبراطورية الروسية –( 1933: صعود أدولف هتلر إلى السلطة في ألمانيا –( 9-10 نوفمبر 1938: ليلة البلور (Kristallnacht) –( 1941-1945: الهولوكوست (“الحل الأخير”).
2. عقدة التوحش الصهيوني، حيث استُخدم الألم اليهودي الموروث، لا للتطهر أو البناء، بل كأداة هيمنة رمزية تُبرّر بها ممارسات تفوق بكثير في قسوتها ما تعرّض له الضحايا الأصليون. فيتحوّل تمثيل المعاناة إلى غطاء أخلاقي دائم، يُبرّر العنف، ويُحصّنه من المساءلة.
ينتج عن تداخل هاتين العقدتين منظومة اختلال عالمي، يُعاد فيها تعريف الظلم بوصفه دفاعًا، والمقاومة بوصفها عدوانًا، ويُحوَّل التاريخ من درس إنساني إلى ترخيص مستمر لإنتاج مأساة جديدة باسم مأساة قديمة.
لفهم هذا الانحراف البنيوي، نقترح مصطلحًا تحليليًا جديدًا “متلازمة شَمشونير “، الذي يكشف الجذور النفسية لتداخل عقدتين جماعيتين تقفان خلف توحش اليوم باسم ألم الأمس.
متلازمة “شَمشونير” Samshonir Syndrome
(شمشون + نيرون).
هي متلازمة نفسية مركّبة، تجمع بين انفلات الهوى الشخصي ونزعة التدمير الكلي حين تُصاب الأنا بالخذلان. تُجسّد العقلية التي ترى أن فناء العالم مبرَّر إذا لم تُلبّ مطالبي، وأن الألم الشخصي يُشرعِن الإرهاب الجماعي.
شمشون: شخصية توراتية
₋ قال: “عَليَّ وعلى أعدائي يا رب”، فحوّل الهزيمة الذاتية إلى انتقام كوني.
₋ لم يحتمل الفشل، فحوّل المعبد إلى ركام على رؤوس الجميع.
₋ اعتبر أن القوة الجسمية تُخوّله إسقاط القانون الأخلاقي.
₋ تماهى مع الدور البطولي لدرجة الهوس، حتى صار الخراب دليله الوحيد على النصر.
الأبعاد النفسية في شخصية شمشون:
₋ العدالة الذاتية البديلة: لم يحتمل شمشون فكرة المحاكمة أو المحاسبة، فاستبدل القانون الإلهي بـ”قانوني الخاص”: ما داموا أساؤوا إليّ، فإن لي الحق في سحقهم جميعًا.
₋ الهُوية الانتقاميّة: لم يرَ في وجوده معنىً بعد الفقد، فاختار أن يتحوّل إلى قنبلة بشرية باسم “الشرف”.
₋ العدوان المُقدّس: وظّف القوة باسم الرسالة، لكنه دمّر الهيكل دون أن يُميّز بين الجاني والبريء.
نيرون: (حاكم الإمبراطورية الرومانية)
₋ مارس الإبادة ثم ارتدى قناع الضحية.
₋ انتقم من المقرّبين بادّعاء الفضيلة.
₋ لعب دور المصلح وهو يشعل الحرائق.
ملامح ” شَمشونير ” المشتركة:
₋ كلاهما دمّر الهيكل: نيرون أحرق “روما”، وشمشون دمّر “المعبد”.
₋ كلاهما يرى أن العالم لا يستحق البقاء إن لم يخضع له.
₋ كلاهما مزج الألم الشخصي بالتوحش الجماعي.
₋ كلاهما يتلذّذ بأداء البطولة في لحظة الخراب.
التفسير النفسي:
شَمشونير تمثّل ذلك الانفجار الذي يقع حين تجتمع ثلاثة عناصر:
1. نرجسية مجروحة: ترى في الخسارة الشخصية إهانة كونية.
2. ذاكرة تبريرية: توظّف الماضي لتشريع الإجرام.
3. بطولة مشوّهة: لا تُقاس بالنجاة أو البناء، بل بعدد القتلى والأنقاض.
السمات السبع لعقدة الهولوكوست في ضوء متلازمة شَمشونير:
1. الذنب المنكر: الغرب لم يُقر بجريمته بحق اليهود ضمن مسار أخلاقي صريح، بل التفّ عليها عبر ترحيل المسؤولية، وصناعة ضحية بديلة تُجلَد كل يوم.
2. الإسقاط النفسي: بدلًا من مواجهة الذات، أسقط الذنب على الفلسطيني، وجعل من دعم إسرائيل طريقًا رمزيًا لتطهير داخلي مزعوم.
3. التكرار القهري للألم: تُعاد تجربة الإخضاع نفسها التي عاشها اليهود، لكن هذه المرة يُمارسها الغرب على الشعوب الضعيفة، وكأن في ذلك تطهيرًا من عقدته القديمة.
4. الاستثمار الرمزي للألم: الصهيونية لا تستخدم الألم كحافز للسلام، بل كسلاح ناعم للسيطرة، يُستثمر في القانون، والإعلام، والتعليم، والمحاسبة الدولية.
5. التوحش الأخلاقي المشروع: اسم المحرقة، تُرتكب ممارسات تفوق المحرقة ذاتها: حصار، قتل جماعي، إبادة بطيئة، وتجفيف للذاكرة الفلسطينية.
6. الانتحار الرمزي – خيار شمشون: أي نقد يُردّ عليه بانفجار أخلاقي: “أنتم تُكرّرون المحرقة!” وكأن العالم ملزم بالسكوت عن كل شيء وإلا فهو شريك في الجريمة القديمة.
7. التدوير الأخلاقي للمعايير: تحوّل الضحية إلى مصدر شرعية للبطش، والجاني إلى ممثل للعدالة، والحقيقة إلى خيانة، والمقاومة إلى معاداة للسامية.
في هذا السياق، لا يمكن فهم السياسات الغربية المنحازة لإسرائيل باعتبارها دفاعًا عن السلام أو الأمن، بل ينبغي تفكيكها كنتاج مباشر لـ”عقدة ذنب” لم تُحلّ. هذه العقدة، التي لم تعالجها أوروبا بالحوار مع الذات، وبتحمّل المسؤولية الأخلاقية الداخلية، عمدت إلى تفريغها في الخارج، فاتخذت من الشعب الفلسطيني كبش فداء رمزيًا، يُقدَّم قربانًا دائمًا على مذبح التطهير الغربي المشوّه.
والأخطر من ذلك أن المشروع الصهيوني – ببراعة استراتيجية – حوّل هذه العقدة من مأساة إنسانية إلى رأسمال أخلاقي، ومن جرح وجودي إلى منصة هيمنة، حيث يُعاد تصنيف الضحايا والجناة، لا وفقًا للحقائق، بل وفقًا لموازين “الذاكرة المنتقاة”. ومن خلال هذا التوظيف الممنهج، أصبح الهولوكوست:
1. آلية لتبرير كل ما لا يُبرَّر.
2. وسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي.
3. وأداة لإعادة صياغة النظام الأخلاقي العالمي، بما يجعل من أي نقد لإسرائيل بمثابة خيانة لذاكرة الضحية، ومن كل مقاومة فلسطينية جريمة ضد التاريخ.
غير أن هذه البراعة الاستراتيجية لا تقف عند حدود التلاعب بالرموز أو إدارة الذنب الغربي، بل تمتزج – بشكل عميق وخطير- بـأطروحات تلمودية مغلقة، وآيات “سفرية” مأخوذة من نصوص توراتية، تُستخدم خارج سياقها أو تُفعَّل بوظيفة سياسية متوحّشة. وهي أطروحات تُعيد تعريف الإنسان وفق تصنيف مزدوج: “شعب مختار” مقابل “أغيار حيوانات”، حيث يُصوَّر الآخر – أي غير اليهودي – بوصفه كائنًا قابلًا للقتل، صالحًا للاقتلاع، لا مكان له في أرض الوعد، بل يُصبح قتله ذاته نوعًا من العبادة يُتقرب بها إلى الرب. (انظر مقالنا السابق بعنوان: ” تمجيد العنف، ماذا يعني أن تقول “كلنا إسرائيليون”؟ بين التوراة والتلمود”).
إن هذا الامتزاج بين الوظيفة النفسية لعقدة الهولوكوست والتبرير اللاهوتي المتطرف، هو ما يضفي على الهمجية الصهيونية مظهرًا مزدوجًا: بكاء في سياسية خارجية، لكنه مدفوعة بجنون داخلي عميق، حيث يتحوّل العنف إلى عقيدة، والقتل إلى طقس، والاستئصال إلى وعد مقدّس.
ذنب لم يحل
تمثل “عقدة الهولوكوست” واحدة من أعقد العقد النفسية التي تشكّلت في الوعي الأوروبي المعاصر، فهي ليست مجرد ذكرى لمجزرة مروّعة، بل تحوّلت إلى بنية نفسية-سياسية مركبة، تُستخدم بوصفها آلية للتبرير، وآلية للابتزاز، وآلية لإعادة تشكيل النظام الأخلاقي العالمي على نحو منحرف.
في جوهرها، تعبر هذه العقدة عن ذنب أوروبيٍ متجذّر، ناتج عن قرونٍ من الاضطهاد والعنصرية ضد اليهود، انتهت فصولها الكارثية في الهولوكوست. غير أن هذا الذنب لم يُحلّ بحوار عميق مع الذات، بل أُعيد توجيهه إلى الخارج. فالغرب، بدل أن يُعيد بناء نظامه القيمي على أسس حقيقية من العدالة والإنصاف، لجأ إلى تفجير ظلم جديد – هذه المرة بحق الفلسطينيين – في محاولة لاشعورية لتغطية جريمته القديمة.
فكل نقد لإسرائيل يُحوَّر إلى “معاداة للسامية”، وكل مطالبة بحق الفلسطينيين تُؤطر كتهديد لوجود من نجا من المحرقة. وهكذا، يتحوّل التاريخ إلى درع زائف، يحمي الجلاد الجديد باسم الضحية القديمة.
ما يحدث إذًا هو تواطؤ مزدوج:
1. الغرب يُغطي جرحه الأخلاقي القديم بخلق جرح جديد.
2. والصهيونية تُعيد تفعيل ألمها الرمزي لتحرق به شعبًا لا علاقة له بالكارثة الأصلية.
هذا النمط من التفكير يشبه دوامة من الإسقاطات النفسية الجماعية: من ذنب لم يُحل، إلى تطهير رمزي خاطئ، إلى عدالة زائفة تُعاد صناعتها بانتظام عبر الإعلام، والسياسة، والمؤسسات الدولية.
“عقدة الهولوكوست” لم تعد مجرّد ذكرى مؤلمة، بل أصبحت جزءًا من البنية العميقة للنظام الدولي الحديث، وهي تُعيد صياغة مفاهيم مثل : الضحايا، الجناة، التاريخ، الحق، والمعاناة، بطريقة تجعل من الضحية مرخصًا لها أن تتحول إلى جاني، ومن الجاني غافلًا عن جرح يتكرر بصور جديدة.
التوظيف: آلية للتبرير، وآلية للابتزاز، وآلية لإعادة تشكيل النظام الأخلاقي العالمي
تمثل النقاط الثلاث التالية الأركان البنيوية التي تكشف بوضوح البُعد الوظيفي للهولوكوست في الخطاب الغربي المعاصر، حيث لم يعد يُقدَّم بوصفه حدثًا مأساويًا فقط، بل أُعيد توظيفه كأداة مركزية لإعادة تشكيل مفاهيم الشرعية، والسيطرة، والمظلومية، والأخلاق السياسية في العالم الحديث.
أولًا: آلية للتبرير
لقد تحوّل الهولوكوست، بمرور الزمن، من حدث تاريخي يستدعي الوقوف عند فظاعته، إلى ذريعة أيديولوجية تُستخدم لتبرير كل شيء تقريبًا يتعلق بإسرائيل:
₋ الاحتلال؟ مبرَّر لأنه دفاع عن “الدولة” التي أُنشئت كي لا يُباد اليهود مرة أخرى.
₋ القصف؟ مبرَّر لأنه مواجهة “التهديد الوجودي” لليهود.
₋ التمييز العرقي؟ مبرَّر لأنه ضرورة لحماية “الدولة اليهودية”.
₋ إقصاء الفلسطينيين من أي سردية إنسانية؟ مبرَّر لأن “من لم يُدِن المحرقة لا يحق له الكلام عن المظلوميات”.
هكذا يصبح الهولوكوست أداة تبريرية جاهزة، تحوّل الفعل العدواني إلى فعل دفاعي، وتجعل من الناقد متهمًا، ومن القاتل ضحية.
إنها ليست فقط شرعنة استعمارية، بل قلب لموازين الأخلاق: حيث يُعاد تعريف العدالة وفقًا للذاكرة، لا للواقع، والمشروعية وفقًا للمعاناة الرمزية، لا للحقوق الحقيقية.
ثانيًا: آلية للابتزاز
الهولوكوست اليوم ليس مجرد “مأساة تذكارية”، بل وسيلة ابتزاز نفسي وسياسي ومالي علني وصريح، يُوجّه إلى الغرب تحديدًا، وإلى أي طرف دولي تسوّل له نفسه معارضة السياسة الإسرائيلية.
₋ تُمارَس الضغوط على الدول لتمرير قرارات موالية لإسرائيل في الأمم المتحدة، عبر التلويح الضمني (أو العلني) بـ”معاداة السامية”.
₋ تُفرض مناهج تعليمية، ومتاحف، ومؤتمرات، وموازنات مالية، لصيانة الذاكرة، لا بُغية عدم التكرار، بل بُغية التذكير الدائم بالذنب الغربي، كمدخل لطلب المزيد من التعويض.
₋ تُحرَّك جيوش من اللوبيات الإعلامية والسياسية كلما اقترب صوت حرّ من تفكيك الرواية الرسمية.
إنها صورة فريدة من “الابتزاز الأخلاقي”، حيث تُستخدم المأساة كعملة دولية، تُستثمر في العلاقات، وتُراكم رأسمالًا سياسيًا واقتصاديًا، وتُقايض بالمواقف، وتُعاقَب بها الدول إن خرجت عن النص.
ثالثًا: آلية لإعادة تشكيل النظام الأخلاقي العالمي
وهنا يكمن أخطر أبعاد التوظيف: إعادة تشكيل المعايير الأخلاقية الكونية انطلاقًا من مركزية “الضحية الصهيونية”. لقد تمكّنت هذه الرؤية من فرض سردية تقول:
1. إن أعظم مأساة في التاريخ هي مأساة اليهود في أوروبا.
2. وإن أعظم “شر” هو من يُعادِلها أو يُقارن بها.
3. وإن أعظم مظلومية لا تقبل الجدل، ولا التقليل، ولا حتى المشاركة معها في فضاء الذاكرة، هي الهولوكوست.
وهكذا يُعاد تشكيل الضمير العالمي، لا وفقًا لمعايير إنسانية عادلة تشمل الجميع، بل وفق نموذج واحد:
1. يحتكر الألم.
2. ويحتكر الحق.
3. ويحتكر تفسير التاريخ.
هذا ما أدى إلى:
₋ تقديس معاناةٍ واحدة مقابل إنكار أو تهميش لمعاناة شعوب أخرى.
₋ تحييد القيم الكونية من مثل: الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان، عندما تتعارض مع “الخصوصية الإسرائيلية”.
₋ نقل مركز الأخلاق من ميزان العدالة إلى ميزان الهُوية: لا تسأل عن الفعل، بل اسأل عن الفاعل؛ فإن كان “الضحية التاريخية”، فكل شيء مسموح.
دوّامة من الدم
وما نراه اليوم ليس سوى دوّامة من الدم، تتغذّى على نفسها، وتُعيد إنتاج العنف جيلاً بعد جيل، حيث لا يمكن الخروج منها إلا عبر مسارين متكاملين:
أولًا: مسار التوبة الحقيقية، وهي توبة لا تعني مجرد الندم العاطفي أو تقديم الدعم المالي الرمزي، بل الاعتراف الصريح بالجريمة التاريخية الأصلية، وما تبعها من توظيف سياسي للمأساة، ثم القطع الجذري مع منطق التعويض عبر الظلم الجديد. فالتوبة هنا ليست بين المعتدي وضحيته فحسب، بل بين الغرب وضميره، بين أوروبا وتاريخها، بين العقل السياسي والعقل الأخلاقي الذي انحرف طويلًا عن موضعه. إنها توبة من آلية الإسقاط، ومن تحويل آلام التاريخ إلى أدوات للسيطرة بدل أن تكون دروسًا للرحمة.
ثانيًا: الخروج من دور “الضحية” إلى موقع الفاعل المسؤول في العالم. إذ لا يمكن لأي كيان – أفرادًا كانوا أو دولًا – أن ينهض حقًّا وهو غارق في هوية الضحية. فالضحية التي تُرفض مغادرة جراحها، سرعان ما تتحول إلى جلاد جديد؛ لأن موقع الضحية يمنح تفويضًا ضمنيًّا لممارسة كل شيء “ردًا على الألم”، ويُسكت كل نقد “حفاظًا على الذاكرة”، ويُبَرر كل عدوان “منعًا لتكرار الكارثة”.
إن الاستمرار في تمثيل دور الضحية هو ما يسمح للصهيونية بالبقاء في موقع حصين أخلاقيًا، رغم أنها تمارس يوميًا كل ما يتعارض مع مبادئ الإنسانية: الحصار، القتل، التجريف، التهجير، تهويد التاريخ، وتشويه الجغرافيا. فـ”الضحية غير القابلة للنقد” هي أخطر أنواع الفاعلين في العالم، لأنها تصنع مظلوميتها الخاصة بيدها، وتطالب الآخرين بالتضامن معها بينما تزرع الألم حولها.
إن التحرر من هذه الدوامة لا يكون إلا حين يتحرر الجميع من أدوارهم القاتلة: حين يتوقف الغرب عن لعب دور الكفّار القديم الذي يبحث عن الغفران بأي ثمن، ويتوقف الصهاينة عن لعب دور الضحية الأبدية التي تستبيح العالم. آنذاك فقط، يمكن أن نتكلم عن بداية حقيقية لعدالة إنسانية، لا تُبنى على الرماد، بل على الاعتراف، والحق، والتوازن.
التطهّر من ذنب الأجداد ألم الأجداد
إن الخروج من دوامة الدم لا يكتمل إلا بـالانتقال من الماضي إلى الحاضر، عبر مسار تطهّري مزدوج: التطهّر من ذنب الأجداد، ومن ألم الأجداد. فالمجتمعات لا تتطهر من تاريخها بالإنكار أو الإسقاط، بل بالمواجهة الصادقة، ثم بتحديد حدود الزمن الأخلاقي: أين ينتهي الماضي بوصفه عبئًا، وأين يبدأ الحاضر بوصفه مسؤولية جديدة.
الغرب لا يزال مسجونًا في ألم أجداده وجرائمهم، ولم يجرؤ بعد على إعلان انتهاء زمن التكفير المرضي. ولذلك، فإن سياساته تتصرّف كما لو أن جريمة الأمس يمكن مسحها عبر منح جريمة اليوم غطاءً أخلاقيًا. لكن الحقيقة أن الألم لا يُغسل بالألم، والعدالة لا تُبنى على المقايضة بين ضحيتين.
لقد آن الأوان أن يُوجَّه البصر إلى الحاضر، حيث يقف الشعب الفلسطيني، لا كطرف في المأساة القديمة، بل كضحية للمأساة الجديدة، لا ذنب له سوى أن أجداده في الأندلس كانوا من بين الشعوب القليلة في التاريخ التي فتحت لليهود أبواب الكرامة، ومنحتهم حرية العيش والتفوق العلمي والازدهار الثقافي، في عهد لم يعرف فيه الغرب غير الطرد والمذابح والمحرقة.
هذا الشعب الذي تاريخه لم يحمل لليهود أي عدوان، يجد نفسه اليوم تحت قصف الذاكرة الأوروبية، وتحت أنقاض تحالفٍ نفسيٍّ لم يعترف أبدًا بألمه، لأنه لا يملك “سردية محرقة”، ولا “خلفية توراتية”، ولا “غطاءً غربيًا”، بل فقط: حقيقة واقعة، وظلم متواصل، وصوت مبحوح في ضمير عالمي أرهقته الكاميرات وخدّرته الأكاذيب.
الانتقال من الماضي إلى الحاضر يعني: تحرير السياسة من سطوة الذنب، وتحرير الأخلاق من هيمنة الألم غير المُعالج، وتحرير الضمير من ازدواجية المعايير. وهو كذلك دعوة لتأسيس مستقبل لا يقوم على ثأر رمزي، بل على عدالة حقيقية، ولا على استثمار في الذاكرة، بل على عهدٍ جديد مع الإنسان، كإنسان.
الألم النفسي والألم المعنوي: من الجرح الحقيقي إلى الاستثمار الرمزي
لفهم البنية العاطفية-السياسية التي تتحرك في قلب “عقدة الهولوكوست”، لا بد من التمييز الجذري بين الألم النفسي والألم المعنوي، لأن الخلط بينهما هو ما يسمح للصهيونية بتحويل مشهد المأساة إلى منصة للسيطرة، وللغرب بإنتاج تضامنٍ أعمى غير مبني على وعي.
أولًا: الألم النفسي
هو ألم حقيقي وعميق، يولد من التجربة المباشرة للأحداث الصادمة، ويُخلِّف آثارًا نفسية واضحة على البنية الشعورية للإنسان. إنه الألم الذي عاشه من نجا فعليًا من الهولوكوست، أولئك الذين عاينوا المعسكرات، ولمسوا البرد والجوع والإذلال والموت الجماعي.
هذا الألم لا يُنكر، ولا يُسَاءل، بل يُقدَّر بصفته تجربة إنسانية قاسية، تتطلب المعالجة لا التوظيف، الاعتراف لا التسليع، الرعاية لا التسويق السياسي.
لكن هذا الألم لم يعد هو المحرّك الأساسي للمشهد الصهيوني اليوم. فجيل الناجين الأوائل إما رحل عن العالم، أو انسحب من الواجهة، ولم يبق إلا رموز قليلة، تعيش في ظل الاستغلال الرمزي لمأساتها، دون أن تكون بالضرورة جزءًا من صناعة هذا الاستغلال.
ثانيًا: الألم المعنوي
هو ألم رمزي، اصطناعي جزئيًا، ومتوارث بصورة غير مباشرة، يتمثل في استدعاء المأساة الماضية وتضخيم حضورها في الحاضر، دون أن يكون المستدعي قد عاشها فعلًا.
وهذا هو الألم الذي يُديره المشروع الصهيوني اليوم: ألم بالنيابة، لا يصدر عن تجربة ذاتية، بل عن ذاكرة سياسية مصطنعة، تُوظَّف بخبرة عالية لخلق شعور دائم بالاضطهاد، يُسوّغ من خلاله العنف، ويُبرَّر الاحتلال، وتُطلب الحصانة الأخلاقية المطلقة.
هذا النوع من الألم لا يُنتج حزنًا حقيقيًا، بل يُنتج عُقدةً يُراد فرضها على الآخرين: عقدة الذنب على الأوروبي، وعقدة التقصير على الأممي، وعقدة العداء على من يرفض الانصياع للسردية. ولهذا، فإن الألم المعنوي في السياق الصهيوني ليس وسيلة للشفاء، بل أداة للهجوم، ومنصة للتربح السياسي.
النتائج النفسية والسياسية:
₋ هذا الألم المعنوي المصنّع يُولّد حقدًا مكتومًا تجاه الغرب نفسه، لأنه كان الأصل في الجريمة، لكنه اليوم يُقدّم الدعم كمن يمنّ، لا كمن يعترف.
₋ ويتحول هذا الحقد إلى مصٍّ ممنهج لمصادر القوة الغربية: المالية، والاقتصادية، والعسكرية. فالصهيونية تعرف أنها تتغذى من “ذنب الآخر”، وتعلم كيف تُبقي هذا الذنب حيًّا كي لا ينقطع مصدر التدفق.
خاتمة:
عقدة الهولوكوست لم تعد جرحًا مفتوحًا في ضمير أوروبا، بل صارت منظومة نفسية-سياسية مغلقة، تستثمر في الألم الماضي لتُنتج ظلمًا حاضرًا، وتبني شرعيات قاتلة على أنقاض الضحايا الحقيقيين. لقد تحوّلت المحرقة من مأساة إنسانية إلى معمل لصناعة الشرعية، حيث يُعاد تشكيل الأخلاق العالمية بناءً على ذاكرة مختارة، لا على ميزان الحق.
إن ما كشفه هذا التحليل هو أن العُقد النفسية الجماعية، حين لا تُعالَج في موضعها الأصلي، تتحول إلى أمراض معدية تصيب السياسة، وتعيد تشكيل العالم بمعايير مشوّهة. فـ”عقدة الذنب الغربي” لم تُواجه بالاعتراف والتوبة، بل أُعيد توجيهها إلى فلسطين؛ و”عقدة التوحّش الصهيوني” لم تُعالج بالشفاء من الصدمة، بل رُكّبت عليها سردية جديدة تُجيد تمثيل الضحية، بينما تمارس دور الجلاد بلا حرج.
وهنا تكمن خطورة “متلازمة شمشونير”: إنها العقلية التي توحّد بين الألم والنار، بين الجرح والدمار، بين الذكرى والانتقام، وتحوّل الضحية القديمة إلى بنية مقاومة لكل نقد، واستعصاء على كل إصلاح. عقلية تُجيد استثمار الذنب، وتفريغ التاريخ، وتسليع المأساة، وتحوير العدالة لتغدو سلاحًا بيد الأقوى لا حقًا للضعفاء.
إن تحرير العالم من هذه البنية المختلة، لا يبدأ من إنكار الألم، بل من منع تحويله إلى مبرر دائم للهيمنة. فالاعتراف بالهولوكوست لا يعني الصمت على الإبادة في غزة، والاحترام لضحايا الأمس لا يُبرّر سحق ضحايا اليوم. ولذا فإن الشرط الأخلاقي للخروج من هذا الانحراف هو فكّ التحالف النفسي بين الذنب والبطش، واستعادة معايير إنسانية لا تُباع ولا تُشترى في أسواق الذاكرة المنتقاة.
فحين يُعاد تعريف الجريمة بمعيار الهُوية، تُفقد الأخلاق معناها، ويُصبح القاتل بريئًا لأن جَدّه كان مظلومًا. وحين يُشرعن القتل بوصفه شكلاً من أشكال التعويض التاريخي، فإننا لا نعيش عصر ما بعد المحرقة، بل نعيد إنتاجها بأيدٍ جديدة وبأسماء أخرى.
لقد آن أوان الخروج من تمثيل الضحية بوصفه خطابًا سياسيًا، ومن تكفير العالم جماعيًا باسم مأساة لم يُشارك فيها الجميع. العدالة لا تُبنى بالتحايل على التاريخ، ولا تُستعاد بالقفز على آلام الآخرين، بل تبدأ حين يُقال للمُخطئ: أخطأت، وللضحية الحقيقية: لم ننسك، ولن نبيع ألمك في مزاد المصالح.
وهذا هو ما يُعيد للضمير العالمي توازنه، وللحق إنسانيته، وللحقيقة قوتها في وجه أخطر استثمار عرفه التاريخ: الاستثمار في المأساة.