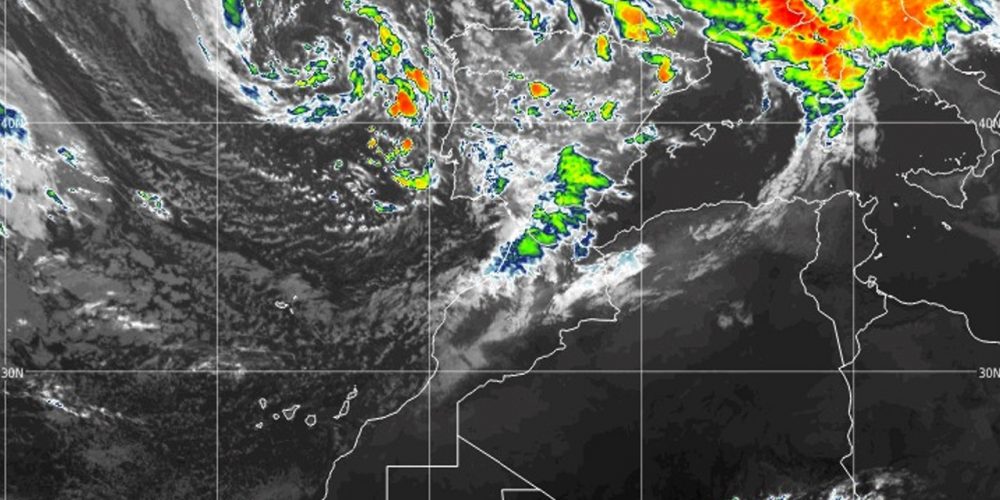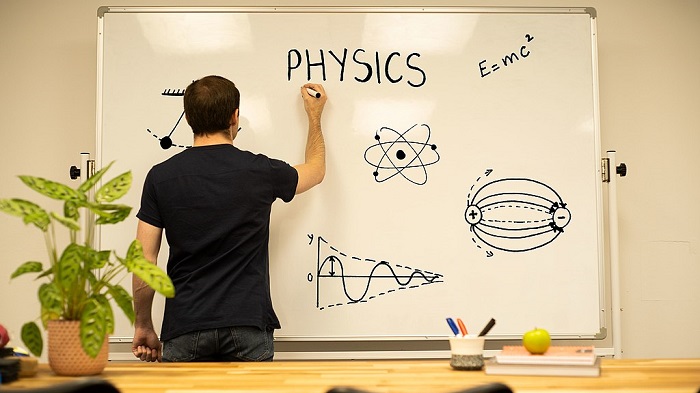المخربقون 2

هوية بريس – محمد أمين خولال
يقول أحمد عصيد في مقطع منتشر له لمستضيفه (برنامج Talks21= Arabi21):
«أتحدَّاك أو أي شخص آخر، أعطني واحدًا من الخلفاء الأربعة قاموا بتدوين الحديث.»
فيجيبه المستضيف بأن الأحاديث النبوية تم نقلها بطريقة شفهية.
فيقول عصيد: «إذن أنت تعتقد أن هذه الطريقة الشفوية تضمن بقاء ذلك المنقول صحيحا؟ إذن فهذا تفكير غير علمي، أنت خارج العلم كليا».
فألزمه المستضيف بأن نفس الشيء ينطبق على القرآن، فيقول عصيد: «لا الخليفة الثالث عثمان دوّن القرآن، أنقذ النص، ولو لم يدون لما وصلك القرآن كما هو الآن».
عندما سمعتُ الكلامَ رجعت إلى المقطع الأصلي كاملا علَّني أجد في سياق كلام صاحبه ما يشفع له قليلا في تدارك هذه الفضائح المعرفية، فوقعت على أدهى منها وأمر، إذ يقول:
«هذه الأشياء كلها -أي الأحاديث- ظلت شفوية لمدة 200 سنة، غير مكتوبة، وليست فيها وثائق».
ولولا المصلحة المعتبرة في نشر العلم وبيان قواعده وقمع الجهل ما شغلنا أنفسنا بهذا الكلام التخريفي ولا بصاحبه، فنقول:
• الخطأ الأول: يتحدى عصيد أن نطلعه على خليفة واحد من الخلفاء الأربعة قام بتدوين الحديث، وهو هنا يتحدث عن مطلق التدوين، لأنه يقول فيما يأتي إن الأحاديث ظلت شفوية لمئتي سنة.
فنقول له: قد قبلنا تحديك وأجبناك إليه: لم يَكتب الأحاديث خليفة واحد، بل خليفتان، كتب الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه كتابه لأنس بن مالك عامِلِه على البحرين، دون له فيه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. كما كتب إلى عمرو بن العاص خطابا، وكان من مشمولاته أحاديث نبوية.
وكتب الخليفةُ الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحديث، و”صحيفة العقل“ له مشهورة يعرفها صغار طلبة العلم عندنا، كان يجعلها في قراب سيفه، وتواتر نقلها عنه من بعده كتابةً وشِفاهًا.
• الخطأ الثاني: يدعي عصيد أن الأحاديث ظلت شفوية لمئتي سنة. [يقصد إلى زمن البخاري].
والحال، أن الأحاديث قد كُتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صحيفة علي آنفة الذكر، وصحيفة أبي بكر، والصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو، وصحيفة سعد بن عبادة، وصحيفة عبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم كثير رضي الله عنهم، وكتبَ التابعون وكتب أتباعهم وأتباع أتباعهم…
وهذه شبهة عتيقة بدأها المستشرقون المتقدمون، ثُمَّ تَمَّ نقضها عليهم، وقد أنجزت في ذلك دراسات كثيرة غربًا وشرقًا، من أهمها ”دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه“ لمصطفى الأعظمي، وأصلها أطروحة نال بها درجة الدكتوراه من جامعة كيمبردج، سنة 1966م، ولكن القومَ لا يقرؤون، وإذا قرؤوا لا يفهمون.
ولو كان لديهم أدنى اطلاع، لعلموا أن التدوين الرسمي للحديث النبوي الشريف قد تم في عهد الخليفة الخامس عُمَرَ بن عبد العزيز، قبل قرنٍ من ولادة البخاري. بل لعرفوا أن موطأ الإمام مالك (ت. 179هـ) رضي الله عنه، الذي يعرفه العوام عندنا، قد كتُب قبل ولادة البخاري، وهم يقولون إن الأحاديث كتبت بعد 200 سنة؟
• الخطأ الثالث: هل الكتابة شرط في الصحة؟
نقول: ليست الكتابةُ شرطًا في صحة المنقول؛ هذا من ناحية المعقول، لمن يعرف ما هو العقل قبل أن يدعي العقلانية.
فقد يَكتُب لنا شخص عاش أحداث المسيرة الخضراء عنها، ويكون مكتوبُه مكذوبا أو مغلوطًا؛ رغم أنه يعود لزمن المسيرة الخضراء، وقد يكتب شيئا صحيحًا، ثم يجري تحريفه مِن بعده. فالكتابة التي يتوهم عصيد شرطيتها ليست شرطًا في الصحة.
ولا تلازمَ ذاتيٌّ بين كتابة شيء وبين صحته في نفسه، كما أن عدم الكتابة ليس سببا في عدم الصحة، وليس في العقل ما يحكم بخلاف ذلك، وهذه حالات أربع لا خامس لها فاحفظها:
1): قد توجد الكتابة ولا توجد الصحة.
2): قد توجد الكتابة وتوجد الصحة.
3): قد لا توجد الكتابة وتوجد الصحة.
4): قد لا توجد الكتابة ولا توجد الصحة.
فهذه حالات كلها يشهد العقل بإمكانها والواقع بتحققها. وحصرُ الإمكان في حالة واحدة دون دليل على الحصر، بل مع قيام الدليل على عدم الحصر، دليل على قلة العلم وغلبة الجهل.
لقد كان علماء الحديث أكثر دقةً وأعمقَ نظرا، ولو أنهم كانوا بمثل تفكير عصيد لصار ديننا مثل الزريبة، يُدخل فيه من شاء ما شاء، ولكنهم اعتمدوا مسبارَ الإسناد، وعن ابن سيرين (ت.110هـ): «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء».
وهو أرقى ما يمكن أن يوصل إليه في ضبط المنقولات، سواء أكان المنقول شفهيا أم مكتوبا، فإنهم يبحثون في وسيلة نقله، فلو نقل شخص مثلا أن: جلالة الملك في خطاب العرش قال كذا وكذا (ولنفرض أنه لا يوجد تسجيل). هنا لو كان عصيد هو من كُلِّف بتصحيح النقل لقال للناقل: هل لديك ورقة مكتوبة تعود إلى عصر الملك؟
وهذه بلاهة وسذاجة. فإن الورقة هي وسيلة في النقل، وليست دلالة على صحة المنقول، ولا على فساده.
أما أهل الحديث فينظرون في الناقل نفسه قبل منقوله: هل هو عدل صادق أم لا، وهل هو مغفل أم لا؟ وهل ثبت عليه كذب مطلقًا؟ وهل ينسى؟ وهل يخلط الأمور؟ وهل هو متهم في دينه أو أمانته أو عقله؟ وهل وهل وهل؟ فإذا نسي أو كذب أو وَهِم عرفوا ذلك واستخرجوه بالمناقيش وميزوه ونخلوه، كما يميز الصيرفي أصيل الذهب من بهرجه وزائفه.
وبعد ذلك لا ينتهي الأمر هنا، بل يبحثون عن نفس الخبر الذي رواه الناقل من طرق أخرى، ومن مصادر أخرى، مع عملياتٍ بحث وتفتيش دقيقة ومقارنات معقدة ومنضبطة؛ تتجاوز بمراحل أعمال رجال الشرطة والمخابرات، فرجال الشرطة يحفظون أمن الدنيا، وعلماء الحديث يحفظون أمن الدين.
فإذا انتهى الأمر إلى سلامة الإسناد، أي الطريق التي نُقل منها الخبر، يبحثون بعد ذلك في مضمونه، هل يعارض عقلا صريحا؟ هل يصادم نقلا آخر صحيحا؟ وفي ذلك مناهج وضوابط غاية في الصنعة والدقة العلمية، وليست روايات شعبية يتناقلها الناس ثم يصدقها المسلمون كما يتصور العوام ويزعمون.
• الخطأ الرابع: يقول عصيد إن الخليفة الثالث عثمان (رضي الله عنه) أنقذ النص القرآني عندما قام بتدوينه، وإلا لما وصلنا كما هو الآن.
قلت: هذه كبيرة الكبائر وأم الفضائح، فالخليفة عثمان رضي الله عنه لم يدون القرآن، القرآن كان مكتوبا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قام الصحابة بحفظه في صدورهم وتدوينه في سطورهم، ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه (الخليفة الأول) بجمعه مكتوبًا بإيعاز من عمر رضي الله عنه. وما قام به عثمان رضي الله عنه هو الجمع الثاني، مع إعادة التدوين والمقابلة، وليس ابتداء التدوين.
وهنا ربما نقول لهؤلاء كلمةً قد يتفاجأ منها جهلهم: لو كانت الوسيلة الرسمية لِنقل القرآن إلينا الكتابةُ لشككنا في صحته.
إن القرآن الكريم قد نُقل إلينا بالحفظ الجماعي، بحيث إن عصيدًا لو كتبَ اليوم قرآنًا من عنده وزاد فيه حرفًا واحدا أو نقصه منه، لأخرجنا له من كتاتيبنا ومدارسنا العتيقة خمسة أطفال يصححون له أغلاطه المكتوبةَ من صدورهم. ونحن نرد إليه تحديه اليوم، في غمرة تخلفنا وبعدنا عن الدين وعلوم الشريعة، أن يزيد حرفا واحدا أو ينقصه من القرآن أو السنة، فكيف يتوهم أنه قد زيد فيهما حينما كانت الأمة في أوج تدينها وقمة عنايتها بالأصلين وعلومهما؟
ولم يكن حفظ الأصلين حفظا فرديا حتى يُتهم أصحابه بالنسيان أو التحريف، بل حفظًا تواتريًا جمعيًّا ممتدًّا في الأزمان والأمكان، بحيث تقضي العادة بعدم إمكان تواطؤ الناس على تحريف نفس النص، ولو أرادوا ذلك لما استطاعوا، يقول أبو الوليد الباجي في مناظرته لأحد النصارى مفاخرًا بحفظ النص القرآني في مقابل نصهم: «وكتابُنا المحفوظ يحفظه الصغير والكبير، لا يمكن أحدًا الزيادة فيه ولا النقصان، والذي يقرأ به من في أبعد المشرق، هو الذي يقرأ به من في أبعد المغرب، دون زيادة حرف ولا لفظة ولا اختلاف في حركةٍ ولا نقطة».
وقد حدث عندنا في تاريخ المغرب، أنه لما جرى إحراق المدونة، ثم تصرَّمت تلك الفترة وانطوى أجلها، أعيدت كتابتها من حفظ الناس، فحينما عثروا على نسخها المخطوطة ما وَجدوا فرقا بينها وبين ما تمَّ تدوينه من حفظ الناس إلا في بضعة أحرف مثل إبدال الواو فاءً.
وعندنا اليوم، بالمئات، من يحفظ الكتب الستة كاملةً عن ظهر قلب، ومن يحفظ التسعة، ومن يحفظ مجلدات كاملةً في الأدب أو الشعر أو التاريخ، فإن كان هذا في الأدب والتاريخ، وفي عصرنا الذي نَدَر فيه الحفظ وكثرت الملهيات، فكيف يكون الأمر في الكتاب والسنة في عصر الصحابة والتابعين الذين هم أحرص الناس على الدين، والذين كان الحفظ لهم حرفةً وطبعًا وسجية؟!
هل كان يعجز كل واحد منهم عن حفظ مئة حديث ونقلها إلى من بعده؟ ويعجز الذي من بعده عن حفظها ونقلها إلى من بعده؟
وهل إذا روى أحدهم حديثا ليس معروفا عند الناس، لم يكونوا يقيمون عليه الحِسبة ويحاكمونه ويسائلونه وهو متعلق بشؤون دينهم ومعادهم؟ وهل يستطيع شخص اليوم في عصرنا أن يروي شيئا عن مَلِكٍ أو رئيسٍ دون أن يتحقق الناس منه ويكذبونه إن كذب أو يصدقونه؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يعرفون عدد شعراته البيضاء في لحيته، ويحفظون طريقة أكله ومشيته؟ وإذا رفع يده أو وضَعَها في جيبه تسابقوا على تسجيل تلك اللحظة ونقلها وروايتها كما تنقل الكاميرا الحديثة الصورة بالجودة العالية والعرض البطيء. فهل يتخيل عصيد مثلا أن هؤلاء سيتركون كذبًا عليه يمر بين أيديهم؟ وقد فرغوا أعمارهم ونذروا أوقاتهم لذلك؟
ثم كيف سيحفظ الصحابة الأحاديث وهم عاشوها أصلا؟ فقد كانوا يروون ما عاشوه وخبروه وعلموه بالمباشرة، والذين جاؤوا من بعدهم كانوا أقرب الناس إليهم، ولما انقرضت الأجيال الأُوَل، كان الناس قد انتهوا من تدوين الأحاديث وجمعها وغربلتها وتمحيصها.
فالكتابة والتدوين موجودان عندنا، ولكنا لم نحتج إليهما في حفظ الدين إلا بالتبع، والكتابة شرط كمال لا شرط صحةٍ في الحفظ، ومن يتوهم غير ذلك فلا حظ له في النظر العقلي.
• الخطأ الخامس: لاحظوا قول عصيد: «إذن فهذا تفكير غير علمي، أنت خارج العلم كليا».
أي إن عصيد الآن رجل علم، يمارس العلم ويملك سلطة إدخال الناس فيه وإخراجهم منه، رغم أن كلامه كاملًا منذ استهلاله إلى اليوم بعيد عن العلم كما بعُدت السماء عن الأرض، ولكنه يتحدث باسم العلم، بمعنى أنه هو الذي يضع الحدود بين ما هو علمي وما ليس علميا، ما هو علم حقيقي وما هو علم زائف!!
وهذا في حقيقته، مجرد ورد يومي يكرره الحداثيون والملاحدة في كل نقاش، حيث إنك عندما تحصره في الزاوية، بدل أن يناقش الفكرة ودليلَها، يكتفي بأن يقول لك: «هذا ليس علميا».
وهو في حقيقته نوع السفسطة العلموية، تقول فيلسوفة العلوم سوزان هاك: «لقد أصبحت مصطلحات “العلم الزائف” و”العلمي الزائف” تتخذ وسيلة للاستخفاف بالمعرفة العامة، بالطريقة نفسها التي تُستخدم بها مصطلحات “العلم” و”العلمي” في وقتنا الحاضر كنوع من التفاخر [والاستعلاء] المعرفي».
ونسأل عصيد: ما هو العلم الذي تقصده؟ هل تقصد علوم الاجتماع مثلا؟ علم الجيولوجيا؟ علم البيولوجيا؟ علم الأعصاب؟ علم الفيروسات؟ علم الاقتصاد؟ على أي مستوى هو ليس كلاما علميا؟ فالعلوم متعددة ومناهجها مختلفة!!
نحن نتحدث في مسألة تتعلق بالنقل، وللمسلمين علم خاص بهذا الأمر يُسمى علم الحديث، قائم بذاته، له موضوعه ومنهجه ومسائله، ويمكن لعصيد أن يقوم ببيان فساد هذا العلم إن استطاع، لكنه يكتفي بأن يقول: هذا ليس علميا !! وكأن روايات عصيد الفولكلورية وخطبه الإنشائية خطبٌ علمية!!
ونحن نعرف أن مبلغ العلم عند عصيد هو أن يحصل ناقل الحديث على مخطوطة فيقيس تاريخ كتابتها بالكربون المشع، هو يتحدث عن علم مادي يستطيع قياس زمن ورقة ربما لا ندري حتى كاتبها الحقيقي!
وهذا موجود لدينا، لكن تصور إثبات الحقائق بهذه الاختزالية والسطحية التي نشرتها الأيديولوجيا المادية في القرن الأخير، ليست حتى نوعا من أنواع العلموية التي كتبنا في نقدها كتابا كاملا، بل نوع من أنواع السذاجة المعرفية والسطحية الفكرية التي تلبس لبوس الثقافة والتنوير.
وبالمناسبة، الكربون المشع ليس وسيلة يقينية، بل ظنية، وقد كان عصيد يتحدث عن اليقين.
كما أن اليقين ليس شرطًا أصلا، في العمل بالأحاديث النبوية، بل الظن الغالب كافٍ فيها، فهل يحاسبنا عصيد إلى ديننا أم إلى تصوره عن ديننا؟
فلك أن تتصور، أن هذه المغالطات كلها، والتي ثنينا جماح القلم عن التطويل فيها، اقترفها المتكلم في خمسِ دقائق، ولكم أن تتصوروا أنه يتحدث هكذا بالساعات الطوال، في الإذاعات الوطنية والقنوات الرسمية وغير الرسمية، فعلى الأقل، عندما تنادون على هؤلاء، فليكن منا شخص معهم، يقولون فنقول، ويتكلمون فنتكلم، وتسمعون شيئا من البراهين العقلية والحجج النقلية والأدلة العلمية، وتتعلمون شيئا من المعرفة الشرعية، فإنا أهلَ المغرب لا نرضى هذا المستوى من السطحية والدوغمائية الشعبوية لا لنا ولا لكم.
ملاحظة: هذه المنشورات نكتبها باليد الشمال في الأوقات الضائعة في الطوابير والصفوف وأمام الصراف الآلي وعند انتظار الأداء في الأسواق، فلا تحسبوا أنا ننشغل بالرد على الخزعبلات أكثر من ذلك.