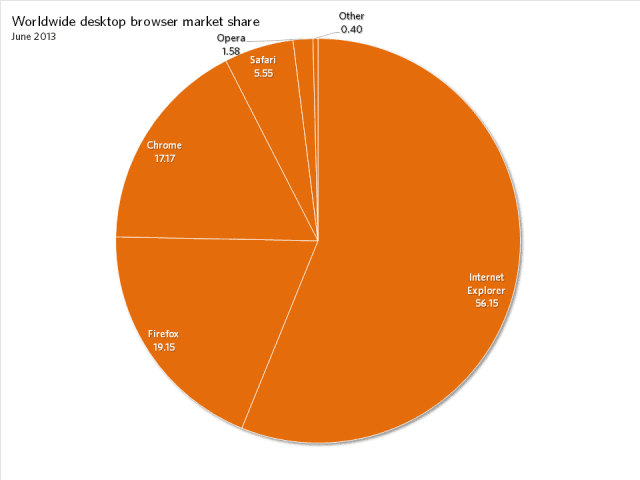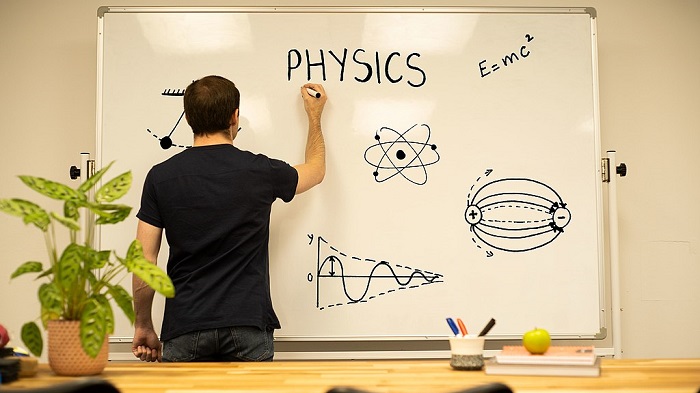ترسيم الوعظ بحدّ السياسة.. بين وظيفة الضمير ووظيفة الدّولة

ترسيم الوعظ بحدّ السياسة.. بين وظيفة الضمير ووظيفة الدّولة
هوية بريس – عبد الرحمن ورشيد
{أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [سورة اللملك 22]
تمهيد:
في لحظة فارقة من التاريخ، حين يغدو الدّين جزءً من الجهاز الإداري، ويتحول الواعظ إلى إنسان وظيفي، يُطرح سؤال جوهري: هل ما زال الواعظ يؤدي مهمته الروحية كضمير للأمّة، أو أضحى أداة من أدوات السياسة؟
في هذا المقال سنحاول استكشاف التوتر القائم بين الوعظ باعتباره خطابًا أخلاقيًا، وفعلًا دعويًا مستقلًا، وسلطة رمزية تتطلب مساءلة نقدية؛ وبين محاولات ترسيمه وحدّه بحدود السلطة السياسية. وذلك عبر قراءة تركيبية، مستندين في هذا الاستكشاف إلى متن أستاذنا ومعلمنا (ميمون نكاز) بعنوان: [ترسيم الوعظ بحد السياسة] أو [همسة في تفكيك العلاقة بين الوعظ والسياسة]، بصفته متنا يؤصّل للعلاقة بين الوعظ والسياسة، ويكشف عن ظواهر في علم الاجتماع السياسي-الديني. كما أننا سنستحضر مثالًا واقعيًا من مقالنا: [من سدّ التّبليغ إلى فتح التّفسيق]، الذي يصف مشهد تكميم المنابر مقابل فتح المهرجانات. وعبر هذه القراءة، سنحاول إبراز حدود الوعظ بين كونه ضميرًا حيًا للأمة وبين كونه وظيفة مرسومة بحدود الدّولة، وما يترتب عن هذا التّرسيم من آثار على الخطاب الديني والمجتمعي.
المحور الأول: في البنية المفاهيمية لجدلية “الوعظ والسياسة”.
حينما نكشف عن العلاقة بين الوعظ والسياسة بمجهر التحليل المفهومي، يظهر أمامنا مشهد لحقل دلالي غني، رسمه أستاذنا (ميمون نكاز) بدقة، بمفاهيم محورية؛
مفهوم الرّسم.
مفهوم الحدّ.
مفهوم السياسة.
مفهوم الوعظ.
مفهوم العظة.
مفهوم التذكير.
مفهوم النّفس.
مفهوم العقل.
مفهوم القلب.
مفهوم الروح.
مفهوم الإلهاء.
مفهوم التضليل.
مفهوم التدليس.
ولا شك أن هذه المفاهيم تحمل دلالات متراكبة بين اللغة والمنطق والفلسفة، وهي تحتاج لشرح موسع؛ فهي تُعتبر شبكة مترابطة نفهم من خلالها التوتر القائم بين وظيفة الضمير ووظيفة الدولة.
مفهوما الرسم والحد:
“الرّسم” هو لحظة إدخال الوعظ في جهاز الدولة (بيروقراطيته)، أي تحويله من فعل أخلاقي حرّ إلى وظيفة إدارية ذات مهام محدودة. “والحدّ” هو الوجه الآخر “للرّسم”، إذ يعني تقييد الخطاب الوعظي، ورسم خط فاصل لا ينبغي تجاوزه. وبذلك يصبح الواعظ محكومًا بإطار خارجي، لا منطلقًا من ضميره الداخلي.
مفهوما السياسة والوعظ:
“السياسة” في جوهرها عقلانية نفعية، غايتها التدبير وحماية المصالح، فهي كما قال أستاذنا: “علم وفن وخبرة وتدبير“. أما “الوعظ” فهو خطاب أخلاقي يشتغل على القيم والضمائر. وحين يدخل الوعظ مجال السياسة، يفقد شيئا من استقلاليته، حيث يغدو أداة ضمن أدوات “التدبير السياسي“، بدل أن يبقى صوتا حرا للمراجعة والنقد.
مفهوما العظة والتذكير:
قال: “العظة أخص من التذكير“؛ فهي خطاب وجداني يستنهض مشاعر القلب، في حين أن “التذكير” أعمّ، فهو يخاطب العقل ليستعيد الحقائق الكبرى. أو كما قال الأستاذ: “التذكير إيقاظ للقلب ليستحضر، كما يراد به تفعيل النفس لتشتغل“. فمن هنا يتجلى الفرق: “فالسياسي يوظف التذكير لتثبيت شرعية اختياراته، بينما الواعظ يوظف العظة لتحريك القلوب نحو القيم المطلقة“.
مفاهيم: النفس والعقل والقلب والروح:
“النفس” مجال للرغبات والمطامع، و”العقل” مجال التدبير والحيلة، وهما ميدان السياسة. أما “القلب” و”الروح” فهما ميدان الوعظ؛ فالقلب بما يحمله من خوف ورجاء ومحبة، والروح بما تحمله من أشواق وتطلعات. غير أن تسيّيس الوعظ يؤدي إلى قلب المعادلة، فالسياسي يخاطب الروح والقلب عبر شعارات دينية، بينما يتوارى صوت الوعظ الحقيقي.
مفاهيم: الإلهاء والتضليل والتدليس:
حين يُرسم الوعظ بحدّ السياسة، يغدو مُعرّضًا للانحراف. فإذا استُخدم لإبعاد الناس عن قضاياهم الجوهرية وقع في “الإلهاء“، وإذا استُخدم لتزييف وعييهم وقع في “التضليل“، وإذا خُلط الحق بالباطل عبر إلباس المصلحة السياسية ثوب الدين وقع في “التدليس“. وهنا تتكشف لنا خطورة تحويل الوعظ من وظيفة ضمير إلى وظيفة دولة.
المحور الثاني: ترسيم الوعظ في الظرف الراهن.
في السياق المغربي المعاصر، يتبدّى لنا هذا الترسيم بشكل واضح. فبينما نجد وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى عمِدا إلى ما يسمى ب “تسديد التّبليغ” عبر خطبة “واحدة” ومنابر مراقبة وأصوات محاصرة، تحت ذريعة تحصين العقيدة، وتسيير الفقه، وتهذيب السلوك؛ نرى في المقابل وزارة الثقافة والشباب والتواصل مُشرَعة الأبواب للمهرجانات الصاخبة، لخرق منظومة العقيدة دون أن تُميّز أهي سلفية أو أشعرية، و”ترخيص” الفقه دون أن تبالي مالكي هو أو حنبلي، وتمييع السلوك دون أن تلتفت أهو صوفي سنيّ أم طرقي.
هذا التناقض، كما وصفه مقالنا الذي هو بعنوان: “من سدّ التبليغ إلى فتح التّفسيق“، يُبرز مفارقة فاضحة: منبر مكموم إذا أنكر المنكر، ومهرجان مفتوح إذا نَشر الفسق. والنتيجة تفريغ وظيفة الوعظ من مضمونه الحركي العملي النّشيط، وترسيمه وحدّه بوظيفة تَنْويمِيّة أو مُنوّمَة. بينما يستحضر بديل آخر لتنشيط المنوّمين بخطابات الفسق والفجور معززة بمعازف الشيطان التي تخرق طبول الآذان و”تُبتِّكُها“، ولا شك أن هذا الأمر يفتت الحس الأخلاقي القيمي في المجتمع، وما ذلك عليكم بغريب.
{ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} [ سورة النساء 119]
المحور الثالث: الآثار المترتبة عن ترسيم الوعظ.
على الخطاب الديني: لا شك أن الوعظ سيفقد استقلاليته ويغدو خطابًا رسميًا متكررًا، يخلو من بثّ الأفكار المحفزة لتنشيط الفكرة المركزية التي هي الإصلاح والتجديد والنهوض وواجب النصرة.
على الضمير الجمعي: تغيب وظيفة التذكير بالحق، وتُستبدل بخطابات الفسق من أجل الإلهاء، مما يؤدي إلى خلل في الحسّاسات الإنسانية على مستوى القيم والوعي والحركة. أو إن شئت فقل: على مستوى “الذكر والفكر والعمل” وهي منظومة ثلاثية يحرص القرآن على أن يصنع بها الإنسان، كما قال أستاذنا (ميمون) في مواطن مختلفة، ومن المعلوم أن إنسان القرآن هو إنسان الحضارة الإسلامية وثقافتها.
على العلاقة بين الدين والدولة: حيث يتحول الدين من سلطة رمزية قادرة على مساءلة السلطة إلى مجرد وظيفة إدارية تضبط المجتمع وتمنحه شرعية شكلية. وذلك من خلال “صناعة” و”ترويض” “وُعاظ الموت” على “منابر الفضيلة” حيث يكون “الواعظ المصنوع” و”الواعظ المُروّضُ” تجسدًا للإنسان: المنضبط، الصامت، الذي لا يُقلق أحدًا، لا يُخطئ، لا يزعج “النظام”. وهذا ما يُنتج لنا واعظًا بمثابة “آلة خالية” من: الإرادة الحرة، والشجاعة في اتباع الحق والتمسك به، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجب النصرة في ظروف الامتثال، وإتمام مكارم الأخلاق.
المحور الرابع: بين وظيفة الضمير ووظيفة الدولة.
الوعظ في أصله ضمير للأمة، يخاطب القلب والروح، ويستنهض القيم الإصلاحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن حين يُرسم بحدود الدولة، يتحول إلى وظيفة ضبط اجتماعي، يُدار من فوق، ويُقنّن وفق اعتبارات سياسية أكثر من كونها دعوية، وبالتالي يفقد “الواعظ” حين “يُرسمُ بحدّ السياسة” مكانته وشرعيته التي يستمدها من “المِخيال الجمعي” لأن سلطته الرمزية تتحول إلى سلطة مفوّضة من سلطات الدولة، وهو ما يجعلها فارغة من استقلالها.
فخلاصة القول: إن “ترسيم الوعظ بحدّ السياسة” يضعنا أمام إشكالية مزدوجة: فمن جهة نراه يهدد بتحويل الوعظ إلى وظيفة شكلية تفقد روحها الإصلاحية الفاعلة؛ ومن جهة أخرى، يفتح المجال لخطابات بديلة لا تخدم القيم الأخلاقية للمجتمع، والواقع أنتم فيه لا نحتاج لذكر أمثلة منه.
وقد تنبه ابن خلدون إلى أن “الاجتماع الديني” هو الذي يزيد الدولة قوة وصلابة وليس اجتماع الفسوق والفجور، ف”الدعوة الدينية” –عقيدة وفقها وسلوكا أو ذكرا وفكرا وعملا- هي التي تزيد الدولة قوة وصلابة وغير ذلك يجعلها سائلة.
ونختم كلامنا بما قاله ابن خلدون (المقدمة 1/275 ت، شبوح) قال: “جمعُ القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه؛ قال تعالى { لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم} وسرّه، أنّ القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا، حصل التنافس وفشا الخلاف؛ وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله، اتحدت وجهتها، فذهب التنافس وقلّ الخلاف، وحسُن التّعاون والتّعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدّولة”.
{ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } [سورة الزمر 29]