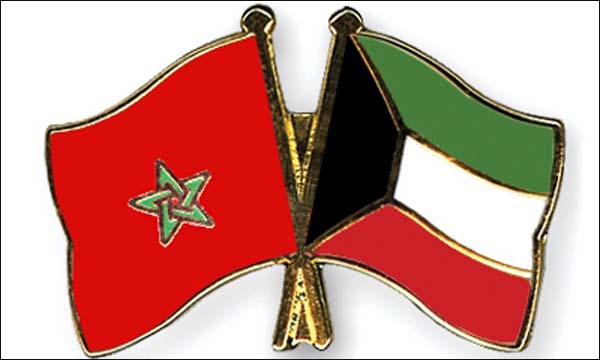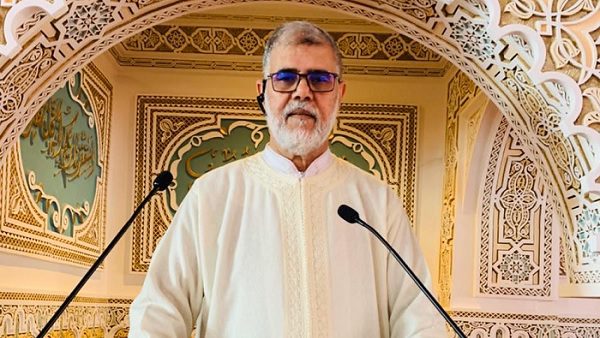هوية الجالية المسلمة في الغرب: عندما تختبر العلمانية حدود التعددية كيبك نموذجا

هوية الجالية المسلمة في الغرب: عندما تختبر العلمانية حدود التعددية كيبك نموذجا
هوية بريس – جمال أحمد الهاشمي
تعيش الجالية المسلمة في المجتمعات الغربية وضعًا مركّبًا، قوامه السعي الدائم إلى تحقيق توازن دقيق بين الاعتزاز بالهوية الدينية والثقافية، واحترام القوانين المدنية والتشريعات العامة، وبين الانخراط الإيجابي في المجتمع، والمشاركة في بنائه. غير أن هذا التوازن، الذي يفترض أن يكون عامل غنى وتنوع، بات اليوم مهددًا بفعل تصاعد قوانين علمانية جديدة تتقدم بها حكومات ذات نزعات يمينية تسعى لإرضاء قواعدها الانتخابية المتشددة على حساب الحقوق الأساسية للأقليات المهاجرة خاصة الجالية المسلمة. تُقدَّم تحت شعار “الحياد”، لكنها تترك آثارًا عميقة على الأقليات الدينية، وعلى المرأة المسلمة بشكل خاص.
وفي مقاطعة كيبك الكندية، يبرز هذا التحدي بوضوح مع مشاريع قوانين تُعيد تعريف العلمانية بطريقة تمسّ المظاهر الدينية في الفضاء العام، وتطرح تساؤلات جدية حول حدود الاندماج، ومعنى التعددية، ومفهوم الحرية الفردية. وندكر هنا احدى آخر القوانين التي تمت المصادقة عليها مشروع القانون رقم 9 والتي تأتي تحت مسمى تعزيز العلمانية بكيبك.
أولًا: حين يتحول الاندماج إلى إقصاء اجتماعي
يقوم الاندماج الحقيقي على أسس واضحة: الاحترام المتبادل، تكافؤ الفرص، الثقة، والتلاقي الإنساني. أما حين يُطلب من الأقليات أن “تندمج” بشرط التخلي عن جزء من هويتها، فإن الأمر لا يتعلق بالاندماج، بل بنوع من الضغط الثقافي المقنّع.
مثل هذه القوانين تخلّف آثارًا اجتماعية ملموسة، من بينها: شعور الأقليات بأنها مراقَبة أو غير مرحّب بها. انكماش اجتماعي وانسحاب تدريجي من الحياة العامة. فقدان الثقة في المؤسسات.
اتساع الفجوة بين مكوّنات المجتمع بدل تعزيز الانسجام. وهو ما يُضعف النسيج الاجتماعي الذي يُفترض أن تحرص الدولة على حمايته.
ثانيًا: تضييق ثقافي يُخفي الإنسان خلف القانون
المرأة المسلمة التي ترتدي حجابها لا تعلن تحدّيًا سياسيًا، بل تمارس قناعة شخصية متجذرة في هويتها. منعها من العمل أو الظهور في مؤسسات عمومية بسبب هذا الاختيار يمثّل تضييقًا ثقافيًا، ورسالة غير مباشرة مفادها أن هويتها “غير مرغوبة” في الفضاء العام. وينتج عن ذلك:
شعور متزايد بالاغتراب رغم سنوات الإقامة. صراع داخلي بين الطموح المهني والانتماء الديني والثقافي.
ضغط أسري وتربوي، خصوصًا حين تضطر الأم لشرح أسباب الإقصاء لأبنائها. وهنا يتجاوز الأثر حدود النص القانوني، ليمسّ الوجدان الثقافي والإنساني للأقلية.
ثالثًا: الخسارة الاقتصادية… المجتمع يدفع الثمن
لا تقتصر آثار هذه القوانين على الأفراد، بل تمتد إلى الاقتصاد ككل. فالمرأة المسلمة اليوم حاضرة في قطاعات حيوية: التعليم، الصحة، الهندسة، التمريض، المهن النادرة، والعمل الحر. إقصاؤها من سوق الشغل بسبب المظهر الديني يؤدي إلى: تراجع الدخل الأسري وزيادة الضغط النفسي. خسارة المجتمع لطاقات مؤهلة، في وقت تعاني فيه كيبك من نقص حاد في اليد العاملة. إضعاف الاندماج الاقتصادي، وهو أساس الاندماج الاجتماعي. هجرة عكسية نحو مقاطعات أو دول أكثر انفتاحًا. وبذلك، يصبح القانون عبئًا اقتصاديًا قبل أن يكون “إجراءً تنظيميًا”.
رابعًا: الأثر النفسي العميق على المرأة المسلمة:
غالبًا ما تُهمل هذه الزاوية، رغم خطورتها. فالمنع من العمل بسبب قناعة شخصية يخلّف جروحًا نفسية متعددة:
شعور بالرفض والإقصاء لا بسبب الكفاءة، بل بسبب الهوية. انخفاض تقدير الذات، حين يُختزل الإنسان في مظهره. قلق دائم من المستقبل والاستقرار. إرهاق عاطفي ينعكس على دور الأم داخل الأسرة. إحساس بالظلم، وهو من أشد ما ينهك النفس الإنسانية.
المرأة المسلمة لا تطلب امتيازًا، بل فرصة عادلة تُقيَّم فيها على أساس الكفاءة لا المظهر.
خامسًا: الأسرة المسلمة تحت ضغط مضاعف:
حين تتألم الأم، تتأثر الأسرة بأكملها. فالقوانين الإقصائية تولّد: خوفًا على المستقبل المهني. حيرة تربوية لدى الآباء. شعور الأطفال بأن هوية أمهم “مشكلة”. مما يخلف توترًا أسريًا ونقاشات حول الهجرة أو البقاء وضغطًا نفسيًا وماليًا يؤثر في العلاقة الزوجية. فالأسرة منظومة مترابطة، وأي خلل فيها ينعكس على المجتمع ككل.
سادسًا: الحل في المشاركة بدل الانسحاب… وهي مسؤولية الجالية:
فأمام هذا الواقع، لا يكون الحل في الانسحاب، بل في الحضور الواعي. والمطلوب اليوم: الانخراط الفعّال في المجتمع المدني المشارطة في مجالس المدارس مجالس الأحياء والهيئات التطوعية. المشاركة السياسية عبر التصويت، والدعم، والترشح. الاحتجاج السلمي القانوني: العرائض، الرسائل، الحوار مع النواب. الحضور في النقاش العام، لأن غياب الصوت يعني غياب التأثيرفالسياسة ليست ترفًا، بل أداة لحماية الحقوق.
سابعًا: دروس من تجارب دولية
تُظهر التجارب الغربية بوضوح أن: النموذج الفرنسي، الذي بدأ بتقييد الرموز الدينية، أدى إلى تراجع الاندماج وزيادة التوتر. كما أن بعض التجارب في بلجيكا وهولندا ساهمت في هجرة الكفاءات النسائية. بينما قدّم النموذج البريطاني مثالًا معاكسًا، حيث عزز احترام الحرية الدينية المشاركة المدنية والاقتصادية.
الدرس واضح أخيرا: القوانين التي تحمي التعددية تبني مجتمعًا أقوى وأكثر استقرارًا.
أخيرا ومن أجل علمانية عادلة لا إقصائية تساعد في ادماج أفضل للجالية المسلمة في الغرب والتي لا تسعى إلى الصدام، بل إلى العدالة والكرامة. ولا تطلب الهيمنة، بل الاحترام. ولا ترفض القوانين، بل تدعو إلى قوانين منصفة تحفظ كرامة الإنسان. فالعلمانية التي تُقصي تُضعف المجتمع، أما العلمانية التي تحمي التعددية، فهي التي تخلق انسجامًا حقيقيًا، وتفتح المجال أمام الجميع ليكونوا شركاء في التشييد والبناء، لا ضحايا للتهميش والاقصاء.