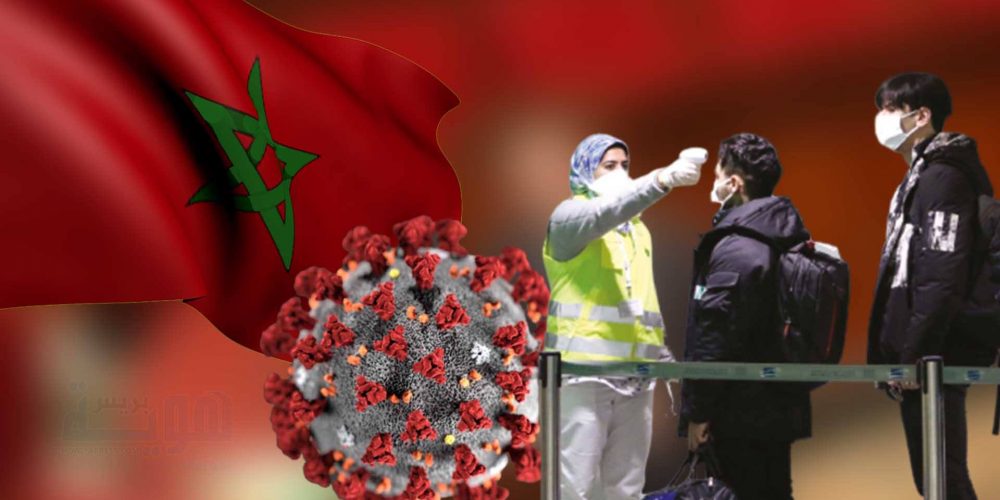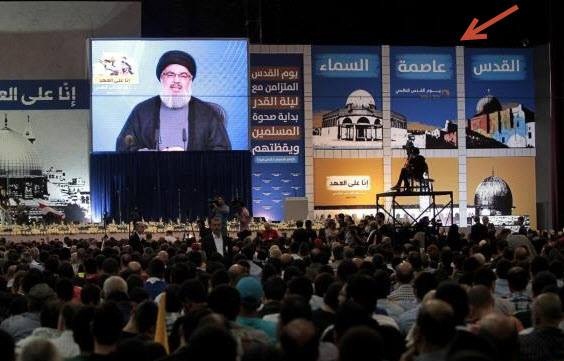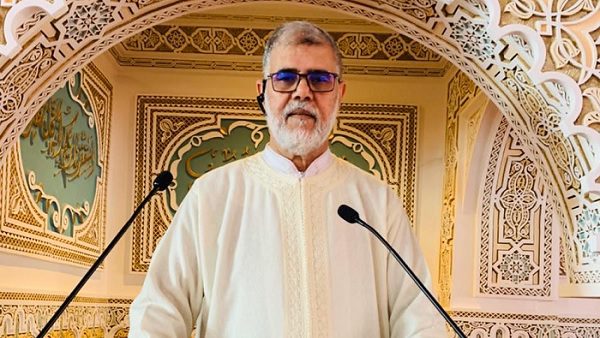دكاترة تحت الإنعاش (إن عاش)

دكاترة تحت الإنعاش (إن عاش) [1]
هوية بريس – ليلى السبيعي
لا يموت بعض دكاترة المغرب فجأة، وإنما يموتون بالتقسيط، والسبب هي جرعة صمت، تليها جرعة تسويف، ثم حقنة “سندرُس الملف قريبا”، إلى أن يتأكد الطبيب الإداري أن الحالة لم تعد تستحق الاستقبال. هكذا يموت بعض دكاترة هذا الوطن؛ أحياء في سجلات الحالة المدنية، ولكن أموات في لوائح التوظيف، أموات مؤجلون في أرشيف الحكومة،
ومعلّقون في قاعة الانتظار الكبرى المسماة: إصلاح المنظومة التعليمية.
كل يوم نفجع بموت دكتور، دكتور كان في الصفوف الأمامية لدفع عربة الدكاترة التي توضع أمامها عقبات، ومعها توضع العقبات أمام تطور العلم في هذا الوطن العزيز، دكاترة حَملة لقب علميّ لا يفتح بابا، ولا يطرق نافذة، ولا يشفع لصاحبه عند وزارة أو وزير. دكاترة يوضعون في مدارس التعليم الابتدائي انتقاما من العلم ومن درجة الدكتوراه نفسها، وليس في الأمر عندنا إهانة للتعليم الابتدائي أو الإعدادي، ففيهما تُبنى الأمم. ولكن الإهانة كل الإهانة أن تُحوَّل الدكتوراه إلى شهادة حسن سلوك، وأن يعامل صاحبها كفائض بشريّ تم ركنه مؤقتا في مدرسة قروية إلى أن يصدأ حلمه.
يطالب هؤلاء الدكاترة بأمر بسيط حد السذاجة: تسوية وضعيتهم قبل أن يتداركهم الكتاب، فلكل نفس أجل وكتاب، ويطلبون مناصب تليق بتخصصاتهم، ومواقع تُنتج المعرفة بدل استهلاك الطباشير، ووظائف تُحاور عقولهم بدل اختبار صبرهم. لكن الحكومة، أطال الله عمر بلاغاتها، تسمع جيدًا دبيب النمل في هذا الوطن ولا تُصغي لمظاهرات الدكاترة أمام برلمانها. ترى الملف وترى ولا تقرؤه. وتسمع الشعارات ولا تنصت لأي منها، وتعترف ضمنيًا بوجود المشكلة، ثم تُحيلها إلى لجنة، ثم إلى لجنة فرعية، ثم إلى لجنة لتقييم عمل اللجان السابقة. وضمن كل هذا يموت الدكتور.
لا يُشيَّع بجنازة، ولا يُنعى في بيان. يموت وهو يملأ جذاذة درس الجملة الإسمية في الصف الثاني ابتدائي، أو يراقب ساحة الاستراحة، أو يشرح درسا يعرف أنه يستطيع أن يدرّسه نظريًا بثلاث مناهج، وتاريخيا بأربع مدارس، ونقديا بخمس مقاربات، لكن لا أحد طلب منه ذلك. الموت هنا ليس بيولوجيًا، بل موت الكفاءة، موت الاعتراف، موت المعنى. والمفارقة الساخرة والغبية أن الدولة التي تتباكى على هجرة الأدمغة هي نفسها التي تدفعها يوميًا إلى الهجرة الداخلية: من الجامعة إلى القسم، ومن البحث إلى السبورة، ومن الفكر إلى المراقبة المستمرة للزمن المدرسي.
ليس هؤلاء الدكاترة خطرا على الدولة، ولا عبئا على الميزانية، ولا تهديدا للنظام العام. الخطر الحقيقي أن يتعوّد الوطن على موت أبنائه بصمت، وأن يصبح الظلم سياسة عمومية غير مكتوبة، لكنها مفعلة بدقة. وفي النهاية، قد لا تنتصر المطالب، وقد يطول الانتظار، لكن شيئًا واحدًا سيبقى شاهدًا: أن هؤلاء لم يطلبوا امتيازًا، بل طلبوا فقط ألا يُدفنوا وهم أحياء بختم وزاري، وتوقيع حكومي، وتاريخ مفتوح على التأجيل.
الحكومة بذكاء تمارس القتل الإداري ببطء في حق دكاترة قضوا أعمارهم في مختبرات البحث، بأناقة بيروقراطية، وبأختام رسمية تحفظ كرامة الملف لا كرامة الإنسان. دكاترة؟ نعم، لكن الدكتوراه هنا ليست درجة علمية، بل عارضا صحيا: إذا اشتد ضجيج الملف إعلاميا، يُنقل صاحبه إلى التعليم الابتدائي، وإذا تفاقم، يُحال على الإعدادي، وإذا شُفي يُترك دون متابعة. يطالب هؤلاء الدكاترة بما تطالب به أي دولة تحترم نفسها: أن يشتغل الباحث باحثا، والمختص في تخصصه، والدكتور في موقع لا يحتاج فيه إلى شرح الفرق بين الفعل والفاعل لمن لا يعرف بعد الفرق بين الحلم والواقع. لكن الحكومة، تلك التي تحفظ عن ظهر قلب خطاب تثمين الرأسمال البشري، تعاني فجأة من فقدان السمع كلما نُطق بكلمة: تسوية وضعية. تسمع: الإضرابات؟ الاحتجاجات؟ بيانات الغضب؟ لكنها لا تسمع: الاستحقاق، الكفاءة، العلم، الجامعة، البحث العلمي. تدير ظهرها وتقول: “الملف قيد الدراسة” وهو نفس الملف الذي دفن منذ سنوات، لكنهم يغيرون له الغلاف فقط، كلما تغير الوزير. أما الحل العبقري الذي توصلت إليه الدولة فهو: تعميم الإهانة بعدالة على الدكاترة. لم نقص أحدا، لم نُفضّل أحدا، الجميع سواسية في الإهمال. دكتور في الفلسفة، في الفيزياء، في التاريخ، في البيولوجيا، كلهم يُطلب منهم الشيء نفسه: “سير خدم وسكت، شبعتوا خبز”.
كأن المعرفة جريمة، والدكتوراه تهمة قبل أن تكون شهادة، والتفوق خطأ، لهذا الدكتور هنا لا يموت واقفا، بل يموت جالسا في قاعة الأساتذة، بين جدول حصص بلا معنى، يموت حين يدرك أن الدولة التي صرفت عليه سنوات من التكوين تستحي الآن من توظيفه في المكان الذي يليق به، فتستعمله كحل ترقيعي لسد الخصاص في فرعية أو إعدادية، ثم يخرج علينا مسؤول ليبكي في ندوة عن: “هجرة الكفاءات” وكأن هذه الأدمغة لم تُطرَد أولا إلى الأقسام الباردة، ولم تجبر على الصمت، ولم تقايض بالسبورة والطباشير مقابل التخلي عن الطموح. هذه ليست أزمة توظيف. هذه سياسة إعدام مؤجل. إعدام لا ينفذ بالسيف، بل بالجداول الزمنية، وبالتجاهل، وببلاغ لا يحمل تاريخ التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــ
[1]– كتبت هذا المقال بعد توالي أخبار وفاة العديد من الدكاترة، ممن أدركهم أجل الموت، دون أن يدركوا حلمهم في تسوية وضعيتهم.