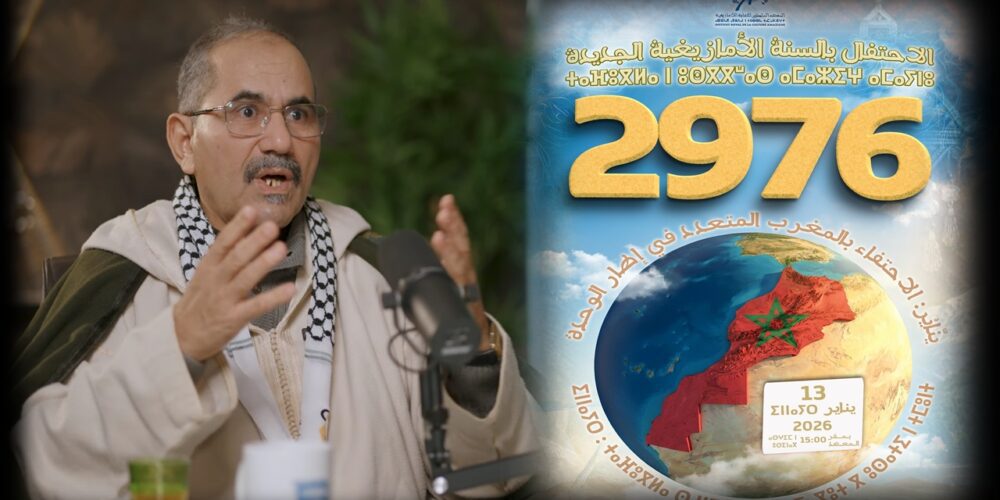رواء المدينة المنورة..

هوية بريس – ذ.محمد بوقنطار
مقدمات بين يدي الحلول المبارك (ح1)
 لم يسبق لي أن ركبت الطائرة قط، غير أني سمعت عن ركوبها كثيرًا من أصدقاء خاضوا تجربة السفر على متن خطوطها في أسفار شتى؛ طاعةً كانت أو سياحةً أو عملاً. وكان المشترك بين أوصافهم جميعًا هو ذلك الشعور الذي يتسلل إلى الجسد دفعة واحدة، فيكون أشبه بقشعريرة هادئة تتغشى المرء من أخمص قدميه إلى أعلى ناصيته، وتلك هي لحظة مغادرة الطائرة مدرجها الأرضي وانفلاتها من ربقة الإخلاد إلى الأرض نحو فسحة السماء.
لم يسبق لي أن ركبت الطائرة قط، غير أني سمعت عن ركوبها كثيرًا من أصدقاء خاضوا تجربة السفر على متن خطوطها في أسفار شتى؛ طاعةً كانت أو سياحةً أو عملاً. وكان المشترك بين أوصافهم جميعًا هو ذلك الشعور الذي يتسلل إلى الجسد دفعة واحدة، فيكون أشبه بقشعريرة هادئة تتغشى المرء من أخمص قدميه إلى أعلى ناصيته، وتلك هي لحظة مغادرة الطائرة مدرجها الأرضي وانفلاتها من ربقة الإخلاد إلى الأرض نحو فسحة السماء.
وما إن استقر بها التحليق حتى انفتح البصر على آفاق واسعة، فيتسلل البصر من النافذة الصغيرة الحجم ليتأمل من خلالها الناظر بديع الصنعة وإحكام الخلق، فيجد القلب ـ من حيث لا تكلّف ـ منقادا في طواعية إلى توحيد الصانع جل في علاه، وقد تلاشى ضجيج الأرض، وسكنت شواغلها، وتصاغر ثم تلاشى كل ما يدب عليها، فلم يبق إلا هذا الكون المترامي في صمته المهيب، شاهدا على الحكمة وجميل التقدير، ثم ما تفتأ في استطراد محموم أن تستسذج وتستغبي وتستبلد نظرة وصنيع أولئك الذين أنكروا في جحود فرعوني ومناكدة قارونية أن يكون لهذا الكون ولأنفسهم وسائر المخلوقات خالق بارئ صانع مصوِّر سبحانه وتعالى علوا كبير عن خرص ظنونهم.
والحقيقة أنها رحلة ـ على سموّ مقصدها ـ لم تخلُ من مشقة، إذ طال زمنها، ومع طولها يستعيد المسافر معنى قول النبي ﷺ في وصف فعل السفر وأنه: «قطعة من العذاب»، عذاب لا لما فيه من طول مكث، بل لما يلابسه من نصب وتعب وخروج عن المألوف، وقد زاد من ملحظ هذا الطول انعطاف مسار التحليق في غير ما كان ينتظر، حتى ليخيل للناظر أن الطائرة طفق ربانها يدير ظهرها للوجهة المقصودة قبل أن تعود إليها من طريق أبعد فيه ذلك القائد النجعة، وقد أخبرني أحد أصدقائي في جوابه عن سؤالي الفضولي قائلا: إن هذا المسار المفروض مردّه ليس إلى اعتبارات جوية بل لمغارم سياسية، تحول دون عبور بعض الأجواء القريبة، فيفتح للطائرة ما أُغلق من الحبيب القريب، فتسلك فضاءات البعيد الغريب، فتترك على مكرهة ما هو أقرب، مجال يقع تحت سلطان وسطوة الجار ذي الجنب، وفي هذا مفارقة تفرض نفسها على الخاطر دون استدعاء، سيما حين يجد المرء أن الطريق إلى مقصدٍ واحد قد يطول لا لسببٍ تعبدي ولا لعلة تقنية محضة، بل لتعقيداتٍ وتصلفات ومناكدات لا صلة لها بروح الرحلة ولا بغايتها.
ومع ذلك، ظلّ المعنى العزيز حاضرا في الوجدان، المعنى الذي مفاده: أن الوصول، وإن تأخر، فإن مريده يزداد شوقا، وأن التمهيد له ـ ومهما طال ـ فسيبقى جزءا من رصيد البركة المرجوة، وتلك سيرة القلوب إذا صدقت صدور أصحابها في صحيح القصد وسليم النية، فحينها ولابد لم ولن يضرها أو يغلب عزيمتها وكبير إصرارها في المضي – حيث مهوى الأفئدة – طول الطريق وبعد الشقة، فتلك ولا شك إرهاصات لا وزن لها ولا اعتبار، فهي زبد سرعان ما يذهب غثاؤه جفاء، ويتهافت أنينها على حاجز ذلك الحلول المبارك… يتبع..
استيقاظ الجنان تحت طائلة عظمة المكان (ح2)
ما إن وطئت القدمان أرض المدينة المنورة وعلى أرض مدرج مطارها يحس المرء بشرف المكان وبركة الزمان، فها نحن بعد طول مأمول، وشوق بين ثنايا الفؤاد محمول، وحامل لرصيد ما جاء في صحيح المنقول، قد حللنا بها ملبين راغبين في النوال من بحر بركتها، وهي دار الهجرة، وموطن التشريع والتأسيس لدولة الإسلام، ومثوى جسد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حيث يأرز الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها وهي خير لهم لو كانوا يعلمون كما قال صلى الله عليه وسلم…وهذا سر انجذاب القلب إلى أصل فطرته الإيمانية وكأنه للتو نطق بالشهادتين معلنا دخوله أو تجديد إسلامه بعد ردة طارئة قد تخللت عرى انتسابه لهذا الدين العظيم، إنه اليوم وقد تسنى للعبد الضعيف الخطاء باصطفاء من الحنان المنان أن يمشي حيث مشى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي حيث صلى، وأن يلقي السلام على حبيبه من مسافة الصفر ليس بينه وبين الرحمة المهداة ترجمان، وإنه استحضار مكاني يولد في القلب استيقاظا ويقظة، فإن القلوب لتتأثر بشرف الأمكنة كما تتأثر بشرف الأشخاص، وإنه لمكان شهد من مسكوب الدمع والذكر والدعاء واليقين والجهاد بأنواعه وأضرابه وشتى أصنافه ما لم ولا ولن يسكب في غيره من مناكب الأرض اللهم حرم البك المبارك في ذلك الواد غير ذي الزرع…
في مدينة رسول الله يتخلص المسلم الزائر من شائبة الضجيج المعنوي والمادي للدنيا بحذافيرها، فتقل في النفس ويكاد ينعدم ميلها لمظاهر اللهو فتفزع إلى محراب الطاعة لا تسقط منها صلاة إلا في محراب روضة المسجد النبوي، وليس هذا منها كما عرفت ووقفت عليه ذوقا بمعية صحبتي الطيبة ومن رافقاني في رحلتي وزيارتي المباركة أثر سلوكي بل هو نفحة إيمانية قلبية غير معهودة، وخروج من سياق الإلف والمعهود، وكسر لصفوان العادة حيث نكون ونحن في بلادنا ومسقط رأسنا أسرى الروتين، ووموالي لنمطية المشاغل، نرسف في أغلال العرض الدنيوي، فنغلبه مرة ويصرعنا مرات.
وليس في مدينة سيد الخلق أثر لهذه المغلوبية، حيث الأرز إلى المسجد النبوي أرز إيماني شبيه بأرز الحية إلى جحرها حيث الأمان والاطمئنان والحرز من كل تهديد، فهذه مدينة رسول الله في أول يوم الحلول المبارك أوقظت ما كان نائما في القلب، وهي من بعد لم تنشئ إيمانا جديدا بل حررت رصيده ومخزونه الراكد الرابض الموجود في قعر قعر القلب وصاحبه… يتبع..
ما سر هذا الفزع وذلك الإقبال؟؟! (ح3)
في المسجد النبوي تتغير الأحوال، وتخف الأثقال، ويصير الزمن هنالك يقاس بالخشوع لا بالخضوع لسلطة الدقائق والثواني…
يتجرد الزائر من كل ارتباط فيفزع إلى الصلاة فزع المشتاق، وقد وجد في نفسه همة ما عهدتها نفسه في سواه من الأصقاع والبقاع، فتمضي خطواتك في إصرار واستبشار لتوقع صلوات يومك الواحدة تلو مردوفتها، فلا يزاورك ملل ولا يطرق وجدانك فتور، بل يولد في الجوف بين المكتوبات شوق متجدد للمكث، وكأن الفراق هو عين التعب واللغوب لا مهوى البقاء إلى جنب الحبيب وجناب المحبوب.
ولست أنت الوحيد من ينتابه هذا الشعور غير المألوف، فكل الوجوه من حولك على اختلاف ألوانها وألسنتها تقر وتعترف وتشهد أن السر واحد والانجذاب مشترك، عرب وعجم وبنو الأصفر، ووفود من أقاصي آسيا وسخائم من إفريقيا، قد اكتنفهم الرحاب الشريف كأنهم النسيج الواحد، لا يعرف الصاحب صاحبه ولا الخل خله فلا تراه يسأل عن موطنه وقد ذابت كل الهويات في صحن الروضة الشريفة وخشعت الوجوه للرحمن واستقبلت القبلة في إخبات واطمئنان…
فسبحان من جعل أفئدة الناس جميعا تهوي إلى هذا المكان الطيب المبارك، حيث تستقر السكينة لتسكن في جنبات المسجد، وحيث مثوى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصديق والفاروق رضي الله عنهما، وحيث يأنس الزائر بقرب جوار جبانة الصحابة في البقيع، وبصمت جبل أحد وجبل الرحمة مربط الرماة، وحيث مدفن شهداء الوفاء، وهنالك ينتابك شعور استحضار بركة المكان وما يلقيه الله في قلوب مريدي هذا المزار من مأساة تلك الغزوة وأثر المخالفة، مخالفة إقبال الرماة على أنفال وغنائم الكفار وترك ظهر المجاهدين عاريا أمام تربص فيلق سيدنا خالد بن الوليد وقد كان يومها ظهيرا لفسطاط الكفر رضي الله عنه وأرضاه…
فسبحان من جعل النفوس هنالك تتعلق بالمقام الشريف، حيث يسكن السلام في الجدران، فهنالك لابد للذائق أن يقف على رصيد واف من زاد البركة، وأن يعرف أن هذه النفحات الإيمانية الربانية ليست كلاما يروى فيطوى، وليست هي أثرا يرى، بل هي أسرار تلقى، سيما إذا خلص القصد، وصدق الشوق إلى مألوهية الرب، وفتحت أبواب القلب أمام هذه الأنوار التي لطالما سمعتها من كل من سبقك فجرب قبلك وقد اصطفاه الله فوفقه إلى هذه الهجرة المباركة التي ما إن توشك أيامها على الانصرام حتى يود هذا المريد وذلك الزائر وتلك الوافدة تكرارها المرة تلو المرات… لا حرمنا الله وإياكم من إعادة حلولها وزيارة بيتها العتيق حيث المسجد النبوي وحيث أول بيت وضع للناس ببكة المكرمة… يتبع..
العروة الوثقى بين صلاة الحياة وصلاة الوفاة… (ح4)
عندما هممت بكتابة خواطر عن رحلتي إلى الديار المقدّسة لأداء العمرة، كنت قد رسمت -في ذهني- خارطة طريق تفصل بين المقام في المدينة المنورة، والأيام التي قضيتها في مكة المكرّمة. غير أن ثمة أمورا مشتركة تأبى هذا الانفكاك، ولا تقبل الإرجاء، وقد عشتها في المدينتين معا.
من ذلك -على وجه التحديد- ما اعتاده المأموم المؤذن في الحرمين الشريفين من القيام في دبر كل صلاة، دون فرق بين فجر أو جمعة أو عشاء…، ليعلن بصوت رخيم جهوري، تحمله مكبرات الصوت، فيفيض على أرجاء واسعة، ويهجم على زوار المدينة في قعر فنادقهم، وعلى أهل الحي في بيوتهم: “الصلاة على الأموات والأطفال يرحمكم الله””
أو “الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله”
أو: “الصلاة على الأموات يرحمكم الله””.
عبارات صرنا ننتظرها لا على احتمال راجح، بل على يقين طافح.كأن علاقتها بالصلوات المفروضة علاقة لا تنفصم، حتى لكأن للمسجدين الشريفين وشائج خفية بالموت والأموات، لا تكاد ترى ولكنها تسمع كل حين.
لقد أخذت هذه النداءات عندي طابعا مزدوجا:
فهي من جهة بشير صلاة،
ومن جهة أخرى ناعي موت،
يؤذن في الناس بإقامة الصلاة على من انقطعت صلاته، من الأموات، ومن الأطفال، ومن الطفل الواحد الذي يختزل به حزن كامل نسأل الله لوالديه الصبر والسلوان والاحتساب.
علاقة غريبة، وتجربة قشيبة لم أسبق أن عشتها في وطني، ولا حتى في مساجد المملكة المجاورة للمقابر والجبانات، حيث يبقى الموت هناك حدثا عارضا، بينما يصير هنا جزءا من الإيقاع اليومي للعبادة، حاضرا مع كل ركوع وسجود، يذكرك -بلا موعظة- أن هذا المكان لا يدرب فيه الإنسان على الحياة فحسب، بل على حسن الوداع أيضا.
إن الناس هنالك يلتمسون البركة لأمواتهم كما يرجونها هم الأحياء ونحن معهم، فيشدون الرحال و يقطعون الفيافي والخلوات ويأتون المسجدين الشريفين من كل فج عميق، يحملون أمواتهم لا يجدون في سفرهم أدنى مشقة ولا صغير مضض، وكأنهم فكوا من عقال أو تحرروا من أغلال، وكيف يجدونها وقد ترجموا محبتهم لفقيدهم بإهداء جثمانه بله روحه العزيزة صلاة جنازة لا يكاد البصر يستوعب صفوفها ولا يستطيع العاد أن يحصي النساء فيها ناهيك عن الرجال والولدان، وذلك الاصطفاء والتوفيق بتوسط أسباب قد سلكوها، نسأل الله القراط والقراطين والقراطات والقراطين لمن شهد الجنازة ودعا للأموات والأطفال والطفل مخلصا صادقا في جهالة عين وانقطاع صلة رحم بهؤلاء الأموات آمين يا رب العالمين.
حين تنطق الأمكنة بسيرة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام (ح5)
كثيرة هي المزارات التي يستحب للمعتمر أن يقف على تفاصيلها عمرانا وحدثا وموقعا، مزارات ليست أحجارا صامتة ولا أطلالا جامدة، بل شواهد حية تنبض بالتاريخ، وتستدعي الذاكرة، وتشد الوجدان إليها شدا، حتى ليجد الزائر نفسه مأخوذا إليها، مرهون الخاطر بها، محبوس النواصي في رحاب ماضيها العزيز المشرق.
والحقيقة أن ما كان لتلك الصفحات من التاريخ من عزة وإشراق، فإنما جذوة إشراقها قد استمدت نورها من سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خطى صحبه الكرام رضي الله عنهم، ذلك الرعيل الذي صنع لأمته رصيدا وافرا من المجد والتضحية والبذل، فكان التفوق للإنسان على العمران حتى صار استمدادا منه للمكان تلك المنزلة الرفيعة والقداسة البديعة.
ومن هاهنا كانت الزيارات المبرمجة خلال مقام المعتمر بالمدينة المنورة زيارات وعي وذكرى لا طقوس إلف وعادة، وزيارات اعتبار لا تعبد، واقتداء لا تبرك، ودعاء مشروع لا غلو فيه ولا ابتداع، إذ المقصود منها أن يتصل الحاضر بالماضي اتصال المتعلم بالمعلم، والسائر بالقدوة، لا اتصال المتعلق بالمكان لذاته.
فكانت أولى محطاتنا مسجد قباء، ذلك المسجد الذي تشرف بأن يكون أول بيت أسس على التقوى من أول يوم، فليس شرفه في جدرانه، وإنما في القلوب التي عمرته بالإيمان،
وفي الأقدام التي وطئته طاعة وخضوعا وإخباتا وإنابة، هناك يستحضر الزائر في تحيين مبارك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في البناء، وكيف ارتبطت العبادة منذ بدايتها بالعمل، والطهارة بالبذل، والنية بالصدق والتميز بالإخلاص.
ثم كانت الزيارة إلى مسجد القبلتين، حيث توقف الزمان لحظة في سياق سيرورته الكونية ليشهد تحولا مفصليا في مسيرة الأمة الشرعية، ففي هذا المسجد نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، في مشهد تجلت فيه حقيقة الامتثال الفوري، والانقياد المطلق لأمر الله، دون أن تسجل لحظة التسليم أدنى كلمة أو إشارة تفيد اعتراضا أو تحيل على جدل أو تردد، وكأن الأمة ما فتئت منذ نشأتها تدرب على أن وجهتها وصوب حركتها وبوصلة سكونها مستقرة منقادة إلى حيث أمر ويأمر الله، لا حيث تهوى النفوس وتسوق الطباع.
ثم انطلقنا إلى جبل أحد، ذلك الجبل الذي نطق بحبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “أحد جبل يحبنا ونحبه”، وكأن العلاقة بين الإيمان وتربة المكان هنالك هي علاقة ود وشهادة، وفي حضن الجبل، يقف الزائر عند تل الرماة، لا كواقف أمام تضاريس جامدة، بل كشاهد على درس خالد في سنن النصر، وأسباب الهزيمة، وأثر المخالفة.
ففي تلك البقعة تستحضر أحداث غزوة أحد بكل ما حملته من عبر موجعة مفجعة، الغزوة التي ذاق فيها المسلمون مرارة المخالفة، حين غلبت الرغبة على الأمر، والعاجل الخسيس على الآجل النفيس، فكان الثمن قاسيا، وكانت النتائج صادمة
هناك فقط تستعاد لحظات الزلزلة، حين اضطرب الصف، وتكاثفت الرماح وترادف صليل السيوف على أجساد الصحابة، ونال النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ما نال، حتى كسرت رباعيته، وشج وجهه الشريف، وسالت دماؤه الطاهرة، في مشهد تخلخلت له القلوب، واهتزت له الأرض تحت الأقدام.
وهناك يستحضر الزائر عبر كلمات الوعظ الراشد المشهد المفجع لاستشهاد سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وما وقع له من تمثيل وتنكيل، ليبقى الجرح نازفا في الذاكرة، لا حقدا ولا ثأرا، بل درسا في ثمن الحق، وضريبة الصدع به.
وفي خضم تلك الفوضى، يتذكر المرء أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان -يومئذ- قائدا لفيلق من فيالق المشركين، يغير بذكاء عسكري على ثغرة قصور الرمي وتقصير الرماة، لتتحول موازين المعركة، ويشيع بين الصفوف المؤمنة خبر كاد أن يقصم الظهور مفاده: مقتل النبي صلى الله عليه وسلم.
إنه الخبر الذي اهتزت من وقعه القلوب، وطاشت موازين النفوس، وانكشف للعيان معدن الإيمان، حيث ثبت من ثبته الله، واضطرب من اضطرب، لتكتب تلك اللحظات من تاريخ الأمة سطورا خالدة في سجل السيرة العطرة تحكي على وجه اليقين حكاية أن النصر ليس بالاطراد دائما هو ثمرة العدد ولا نتيجة مباشرة لامتلاك العدة والقوة، وإنما هو مباشرة لثمرة الطاعة والثبات على الأمر.
وإنها والله وبالله وتالله لمحطات يخرج الزائر من جبلها أحد، لا محملا بالحزن والكمد، بل يبرحها مثقلا بنور البصيرة، مهديا إلى حقيقة أن هذا الدين قام على التسليم قبل البطولة، وعلى الامتثال قبل الاندفاع، وعلى الاتباع لا الابتداع…
وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مزاعم تترجم بالعاطفة وحدها، بل هي عروة وثقى لا تقوم لأنفاسها قائمة إلا باتباع أمره، وتصديق خبره والوقوف عند حدود نهيه، والتزام تركته مهما قعقعت المغريات وفرقعت المبررات، وإلى أي سقف بلغت دعاوى وتلبيسات مطففي الانتساب إلى منهجه القولي وسننه الفعلي، من الوضاعين والكذابين المنتحلين ثوب المحبة زورا وبهتانا.
في حضرة المسجد النبوي تتهذب القلوب… (ح6)
…لم يكن ذلك القول الذي أسررت به في أذن صاحبي عن جهلي بالصوب الصحيح للقبلة إذا ما وجدت المسجد النبوي الشريف فارغا من السباقين الأولين قولا عابرا ولا مزاحا ثقيلا، بل كان اعترافا صريحا بعلة لازمتني طويلا، فذاكرتي في بوصلة المكان وتحديد الدروب بدقة مخرومة حدّ القرف والاستثقال لمن يرافقني، لا تثبت على جهة ولا تقوى باحاتها على تخزين خرائط الطريق وإحداثيات الظرف المكاني، مهما طال المكث أو تكرر المرور، على خلاف ما أُوتيت من قدرة عنيدة على حفظ الوجوه، واستحضارها بالرسم مع الاسم كما هي، ولو بعد عقود من انقطاع الصلة وانعدام دربة الرؤية وحصول اللقيا.
ولعلها المفارقة التي جعلت دخولي المسجد النبوي امتحانا مضاعفا، سيما والمكان هنا لا يدرك بالحد ولا بالزاوية، ولا يستطيع الناظر إلى أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو يساره أن يستوعب نظره الجهة الواحدة، حتى كأن الجهات نفسها قد تخلت عن صرامتها، واكتفت بأن تكون احتمالات تحت سطوة الضم والإدماج، في توسعات مترادفة لا يكاد فعلها ينقطع ولا معول الهادم الحافر خدمة لساعد الباني المشيد يكف عن هده.
غير أن الذي أنقذني من هذا الاضطراب المكاني، لم يكن نقشا ولا علامة ولا محرابا، بل إنما كان الارتكاز على الوجوه ذاتها وجوه المصلين وهي تنثال، وتنتظم، وتستقر في صفوفها، وتطفق ملبية في صمت وتأمل يعكس ما وصلت إليه من خشوع وما نالته قلوبهم في غير طرق ولا استئذان من إخبات وتهذيب، فصرت أقرأ القبلة في سكونها، وأهتدي إلى الاتجاه منطلقا من استقامة الأكتاف قبل استقامة الجدران.
وهنا فقط بدا لي أن ضعفي لم يكن ضعفا مطلقا، بل ميلا قسريا إلى أن أهتدي بالمريد لا بالجدران، وبالأثر لا بالنظر.
ولعل في هذا بعض أسرار تلك البركة التي تضيق بها الساحات ولا تضيق بعروتها الصدور، إذ كلما همت طائفة وكادت أن تغادر خلفتها أخرى في غير انقطاع، وعلى بدء متكرر، حتى ليخيل للناظر أن المدينة النبوية لا تتسع ولا يتوسع عمرانها إلا بقدر ما يقصد فيها، وأنها لا تعرف بالخرائط، بل بما تحفظه الوجوه من قصدٍ واحد، وسعي واحد، وتوجّه لا يخطئة المراد.
وكنت كلما هممت أن أبحث عن نفسي في هذا الاتساع، وجدتها تتضاءل لا خوفا ولا ضياعا، بل حيرة واستغرابا فهنا لا يليق للذات أن تتقدم الصفوف، ولا للذاكرة أن تزاحم السيرة.
لقد فهمت من أول يوم وطئت قدماي المدينة المنورة أن هاهنا يعاد ترتيب المقاييس وتتغير معايير المعهود الذي دأبت على النهل من معينه المحلي:
ولا جرم أنني صرت أعرف أن هذه العظمة وهذه الهالة من القداسة ليست هي ترجمة ما يملأ العين ويرد البصر، بل لما يملأ الفؤاد من إيمان حدثني الصادق المصدوق عن رصيده الوافر وأنه يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها،
وأن القريب من مرمى بصرك لم يعد هو ما تُدركه اليد وتلمسه الكف، بل هو ما تجنيه الروح وتتدثر به النفس المقبلة على ربها هنالك أيما إقبال…
لقد وجدت نفسي فجأة أغير نظرتي بل أنسف تصورها نسفا، إذ كل المساجد المحلية والوطنية ومعها التركية و المصرية والتونسية من التي كنت أتوهم فيها الضخامة والفخامة وأتخيل نفسي أمشي طويلا بين أروقتها وعلى صرحها أظن فيها الفرادة والتميز والخصوصية، فكلها في مقابل هذا الصرح الإسلامي البديع على صعيد العمران كونا ناهيك عن قداستها شرعا، نعم صارت صغيرة في عيني متصاغرة في تقديري الاستدراكي، في ظل جديد نظرتي وكبير تأثري بعظمة وضخامة هذا الصرح والبنيان والعمران الإسلامي العظيم… يتبع..
حين يخبت القلب وتنيب الخطى… فثمة الروضة الشريفة (ح7)
سمعت الكثير عن ذلك الشعور الوجداني الفريد، وعن ذلك التعلق العميق، وتلك الرغبة الملحة التي يبديها زائر المسجد النبوي الشريف، حين يتعلق أمر زيارته بالروضة الشريفة، فما يفتأ حريصا كل الحرص على ألا يتنازل عن فرصته في أن يصلي على سجادها الأخضر المنمق ركعتين، ثم يدعو متضرعا إلى مولاه وخالقه بما شاء من الأدعية المأثورة أو المرتجلة في عفوية وفطرة ملهمة، ولا غرابة ولا استغراب من هذا الحرص وهذه العروة الوثقى التي جمعت وربطت المريد بالروضة الشريفة فقد ثبت في شأنها من الفضل الخاص والمكانة العظيمة الكثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة.
كلها تؤكد على شرف هذا الموضع المبارك من المسجد النبوي، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إِنَّ مُنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَحُجْرَتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ”.
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَمَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَ بَيْتِ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ”.
وكذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَقَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ”.
وكلها أحاديث صحيحة متضافرة متظافرة، تفسر ما تشهده صفوف الروضة الشريفة اليوم من شدة الإقبال، وطول الانتظار، والتنظيم الدقيق للدخول، حتى بات الزائر يمكث ساعات مترقبا موعده، راجيا أن يوفق لتلك اللحظات القليلة التي يعدها من أعظم بركات رحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعد الفراغ من هذه الزيارة المباركة، يكون الزائر كما كنا على موعد آخر لا يقل شرفا، وهو السلام على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف، ثم السلام على صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، زيارة ومرور يؤدى بسكينة ووقار، وخفض صوت، واتباع للأثر، دون تمسح ولا تقبيل للجدار الحائل، ولا رفع للأصوات بالدعاء، إذ هي زيارة تعبدية منضبطة، قوامها الاتباع لا الابتداع، والسير على هدي السلف لا محدثات الخلف.
وقد كان من بركات المقطع بعد المطلع أن شاء الله لنا في يومنا الأخير من برنامج مقامنا بالمدينة المنورة -وفي عتمة وغلس الفجر – أن يكتب لي ولمن رافقني، ورافقته، حظا موافقا حذو القذة بالقذة، إذ تنبه هو على المعهود إلى جمهرة من المعتمرين كانوا قد فرغوا لتوهم من زيارة الروضة الشريفة، متوجهين بعد ذلك على ترادف محمود لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فتسللت، وإياه، مندسين في ذلك الصف المبارك، فإذا هي كرة قد جاد علينا بها الجواد الكريم سبحانه، أعيدت لنا كرتها، فأتيح فيها إلقاء السلام وإقراؤه على خير البشر، وسيد ولد آدم ولا فخر، وكانت تلك خاتمة العهد بمكثنا في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أزف انصرام ثواني الأيام الخمسة، مؤذنا بشد الرحال إلى مكة المكرمة، حيث كانت تنتظرنا سبعة أيام أخرى، دأبا ونسكا وطوافا وسعيا ومقاما… يتبع..
يا له من رحيل تئن من وداعه نفوس الزائرين (ح8)
هممنا بالرحيل مودِّعين مدينةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، على أمل العود ومأمول تكرار الزيارة؛ وكيف لمودِّعٍ مُحبّ، أيًّا كانت جنسيته، ومهما تعاظمت مظاهر العمران المادي في موطنه الأصلي، ألا يشتاق إلى استطالة المكث، أو يؤمِّل الرجوع كرةً بعد كرة؟
ركبنا الحافلة على مضضٍ، يخفف من وطأته الشوقُ إلى الوجهة المقبلة؛ تلكم مكةُ البكِّ، العامرةُ الظاهرة، المرفوعةُ المنزلة ببيتها العتيق، مهوى القلوب، وعشقَ الأفئدة المنيبة المخبتة لرب هذا البيت، مشرِّفه ورافع قدره منذ أول الخليقة إلى يوم الناس هذا.
ركبنا الحافلة نسمع لأقدامنا على مدرج بوابة ولوجها وقعا شجيا، متأبطين ثوبًا قد برئت ذمته من محدثة المخيط وموضة الفصالة، وكانت وجهتنا القريبة وفق منسك العمرة الوقوف عند ميقاتُ إحرام أهل المدينة، أو ما صار يُطلق عليه «أبيار علي».
وللتسمية قصةٌ مفادها -على غير ما يظنه كثيرون- أن ميقات ذي الحليفة سُمِّي «آبار علي» نسبةً إلى السلطان الصالح علي بن دينار، والي دارفور، الذي قام بحفر الآبار وتجديد المسجد سنة 1898م، تلبيةً لحاجة الحجاج إلى الماء والطعام، لا نسبةً كما يتوهم وتوهمنا لأول وهلة إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أما اسم «ذي الحليفة» الأصلي، فمرده إلى كثرة نبات الحَلْفاء (تصغير الحُلاف) في تلك البقعة، وتلك طبيعة الأسماء تظل قوالب معانٍ، فلطالما أحالت على الأعيان والمنقولات، وذلك ضربها كذلك مع صنعة النحاة فإن الحال بيان لمستبهم هيئة على التحديد والتمييز توضيح لمستبهم ذات على التعيين، والنعت وصف مقيد أو صفة كاشفة وهكذا…
لقد ظننتُ، تحت وطأة إرهاصات الزيارة الأولى، أن ميقاتَ أهل المدينة بعيدٌ عنها، قريبٌ من مكة؛ فما خطر على بالي، ولا تخيلتُ -والحافلة طافقة تسير بسرعةٍ تناسب شوق الراكبين إلى خوض تجربة التدثُّر بذلك الثوب الفاقع البياض، بعد التجرّد من كل لباسٍ يدخل في جنس المخيط- أن منطقة أبيار علي لا تبعد عن المدينة المنورة إلا نحو عشرة كيلومترات، قد تزيد في أقصاها لتبلغ أربعة عشر كيلومترًا بحسب بُعد نقطة الانطلاق من المدينة.
وفعلًا، ما هي إلا دقائق معدودات حتى تراءت لنا جُمَّرةٌ من المُحرِمين، كأنها أسرابُ حمامٍ زاجلٍ شديدِ البياض، تهمّ بالرحيل بعد أن صلّت ركعتين، في لباسها القشيب، ووضعها التعبُّديِّ الحادث… يتبع..
من ثوب العادة إلى دثار العبادة… (ح9)
ترجلنا من الحافلة، فاتجهنا لنتجرد من لباسنا المعهود، في إشارة ضوئية فاقعة الاخضرار، تؤذن بالانتقال من حال إلى حال، ومن وضع إلى آخر، ومن إحساس إلى غيره، ومن شعور إلى نقيضه.
نعم، أخيرا سأدخل تجربة تعبدية لم يسبق لي أن لامست منزلتها، ولا أن خضت غمارها.
فلطالما استشكلت إمكانية التدثر بإحرام عمدته إزار أبيض قطني مشطور إلى نصفين، لا أدري أي منهما الأكبر حجما، دون أن أتلبس حد الخوف بهاجس احتمال سقوط الجزء السفلي، فتبدو السوأة ويتكشف من المحرم ما وجب ستره طبعا وعرفا وشرعا. ثم تبين لي سريعا أن ذلك لم يكن إلا وهما، مرجوح الوقوع.
لا أزال أستحضر ذلك الإحساس، وتلك النشوة الخشوعية التي أخذتني هذه الطلعة الجديدة بعزتها محلقة بهامتي إلى حيث بيت الله العتيق، حتى تمنيت لو أن ثمّة مرآة موجودة في المحيط، فأهرول إليها مسرعا، أقف أمامها وأُرسل بصري في هيأتي القشيبة وطلعتي الجديدة، مستلذا غرابتها ومهابتها.
لم يطل المقام على هذه الحال، إذ توجهنا لنصلي ركعتي سنة الوضوء، إذ لا صلاة خاصة للإحرام بذاتها، ثم صلينا العصر عقب رفع الأذان مباشرة، بعد ذلك عقدنا نية العمرة، وتلفظنا بها بيانا للنسك: “لبيك اللهم عمرة”، وعطفنا -خشية طروء مانع- قولنا: “فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني”.
ثم شرعنا من فورنا في الصدع بالتلبية: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”، وهي العبارة التي لازمتنا تردادا وتجديدا طيلة مسافة السفر الموجب للقصر والجمع، باستئناف محمود وأنفاس طيبة مباركة متصلة اللهج.
صعدنا الحافلة، فتحركت عجلاتها تحت وقع ذلك الصوت الجماعي الذكوري الجهوري، الملحون الكلمات، الشجي النبرة، متوجهين إلى مكة البك المكرمة… فبسم الله مجراها ومرساها.