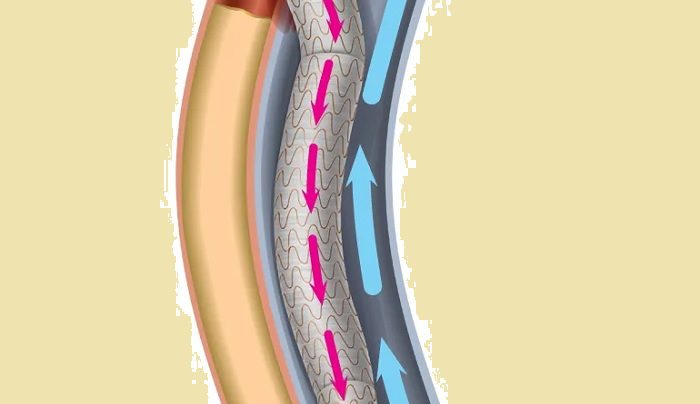الجنس مقابل المعنى

هوية بريس – إبراهيم أقنسوس
ما علاقة الاشتغال بالمعرفة والتدريس، باستدراج الطالبات، واستغلال ضعفهن وحاجتهن، للنيل من أعراضهن، والعبث بشرفهن؟؟، سؤال بدهي، يتبادر إلى الذهن سريعا، بعد توالي الحكايات، حول ما أصبح يسمى عندنا، (الجنس مقابل النقط)، هل يمكن أن يرتد أستاذ، في مستوى جامعي، إلى كل هذا الحضيض؟؟، ماذا يتبقى من الأستاذ، أو من هذا الأستاذ، حين يحول علاقته بطالباته، إلى مشاريع لتفريغ مكبوتاته الغريزية.
الجنس مقابل النقطة، عنوان آخر، يحكي فداحة التراجع الذي أصاب منظومتنا التربوية، إذ كيف يمكن تصور أستاذ جامعي، يفترض بداهة أنه يمتلك عقلا باحثا، لا يهمه من أمر الجامعة وحرمها، إلا رغباته الجنسية المريضة، وكيف يصرفها؟؟.
بكل تأكيد، وبلا مقدمات كثيرة، هذا المخلوق المسمى أستاذا، لا علاقة حقيقية، له بالمعرفة، بالمعنى العميق والمسؤول للكلمة، ولم يتذوق معنى البحث العلمي، ولم يفهم معنى الحياة من أجل إنتاج الأفكار، وتوليد الأسئلة، وصياغة البدائل والمشاريع، التي ترقى بالإنسان وتساهم في تقدمه.
ينتظر من كل أستاذ، ومن الأستاذ الجامعي بخاصة، أن يكون صاحب مشروع علمي، يحيى به ومعه، طيلة مكوثه على هذه الأرض، وفي كل مرة، يعرض أمام الرأي العام العلمي والثقافي، ما جد لديه من أسئلة وأجوبة، تخص مجال بحثه واختصاصه، وقد تتعدد اهتماماته وتتنوع، كما تتعدد أنشطته العلمية وتختلف، وكلها في النهاية، تصب في خدمة منظوره العام، ومشروعه الثقافي الذي يريد المساهمة به، بما هو أستاذ باحث بداهة، ويغلب أن يستغرق هذا المسار العلمي كل حياته، وربما غادر هذه الدنيا، دون أن يتمكن من إتمام ما كان يصبو إليه، وهذا ديدن الكثير من أساتذتنا الكبار، ومفكرينا العمالقة، عشاق المعرفة، ومحترفي السؤال، هؤلاء الذين نفتخر بالتتلمذ عليهم، ونعتزفي كل مرة، بلقائهم والإستماع إليهم، باختلاف مشاربهم وتخصصاتهم.
فما الذي حدث حتى انتهينا إلى كل هذا التردي البئيس؟ فأصبحنا نتحدث عن النقط مقابل الجنس، وعن التجارة بالشواهد (الماستر)، وعن الوساطات في الحصول عليها.
بالطبع، لكل نتيجة مقدمات، ومقايضة المعرفة بالغريزة، تعني الاستخفاف بالعلم، وتحويل الدرس، إلى تجارة خسيسة، مذرة للمال وللجنس ولكل رغبة أنانية، وشهوة مريضة، بصرف النظر عن كل الأخلاق والأعراف والمواضعات التي يفترضها طقس المعرفة ابتداء، ما يعني الغياب الكلي لمعنى الدرس والتحصيل، وضياع مؤسف لحرمة المعرفة، والسؤال الشقي الذي يبدو ملحا هاهنا هو، ألم نكن ننتظر مثل هذه الخرجات والحكايات، ونحن نمضي في تبخيس المعرفة، ونصر على تحويلها إلى أرصدة مالية، وعقارات وأسفار، وامتيازات مادية وولائم وما إليها؟؟
لكل نتيجة مقدمات، فالكثير من المشتغلين بالتدريس، لم يعد يهمهم من أمره إلا ما يتقاضونه من أجر، عند نهاية الشهر، والكثير من التلاميذ والطلبة، لا يهمهم من أمر المعرفة إلا النقط والشواهد، بغض النظر عن قيمتها وحقيقتها، فالشهادة تعني العمل، والعمل يعني المال، وهنا تنتهي كل الحكاية والسلام.
أليست هذه هي النتيجة التي كنا ننتظرها، وربما أيضا منا من يريدها، بعد كل الإخفاقات التي توالت على منظومتنا التربوية؟؟، ولم نتمكن، وأيضا، لا نريد أن نتمكن، من تصحيحها؟؟
حين تتراجع القيم، بتراجع حاضناتها الأساس، (الأسرة، المسجد، المدرسة، الجامعة، مؤسسات المجتمع المدني، المعنية بالتأطير الفكري والتربوي، الشارع…)، وحين تتحول المعرفة إلى مجرد مشاريع اقتصادية، مذرة للمال والجاه والسلطة، وحين تتراجع قيمة العلم، ولا يتم الاحتفال بالمعرفة الجادة، بقواعدها وأصولها، وأخلاقها وأسئلتها وغاياتها، التي تعني النهوض بعقل الإنسان، وإعادة صياغته، ودفعه إلى طلب التغيير والتقدم إلى الأمام، والانخراط في عالم اليوم اقتدارا واستحقاقا.
حين يحدث مثل هذا، يكون علينا أن ننتظر حكايات أخرى، ومآسي أخرى لا تنتهي. فالجنس مقابل النقطة، يعني في النهاية، الجنس مقابل المعنى.