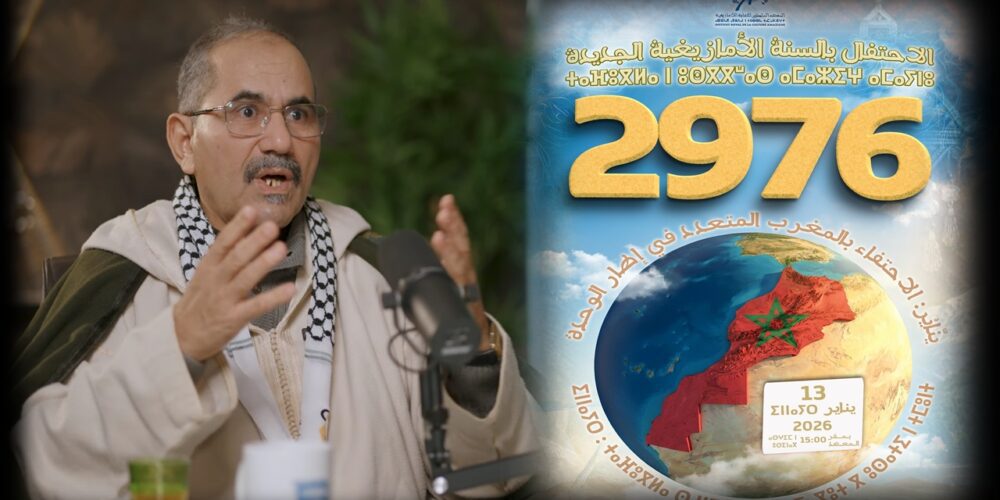الحداثة بعيون مغربية

الحداثة بعيون مغربية
هوية بريس – محمد كرم
في صيف إحدى السنوات الخوالي تلقينا دعوة كريمة من معارف سطحيين و من محدثي النعمة لحضور حفل زفاف ابنهم البكر، إلا أن الأسلوب المعتمد في تحرير متن بطاقة الدعوة كان سببا كافيا للاعتذار عن الانضمام إلى المدعوين و لتوفير ثمن الهدية. فقد ألح والدا العريس على إلصاق لقبي “دكتور” و “دكتورة” بإسمي العروسين، كما أكدا على ضرورة الإدلاء بما يثبت الدعوة قبل ولوج فضاء الحفل تحت طائلة الطرد مع وجوب التقيد بعدد المدعوين المبين على البطاقة.
و على امتداد ثلاث سنوات كاملة دأبت ابنتي الصغرى على استقبال إحدى رفيقاتها بمعدل مرتين في الأسبوع تقريبا من أجل التعاون على إنجاز فروضهما المدرسية المشتركة. و طوال هذه المدة اعتادت أم الضيفة الصغيرة على نقل فلذة كبدها إلى مقر إقامتنا الكائن بحي شعبي باستعمال سيارتها الرباعية الدفع الفارهة ثم الاختفاء بالتوجه إلى وجهة مجهولة. و بمجرد انتهاء حصة التعاون (الذي كان في الغالب في اتجاه واحد) كان من الطبيعي أن تعود الوالدة لاصطحاب ابنتها مع حثها على الإسراع حتى لا تتأخر عن درس البيانو أو موعد حصة الفروسية المبرمجة لنفس اليوم… دون أن تتواضع و لو مرة واحدة و تقبل بولوج بيتنا أو تحاول التقرب من زوجتي و لو بتوجيه تحية خفيفة لها عن بعد !!! لقد كان الهدف من ترددها على حينا و التوقف عند عتبة منزلنا واضحا منذ البداية.
و بعد معاناة طويلة مع “التخلف” تحسن وضعنا المادي فمن الله علينا بمسكن جديد بحي يدخل في خانة أحياء الطبقة المتوسطة الوسطى ـ إذا جاز التعبير ـ و غادرنا الحي الشعبي الذي احتضننا لسنين طويلة و ودعنا بالدموع جيراننا “المتخلفين” و “الجاهلين” و “الرجعيين” و “الأميين” و “أشباه الأميين” و طوينا صفحة و فتحنا أخرى بدخولنا بيئة نظيفة و عالما متحضرا و مجتمعا راقيا.
و كان من الطبيعي أن أعمل على الاندماج بوسطي الجديد، و كان من الطبيعي أيضا أن تشكل التحية جسري الأول إلى قلوب من وضعتني الأقدار بمحيطهم المباشر. للأسف، لم يكن من السهل إقامة تواصل حقيقي لا مع الجار المتواجد بالجهة اليمنى الآسيوي و لا مع الجارة المقيمة بالجهة اليسرى الأوروبية. فالأول لا يجيد التحدث بغير لغته في حين أن الثانية لا تظهر إلا نادرا و غالبا ما يقع بصري على ظهرها فقط عندما تكون بصدد فتح باب بيتها أو إغلاقه. أما الجار ابن البلد القاطن على الجانب الآخر من الزقاق فمنذ أن علم باستقراري بالمنزل المقابل لمنزله و هو يصر على تجاهلي و يبذل كل ما في وسعه حتى لا تلتقي عيناه بعيني، بل إنه يتعمد أحيانا ركن سيارته في وضع يعفيه من مجرد النظر إلى بابي و نوافذي. و كان من الممكن أن تكون الصدمة بوقع محدود نسبيا لو لم أكتشف فيما بعد بأن صاحبنا ليس استثناء، إذ أن معظم سكان الحي يتصرفون على شاكلته حيث قرروا بما يشبه الإجماع إقامة متاريس غير قابلة للاختراق فيما بينهم و اعتبار بعضهم البعض مجرد جدران إضافية تزيد في تكريس الفصل بين الوحدات السكنية محولين ما يعتبرونه احتراما إلى تجاهل متبادل و دائم.
و من نافلة القول أن جيرانا من هذه الطينة قد لا يهمهم حتى التعرف على إسمي على الأقل فأحرى عيادتي في حال اختلال صحتي أو الوقوف إلى جانبي في حال وقوعي في أزمة من نوع آخر. جيران كهؤلاء لن يعترفوا بوجودي إلا كزبون بمكاتبهم أو عياداتهم أو متاجرهم، و حتى إذا ما ابتسم لي الحظ في ما يستقبل من الأيام و قرروا أن يشملوني بعطفهم بدعوتي إلى عرس أو مأثم فسيكون ذلك في الغالب لضرورة “ديكورية” (كما هو الشأن بالنسبة لحفل زفاف الدكتور و الدكتورة) أو لأهداف محسوبة النتائج.
و بناء على ما سبق، لم أستغرب إطلاقا عندما أسر لي حارس الزقاق الليلي بأن أحد سكان الجوار لبى نداء ربه قبل وضعي لعصا الترحال بالحي بأشهر قليلة و لم تجد أسرته الصغيرة من يسير و راء جنازته غير أفراد معدودين من أسرته الكبيرة وفدوا من مدن أخرى. و أغلب الظن ـ و الله أعلم ـ أن المرحوم لم يكن قيد حياته يختلف عن جيرانه في مقاربته للعلاقات الإنسانية فغادر دنياه في صمت مخجل و مهين.
هذا هو مجتمع كوادر و متعلمي و أغنياء اليوم. مجتمع مجرد من كل حس إنساني. مجتمع شعاره هو “التيقار” السلبي و دينه هو الفردانية الهدامة و مذهبه هو الأنانية المقيتة و ملجأه و قت الشدة هو المؤسسات المالية حيث الاقتطاع من المنبع يغنيك عن التقرب من الناس و التودد إليهم و طلب مساعدتهم.
لقد بات بإمكان الكثير منا الإقامة بأفخم المساكن و ارتداء أجمل الملابس و تناول أشهى المأكولات و امتطاء أكثر وسائل النقل توفيرا للراحة و استخدام أكثر الآلات تطورا و الدراسة بأحسن الجامعات و نيل أعلى الشهادات و الحصول على أسمى الوظائف … لكننا فشلنا فشلا ذريعا في الاحتفاظ بأصالة علاقاتنا الإنسانية ، بل إننا أفرغنا هذه العلاقات من محتواها على نحو رهيب، و عوض أن نرتقي بقيم النبل و الشهامة و الأريحية الموروثة فقد فضلنا تعبئة معاولنا و انبرىنا بشكل جماعي إلى وأد ما تبقى من أصالة الأجداد مبشرين بحداثة واضحة في أبعادها العلمية و التكنولوجية و العمرانية لكنها جد مبهمة في أبعادها الإنسانية و الاجتماعية و الحضارية. و حتى عندما نفطن إلى تيهنا فإننا غالبا ما نعلقه على مشجب العولمة علما بأن هذه الظاهرة بريئة من معظم ما نقترفه من فظائع في حق أنفسنا و حضارتنا و إنسيتنا.
ثلاثة أشهر من الإقامة بالحي الجديد إذن كانت كافية لتجعلني أقتنع بأن الفقراء و البسطاء و الأميين هم أحسن فهما للحياة من جيراني الجدد المتنورين و المترفين. لهذا السبب فإني أعود من وقت لآخر إلى حيي القديم لمعانقة الخباز و الإسكافي و الدراجي و الحداد و النجار و لإحياء صلة الرحم مع الجهل و التخلف و الفقر و الهشاشة، وهذه كلها مواصفات اتضح لي بأنها أكثر انسجاما مع ذاتنا و عقليتنا من علم اليوم و من المفهوم الحديث للرقي و التحضر.
و قد تزامنت هذه الاستنتاجات مع بث إحدى القنوات التلفزيونية لشريط وثائقي حول تجربة فريدة من نوعها عرفتها إحدى مدن أمريكا الشمالية. فقد قرر سكان إحدى العمارات التخلي عن فردانيتهم و انزوائهم فحولوا الحديقة الخلفية للبناية إلى فضاء للالتقاء اليومي و وزعوا المهام فيما بينهم في جو من المودة و التضامن و ذلك بعدما اقتنعوا بأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه خلق ليعيش و يتفاعل مع غيره و بأن أسلوب الحياة المعاصر القائم على أساس التباعد الاجتماعي هو السبب الأول في تفشي معظم الأمراض الاجتماعية و النفسية بمجتمعهم.
و لحداثة المغاربة أوجه أخرى يتقاسمونها مع الكثير من المجتمعات العالمية.
فالحداثة هي أيضا خفض حجم الاختلاط بالأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أبنائهم إلى أدنى مستوى ممكن، بل هناك من يبذل قصارى الجهود حتى يتوقف التفاعل مع هؤلاء عند “جمعة مباركة” إلكترونية أو “كل عام و أنتم بخير” إلكترونية أيضا إذا سمحت حالته المزاجية بذلك.
الحداثة هي أن تكتفي بالتعرف على جزء من أصهارك في ليلة زفافك دون أن تكون لديك نية البحث عنهم أو تكون لديهم نية البحث عنك في ما تبقى من سنوات المصاهرة.
الحداثة هي الامتناع عن فتح باب بيتك في وجه كل من لا يتوفر على موعد مسبق.
الحداثة هي تجهيز “بيت الضياف” بأرقى ما تستطيع ميزانية العائلة اقتناءه من أثاث ليظل مغلقا على مدار السنة. (للمزيد من الإضاءات أدعوك، عزيزي القارئ، إلى مراجعة مقال “صالونات خارج الخدمة” الحامل لتوقيعي أيضا.)
الحداثة هي أن تستقبل من حين لآخر أحبابك و أصدقاءك القادمين من مدن أو بلدان أخرى مع إفهامهم بما أوتيت من لباقة بأن المبيت يكون بالفندق.
الحداثة هي أن تظل منفصلا طوال اليوم عن العالم بتعليق كابلات بأذنيك أو بتثبيت سماعات متطورة بدون كابلات.
الحداثة هي أن تتحول الحياة في عينيك إلى قطعة من جهنم في حال ضياع محمولك أو تركه بالبيت سهوا أو في حال تعطل أداة من أدوات التحكم عن بعد.
الحداثة هي أن تنشر صورك في كل الأوضاع الممكنة و تنتظر هطول “اللايكات” لإشباع نرجسيتك المثيرة للشفقة.
الحداثة هي أن تلغي وظائف يديك و رجليك و حواسك و عوض أن تستجمع قواك و تتوجه إلى سوق حيك أو إلى دكان البقالة الأقرب إلى بيتك فإنك تفضل استخدام أزرار محمولك حتى تصلك مشترياتك عن طريق عامل توصيل حتى و لو تعلق الأمر بقنينة ماء معدني واحدة لا غير.
الحداثة (دون وجود أية نية في التعميم طبعا) هي أن تحضر رسالة دكتوراه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي و تناقشها بحضور “طريطور” مع توثيق الحدث بتجنيد فريق من المصورين لهم كامل الاستعداد لالتقاط مئات الصور لكل كبيرة و صغيرة (بما في ذلك جوارب أعضاء لجنة المناقشة) في زمن غابت فيه هيبة العلم و عناء التحصيل العلمي و حضر فيه التدليس و فقاعات الشكليات.
الحداثة هي أن تردد على مسامع بناتك صباح مساء و دون كلل أو ملل بأن الوظيفة هي أهم ما في الوجود بالنسبة للمرأة و ليس الزواج و تأسيس أسرة مع ما يرافقهما من قهر و شقاء.
الحداثة هي …
الحداثة هي …
الحداثة هي أن يقول لك صديقك أو جارك بأن زوجتك جميلة فترد عليه أنت ب “ميرسي بوكو”.
و كما تلاحظ، عزيزي القارئ، ليس بهذا المقال ما يوحي بأني أنوي تجييش الشعوب في أفق النزول إلى الشوارع و رفع لافتات و ترديد شعارات و أناشيد شديدة اللهجة تنديدا بما يعرفه العالم من تطورات على مستوى التفكير و السلوك البشريين. ما أنا سوى شاهد على العصر و متفرج قابع بمقعد خلفي بمسرح متخصص في عروض التراجيكوميديا. و على الرغم من استهزائي المتكرر مما هو حاصل فإني مقتنع تماما بأن التطور مهما كانت طبيعته سنة ثابتة من سنن الحياة و بأن العودة إلى النظام الاجتماعي السابق و السلوكات السابقة أمر مستبعد خاصة و أن المنظومة القيمية الحالية تشكل القاعدة بالنسبة لتفكير أفراد جيل اليوم بحكم أنهم لم يخبروا غيرها، و بالتالي فهم في وضع لا يؤهلهم للمقارنة بين خصائص الأمس و ما يعتبره أفراد جيلي عجائب الحاضر.