الزواج من منظور الأدب الرّافعي.. «وحي القلم» نموذجا

ذة. لطيفة أسير
هوية بريس – السبت 02 يناير 2015
شراسة الحياة تزداد كل حين، وخوض غمارها أضحى مغامرة غير مأمونة العواقب، تشعر وكأن البشرية تجرّدت من كل إنسانيتها، وباتت تصارع ذاتها لتصرعها، كنا بالأمس نتحدث عن صراع الحضارات، فبتنا اليوم نتحدث عن الصراع بين الجنسين: أيهما أقوى، وأيهما أجدر بالقيادة، ومن ظلم الآخر وجرّده من حقوقه، ومن تناسى خصوصياته وسطا على خصوصيات الآخر.. الخلافات الزوجية المتكررة، والمشاكل الأسرية التي تتناسل كل يوم بشكل رهيب، تجعل المرء يتوجّس خيفة من الزواج ويؤْثر الانزواء في عالمه بعيدًا عن أي منغصّات من طرفٍ آخر غير مسؤول..
عفوا أخي القارئ..
ما لهذا أتيتُ!! وما دار بخلدي أن أهدر دقائقك الثمينة بحديث قد ألِفته حتى ضاق صدرك به. بل أحببتُ أن تشاطرني متعة سحرٍ تتوق أنفسنا المرهقة لمعانقته، سحر سطّر حروفه ساحر البيان الرافعي في تحفته «وحي القلم»، سحر يحلق بك في عالم إنساني إسلامي رائع، يجعلك تتوق للانخراط في الحياة الزوجية دون توجّس.. فما أمتع أن يحيا المرء إنسانيته متجردا من كل المطامع الدنيوية مستشعرا كل القيم التربوية التي توج الله بها هامته لترقى عن البهيمية التي لا تليق به كخليفة لله في أرضه.
تعال معي أخي القارئ كي نحلّق سويا في سماء الرافعي التي نسجت هذا العالم البديع من واقع كان بالأمس ملموسا وغدا اليوم حلما لا نفتأ نرنو إليه دون جدوى.
فرحة العمر عند الفتاة أو الفتى حين تلتفّ الروح بالروح، ويعانق القلبُ القلبَ تحت ظل ميثاق غليظٍ يُعطي العهد بالأمان ويجعل المرءَ يعيش تلك اللحظات بمشاعر تتخطّى حدود الزمن وتسمو في علياء الفرح مردّدة أنّ مثل هذا اليوم ( لا يكون من أربع وعشرين ساعة، بل من أربعة وعشرين فرحا، لأنه من الأيام، التي تجعل الوقت يتقدم في القلب، لا في الزمن، ويكون بالعواطف لا بالساعات، ويتواتر على النفس بجديدها، لا بقديمها)(1).
ولأنه فرحة العمر، كان لزاما على من ينخرط في سلكه أن يحسن التدبير، ويؤسس لهذا البناء الجديد على بصيرة وهدى من دين الله تعالى، وحسن التدبير ليس مالا فحسب، لأن الكيان الأسري كيان بشري قوامه روح وعقل تآلفا وامتزجا فــ(المرأة للرجل نفس لنفس، لا متاع لشاريه) وربنا سبحانه قال في محكم كتابه: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) (الأعراف:189)، فالمرأة تبحث في الرجل عن كيان يحتويها عاطفيا وعقليا وماديا، والرجل يهفو لروح يسكن إليها وينصهر في بحر ودادها ويلمّ بها شعت نفسه المبعثرة، فالمرأة (زوجة حين تجده هو لا حين تجد ماله، وهي زوجة حين تتمّمه لا حين تنقصه، وحين تلائمه لا حين تختلف عليه)(2).
ولهذا حين تقرأ بعض فصول «وحي القلم» تأخذك الرهبة وأنت تقف مع تلك المواقف التي تجسد الإنسانية الحقّة بكل معانيها، مواقف للسلف الصالح يروي فصولها الرافعي بأسلوب ماتع تخرّ له الذائقة ساجدة، تتجسّد أمام ناظريك تلك الأنوثة الزاخرة بالحنان والمودة والعطاء وإنْ في أضيق الظروف، وتلك الرجولة الحانية التي تحدب على الأنثى وترتقي بها إلى أعلى مقام.
أنظر -رعاك الله- إلى التابعي الجليل سعيد بن المسيب حين جاءه رسول عبد الملك بن مروان معْربًا عن رغبة أمير المؤمنين في مصاهرته، لكنه أبَى أن يستجيب لهذا الإغراء وقال: (أمَا إني مسؤول عن ابنتي، فما رغبتُ عن صاحبك إلا لأني مسؤول عن ابنتي، وقد علمتَ أنت: أن الله يسألني عنها في يوم لعلّ أمير المؤمنين، وابن أمير المؤمنين، وألفافهما لا يكونون فيه إلا وراء عبيدها)(3). ألا يجعلك هذا الموقف تتحسّر على حال البنت اليوم وقد غدت مشروعا استثماريا بين يدي والديها، تُزف لمن يحسن الدفع دون أن يُخشى عليه المنع؟!
ولئن كان المهر اليوم من أهم أسباب تعسير الزواج، فإن السلف الصالح تعامل مع هذا الجانب تعاملا شرعيا أنيقا نجا به من مشكل العنوسة، وجعل الشباب يقبل على الزواج وإنْ بأيسر المتاع. وقد أسهب الرافعي في الحديث عن المهر لحظة عرضه لقصة تزويج سعيد بن المسيب لابنته بطالب علم فقير هو عبد الله بن وداعة حيث كان مهرها ثلاثة دراهم، وهو الذي رفض تزويجها بولي عهد أمير المؤمنين بمهر يعدل وزنها ذهبا لو شاءت. وما هذا إلا لأن التابعي الجليل قدّر في الزواج أنه سنة الأنبياء التي تُعمر بها الأرض بالنسل الشريف الصالح، وليس منفعة مادية يُرجى منها تكثير الدرهم والدينار، بل إن المغالاة في المهر يعتبرها سعيد بن المسيب نوعا من التدليس فيقول: (يوشك أن يكون المهر الغالي كالتدليس على الناس، وعلى المرأة، كي لا تعلم، ولا يعلم الناس، أنه ثمن خيبتها، فلو عقلت المرأة لباهت النساء بيسر مهرمها، فإنها بذلك تكون قد تركت عقلها يعمل عمله، وكفت حماقتها أن تُفسد عليه)(4).
وبما أنّ الزواج الحقّ هو اقتران روحين وعقلين، فلِم الاستهانة بكرامة المرأة وجعل قدرها في قيمة مهرها، هي ليست متاعا كي تُقوّم، بل إنسانة تبحث عن ذات تفهمها وتستوعب ضعفها وتحتويه برفق ولين، لذا فمهرها الحقيقي ليس الذي تحصل عليه قبل أن تُحمل لبيت زوجها (ولكنه الذي تجده منه بعد أن تحمل إلى داره، مهرها معاملتُها، تأخذ منه يوما فيوما، فلا تزال بذلك عروسا عند نفْس رجُلِها ما دامت في معاشرته. أما الصداق من الذهب والفضة، فهو صداق العروس الداخلة على الجسم لا على النفس)(5).
فأيّ سمو اكتنف روحك يا ابن المسيّب وأي لبّ جمّل منطقك!!
المرأة في ديننا ليست دمية للهو والعبث، ولا أداة جامدة لتفريخ النسل، بل إن المرأة لا تبلغ كمال إنسانيتها إلا حين تقترن أنوثتها بذهن حصيف وخلق شريف، لهذا حين تطمح في الاقتران برجل كفء لها، إنما تبحث عن إنسان يقدّر إنسانيتها وعقلها قبل شكلها ومظهرها، فيكون مهرها المادي رمزيا لاستكمال النكاح الشرعي، لأن نفسها الأبية تأنف أن تجعل قيمتها في دريهمات. من هذا المنطلق كان فقه سعيد بن المسيب لزواج ابنته بشاب فقير وليس بابن أمير المؤمنين، فكانت كلماته رسالة صادحة لكل حرّة أبية أنّ (خير النساء من كانت على جمال وجهها، في أخلاق كجمال وجهها، وكان عقلها جمالا ثالثا: فهذه إن أصابت الرجل الكفء، يسّرت عليه، ثم يسرت، ثم يسرت، إذ تعتبر نفسها إنسانا يريد إنسانا، لا متاعا يطلب شاريا، وهذه لا يكون برخص القيمة في مهرها إلا دليلا على ارتفاع القيمة في عقلها ودينها، أما الحمقاء فجمالها يأبى إلا مضاعفة ثمنها لحسنها، أي: لحمقها، وهي بهذا المعنى من شرار النساء، وليست من خيارهن)(6).
فالأب الجيد هو من يبحث لابنته عن رجل يكون أمينا عليها في دينها قبل دنياها، رجل يكون عكازتها في سيرها إلى الله، وتكون عصاه التي يتوكأ عليها للصمود أمام فتن الحياة وطوارقها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه” (فقد اشترط الدين، على أن يكون مرضيّا، لا أي الدين كان، ثم اشترط الأمانة، وهي مظهر الدين كله بجميع حسناته، وأيسرُها أن يكون الرجل للمرأة أمينا، وعلى حقوقها أمينا، وفي معاملتها أمينا، فلا يبخسُها، ولا يُعنتُها، ولا يُسيءُ إليها، لأن كل ذلك تلْمٌ في أمانته)(7).
ولأن سعيد بن المسيب كان أبًا جيدا فقد ردّ على أولئك الذين استعظموا رفضه لابن أمير المؤمنين وقبوله بطالبٍ فقير قائلا: (أما إني -علم الله- ما زوّجتُ ابنتي رجلا أعرفه فقيرا، أو غنيا، بل رجلا أعرفه بطلا من أبطال الحياة، يملك أقوى أسلحته من الدين والفضيلة، وقد أيقنتُ حين زوّجتها منه أنها ستعرف بفضيلة نفسها فضيلة نفسه، فيتجانس الطبعُ والطبع، ولا مَهْنأ لرجلٍ وامرأة إلا أن يجانس طبعُه طبعَها، وقد علمتَ، وعلم الناس: أن ليس في مال الدنيا ما يشتري هذه المجانسة، وأنها لا تكون إلا هدية قلب لقلب يأتلفان ويتحابّان)(8).
فأجملْ بأبٍ ترتقي معه الأبوة إلى أسمى مراتبها!!
فسمو المرأة بسمو خلقها ودينها وعقلها، ولو فقه الآباء هذا الأمر لحرصوا على غرس بذور الفضيلة فيهن منذ الصغر، حتى تكون الثمرة كتلك التي كان مهرها ثلاثة دراهم، يقول عنها عبد الله بن وداعة : (ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس، وأحفظهم لكتاب الله، وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق الزوج، لقد كانت المسألة المعضِلة تعيي الفقهاء، فأسألها، فأجد عندها منها علما)(9).
ولأن هذا الفرع من تلك الشجرة المثمرة، فلا تعجب إنْ رأيت هذ التابعي الجليل يأتي بما بات عندنا ضربا من الأحلام، فمن دوحة النبوة تفرع ذاك الفهم الثاقب وتلك الروح السامقة، ومن نبعها تشرّبت نفسه عزّة الدين ومتانته حتى غدت الدنيا متاعا لا يُأبه به. فقد رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: (روينا أنّ عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المغالاة في الصّداق، ويقول: “ما تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زوّج بناته بأكثر من أربعمائة درهم” ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة، لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم!)(10)، بل إنه رضي الله عنه عايش ظروف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد شظف العيش الذي كنّ فيه، ورغم ذلك لم تُسمع لهنّ أناة، لِيَقِينهن أن الآخرة خير وأبقى، وماذا تبغي من كانت للرسول صلى الله عليه وسلم زوجة ورفيقة: حازت خير الدنيا والآخرة، وما سَقَط المتاع إلا زينة سرعان ما تبلى!! يقول بن المسيب -رحمه الله-: (وأنا فقد دخلت على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتهن في دُورهنّ يُقاسين الحياة، ويعانين من الرزق ما شحّ درُّه، فلا يجيء إلا كالقطرة بعد القطرة، وهنّ على ذلك، ما واحدة منهن إلا هي ملكة من ملكات الآدمية كلها)(11). ويقول في موضع آخر: (رأيتُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيرات مقتورا عليهن الرزق، غير أن كُلاّ منهن تعيش بمعاني قلبها المؤمن القوي، في دار صغيرة فرَشتها الأرض.. ولكنها من معاني ذلك القلب كأنها سماء صغيرة مختبئة بين أربعة جدران)(12).
ولهذا فالمرأة المؤمنة حين تُرزق بالرجل المتدين الخلوق يصبح من فروض العبادة لديها أن تتزين بالصبر وتتحلى بالقناعة وتجعل قدوتها وأسوتها نساء الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي عشن في الدنيا على الكفاف والقناعة رضا بقدر الله ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقين على مرّ التاريخ الأسوة والقدوة وبقيت أنوثتهن في ارتقاء دائم، بل إن: (أنوثتهن أبدا صاعدة متسامية فوق موضعها بهذه القناعة، وبهذه التقوى، ولا تزال متسامية صاعدة)(13).
وعلى الرجل أن يكون لبِيبًا فطِنًا في تعامله مع هذا الكائن الضعيف الذي يتنزه عن الإقرار بضعفه إلا بين يدي قوة خارقة تقتحم ساحة قلبه فتحتويه الاحتواء كله ( المرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبها، وهي على ذلك تأبى أن تكون ضعيفة أو تقرّ بالضعف، إلا إذا وجدت رجُلها الكامل، رجلها الذي يكون معها بقوته، وعقله، وفتنته لها، وحبّه إياها)(14).
واعلم أيها الرجل أن (المرأة لا تكون امرأة حتى تطلب في الرجل أشياء: منها أن تحبّه بأسباب كثيرة من أسباب الحب، ومنها أن تخافه بأسباب يسيرة من أسباب الخوف، فإذا هي أحبته الحبّ كله، ولم تخف منه شيئا، وطال سكونه وسكونها، نفرت طبيعتُها نفرةً كأنها تُنخّيه وتذمرهُ، ليكون معها رجلا، فيُخيفها الخوف الذي تستكمل به لذّة الحبّ، إذ كان ضعفها يحب فيما يحبه من الرجل أن يقسُوَ عليه الرجل في الوقت بعد الوقت، لا ليؤذيه، ولكن ليُخضعه، والآمر الذي لا يُخاف إذا عُصي، هو الذي لا يُعبأ به إذا أطيع أمره)(15).
فمتى كان هذا الوعي الإنساني أولا والديني ثانيا، من الأهل بدءًا ثم من الزوجين، فإن الأسرة المسلمة ستحيا في جو من الألفة والمودة التي امتدحها الله تعالى في كتابه العزيز وجعلها من آياته الكونية ودلائل عظمته سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21] وستخِفّ وطأة هذه الصراعات بين الزوجين، ويتزوّد كل منهما بما يعينه على تحمّل تبعات مسؤوليته حتى يلقى الله تعالى وقد أعدّ الجواب لسؤاله عما استرعاه الحق سبحانه، يقول الرافعي:(متى كان الدين بين كل زوج وزوجة، فمهما اختلفا وتدابرا، وتعقدت نفساهما، فإن كل عقدة لا تجيء إلا ومعها طريقة حلها، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهو اليسر، والمساهلة، والرحمة، والمغفرة، ولين القلب، وخشية الله، وهو العهد، والوفاء، والكرم، والمؤاخاة، والانسانية، وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق كل ما تكون به منحطة أو ضيقة)(16).
إنّ بيوتا تُؤسس لَبِناتها على الحبّ والدين بيوت عامرة بأهلها، على أكتافها تُبنى الأمة، ومن رحِمها تُنجَب الذرية الصالحة التي تحمل همّ إصلاح ذواتها ومجتمعها.. ومن رياضها يفوح عبق الوفاء الذي روى أبو خالد الأحول الزّاهد أحد فصوله حين قال: (لمّا ماتت امرأة شيخنا أبي ربيعة الفقيه الصُّوفي، ذهبتُ مع جماعة من النّاس، فشهدنا أمرَها، فلمّا فرغوا من دفنها، وسُوِّيَ عليها، قام شيخنا على قبرها، وقال:
يرحمك الله يا فلانة! الآن قد شفيتِ أنت، ومرضتُ أنا، وعوفِيتِ، وابتليتُ، وتركتني ذاكرًا، وذهبتِ ناسية، وكان للدنيا بكِ معنى، فستكون بعدك بلا معنى، وكانت حياتك لي نصف القوة، فعاد موتكِ لي نصف الضَّعف، وكنتُ أرى الهموم بمواساتك همومًا في صورها المخفّفة، فستأتيني بعد اليوم في صورها المضاعفة، وكان وجودكِ معي حجابا بيني وبين مشقّات كثيرة، فستخلُص كل هذه المشاقّ إلى نفسي، وكانت الأيام تمرُّ أكثر ما تمرّ في رقتك، وحنانك، فستأتيني أكثر ما تأتي متجرِّدة في قسوتها، وغلظتها! أما إنّي -والله!- لم أُرْزأ منك في امرأة كالنساء، ولكنّي رُزِئتُ في المخلوقة الكريمة، التي أحسستُ معها أنّ الخليقة كانت تتلطّف بي من أجلها!)(17).
فيا من أضحى الزواج بين أيديكم متعة سرعان ما تنقضي، وديكورا اجتماعيا يؤثث حياتكم الشخصية، عيشوا إنسانيتكم قبل الزواج ولقّنوا تلك الأمّارة بالسوء فنون الأدب والمعاشرة الطيبة، ارتقوا بتفكيرهم ولا تجعلوا إشباع شهواتكم غاية أملكم، تعلموا فقه الزواج من السلف الصالح قبل أن تخوضوا غماره، واجعلوا معايير انتقائكم قائمة على سلامة الدين واستقامة الخلق عسى تستقيم حال أمتنا!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) «وحي القلم» ص.60.
(2) «وحي القلم» ص 140.
(3) «وحي القلم» ص 137.
(4) «وحي القلم» ص 140.
(5) «وحي القلم» ص.139.
(6) «وحي القلم» ص 139.
(7) «وحي القلم» ص.140.
(8) «وحي القلم» ص 154.
(9) «وحي القلم» ص 145.
(10) «وحي القلم» ص.138.
(11) «وحي القلم» ص.154.
(12) «وحي القلم» ص.146.
(13) «وحي القلم» ص.154.
(14) «وحي القلم» ص.163-164.
(15) «وحي القلم» من كلام أبو معاوية الضرير ص.167.
(16) «وحي القلم» ص.173.
(17) «وحي القلم» ص.253.







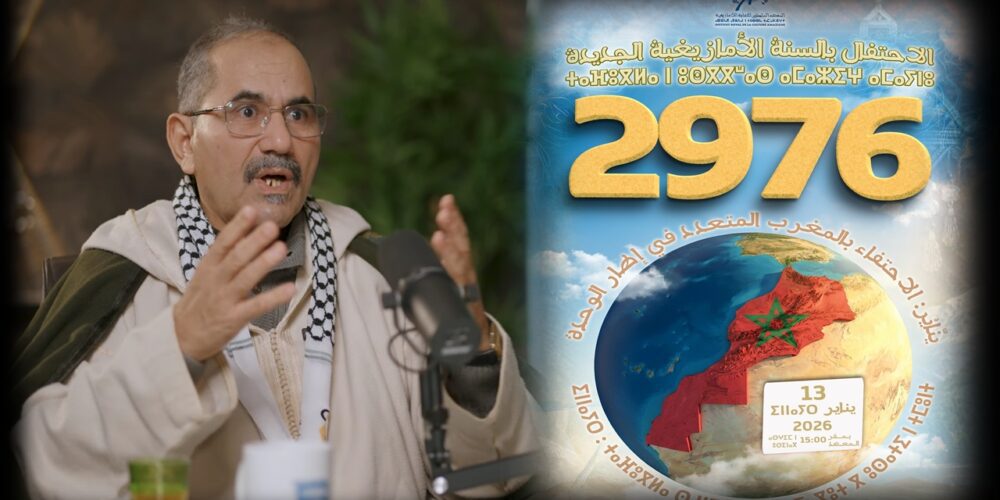

































مقال رائع