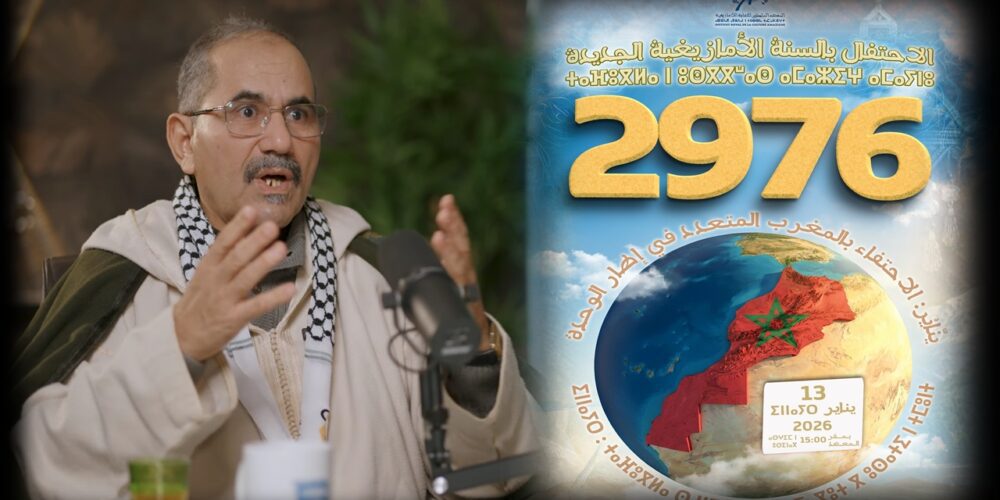العناصر المغربية للمشكلة الأهلية 1930 (3/3)

الـمـهـمــة الـتـعــلــيــمــيــة
هذه المهمة التعليمية، من أهم مستعجلات التنمية، سواء بالنسبة للفتيات، أو كما هو الحال بالنسبة للفتيان، مع التأكيد هنا على ما يتعلق بتعليم الذكور، دون نسيان أهمية تعليم الإناث اللواتي تعتبرن أيضا قوة أساسية، في تطوير البلاد، هذان المسعيان من أكثر المساعي صعوبة في التنفيذ، لأننا نعتمد عليهما بشكل كبير، في زوال التوتر الحالي، ومستقبل المغرب.
ولكن ما هي الأسئلة الرئيسية التي يجب معالجتها؟
وكمثلها، كانت صعبة عندنا، وأصبحت معقدة هنا، مستحيل مثلا إنشاء برنامج واحد، لأننا نتعامل مع المُعَربِين والمبَربَرين، بما ليس في العقل، ولا في “القرآن”، الذي يغرقهم في تفاهة الأولويات.
على العكس، يجب أن نقود كلا الطرفين نحو التقدم المبرمج له، من قبل الفرنسيين، في احترام لخصوصية تعبيراتهم الأصيلة بشكل تامٍّ.
من المستحيل العمل على مبدإ الاستيعاب والفتح، إلا في حالات استثنائية للغاية، أقسام مدارسنا لشباب الأهالي؛ هؤلاء أو آباؤهم يحَمِّلوننا المسؤولية أحيانا، لأنهم يجهلون، أو لا يريدون أن يفهموا، أن مدارسنا مصممة للعقليات، التي اعتادت بالفعل على مرحلة معينة من الحضارة، قد تكون غير ملائمة لاحتياجات العقول، التي تعيش في بيئات مختلفة تماما، ذلك أن أطفال المدارس الأوروبية، يجدون في عائلاتهم امتدادا للتعليم الرسمي، الذي يعجز الوسط الأهلي توفيره لأطفاله.
قد يتساءل أحدهم، ما دعوى الإبتكار؟
“ألا توجد مؤسسات مرموقة محليا، على سبيل المثال في فاس بالقرويين “؟
بالتأكيد، ولكن في إي حالة؟
جاء في الدراسة المعمقة للسيد مارتي (إفريقيا الفرنسية 1924) قوله لنا:
“إن المؤسسة القديمة لا تحمل سوى ذكريات تأثير، عفا عليها الزمن، لأن أساليبها وتنظيماتها صارت بعيدة عن الاحتياجات الحالية.
المسلمون يشعرون بذلك، ويمارسونه عدة مرات، وقد قدموا مطالب للإصلاح، المسألة حسَّاسة؛ فرنسا لا يمكنها أن تمس أسس التعليم الإسلامي الجوهري، دون تشويهِ جمِيع مبادئه مسبقا، لا يمكنها التدخل من الخارج، إن جاز التعبير، مع ضمان الإستخدام السليم للموارد المختلفة، وتجنب إهدار الأموال، والحفاظ بالخصوص على الثروات المادية، التي تشكل تراث القرويين، وهي لا تغفل عن ذلك، يشهد عليه، إنقاذ المكتبة الذي ورد مؤخرا في نشرة (إفريقيا الفرنسية 1929، ص490) والذي لم يكن من الممكن تحقيقه إلا بعد طلب رسمي من مجلس الجامعة وإدارتها.
إمكانياتنا محدودة، لا يمكن للمبادرات المتعلقة بالتدريس أن تأتي إلا من الجامعة نفسها، وهنا يظهر عجز جوهري، عن إحداث أي تغيير تلقائي، الصعوبات التي واجهتها مصر -التي حافظت على تقاليدها الرجعية لسنوات- قبل الإصلاحات، الأزهر الآن في تقليدانِيَّته الرجعية، يلعب في المغرب دورا كبيرا، لأنه بسبب أسئلة الناس، والمنافسات، تقع معارضة تطوير البرنامج الذي تم إعداده له، من قبل جميع المعنيين، بالتنسيق مع سلطة الرقابة، وهكذا يمر الوقت في طموحات لا تتحقق أبدا.
في حين أن المحمية تتطوَّر كل يوم، وهي تدرك ضرورة تحقيق مهمتها التعليمية بإلحاح، لأن أي إخفاق من جانبها في هذا الصدد، ينذر بنشوء أشكَالٍ معينة من التعليم السري، الذي تهيمن عليه مشاعر كراهة الأجانب والتي ستُوَّجه نحْوَنا.
لذلك قررنا إنشاء نظام تعليمي ذي مستويات ثلاث:
مدارس؛ فرنكو-عربية، فرنكو-بربرية، تعادل المدارس الإبتدائة، ومدارس أبناء الأعيان، تعادل المرحلة الإبتدائة العليا، كوليج أو إعدادية إسلامية قريبة من مدارسنا للتعليم الثانوي، يا لها من مهارة في هذا الإنشاء!
في المدينة، يسهل تحقيق هذه الفكرة، لأنها تستجيب لرغبة معينة في التعلم، بسبب فكرتهم الأكثر وضوحا، بسبب بيئتهم المتطورة نوعا ما. في لَبْلادْ (البادية) من المرجح أن يُحدث توْطينها السابق لأوانه، اضطرابا تاما في الناحية، مثال واحد فقط:
أساتذتنا الفرنسيون، على عكس الفقهاء، لديهم وعي كبير جدا بواجبهم المهني، لدرجة أنهم لا يُقَيِّمون استحقاق تلاميذهم حسب الوضع الاجتماعي لآبائهم.
إذا حدث أن ابن الخمَّاس، كان أكثر موهبة، أو أكثر اجتهادا، فإنه يحتل المرتبة الأولى في الفصل، وتبقى الرتبة الأخيرة لابن القايد الكسول المشاغب، فيهاجم الأب، مسؤولي المراقبة باستمرار، بتلميحات أكثر فأكثر.
نحاول أن نشرح له سبب تعثر ابنه، فلا يفهم، أو لا يريد أن يفهم، فيجد الكمندار المكلف بالتهدئة، كلامه غير مسموع، ولا اعتبار لرأيه، مع أنه محل ثقة لحد الآن، فبدل أن يجر الأب أذن الكسول، يشكِّك في حسن نية النصراني.
ألم يكن في مثل هذه الحالات، الإنتظار حتى يبدأ تعليم الأبناء، ليضمنوا للآباء الحصول على مزيد من الإطمئنان؟
تهدف المدارس الأهلية، إلى منح التلاميذ توجيها مهنيا مفيدا للغاية، لتجنب أي تغيير مفاجئ في المشهد، هل هذا كاف؟
يبدو من المرغوب فيه، على الأقل في المدارس الإعدادية، أن يتطور التعليم الثانوي نفسه، حتى يصل لفهم اللاتينية، وفي كل الحالات، لا يتم إلغاؤها تدريجيا بواسطة غزو تمهيدي، في هذه الحالة سيحدث تفاوت في المستويات، ضارٌّ بالتلاميذ والحماية على حد سواء.
عملنا يخشى من العقول المتسرعة، التي تتخذ المبادئ التي لم تستوعب جيدا علما فعالا؛ بل بالعكس يمكن أن يجد مساعدين قيِّمين في العقول التي نَمَا لديها حس نقدي لذاتها، والتي اعتادت على النظر إلى الأمور، ليس من زاوية المنفعة الشخصية المباشرة، بل بموضوعية، وهنا لا يكفي التعليم، بل لا بد من التَّثقِيف، وإنسانيَّتنا هي أفضل مُعِدٍّ، لكل من يدَّعي الوصول الى الحضارة.
ا لـشـبـاب الـمـغـر بـي
علاوة على ذلك، الشباب الذي نشأ في كوليجات الحماية، عنده بلا شك رغبات ذاتية، يطمح للتعبير عنها، وهو يدعمها بحجج وجيهة، كسعيه إلى توفير فرص التعليم العالي (الطب، القانون الخ..).
لماذا لا تكون جميع مطالبه معقولة؟
ولماذا عندما يُتَجاهل تلك المطالب، يقوم مرجوها بتصرفات غير لائقة؟
شباب فاس حسَّاس، ودود، حسن السلوك، وهم يعرفون كيف تكون مرحبة مع أجمل مجاملة، أما الذين هم “أقل من ثلاثين سنة فاستغلوا مرورهم في الكوليجات، كوليج مولاي إدريس، تعلموا لغة فرنسية راقية، وثرية، وتفاعلوا مع أحدَث إنتاج أدبنا، ببراعتهم الفطرية، وروحهم المتمردة، يعرفون كيف يستغلون ترسانة إنتاجنا، لإشباع رغباتهم (وطارتيف) يستوعب المُوضَة، الفاسي يصير آلة حرب في النزاعات الإسلامية تحديدا، نشعر به يرتجف برغبة في العصْرَنة، فورا، وبكل الطرق، وهذا واضح في تفاصيل الزَّي الذي من خلاله، يُظهر اعتماد عادات مختلفة، أو تكرار أفكار جديدة أكثر غرابة.
لا يوجد شيء أكثر تأثيرا من هذا الحماس، الذي يعتبر دليل حيوية فائقة، لوضع العقول في حالة مثالية من التقبل.
لا شيء أخطر على هذه العقول نفسها من الحماس، الذي إذا ترك لوحده، ولم يُوَّجه بشكل كاف، فسيدفهعا للوقوع في كل شَرَك، ومن ثَمَّة إلى كل هاوية.
كيفما كان الحال، فإن التسرع المفرط، وكما شرحت ذات مرة: الواجب في مثل هذه الظروف، الإلتزام بحسن التصرف، من أجل مصلحة التلاميذ، كبار السن، في ظل الحاجة لمعرفة كيفية الإنتظار، لبضعة أشهر أيضا، بعدما انتظر الأسلاف قرونا.
روى أحد رفاقي الشباب هذه الحكاية القصيرة؛ كان ياما كان، كان هناك رجل يحترق حُبّاً لامرأة متزوجة، توسل لها بألف طريقة، لكنها واجهت صعوبة في مقاومة الخطيئة، مهما حاولت أن تثير أمر الزنا أمام المغْوي، مستنزفة حججها الأخلاقية دون جدوى.
في أحد الأيام، بعد يأس مطبق، قبِلت أخيرا، لكن بشرط واحد هو:
“ستصلي صلاة إضافية كل ليلة، لمدة أربعين ليلة، دون أن تفوت ولو مرة واحدة، وبعد ذلك إن كنت ما تزال ترغب في ذلك، فسأكون لك”.
وقع الاختبار، وتم الوفاء به بدقة، في اللحظات الأولى من الأسبوع الأول، وقبل اكتماله، لم ينته الشغف فقط، بل مات العاطفة التي كانت تشعله، ويختم الراوي حكْيَه قائلا:
“لا تجعلنا ننتظر طويلا، حتى لا تخيب آمالنا، فنبتعد عنك”.
دعونا لا نناقش ما يحتويه هذا التحذير المقدم روحيا من إلحاح مفرط؛ دعونا لا نسعى للخوض في تفاصيل معَيَّنة، ولا ما إذا كانت القيمة الزائدة لصلاة الليل لا تعنـي تلميحا إلى حركة الإصلاح الوهابية، أو السلفية الناشئة في المغرب، والتي من شأنها أن تسلط الضوء بشكل أكبر على الشكل المتحيِّز للمثل، دعونا نسجل فقط التعبير الواضح للغاية، عن رغبة للتَّعَلُّم، ورؤية التعليم ينتشر في البلاد.
مهما يكن، فإن هؤلاء الشباب فخورين بالرؤى التي اكتسبوها مؤخرا، بفضل معلميهم الفرنسيين، ومدركين لتفوقهم المرضي على من حولهم، والذي يعتقدون أنه يمنحهم قيمة، ربما يبالغون في رسوخها، ويطمحون بشدة للعب دور مُهم، هل هم موجودون؟ هل استعدوا بما فيه الكفاية؟
يبدو لهم أن المغرب في حالة اضطراب، ما يرونه حولهم من إبداع فرنسا، يمنحهم الثقة بالمستقبل، يقولون: “تقدَّم المغرب، بفضلنا! بالنسبة لي” أحيانا ما يضيفون في السِّر؛ ضمن هذا، هناك عدد لا بأس به من الصفات التي يصفها البعض بأنها عيوب مشتركة، بين جميع الشباب، ولكن أيضا خصائص مميزة، تُضفي عليها هنا سمات خاصة، تميز الأجواء الفاسية، يجذب هذا الفريق التعاطف، الذي إن كان حقيقيا، أي لم يُغفل قيمته أو عيوبه، يسمح بالنقد والثناء.

هذا الشباب طموح لكنه حساس، لديه مزايا، هل يُعترف بها؟
إنه يُعززها أكثر، ألا يمنحون اهتماما كافيًا في نظره؟ إنه مُتَعالِي الطموح، مزايا حقيقية أم مبالغ فيها: الخلاصة، لماذا لا نُوظَّف؟ لكن أين؟ في التسلسل الإداري لبلدِ ما، لتوجيه تطوره السياسي؟
وسط المغرب القديم، حيث في غياب الثقافة لم يمتلك القادة سوى تقاليد عسكرية، وأحيانا أيضا خبرة شخصية مكتسبة، الله وحده أعلم بقدرها وقيمتها، والمغرب الجديد الذي لا تكفيه هذه الصفات.
هذا الجيل لا يوافق على الإعتراف بأنه تم التضحية به قبل الحرب، لأنه يفتقر لنوعية الصفات القديمة والثقافة العصرية، فهو يذهب على الفور للأسهل في كل شيء، على الأقل كما يبدو له في السياسة التي تضع المَرْء في دائرة الأضواء، التي تغري إعلاناته بالتملق الباطل.
على الأقل، ينطلق بثقة في الحافز الذي من شأنه أن يجعل المرء، يشك في قابلية تطوير أهالي شمال إفريقيا، كما لو كان مدفوعا برجعية مظلمة، ولكن حازمة.
طعم السياسة، حب الخطب، هيبة الخطباء، لم يتغير شيء هنا منذ 1800 سنة.
وقد يكون من الأحسن التركيز على الطموحات الأخرى، لتشكيل العقول والقلوب، هناك نقص في الأطباء والمهندسين بالمغرب، هذه المهن صعبة للغاية، ونتائجها غير مرضية، والمزايا الجيدة المكتسبة هناك تفتقر إلى التألق؟
من ناحية أخرى، ما الذي سيستفيده الشباب من الإنزواء في معارضة سرعان ما تتحول إلى كراهية؟
إذا كانوا حريصين على التطوير بدلا من الحفاظ على الفجوة أو حتى تعميقها، فلماذا لا يكرسون جهودهم لبناء جسر بين الماضي والحاضر؟ المغرب كما رأينا في أفضل حالاته من هذا المنظور، تحت رعاية فرنسا الليبرالية والمسؤلة، وبفضل المساعدة التي تبدلها الحماية، يمكنها -الحالة- أن تصبح مُحِبَّة للتقدم المستقر والمنَسَّق، في مواجهة الفوضى، ومخاوف الشرق.
الشباب الذين لا تفكرون، في هذا، ينجذبون إلى التطرف، يصبحون أكثر رشاقة، ويرغبون في التعبير عن أنفسهم من خلال عروض مسرحية، متحيِّزة أحيانا، ويعتقدون أنهم مُفسدون، فيبحثون عن منصة انطلاق نحو غايتهم، يزينهم وضعهم المتوسط في أعينهم، بهالة من الغموض تكفي لتبرير طموحاتهم، ولكن ماذا فعلوا مع مانعيهم من تحقيقها؟
لقد تركوا أنفسهم يعيشون، دون معاناة دائمة، دون رغبة في الخضوع للإنضباط، بدون إكراه كاف، يجعل الفرد منهم يتحكم في نفسه تلقائيا، حتى يتحقق القضاء على الخلافات المستمرة التي تفرقهم، غافلا عن التناقضات، يدعي الإستمتاع بمزايا ثقافتنا دون الإلتزام بها، ونَبْذِ تقاليدها، مدعيا الإستفادة من ذلك أحيانا، تتخيل سيناريوهات سياسية لتلعب دورا، وتُلبَّس شهواتها بذرائع عامة، تستخدم كلماتنا ضدنا، مُشَكِّلة على سبيل المثال، مغربا لم يكن موجودا قط، إقليميا وأخلاقيا وتاريخيا، تدَّعي الدفاع عنه لمصاحها الخاصة وضدنا. في هذا الموضوع حساسيتها مفرطة، وتقودها انحرافات سخيفة، مثل هذه الدعوة الموجهة لا للجنرال كومندار قوات احتلال المغرب، لكن للجنرال كمندار قوة الإنزال في المغرب!
هذه الصبيانية التي تبدو كأنها أفعالاً تدفع أفضل العقول إلى إهمال الشبيبة وتطلعاتها، هل يُنصح بدفن الرؤوس في الرمال؟
لا نعتقد ذلك، لأن واجبنا في التثقيف يجب أن نتجاوز تفاهات القصور، أو الأخطاء الفردية، فتجاهلها ليس حلا للمشكلة؛ لأننا إذا أغمضنا أعيننا عنها، فتحها الآخرون، أو فتحوها ضدنا..
إذا كان لا بد من وجود تواصل دقيق بين الفرنسيين والأهالي، في كل مكان بالمغرب، فيجب أن يكون أوثق مع هؤلاء الشباب، فهم لا يسعون إلى فرض أنفسهم، من خلال المضايقات المزعجة، أو الصراحة المشكوك فيها لكن الذكاءات الثاقبة، قد تكون قادرة على إشباع الرغبة في التعلم التي تحرك هذه المجموعة الصغيرة، لتسليط الضوء على إمكانياتها، وأن القلب المفتوح على مصراعيه، لا يثَبِّط نفسه عن فهمها، بل يجذبها بدلا من ذلك، من خلال الرعاية المستمرة للتعاطف الفعال، وأن اليد الممدودة بقوة، تحافظ عليها في الطريق الصحيح، وتدعمها في مواجهة العقبات، كما تقمع أيضا بشدة أي رغبة في إساءة استخدام التعاطف، الذي يجب أن يكون يقظا، دون ضعف، ليكون فعالا.
ا لـو سـط الإسـرائـيــلـي
هذه الملاحظات تنطبق على الوسط الإسرائيلي، فاليهود أكثر من المسلمين استفادة من عمل الحماية، علاوة على ذلك، فهم مدينون إلى حد كبير لصفاتهم الخاصة، وقدرتهم على التكيف، والميل للمخاطرة على المستوى الإقتصادي، وهي من السمات العامة لمزاجهم.
هل يعني هذا أنهم أكثر تعلقا بنا لهذا السبب؟
عندما وصلنا إلى المغرب فّسِّرت بعض مظاهر الملابس أو تم تفسيرها، على أنها علامات ولاء لنا، بينما كانت في المقام الأول تجسيدا لزوال الشعور بالخوف والخضوع إن لم يكن بانكسار مظاهر العبودية.
الإسرائليون بالغوا في استغلال الوضع، وجعلوه يظهر أحيانا في نظر المسلمين بأبشع تأثير.
كثير من الإنتقادات كانت مجحفة تماما، هناك انتقادات أخرى جديرة بالثناء، لدرجة أنها تبرُز في الذين يلاحظون الخير الموجود فيها مهما كان مرًا، اليهود المغاربة يدينون أكثر من غيرهم، بكل شيء لفرنسا، ويعترف بذلك عدد كبير منهم، لكن ما يزال هناك الكثير منهم حتى بين أكثر الناس عنادا، ممن دون عذر بالجهل، يستخدمون السخرية لنشر جحودهم، متظاهرين بأنهم بعد أن طلبوا حمايتنا من المغرب، طلبوا حماية دول أخرى ضدنا، وكما أشار عالم نفس مُلِمٍّ بالخير والشر، فإن هذه المناشدات للحماية الأجنبية، ضد حماة طبيعيين أو سياسيين، نشأت من التقاليد العامة، ومن التقاليد المغربية، المتكررة أصداؤها عبر العصور.
ومع ذلك تثير اليوم صعوبات فريدة، إذ يكافح هذا النوع من النشر، لتقديم رؤى حول الأحداث الفلسطينية، من غير أن يُلحق ضررا كبيرا بقرائه، أو رعاته الخارجيين، ويزين هذا التقويم، بتناقضات اسمية لتقويم جديد غير متوقع، حقا تشجع هذه المساعدات بني إسرائيل على الخوف من أي شيء يُقرِّبهم منا، خارج نطاق العلاقات الضرورية لشؤونهم، كما لو كانوا يخشون من أن يكونوا إضافة جديدة إلى حضارتنا.
ومن هذه الحالة النفسية، ينشأ هنا أيضا شعور بالضيق، وهو ما تدعمه أيضا التدخلات الخارجية، والزيارات السنوية لنوع من missi dominici القادمة من الشرق، والدعاية الصهيونية التي لا تهدف إلى جمع الموارد لفلسطين، بقدر ما تهدف إلى الحفاظ على التماسك الإسرائيلي، في المغرب نفسه، لمواجهة العنصر الأوروبي، الخ،
كل هذا نادرا ما يتخذ شكلا عدوانيا حادا، بل يتجلى في معارضة كامنة مخفية تحت الابتسامات، أو ضائعة بين سطور جريدة خاصة.
مع ذلك ظلت بعض الاجتماعات مُشينة، وهو ما لم ينكره شيوعيونا، ولتقدير الدور الذي لعبه السيد بوانكاري خلال الحرب، لم يكن أحد المتحدثين قبل عامين، يعرف كيف يستقي مؤهلاته من المصادر المتداولة، في شارع لافاييت أو في بوبينـي،
هذه التجاوزات نادرة جدا، والحماية تراقبها، ولكن سواء كانت صريحة أو مخففة، فإن هذه المعارضة التي لا نوليها دائما أهمية كافية، تشكل في البلاد عنصر إزعاج لعملنا، وعقبة قادرة للأسف على إعاقة أي شيء، مما يؤخر تطوير بناء المغرب.
وهكذا تبدو السياسة الأهلية صعبة التناول، وتزداد صعوبة يوما بعد يوم، مع تعقُّد المشاكل، لذلك فهي تتطلب من القائمين عليها كفاءات تُمكنهم من استيعاب جميع القضايا، بعموميتها وتفاصيلها، إنها تفرض على جميع الفرنسيين، تعاونا يهدف في نطاق كل فرد على حدة، إلى سد الفجوة التي ماتزال تفصل بين مكونات الشعب المغربي، من حقنا أن نطلب من الأهالي تقييما عادلا لجهودنا، وأن تصنف جميع التحسينات التي ندخلها عليهم في المجال المادي، وقد تحققت النتيجة بالفعل، إذ يجري بناء احتياطيات بأشكال مختلفة:
المحاصيل، والقطعان، والملابس، وزيادة الأرباح التي تجاوزت الإحتياجات. ومع ذلك فإن التعاون والارتباط بين الرأسماليين الأوربيين والأهالي، إذا لم يحدث سيؤدي بالنسبة للأخيرين، إلى أزمة خطيرة.
في المجال الفكري، ثم إحراز تقدم كبير، لا بد من تعزيزه، وهي مهمة الغد، لتحقيق أي هدف، قال لي أحد الأهالي:
“أحمل زهرتين في يدي، أنظر إليهما، ما أجمل ألوانهما المختلفة، شُمَّهما دون الخوض في تباين ألوانهما، لن تفقد أيا منهما سحرها، واتحادهما ينتج وحدة مثالية، هو هذا العطر الرائع”.
ما هو المثل الأعلى الآخر الذي نسعى إليه؟
يبدو المغرب بالنسبة لفرنسا حقلا شاسعا، تجلت فيه الرح الفرنسية، وستجد فيه أفضل صفاتها.
الدول التي لا تملك مستعمرات، تجهل المشاكل المطروحة عليها بالمناسبة، وكثيرا ما تصدر أحكامها دون أن تقيِّم تعقيد العناصر أو صعوبة المهام، وتلقي اللوم، وتُنْهي باسم أخلاقيات شكلية بعيدة، فالحياة ليست بهذه الصرامة، وكثيرا ما تؤجِّل العمل، وفرنسا تدرك جيدا تلك الهواجس، التي تؤخر في كثير من الأحيان ذلك الفعل.
بإحلال التهدئة، والبدء في تنمية البلاد، أعددنا المرحلة الثالثة لغزو المغرب، حيث يجب على الإمبريالية الفرنسية أن تجعله غزوها الأخير.
يمكننا نطق هذه الكلمات البالية اليوم، لأنها تعني الغزو الأخلاقي، بواسطة إمبريالية القلب. لنعمل؟
————
- Ladrerr de lacharriere
في :les elements marocains du probleme indigene
في : نشرة؛إفريقيا الفرنسية 1/1930 ص:23-27.
اقرأ أيضا: