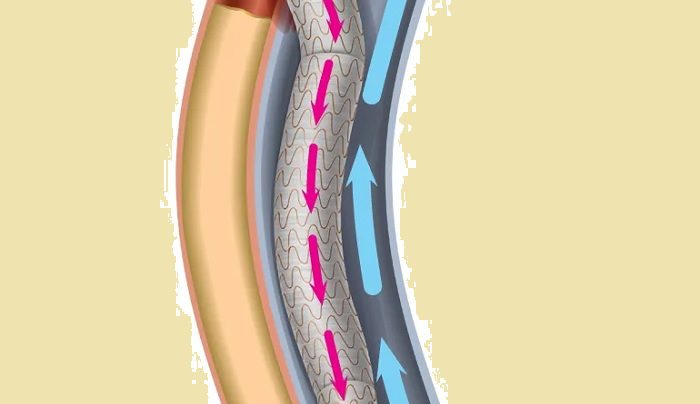المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجتمع المدني: أسئلة الحاضر والمستقبل

هوية بريس – كمال الدين رحموني
بعد مرور عشرين سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي هي أحد الأوراش الكبرى يمكن للمتابع أن يرصُد حدودَ التجاوب بين هذا المشروع الاجتماعي الضخم ، وبين القاعدةِ الاستراتيجية التي بُنِي عليها المتمثلةِ في رافعتِه الأساس التي يمثلها المجتمع المدني، باعتباره جسر التواصل بين الدولة والمجتمع ، فأي طبيعة لهذه العلاقة الناظمة ؟ وما حدود العلاقة بين التصور المؤسس للمبادرة الوطنية والمجتمع المدني ؟ وأي آليات لتقويم الإنجاز الاجتماعي المشترك بين الدولة والمجتمع المدني ، في الحاضر للعبور إلى المستقبل؟ إن من يرصد مشاريع العمل الجاد، الذي يتوخى إحداثَ التأثير المطلوب، وترجمةَ الأفكار والتصورات إلى واقع عملي – تتحرك مفرداتُه بشكل سلس بين قطاعات واسعة- لا يحتاج إلى التخندق وراء الأسوار، ليجعل المستهدَف ينصهر في قالب نمطي يكرر ذاته ، ويشكل اقتناعاتِه ، استنادا إلى تصور معين، يسعى إلى أن يرتبط الفعل بالأسماء والعناوين، فإذا ما انبعث صوتُ هذا الاسم ، أو لمَع نجمُ ذاك العنوان ، تداعى له الأتباعُ بالانجذاب والإطراء ، ويتعزز هذا الأمر حين تسخَّر القنوات التي يُسمح لها بالعمل، لترسيخ خطاب الهيئة أو المؤسسة ، فتسعى ما وسعها الجهدُ لصياغة شخصية نمطية تنتشي بترديد صدى هذا التيار، أو التفاعل مع الناس من خلاله ، ومن ثَمَّ تغدو الهيئة محورا لتحديد الانخراط ، وتحريك الفعل في المشروع الجمعوي انطلاقا من هذا المعطى .
بالمقابل ينبري اتجاه مدني آخر، يتصور أن قضية التطوير والتحسين المجتمعي الإيجابي ، مردُّه إلى القاعدة الأساس التي يُمثِّلُها بضعةُ أفراد يشكلون نخبة في المجتمع ، منهم العلماء والمفكرون والصحفيون والمؤلفون والسياسيون والفاعلون التربويون وغيرهم…. ومن ثم يتأسس هذا الاتجاه المدني على قاعدة النخبوية، التي بالرغم من نوعيتها ، تظل صوتا غير مسموع أو محدودَ التأثير ، ولذلك ينحسر دورها ، فتظل هامشا نخبويا يخاطب الذات أو مَن يُقاسمها الاهتمام بمجال التفكير والنظر، ويقنع بأهداف صغيرة تظل حبيسة العقول والأذهان ، وغالبا ما يأسُرها التنظيرُ العلميُّ الصارمُ المتفرّق في بطونُ الكتب والمُدَبَّجُ في المقالات الرصينة ، ويحتفُّ بها العَرْضُ المُشْبَعُ بجِذوة الانفعال ، وفي كثير من المواقف تتدثَّـر هذه النخب بدثار “الحكمة” و “الواقعية” ، فتبرُّر العجز والقصور بتخلّف المجتمع، أو عدم أهليته للاستجابة ، أو بافتقاد الإمكانات والأدوات لتنزيل هذا التصور أو ذاك ، في الوقت الذي ينتظر المجتمعُ منها التفاعلَ الإيجابيّ، والإجابةَ الملحّة عن كثير من مشكلاته المتعددة ، باعتبار هذه النخب – في الواقع الموضوعي- تمثل قاطرة الوعي في المجتمعات المتطورة. في مقابل هذين الاتجاهين يبرُز اتجاه آخر، يحاول استيعاب الواقع برؤية أصيلة، تستمدّ مضمونها العام من الثقافة المتجذرة في الهوية الثقافية للمجتمع ، لكنَّ هذا الاتجاه – الذي قد يبدو جادًّا في خطه العام، وإنْ لقي بعضَ المناكفة من بعض الفاعلين في الحقل المدني نفسه – من حيثُ كونُه يرتكز على اجتهاد فكري متوازن – فإنه لا يواكب القاعدة النظرية التي يقوم عليها ، أي إن هذا التصور لم يستطعْ بعدُ أن يكسب رهان التنزيل وفق إطار منهجي، لترجمة التصور إلى مشاريع عمل، تستند إلى قواعد منهجية، ولمْ يحدّدْ لنفسه أهدافا بعيدة ومتوسطة المدى ، ومن ثمَّ تتسم آليات التدخل المدني بالانفعالية التي يغلب عليها طابع الموسمية، مع مراعاة المصلحة المادية للهيئة على حساب البعد الاستراتيجي ، في الوقت الذي تعتبر هيئات المجتمع المدني جسرا سالكا لتنزيل مشاريع الدولة التي تمكنت في زمن يسير – من عمر المبادرة الوطنية منذ الثامن عشر من ماي سنة خمس وألفين من استباق الفعل المدني ، في الاستيعاب الحاصل للفئات الهشة ، والاستجابة لحالات الخصاص الاجتماعي – إلى حدّ ما- التي تعتبر إفرازا لحالات المجتمع المتباينة ، من حيثُ التفاوتُ في الاستفادة من خيرات البلاد ، بالإضافة إلى عوامل أخرى كالخلل في التوزيع ، واستئثارِ طبقة الأقلية بفرص الاستثمار والثراء ، الذي تتداخل فيها عواملُ الأنانية، والرغبةُ القاصرة على الذات، دون الإحساس بالضمير الجمعي ، ولذلك تطفو على السطح ظواهر الاختلال التي تكلّف الدولة الكثير، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقيمي ، ومنها-أيضا- آفة الهشاشة وحالات الخصاص التي تترجمها الحاجة الماسة إلى ما تقوم به حياة الناس ، لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم من جهة ، لكنها أيضا- عنصر مهم في الأمن الاجتماعي والسلم المدني ، وهذا ما لا يتأتى إلا باعتماد المنهجية في العمل الاجتماعي ، وأولُ أسسها استثمارُ الخصاص الاجتماعي لمعرفة مطالب المجتمع، والنفاذِ من خلالها لتلبية حاجاته الاجتماعية الماسة ، دون إغفال رصد الخصاص المجتمعي على مستوى بناء الوعي بطبيعة الوجود ، وإدراك الوظائف الأساس ، التي تستدعي جملة من الواجبات نحو الوطن والمجتمع ، وتلك هي النجاعة الفاعلة الهادفة التي تُسبَر أغوارُها بمدى الاستجابة لهذه الحاجات ، التي هي وسائل ضرورية لإيصال الخطاب وإحداث الأثر ، ولكنها – أيضاـ أدوات منهجية في توصيف طبيعة الساكنة من حيث وضعها الاجتماعي. إن الراصد للفعل المدني يخلُص إلى أن غالبية هيئاته – بِتعدُّد أسماءها وانتماءاتها- لا تُعوزها مرجعياتُ التأسيس القانونيةُ، ولا التصورُ المؤطرُ للفعل ، ولا تفتقر إلى الحد الأدنى من الوسائل – خاصة في ظل انخراط الدولة في العقدين الأخيرين في تحريك الفعل المدني من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي جعلت أحد أهم قواعدها الاستراتيجية استحضار البعد الجمعوي – ومن ثم لازالت مؤسسات المجتمع المدني – مع استثناءات قليلة- تعيش حالة من الأسر الذاتي ، فيتحوّل العمل الجمعوي إلى ترفٍ أحيانا، أو ملاذٍ لتمضية جزء من الوقت، أو في أفضل الأحيان ، يصبح فعلا موسميا محكوما باللحظة الآنية ، أو منتدىً نخبويا يخاطب الذات بمعزل عن الاحتكاك اليومي بهموم الناس ومعاناتهم وانشغالاتهم ، أو هيئاتٍ لتصريف التصورات والرؤى، حتى وإن كانت أحيانا تصادم ثقافة المجتمع الذي تستهدفه ، فإن لم يكن هذا ولا ذاك ، فقد تغدو هذه المؤسسات المدنية بوابة للإطلالة على المجتمع بسيل من الأحكام الجاهزة التي تختزل طبيعة القصور والعجز، لتحريك المجتمع بمنظومة مؤسسية ، وفق أهدافٍ مسطَّرَة ، وبرامجِ عملٍ قابلةٍ للتنفيذ مواكبةٍ لتطلعات وحاجات الناس. إن ما ينبغي الحذرُ منه ، هو اعتيادُ المجتمع المدني وأُنْسُه بنموذج رتيب ، يستنسخ الذات ، ويكرّر الفعلَ بالوسائل نفسِها ، فلقد وُصِمَت تجاربُ بعض هيئات المجتمع المدني بتجرّع مخاض التأسيس ، فكان الهمُّ أن يُسمَع لها صوتٌ ، ويوجَدَ لها مكانٌ في ظل مناخ متقلّب، مع ما اعترضها من عوائقَ وتحدياتِ الاستمرار، فاستطاعت – مع ذلك- أن تكسب الرهانين معًا ، لكنها اصطدمت – بعد ذلك – بعائق المنهج الغائب أو المُغيَّب أو المُتجاوَز، باعتبار الرغبة السريعة غير المدروسة في الاستجابة للمطالب الاجتماعية، ولذلك تصطدم مؤسسات المجتمع المدني -اليوم- بأسئلة موضوعية، لا مناص من الإجابة عنها من قبيل ما يلي:
– هل استطاعت مؤسسات المجتمع المدني أن تؤدّيَ الدور المطلوب بمستوى الخبرة والرصيد التاريخي منذ النشأة إلى الآن؟ وهل تمكنت من تطوير الذات ومواكبة المتغيرات، أم إن النظرة التي حكمتها إبان مرحلة التأسيس، هي ذاتها التي تحكمها في الوقت الراهن؟
– هل ارتقى مستوى الفعل المدني ليصبح قوة اقتراحية كما هو الحال في المجتمعات الغربية، وكما تمّ التنصيص عليه في دستورُ 2011 ، أم لازالت تبدو أدواتٍ للتنفيذ وتصريف “الأزمات”، والانفعال بالمواسم والمناسبات؟ -هل استطاع الفعل المدني بعناوينه ومسمياته المختلفة، أن يتخلص من إرث ” الإديولوجية” و المرجعيات المختلفة الضيقة في التفاعل مع حاجات المجتمع الثقافية والاجتماعية والتربوية، أم لازال التَّمترُس الذاتي خلف هذه الاقتناعات حائلا ، بل ومعيقا لكل فعل إيجابي مؤثر ؟
-هل استطاع الفعل المدني أن يتجرد من التصنيفات: السياسية والحقوقية الكونية والحزبية والحركية، ويبلورَ فعلَه على أساس أرضية تشاركية عنوانُها الكبير “المواطنة” ولا شيء سواها ؟
إن استفزاز المجتمع المدني بهذه الأسئلة الموضوعية، لا يمكن أن يغُضّ الطَّرْف عن إبراز المحاسن والمكاسب، التي برز فيها العمل المدني طيلة الفترات الماضية ، لكنْ، ليس من المنطقي الزعمُ ببلوغ العمل المدني سقفَ العطاء أو الادعاءُ بقدرته الناجعة على إحداث التأثير الملموس بالمواصفات المطلوبة داخل المجتمع ، وهو ما عجزت عنه – لحد الآن- الهيئات السياسية ذات الرصيد التاريخي الكبير ، وهو ما تترجمه حالة الانفصام بين هذه الهيئات والمجتمع ، خاصة مع شريحة الشباب التي وجدت ضالتها في التعبير في عالمها الأزرق الذي يحتاج إلى التأطير المدني، وإن من مثالب المجتمع المدني – بأسمائه وعناوينه المختلفة- غيابَ المنهجية الشاملة التي تترجم الرؤية الاستراتيجية في تسطير البرامج، وربطِها بالأهداف وتحديدِ المستهدَفين ، وإنجازِ هذه البرامج وتقويم النتائج ، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في آليات العمل، من أجل استيعابٍ كمي ونوعي بمنأىً عن النظرة الضيقة التي تعلق العجز على الآخرين، وتستبعده عن الذات.