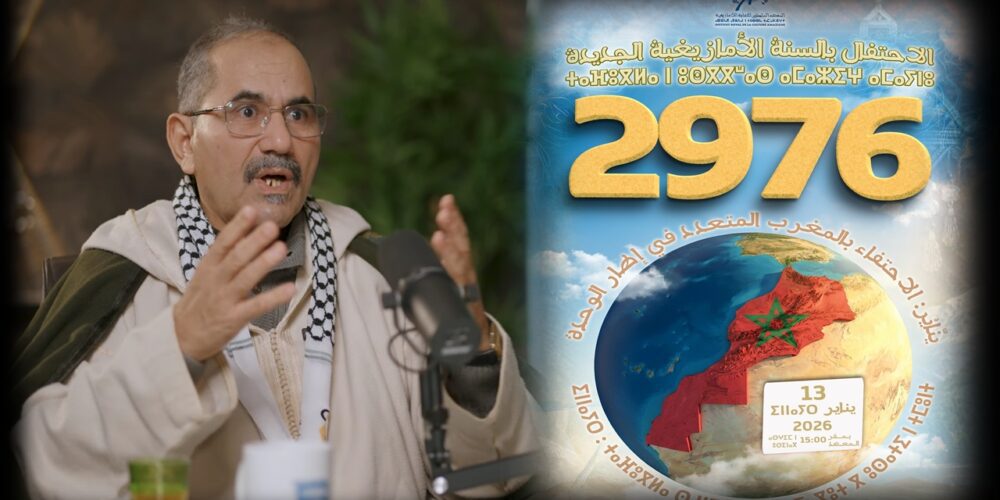لماذا يُحارَب الإسلاميون؟؟

هوية بريس – إبراهيم الطالب
أصدر حزب اليمين المتطرف الفرنسي بقيادة “ماري لوبان” بلاغا تعليقا على قرار السلطات المغربية منع صناعة وبيع النقاب بالمغرب، وَمِمَّا جاء فيه: “مرة أخرى، يأتينا مثال من بلد مسلم على الحزم في مكافحة آفة الإسلامية، بعيدا عن الشعور بالذنب والاعتبارات الإيديولوجية التي تشل المسؤولين السياسيين من اليسار إلى اليمين من خلال سياسة تيسيرية معقولة“.
وما يهمنا في هذا النقل هو كلمة “مكافحة آفة الإسلامية”، ولا شك أن سياسيي هذا الحزب يدركون معنى “مكافحة” ومعنى “آفة” كما يدركون معنى “الإسلامية” أو “الإسلاميين“.
فلماذا يحارب العالمُ الإسلاميين؟؟
ولماذا لا يقبل بوجودهم شريكا في تدبير شؤون الدول؟؟
ولماذا حوربت طالبان حتى أسقط الغرب نظامها بعد أن حازت على اعتراف أربع دول؟؟
ولماذا تحارب السودان منذ تولي الإسلاميين الحكم؟؟
ولماذا شنق عدنان مندريس في تركيا؟؟
ولماذا يحاول الغرب الانقلاب على حكومة أردوغان عسكريا واقتصاديا؟؟
ولماذا تم الانقلاب على جبهة الإنقاذ في الجزائر بداية التسعينيات؟؟
ولماذا رفضت أوربا صعود الإسلاميين في البوسنة والهرسك؟؟
ولماذا تم الانقلاب على مرسي في مصر؟؟
وأزيحت النهضة من حكم تونس؟؟
ولماذا هذا الانقلاب الهادئ على حكومة بنكيران؟؟
كلها أسئلة -وما أغفلته كثير جدا-، تعطي الأدلة القطعية اليقينية أن “الإسلاميين” غير مرغوب فيهم في عالم السياسة الدولية، وأن حكمهم في بلدانهم محارب بقوة من الداخل والخارج.
فلماذا هذه الحرب، ولماذا هذه الكراهية العمياء في التعامل مع كل ما هو “إسلامي”؟؟
بداية من حيث المصطلح، لم يختر الإسلاميون هذا الإسم بل تم صنعه في معامل الفكر والاستراتيجيا الغربية، ويتقصد من يستعمله في مختلف الحقول التداولية، أن يجعل تمييزا واضحا صارما بين “المسلمين” و”الإسلاميين” وذلك تنفيذا لسياسة مسبقة تروم عزل الإسلاميين عن مجتمعاته.
فـ”الإسلامي” بالنسبة للساسة الغربيين ولمراكز الدراسات الغربية هو كل شخص يؤمن بأن الإسلام دين ودولة، وأن المسلمين يجب أن يحكموا بشريعة الله التي أنزلها في القرآن الكريم، وطبقها رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وتعاقب حكام المسلمين من لدن عصر خلافة الصديق رضي الله عنه إلى غاية آخر سلطان تولى الحكم في نظام الخلافة العثمانية حتى إسقاطها من طرف العلماني أتاتورك.
الخلاصة، الإسلامي: هو كل من يرى سياسة دنيا المسلمين بشريعة الإسلام.
ومهما تنازل هذا “الإسلامي” عن قناعاته، ومهما أظهر من مرونة وقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية، ومهما تظاهر بأنه حداثي، ومهما ادعى أنه يمارس السياسة ويمايزها عن الدين في سلوكه السياسي والحزبي، ومهما تنازل عن مرجعيته الإسلامية ليسمح له بممارسة السياسة، فلن يقبل منه ذلك، بل يبقى في نظر العالم مراوغا، ومستغلا للآليات “الديمقراطية” للوصول إلى الحكم ثم يعلن انقلابه على “الديمقراطية”، وإذا تظافرت الظروف والأحداث واضطر العالم إلى إشراكه في اللعبة ووصل إلى الحكم سرعان ما ينقلبون عليه.
أما “المسلم” فهو بالنسبة للغربيين ساسة ومفكرين، هو إنسان يؤمن بدين الإسلام، لكنه لا يطالب بتطبيق الشريعة، ولا يمزج بين الديني والسياسي، ويعتبر أن المسألة الدينية هي أمر شخصي لا شأنا عاما يجب احترامه وامتثال تعاليمه على مستوى تدبير الحكم وممارسة السياسة، بل يعيش حياة تشبه حياة النصراني في فرنسا وأمريكا.
وبهذا التمييز بين “إسلامي” و”مسلم”، يضمن أعداء الإسلاميين في الخارج وخصومهم في الداخل عزلهم عن مجتمعاتهم، وتسهل عملية إقصائهم وإلصاق التهم بهم، بل سجنهم واضطهادهم، بعد إظهارهم للناس بمظهر المخالف لجماعة المسلمين، وبأنهم يستوردون نموذجا للتدين وفهما للدين من بلاد الوهابية أو الشيعة، أو داعش أو القاعدة، وذلك حسب الجهة التي تروج لها وتشيطنها الآلة الإعلامية الدولية.
فالعالم الغربي بعد إسقاط جدار برلين بقيادة أمريكا لم يبق له عدو إديولوجي يحاربه سوى الإسلاميين في بقاع العالم على اختلاف مدارسهم ومرجعياتهم، ولهذا قبل أن يجف حِبر القلم الأمريكي الذي أمضى به رئيس الاتحاد السوفييتي “غورباتشوف” اتفاقية الخضوع لأمريكا، انطلقت الحرب على الإسلاميين فكانت “الحرب القذرة” التي حكى عنها ضابط الجيش الجزائري الهارب إلى فرنسا، ولم تنته إلا وقد أصبحت الجبهة في خبر كان بعد أن كانت تتهيأ للجلوس على عرش الجزائر، ومن ذلك الحين كلما وصلت جماعة للحكم تم الانقلاب عليها.
ولا شك أن الغرب لا يترك بصمات يده في مسرح الجريمة، لأنه على الدوام يلبس قفازين يصنعان في دهاليز السياسات الداخلية لبلداننا، لكن المتتبع للتصريحات التي يدلي بها الساسة الغربيون وزعماء الفكر في الغرب يتبين له أن العداء بين الدول الغربية والإسلاميين أزلي دائم، وأن حماية المصالح الاستراتيجية لتلك الدول تقتضي محاربة الإسلاميين قبل الوصول إلى الحكم، وهو ما يفسر هذا الاهتمام الكبير والمتزايد بالجماعات الإسلامية من طرف مراكز البحث والاستراتيجيا الممولة من صناديق الدول أو من الشركات المتعددة الجنسية والتي يمثل أصحابها نخبة صناعة القرارات في دولهم.
العداء الغربي للإسلاميين هو امتداد للعداء الصليبي للمسلمين، ثم العداء للمقاومة والجهاد إبان حملات الاحتلال الغربي للدول الإسلامية، إنها حرب وجود مهما حاول إخفاءها العالم الغربي بديبلوماسية النفاق وسياسته النفعية في ترويض الحكام وتحقيق التوازنات، وضمان استمرار مصالحه الاستراتيجية في بلداننا.
لقد خرجت الحركات الإسلامية إلى الوجود عقب إسقاط نظام الخلافة الإسلامية من طرف الدول الغربية الكبرى، بعد قرون من الحروب الصليبية وأخرى من حملات الاحتلالات الأوربية، تكللت في النهاية بانتصار الحضارة الغربية التي تعتبر العلمانية نموذجها في الحكم والرأسمالية نموذجها في الاقتصاد، بعد أن ألغت الدين من تدبير شأنها العام، وأصبحت النصرانية بمؤسسات “التبشير” المختلفة أداة من أدوات تفتيت النسيج الاجتماعي والعقدي للدول المستهدفة من طرف الدول الإمبريالية.
فهذه الحركات الإسلامية قادها العلماء منذ السنوات الأولى لحملات الحروب التوسعية، وشكل العلماء والفقهاء نواة كل حركات المقاومة في بلدان الإسلام كما شكل طلبة العلم والمريدون وعموم المسلمين جيوش تلك الحركات، ولهذا نجد السياسي والعسكري المحنك الجنرال اليوطي يقرر هذه الحقيقة بقوله:
“لا أخاف على وضعيتنا إلا من أصحاب هذه الجلابيب والبرانس الذين يترددون على القرويين ليتحلق الطلبة حولهم، فيبثون فيهم من روحهم الإسلامية المتعصبة، قبل أن يلقنوهم دروسا في الشريعة الإسلامية” (قدور الورطاسي؛ ذكريات في الدراسة بفاس ص:50).
“الروح الإسلامية المتعصبة” أو “آفة الإسلامية” أو ما عبر عنه “بول مارتي”(*) بـ”الظاهرة الإسلامية”؛ كلها أسماء لمسمى واحد تمثله اليوم الحركات الإسلامية؛ هذه الحركات التي لا تزال تعتبر رغم التشويه والتضييق والحرب، أمل الشعوب الإسلامية في الخلاص من هيمنة الغرب على مقدراتها وثرواتها، ومن استبداد الحكم الفاسد فيها، ويشهد لما قلناه هذه الثقة الكبيرة التي تحظى بها الحركات الإسلامية لدى مجتمعاتها والتي دلت عليها نتائج الانتخابات رغم كل عمليات التزوير المختلفة التي طالت إرادة الناخب، لذا فلن تتغير نظرة الغرب لتلك الحركات، وتبعا لذلك لن تتغير نظرة الأنظمة التي ربطت مصالحها وسياساتها بمصالح الغرب وسياساته.
فلا عجب إذًا أن نرى هذه الانقلابات المضادة على الحركات الإسلامية التي وصلت للحكم في مختلف بلدان ما سمي بالربيع العربي، فكلها محكومة بتوصيات “بول مارتي” التي ضمّنها في كتابه “مغرب الغد” (ص:241) حين قال: “كل تدخل من قبل الفقيه وكل ظاهرة إسلامية يجب منعها بصرامة تامة“.
فالغرب يحارب “الروح الإسلامية” التي تأبى أن تكون تابعة لغير الوحيين، وهذا منذ كان للإسلام دولة إلى يومنا هذا، فهم يعلمون أن هذه الروح تشكل آفة بالنسبة لهم تهدد مصالحهم الاستراتيجية، وتهدد هيمنة حضارتهم العلمانية، لذا فهناك إجماع عبر العصور وعلى امتداد العقود والقرون على محاربة كل وجود للجماعات الإسلامية للحيلولة دون قيادتها للمجتمعات الإسلامية، فالقيادة الاجتماعية في نظرهم لابد أن تؤدي إلى القيادة السياسية، والقيادة السياسية تقود إلى القيادة العسكرية، والقيادة العسكرية تقود إلى الجهاد والتوسع لاسترداد الملك الضائع والعمل بنظام الخلافة؛ هكذا يفكر العقل الغربي، وهكذا هي نظرة ساسته لقضية “الحركات الإسلامية”؛ ولن يسمح بسهولة أن يسترد المسلمون ذاتهم ووجودهم بعد ما بذله هذا الغرب من أجل إسقاط نظام خلافتهم، من ملايين الأرواح وأطنان الذهب والفضة.
هكذا يفكر العقل الغربي عندما يتناول “الحركات الإسلامية” كمكون يهدد هيمنته على القرارات السيادية في بلداننا.
لهذا، سيبقى العداء هو الأساس الذي يبني الغرب عليه سياسته في تدبير ملفات الحركات الإسلامية سواء تعلق بتدبير حربه ضد ما يسميه “الإرهاب” أو في مقاربة ملفات المشاركة السياسية للحركات الإسلامية في البلدان التي كان يديرها من خلال وزارات مستعمراته.
إنه بات من اللازم أن تعيد الدول العربية النظر في سياساتها تجاه الحركات الإسلامية، وأن تنتهج سياسة يحكمها العقل والحكمة، حتى تجد طريقا وسطا في التعامل والشراكة، قبل فوات الأوان، فلا الدول ستسمح لهذه الحركات بالهيمنة والتفرد بالحكم، ولا هذه الحركات ستسمح للدول بإبادتها وتهميشها، لكن الأكيد أن هناك طريقا ثالثا يمكن العمل من خلاله يكون البقاء فيه للأصلح لدين الشعوب ودنياها، وهذا الطريق الثالث لن يُرضي الغرب بالتأكيد، لكنه الوحيد الذي يكفل السلم الاجتماعي ويحقق الالتحام للوصول إلى الانعتاق، ودون ذلك يبقى طريق الفوضى هو السرداب الذي يقتتل فيه الجميع لا قدر الله.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
إبراهيم الطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بول مارتي: مستشرق فرنسي ولد بالجزائر وخدم ببحوثه ورحلاته واستشارته الإدارة الفرنسية في الجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال وخاتمة حياته كانت بتونس، حيث مات بمستشفى لويس فايان (Louis-Vaillant) العسكري بتونس في 11 مارس 1938.